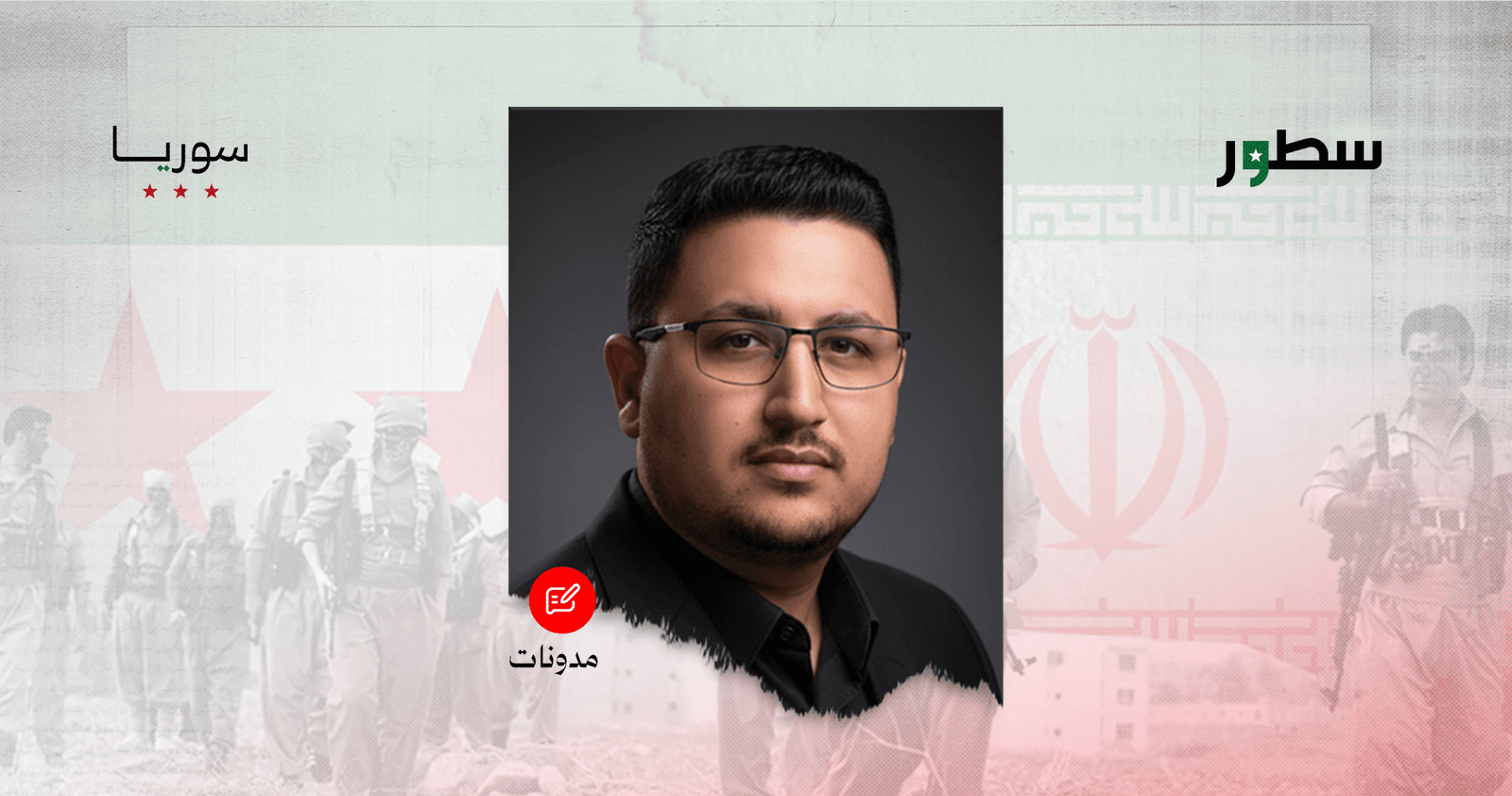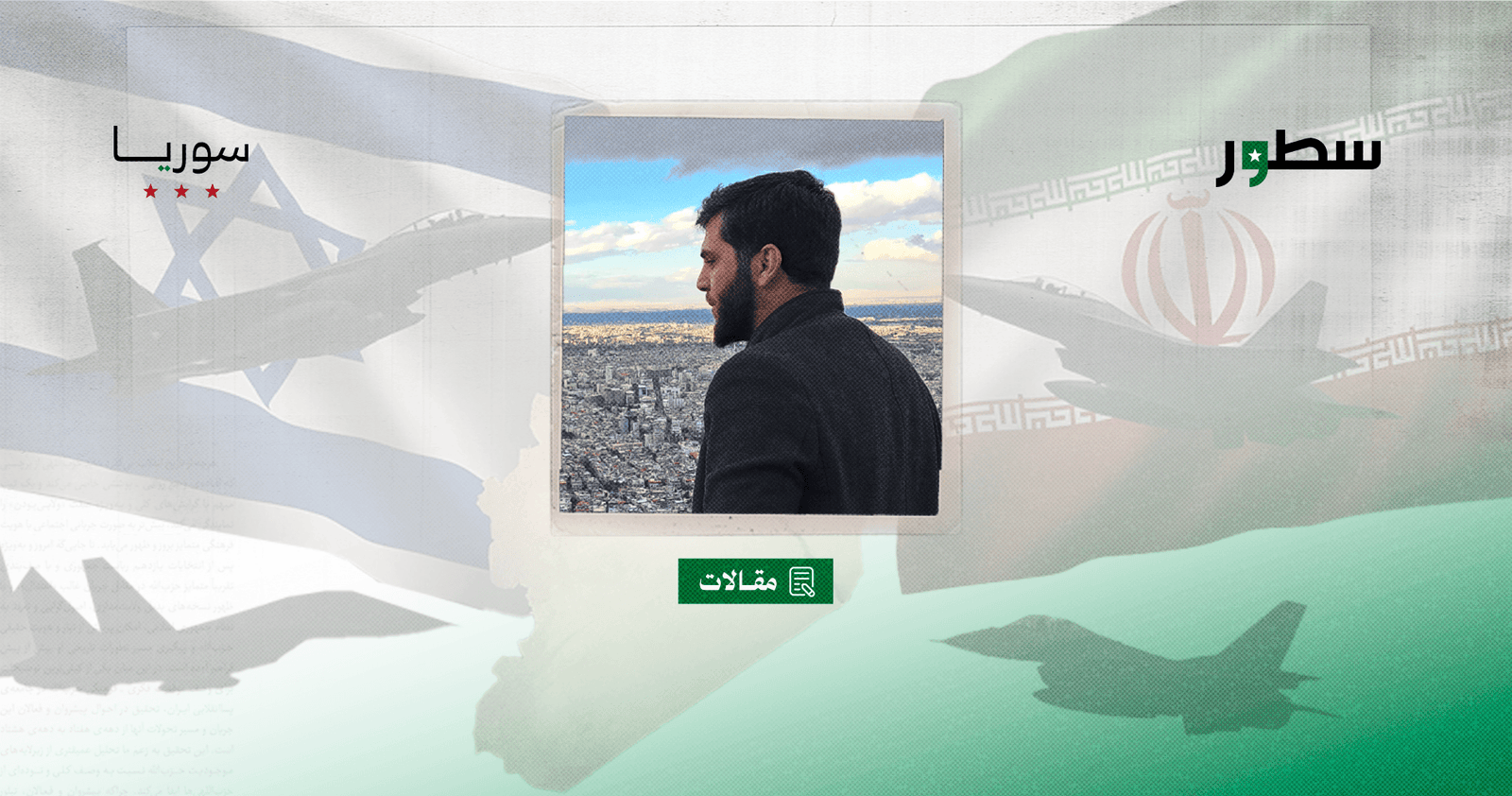مجتمع
مغالطة المفاضلة السياقية.. إرث الاستبداد المتجدد
مغالطة المفاضلة السياقية.. إرث الاستبداد المتجدد
محمد السكري
ظهرت في المرحلة الانتقالية السورية، ظواهر عديدة في المجتمع السوري، والتي تعكس عمق التمزق الذي خلفه الاستبداد، حيث أنتج مجتمعًا تهيمن عليه الريبة والخوف والمطلقات والثنائيات، إحدى أهم هذه الظواهر هي المقارنة بين الحاضر ومرحلة نظام الأسد، يمكن تسمية هذه الظاهرة بـ “مغالطة المفاضلة السياقية” والتي تقارن بين الواقع في المرحلة الانتقالية وبين فترة نظام الأسد، بهدف تبرير الأوضاع الحالية أو التقليل من مشروعية النقد، وتستهدف هذه الظاهرة كلّ من ينتقد، وإن كان نقده بنّاءً، إذ تستهدف هذه الظاهرة النقد من أجل التقليل من مشروعيته ولا سيما عبر تغليف النقد بمقولات تلقى قبولًا اجتماعًيا كبيرًا، مثل “أيام الأسد لم يكن أحد يستطيع النقد” مطالبين بنزع الحق عن النقد، والتقليل من شرعية “حق التعبير” الذي ضمنه الإعلان الدستوري. تبدو هذه المقارنة، في ظاهرها، دعوة إلى الواقعية والاعتدال، لكنّها في جوهرها تُستخدم أداة لإسكات المجتمع وتجميد النقد، من خلال تحويل النقاش العام إلى معادلة صفرية معنا أو ضدنا.
في الأصل، تستند هذه المغالطة إلى قياسٍ غير متكافئ بين مرحلتين مختلفتين جذريًا، فالمرحلة الجديدة في سورية، هي مرحلة الحريات العامة والسياسية، والتي تعتبر أكبر مكتسبات الثورة السورية، بينما المرحلة الماضية هي فترة الاستبداد، ومعايير الاستبداد لا تنطبق على مرحلة الحريات.
إنّ استخدام أدوات التقييم نفسها بين هذين السياقين يعني تجاهل طبيعة التحول ذاتها، والتعامل مع مكتسبات الثورة، كأنّ أسبابها تغيير النظام شكلًا لا مضمونًا. فإذا كان لا بدّ من إجراء مقارنة، فإنّ المرجع الصحيح لا ينبغي أن يكون نظام الأسد، بل تجارب التحوّل السياسي في دول أخرى مرت بظروف مشابهة أو الدول المتقدمة والمتحضرة إن كان هذا ما ترنو إليه سوريا الجديدة.
ولا مانع مثلًا من العودة للحظات التأسيس التاريخي في سوريا خلال مرحلة الاستقلال من أجل القيام بالمقارنة، حيث شهدت تلك المرحلة مستوى عالٍ من الحريات، ففي مذكرات “خالد العظم الجزء الثاني”، يقول العظم” إنّ مواجهة الناس لا تكون في معاقبتهم وإنّما بمزيدٍ من الحرية”.
ومن المفارقات الكبرى عند تفكيك مستويات الظاهرة، أنّها تستهدف حتى الجمهور الذي شارك في الثورة السورية، ويمكن كشف ذلك عبر مستويات الظاهرة.، حيث تتجلّى في مستويين. يبين عمق التحولات البنيوية في المجتمع السوري. ففي المستوى الأول، يتبين استغلال المجموعات التي كانت سابقًا تدعم نظام الأسد هامش الحرية السياسية النسبي في البلاد، من أجل تكميم أفواه المعترضين، أمّا الثاني: فيتجسد عبر قيام مجموعات كانت إمّا رمادية أيّ أنّها لم تبد أيّ موقف ضد نظام الأسد، أو معارضة كانت لنظام الأسد بتكميم أفواه المعترضين.
هذه الازدواجية أنتجت هذه المغالطة، أيّ بالتعامل مع جميع المعترضين بذات المستوى، باعتبار أنّ كلّ من يعترض قد يكون “مجتمع فلول” بالتالي لا يجوز معارضة أيّ قرار حكومي. مع أنّ هناك عينات عديدة من المعترضين من الذي شاركوا في الثورة. كما من الملفت أنّ من يقحمون أنفسهم في هذه المغالطة قد يكونون داعمين سابقين لنظام الأسد، لكنّهم باتوا جزءاً من المجتمع الجديد، وهذا ما يدلل على حجم الانزياح داخل المجتمع السوري، على مستوى المنطلقات المجتمعية والمواقف السياسية.
وبعكس الاعتقاد الذي يرى “أنّ مجموعات الثورة السورية هي التي تقوم بهذه الظاهرة”، فإنّ المجموعات التي تدفع تجاه هذه الظاهرة قد تكون كذلك مجتمعات النظام السابق، ولا سيما تلك التي امتهنت تأييد الأنظمة السياسية، أو المجموعات التي باتت ترى سوريا أفضل ممّا كانت عليه، وهذه الفئة في الغالب هي من مجموعات الكتلة الصمّاء خلال مرحلة الثورة.
هذه الظاهرة تشير إلى مشكلة بنيوية عميقة داخل المجتمع السوري، حيث إنّ المجتمعات الخارجة من الاستبداد تمر في الغالب، بمراحل “إعادة بناء الشرعية” حينها تتداخل أنماط السلوك القديمة بالممارسات الجديدة، فينشأ ارتباك في الهوية السياسية والمجتمعية، بالتالي تكون هذه الظاهرة استمراراً للثقافة الماضوية، ضمن نظرية “الثقافة السياسية”، فالثقافة التي شكلتها المجتمعات الخائفة، تبقى قائمة في مراحل التحوّل بأنماطٍ جديدة، حيث تعتقد المجموعات التي تقوم بالتنميط السياسي، بمحاولة إعادة إنتاج السلطة، لأنّها ترى هذا المسار هو الطبيعي في السياسة، بالتالي تبقى لغة التخوين والتصنيف أدوات مهمة لإعادة ما تراه هذه المجتمعات “طبيعي” أيّ الاستبداد.
وتنطلق اعتقادات هذه المجموعات، من إدراك ما يريد النظام السياسي، فتفترض أنّ تنميطها وهجومها على المعترضين، قد يلقى إشادة من النظام السياسي القائم، لأنّ المعيار الذي تنطلق منه، هو الثقافة السياسية الماضية التي شكّلها نظام الأسد، وعلى خلاف الاعتقاد الشائع بأنّ مجموعات الثورة السورية هي التي تغذي هذه الظاهرة، فإنّ المجموعات الأكثر إسهامًا فيها غالبًا ما تنتمي إلى البيئات الاجتماعية للنظام السابق، خصوصًا تلك التي امتهنت تأييد السلطة على نحو دائم، أو الكتلة الصمّاء، التي ظلّت على الهامش طوال فترة الثورة، لكنّها اليوم تشكّل قوة رمزية تعيد إنتاج مفاهيم “الاستقرار” و”الطاعة” في الوعي العام.
وفي سيكولوجيا الفرد الذي يقوم بهذا التنميط ممّن دعم نظام الاستبداد في الماضي، ويعيش في مرحلةٍ انتقالية جديدة، عندما يعاني من تناقض داخلي بين قناعته السابقة والواقع الجديد، من أجل تجنب الشعور بالذنب أو الخطأ. يبرر هذا الفرد موقفه السابق عبر اتهام المعارضين بأنّهم فلول، بالتالي يسقط تناقضه الداخلي على الآخرين، لأنّ الأفراد في البيئات السياسية المضطربة في الغالب ما يميلون تجاه تصنيف أنفسهم والآخرين إلى ثنائية “نحن هم”، من أجل إحساسهم بالتفوق الاجتماعي، ممّا يعني أنّ هذا النمط في الظواهر دوافعه التفوق والدفاع، وفي إطار فكرة “الدفاع” لسيغموند فرويد المفكر النمساوي المؤسس لعلم التحليل النفسي نظرية “آلية الإسقاط النفسي” الذي يقول فيها إنّ الإنسان يسقط عيوبه أو مخاوفه على الآخرين كي يتجنب مواجهتها داخليًا، وهي ما تثبت دوافع هذا السلوك.
في المحصلة، إنّ أخطر ما تتركه هذه المغالطة من آثار سلبية هو إضعاف الحس النقدي العام والمراقبة الشعبية، وإعادة إنتاج ثقافة الخضوع والصمت، عبر إيهام الناس بأنّ المطالبة بالإصلاح أو الاعتراض السياسي هي شكل من أشكال الجحود أو النكران. وهنا يتحوّل الخطاب العام إلى ساحة تبرير لا مساءلة، ويختطف صوت المجتمع لصالح استقرار زائف، من ثمّ، فإنّ النقد البنّاء والمعارضة في المرحلة الراهنة لا يعدّان إنكارًا للماضي، بل شرطًا لتجاوزه. فبقدر ما يتسع المجال للنقد والمساءلة، تزداد فرص بناء نظام سياسي أكثر نضجًا وعدالًة. والمجتمعات التي لا تتصالح مع ماضيها بالنقد والتحليل، تظل رهينة لآلياته النفسية والثقافية.
تعكس هذه الظاهرة التحوّل الاجتماعي العميق الذي يشهده المجتمع السوري في مرحلة الانتقال، بين إرث الاستبداد ورغبة التغيير، وبين البحث عن الاستقرار والخوف من المجهول. وهي بذلك تعطي مثالًا واضحًا على التفاعل المعقد بين البنية السياسية والوعي الجمعي في المجتمعات التي تخرج من الاستبداد.
إنّ تجاوز هذه المغالطة لا يتطلب فقط تفكيك خطابها السياسي، بل أيضًا تحرير الوعي الاجتماعي من إرث المقارنة الخاطئة، وضرورة مواجهة هذا الظواهر التي قد تعيد صناعة الاستبداد، والانتقال من ثقافة المفاضلة إلى ثقافة المساءلة والمراقبة والمشاركة من الواقع نفسه. فالمستقبل والحاضر لا يُبنيان على المفاضلة بين السيئ والأسوأ، بل على الإصرار الدائم في تحقيق أفضل الواقع والأقرب للمثالي، وحلم المثالي، وتثبيت مبادئ الثورة السورية “الحرية أولًا” وضمان “حقّ التعبير”.