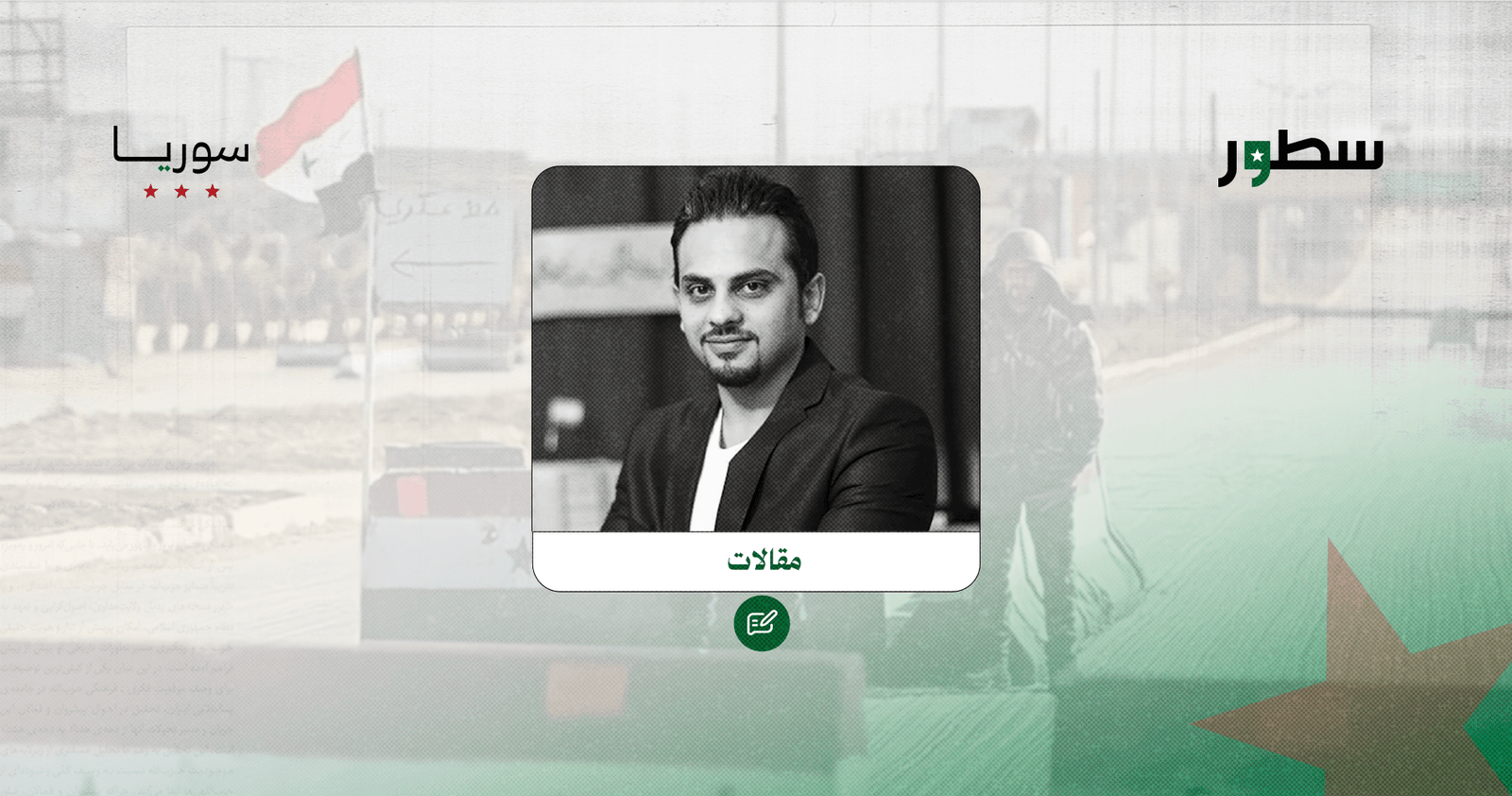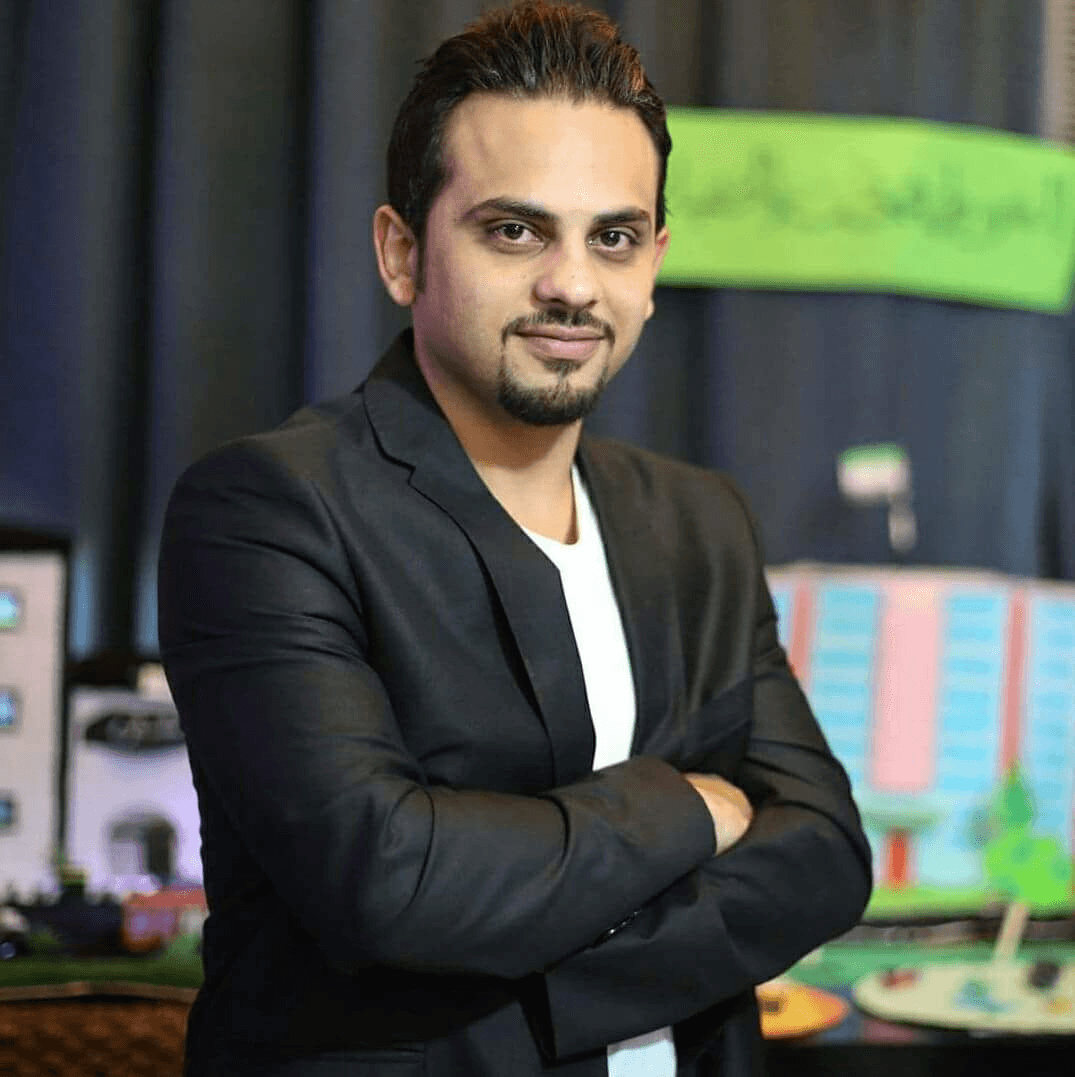سياسة
بيضة القبَّان.. هل تحقق سوريا توازناً سياسياً؟
بيضة القبَّان.. هل تحقق سوريا توازناً سياسياً؟
لم تقل موسكو إنها منزعجة من دخول الرئيس السوري إلى البيت الأبيض، ولم تحتجّ، بل قالت بوضوح: “نحن نُطوّر علاقتنا مع سوريا، بغض النظر عن اتفاقاتها مع واشنطن.” لم يكن في ذلك رسالة عدائية، بل إشارة مضمَنة إلى أن موسكو تعرف، تماماً، أنها لم تعد وحدها في دمشق، وتعرف أكثر أن سوريا نفسها لم تَعُد تنتظر ضوءًا أخضر من أحد. في المشهد الظاهري، الأمر لا يبدو جللاً: رئيس دولة زار عاصمتين متنافستين خلال شهر واحد، تبادل كلمات، وعاد. لكن في العمق، ما حدث لم يكن مجرد إعادة فتح خطوط، بل إعادة تركيب موقع. سوريا، التي كانت لسنوات ساحة اختبار لمشاريع الآخرين، تُقدَّم اليوم، ولو ببطء، كفاعلٍ يحاول ضبط توتّر القوى، لا الخضوع لإحداها.
هي ليست قوية بما يكفي لتفرض توازناً إقليمياً، ولا تملك عمقاً اقتصادياً يجعلها لاعباً أول، لكنها تدرك أن الهامش، حين يثبّت نفسه، قد يصير مركزَ عبور، وأن الأطراف إذا أحكمت موقعها، قد تُجبر الأقطاب على الميل. لم تخرج دمشق من الحرب بانتصار صافٍ، ولا بتسوية كاملة، لكنها خرجت بعنصر نادر: قدرة على الحركة بين الخصوم دون انهيار فوري. فهل هذه قدرة حقيقية؟ أم مجرد فراغ في اللحظة الدولية تُملؤه أي دولة لا تقع؟ وهل تزن سوريا فعلًا شيئًا؟ أم أن وزنها مشروط فقط بغياب البدائل؟
هكذا تُطرح اليوم مسألة “بيضة القبّان”: لا كصورة بلاغية، بل كأفق سياسي لدولة تحاول النجاة لا بالتحالف، بل بالتوازن. في هذا المقال، نحاول أن نشرح كيف تدير سوريا الجديدة هذا التوازن بين واشنطن وموسكو وبكين، وكيف تحوّلت من ملف تفاوضي إلى مسار قائم بذاته، يُقاس لا بما تطلبه، بل بما لا تتنازل عنه.
القوة والقبول: كيف تُعامَل سوريا في مراكز القرار؟
في أزمنة الحرب، كانت العواصم تُقيس سوريا بعدد الجبهات المشتعلة فوق ترابها. في أزمنة التسوية، تقيسها اليوم بعدد الأبواب التي يُفتَح لها دخولها. وبين موسكو وواشنطن، بدا أن دمشق لم تعُد مجرّد ملف ينتقل من يدٍ إلى يد، بل باتت -على الأقل من منظور بعض اللاعبين- طرفاً يستحق الجلوس إلى الطاولة.
زيارة الرئيس السوري إلى موسكو، قبل أسابيع من دخوله البيت الأبيض، لم تكن بروتوكولية. في البيان الرسمي تحدّث الطرفان عن “إعادة تعريف العلاقة”، وهي عبارة لا تُقال لحليف مستمر، بل تُخصّص لحالة تغيّرت. موسكو تعرف أن دمشق لم تعد حصرية الولاء، وتعرف في الوقت نفسه أنها لا تستطيع التخلي عن شراكتها معها. ما حصل خلال اللقاء، من تأكيدات على التعاون العسكري والطاقة، إلى تنسيق أمني غير علني، لم يكن هدفه “الاحتفاظ بسوريا”، بل الإبقاء على موقع ثابت في نظام دولي بدأت خرائطه تنزاح.
ثم جاءت زيارة البيت الأبيض، الأولى من نوعها منذ عقود، لا بوصفها خصمًا لموسكو، بل بوصفها استمراراً لمسار الانفتاح المدروس. لم تطلب واشنطن من دمشق أن تغيّر تحالفاتها، بل أن تضبط حدودها، وأن تفصل مساراتها عن حلفاء كانت جزءاً من منظومتهم. في المقابل، لم تعرض صفقة كاملة، بل عرضت خطوات: تعليق جزئي للعقوبات، دعم لمشاريع الإعمار عبر وسطاء، واعتراف ضمني بأن القيادة الجديدة قادرة على إدارة شراكة مشروطة، لا اصطفاف محسوم.
هذا الشكل من “القبول المتحفظ” ليس اعترافًا كاملاً، ولا شراكة مكتملة. لكنه يعني -ولو مبدئياً- أن سوريا، بقيادتها الجديدة، لم تَعُد تحت مستوى الرؤية، وأن من يريد أن يمرّ بالمنطقة، عليه أن يمرّ بها أو منها. ليست هذه قوة صافية، لكنها تشبه القوة حين تُمارَس من مكان ثابت، لا من موقع مُنهك. والشرع لا يأتي إلى الطاولات الدولية بوصفه مجرّد وريث لخراب، بل كممثل لدولة تعرف أنها وُلدت من ركام الاصطفافات، وأن بقائها مرهون بقدرتها على إدارة تناقضاتها، لا تبنّي أحدها.
المال والدور: من اقتصاد مدمّر إلى حافة الجذب
لم تكن الدولة السورية الجديدة بحاجة إلى استعادة كل مؤسساتها كي تبدأ بالتفاوض على موقعها الاقتصادي. ما امتلكته، ميدانيًا، كان يكفي لصياغة شروط أوليّة: استقرار نسبي على الأرض، بنية إدارية قابلة للترميم، وخطاب خارجي يتجنّب الصدام الحادّ مع مراكز المال. لم تعرض دمشق “خصخصة القرار” مقابل التمويل، لكنها أيضًا لم ترفع شعارات الكفاح المستمر. وهذا تحديدًا ما منحها موقعًا رماديًا مفيدًا: ليست على رأس لائحة الأولويات الغربية، لكنها أيضًا ليست خارج دفاتر الاحتمالات.
مع الأشهر الأولى لمرحلة ما بعد التحرير، بدأ رأس المال بالاقتراب، لا من باب المغامرة، بل من باب التوقيت. الأوروبيون، الذين لم يعلنوا دعمًا سياسيًا مباشرًا، بدأوا بتليين قيود التحويلات الإنسانية، وبتشجيع بعض الشركات على الدخول في مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية. لكن الانفتاح الحقيقي جاء من الخليج، وتحديدًا من السعودية، التي تعاملت مع الدولة السورية الجديدة كجزء من هندستها الإقليمية لا كعبء يجب احتواؤه.
في وقت مبكّر، أعلنت الرياض -على لسان وزير الاستثمار السعودي- أن العلاقة مع دمشق “لم تعد علاقة جيرة فقط، بل علاقة رؤية”، مشيرًا إلى أن “توجيهات الأمير واضحة: سوريا اليوم هي الرياض”. لم تكن هذه كلمات رمزية، بل ترجمتها الميدانية جاءت على شكل صندوق تمويلي مشترك، واتفاقيات واسعة في قطاعات الطاقة والإعمار والتكنولوجيا والبنى التحتية، فضلاً عن دعم مالي غير مباشر في ملفات الرواتب وإعادة فتح الاعتمادات الائتمانية الدولية.
دمشق، من جهتها، لم تعرض بلادها للبيع، لكنها فهمت مبكرًا أن المال ليس تابعاً للسياسة دائماً. أحياناً، يسبقها. بل إن الدولة الجديدة استخدمت هذا التناقض بذكاء: لم تربط شراكاتها بشروط أيديولوجية، ولم تضع سقوفاً حادة للتعاون، بل تركت الباب مفتوحًا لكل من يملك تمويلًا بلا وصاية. وهذا بالضبط ما جعلها قابلة للجذب: قوة محدودة، لكنها مستقرة نسبياً؛ قيادة لا تملك فائض نفوذ، لكنها لا تُدار من الخارج.
في هذا المعنى، لا يُمكن اعتبار التحوّل الاقتصادي السوري مجرّد نهوض تقني، بل جزءاً من معركة التموضع السياسي. فحين تنجح دولة خارجة من حرب طويلة في جذب المال دون التنازل عن قرارها، فهي لا تعيد بناء بنية تحتية فقط، بل تعيد تشكيل موقعها في خريطة العالم.
الصين: طريق طويل لا يمرّ بالتعليمات
من بين القوى الثلاث الكبرى التي تتقاطع في الساحة السورية الجديدة، تُعتبر الصين هي الأقل صخباً، لكنها في الوقت ذاته الأكثر اتساقاً في السلوك. بكين لم تُراهن على انتصار طرف بعينه خلال الحرب، ولم تتورّط في الصدامات المباشرة، لكنها راقبت من كثب، وحين بدأت ملامح الدولة الجديدة بالظهور، تحركت بسرعة مبرمجة، ومن دون ضجيج.
المقاربة الصينية ليست جديدة تماماً، لكنها تتكثّف اليوم في سوريا: لا تدخل في الهياكل، لا اشتراطات سياسية مسبقة، لا استنساخ لنموذج. ما تريده الصين من دمشق هو ما تريده من أي نقطة في خريطة “الحزام والطريق”: ممرّ مستقر، لا يعيق التدفّق، ولا يستنزف الطاقة. ولهذا تحديدًا، كان تحرك بكين نحو الدولة السورية الجديدة خاليًا من التوترات، مليئًا بالحسابات.
في الأشهر الأولى بعد إعادة تشكيل السلطة، زار وفد اقتصادي صيني رفيع دمشق، ووقّع مذكرات تفاهم في مجالات البنى التحتية، والنقل، والاتصالات، والطاقة المتجددة. اللافت لم يكن نوع المشاريع، بل منطق التعامل: الصين لا تسعى لفرض أجندة، بل تشتري مساحة استقرار طويل الأمد. ودمشق، بدورها، لا تطلب حماية، بل استثمارًا بلا شروط. هذا التلاقي البارد، بين قوة عظمى تصدّر التمويل بلا خطاب، ودولة خارجة من حرب تبحث عن مال بلا وصاية، هو ما يجعل العلاقة قابلة للاستمرار.
وتُوّج هذا المسار بلقاء رسمي عُقد في بكين في 17 تشرين الثاني، جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الصيني وانغ يي، حيث أعلنت الصين صراحةً أنها “تحترم خيارات الشعب السوري”، وأكدت استعدادها “للمساهمة في أمن واستقرار سوريا” و”بحث المشاركة في إعادة بناء الاقتصاد”. لم تكن هذه التصريحات مجرد مجاملة دبلوماسية، بل إعلان ناعم أن سوريا باتت على خريطة بكين، لا كملف سياسي بل كشريك تنموي ضمن رؤيتها الكبرى للمنطقة.
لا تقدم الصين غطاءً سياسيًا لسوريا كما تفعل روسيا، ولا تضغط عليها لإعادة رسم تحالفاتها كما تحاول واشنطن. لكنها تمنحها ما هو أثمن في لحظة ما بعد الحرب: نافذة اقتصادية محايدة، قد تتحول، تدريجيًا، إلى سند جيواستراتيجي في قلب مشهد مضطرب.
الهندسة الدقيقة: كيف تُدار السياسة الخارجية الجديدة؟
ليست المشكلة في المحاور فقط، بل في ثقلها. فحين تقع دولة ما تحت محور، فإنها لا تتحمّل ثقله وحدها، بل تتحمّل أيضًا رد فعل المحاور الأخرى. وسوريا، التي دفعت ثمن التبعية سابقًا، تحاول اليوم -ضمن حدود الممكن- أن تبني نمطًا سياسيًّا جديدًا: لا يقوم على الانحياز الحادّ، ولا على الحياد السلبي، بل على توزيع الوزن. ما تفعله دمشق الجديدة ليس انسحاباً من الساحة الدولية، بل انخراطاً محسوباً مع الجميع، من دون استنزاف لصالح أحد.
في أقل من عام، استعادت سوريا خطوط التواصل النشطة مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو ثم واشنطن، بعد لقاء فرنسي في باريس، ثم زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لندن لافتتاح السفارة والمجلس السوري البريطاني للأعمال، وصولًا إلى لقاءه مع نظيره الصيني في بكين بعد أيام فقط. لم يكن ذلك مساراً تلقائياً، بل كان هندسة واعية: فتح متزامن على الجميع، من دون دخول في أي منطق استلحاق.
وما يُثبت أن هذا الانفتاح ليس مجرّد رغبة شكلية، هو مضمونه الاقتصادي والسياسي. فالمباحثات مع باريس دارت حول التعليم والصحة، ومع لندن حول الاستثمار والبيئة القانونية، ومع بكين حول إعادة الإعمار واحترام السيادة. لم يكن لأي من هذه اللقاءات طابع تبعي، بل كانت كلها محكومة بمبدأ واحد: الشراكة بلا وصاية.
هكذا، تتبلور السياسة الخارجية السورية الجديدة كفن إدارة لا كمجرد موقف. فالدولة الخارجة من الحرب لا تسعى لعزل نفسها عن العالم، لكنها في الوقت نفسه لا ترغب في إعادة إنتاج لحظة الارتهان. وما تفعله اليوم، رغم محدودية أدواتها، هو السعي لبناء مجال حركة قابل للاتساع، قائم على فهم دقيق لمصالح اللاعبين، ومحكوم بإرادة عدم السقوط مجددًا في مطبّ الاصطفاف.
ولأن اللعبة شديدة الحساسية، تبدو خطوات دمشق محسوبة بدقة: لا تستفزّ موسكو، ولا تعادي واشنطن، ولا تهمل بكين، ولا تنجرّ وراء مشروعات بديلة. وكل هذا، لا يصنع نفوذًا فوريًّا، لكنه يبني شيئًا أكثر أهمية: قدرة على المناورة، وربما لاحقًا، قدرة على صياغة التوازن بدل الخضوع له.
المفترق الهادئ: هل يمكن لصوت صغير أن يضبط ميزاناً كبيراً؟
لم يكن هدف سوريا الجديدة أن تصير قطبًا، ولا أن تُفرض على مائدة الكبار. كل ما فعلته، حتى الآن، هو تثبيت مقعد، وإن لم يُمنَح رسمياً. هذا المقعد لا يُقاس بحجم الاقتصاد، ولا بعدد الحلفاء، بل بالقدرة على الحركة داخل زحام الخصوم، دون الانكسار لأحدهم. وهذا، بحدّ ذاته، ليس إنجازاً بسيطاً.
في اللحظة التي تعثّرت فيها خرائط كثيرة، واهتزّت محاور كانت تُعتبر ثابتة، برزت دمشق بهدوء. لا باعتبارها بديلاً لأحد، بل باعتبارها نسيجاً ثالثاً: دولة تعرف من أين جاءت، لكنها لا تسمح للماضي أن يكتب وجهتها القادمة. وهذا النمط، حتى لو كان صغيراً في مداه، يحمل إمكانيات كبرى في لحظة عالمية مشبعة بالتردد والتقلب.
هل تزن سوريا اليوم فعلاً؟ في المقاييس الكلاسيكية للقوة، ربما لا. لكنها تزن بما يكفي ليحسب الآخرون حساب صمتها، وأن يتعاملوا مع حيادها كعامل استقرار. وهذا لا يصنع توازنًا كاملاً، لكنه يمنحها دورًا: دور بيضة القبّان.
في النهاية، لا تملك الدولة السورية الجديدة رفاهية الغياب، ولا أدوات فرض الإملاء. لكنها تملك شيئاً نادراً في سياستها المعاصرة: وعياً متراكماً بأنها إن لم تتموضع، ستُوضَع؛ وإن لم تبنِ توازنها بنفسها، فسيُبنى ضدها.