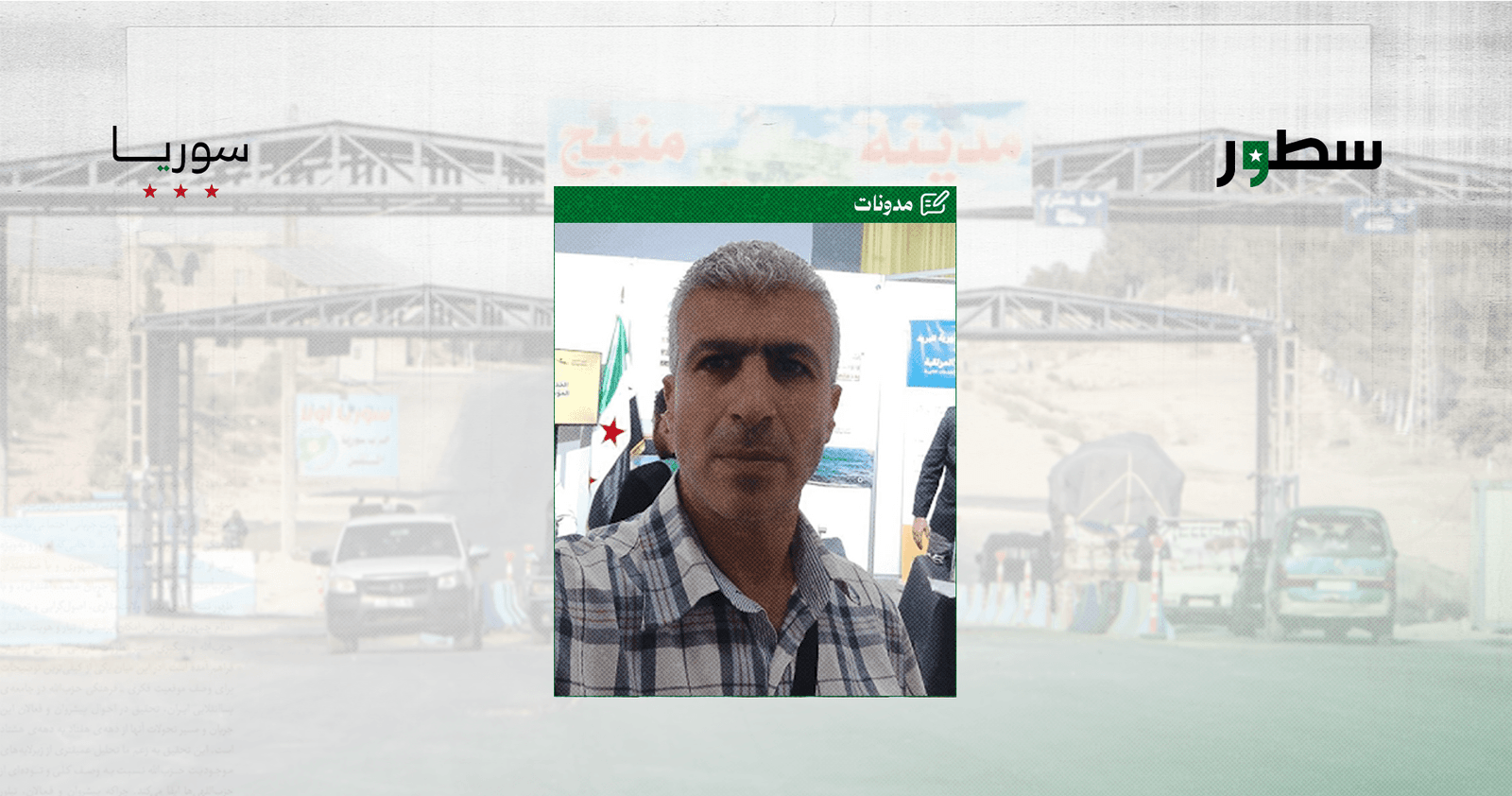مدونات
منبج وثلاثية القوى المتعاقبة على مؤسساتها
منبج وثلاثية القوى المتعاقبة على مؤسساتها
يونس العيسى
تُعد أزمة المؤسسات في مدينة منبج من أكثر الملفات المتشابكة بعد تحرير المدينة من تنظيم قسد، إذ تحوّلت مؤسسات المدينة، على اختلاف اختصاصاتها، إلى ساحةٍ مفتوحة للصراع الوظيفي تتشابك فيها الارتباطات الوظيفية والجهة المؤسساتية، وينقسم موظفوها بين التابعين إداريًّا لمؤسسات نظام الأسد البائد وآخرين كانوا يتبعون للمؤسسات التي أنشأتها الإدارة الذاتية لتنظيم قسد.
فمنذ احتلال داعش للمدينة ومن ثمّ قسد، دخلت البلاد في مرحلة ضبابية بلا مسار واضح، تصاعدت خلالها الانقسامات، وظهرت اختلالات بنيوية أعاقت بناء مؤسسات موحدة يتنافس موظفوها على الشرعية. فقد شهدت المدينة تحولات كثيرة، وأصبح كيان مؤسساتها متعدد المرجعيات ومرهونًا بقوى المجموعات المسلحة التي تسيطر عليها.
تحررت منبج من سيطرة نظام الأسد عام 2012، وأدارها أبناؤها الأحرار بشكل مدني، محافظين على مؤسساتها وخدماتها. لكن سرعان ما تسلل إليها تنظيم داعش وأصبحت في قبضته، إذ شن حربًا شرسة على ثوارها فقتل الكثير منهم وشرّد البقية نحو الشمال السوري، وبعده تدخلت قوات قسد المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لطرد التنظيم والسيطرة على المدينة.
تعاقبت هذه القوى على منبج، من داعش إلى قسد، ما ألقى بظلاله الثقيلة على المدينة، تاركًا إياها في حالة مزرية، حيث بات مصير أهلها مرهونًا بسلطة الأمر الواقع التي فرضتها هذه التنظيمات المسلحة، ممّا أدى إلى استنزاف مواردها البشرية والمادية لصالح أجنداتها الخاصة.
تلك الظروف التي شهدتها مدينة منبج وترسبات قوى الاحتلال التي تعاقبت بالسيطرة عليها جعلت المجتمع المنبجي في مواجهة تحديات وإشكالات عديدة سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية فرضت نفسها على واقع المدينة وعلى مدى استقرارها.
ولعل أهم تلك الإشكالات التي شكلت كابحًا أمام بناء مؤسسات المدينة كافة هي إشكالات ثلاثية ومركبة، انطلاقًا من أنّ تحقيق البناء الذاتي للموظفين يُعد حجر الزاوية في تأسيس أركان المؤسسات إلى جانب الأبعاد الأخرى.
وبعد تحرير المدينة، ظهرت كلّ أمراض مؤسساتها ولم تستعد عافيتها كما يجب نتيجة إرث قوى الاحتلال المتعاقبة، فقد مر على البلد أكثر من سلطة أمر واقع: نظام الأسد البائد، وداعش الباغية، وقسد المحتلة.
والبعض من أهلها تعايش وتخضرم مع السلطات المتعاقبة وقلّد الكثير منهم منهج تلك السلطات، وأصبح كثر منهم من جماعة “باقية وتتمدد”، وبنهاية التمدد وحضور قسد أصبحت نفس الجماعة الدينية “ديمقراطية” وينادون بأخوة الشعوب، ومن تشرد وهُجّر من الثوار صار بنظرهم عميلًا ومرتزقًا.
منهج التكويع بعد التحرير كان أمرًا لا بدّ منه، ولكن ما يثير العجب أن نفس الفئة التي تخضرمت مع السلطات الثلاث السابقة بدّلت قناعها وأصبحت تُزاود على ثوارها، وأصبح عنبهم زبيبًا قبل أن يتحصرم.
ففي المنعطفات التاريخية يُصاب المتلونون بوجوهٍ متعددة برجفة البقاء، وللشفاء من تلك الرجفة يقومون بالمزاودة والتقرب من المسؤولين وتمسيح الجوخ لهم من خلال طرق حديثة.
فتعاقب التنظيمات على مدينة منبج أدى إلى مأسسة الهويات الفرعية والانتماءات الوظيفية. فقد كانت مؤسساتها قبل تحريرها يشغلها موظفون بعضهم كان مرتبطًا وظيفيًا بمؤسسات نظام الأسد البائد، والآخر موظف محسوب على إدارة قسد، وقبلها كان مع تنظيم داعش.
وهذه الثلاثية في المؤسسات أدت إلى نشوب صراعات حول مكانة وحجم وحدود وقوة كل سلطة في المؤسسة، وقد كان لهذه الصراعات أثر مزعزع لاستقرار البلد وجعل موظفي مؤسساتها منقسمين الولاءات، وكلٌّ يتبع الجهة التي تدفع له راتبه. وبدورها سلطة الجهة التي يتبع لها إداريًّا ووظيفيًّا تستخدمه لتحقيق مشاريعها السياسية وتعبئته كجمهور داعم لسلوكها ونشاطاتها.
فتعدد الارتباط الوظيفي بمؤسسات مدينة منبج جعل الانقسام أداة للبقاء في الوظيفة، وحوّل المؤسسات إلى غنيمة تُقتسم بين قوى متصارعة على النفوذ، فيما تُرك الشعب يواجه وحده البطالة وغلاء الأسعار وانعدام الخدمات وتآكل ثقته بمؤسسات بلدته.
وعندما تحررت سوريا وسقط نظام الأسد كانت جميع مؤسسات المحافظات والمدن يديرها أيتام نظام الأسد، ما عدا مدينة منبج كان يتقاسم إدارة مؤسساتها، وبمختلف المجالات، موظفون يتبعون لمؤسسات نظام الأسد وكذلك الذين ارتبطوا وظيفيًّا مع سلطة قسد.
هذا التحوّل التاريخي عقب تحرير المدينة كان له ردود فعل متباينة عند الموظفين، فردة فعل المرتبطين بنظام الأسد أنّ المؤسسات عادت لهم وأنهم وحدهم أبناء الدولة، حيث تختصر الدولة عندهم بمن يستلم مقاليد السلطة الجديدة، وأنّ سلطة قسد المندحرة وموظفيها “ارتزاقيون” يجب إبعادهم عنها.
لم يكن سقوط نظام الأسد مجرد نهاية حكمه في سوريا، وكذلك تحرير مدينة منبج من ميليشيات قسد، بل كان بداية لانكشاف أمر أولئك الذين ربطوا مصيرهم بمصير السلطات التي كانوا يتبعون لها وظيفيًّا، وأقنعوا أنفسهم أن حياتهم لا معنى لها إلا بوجودهم.
هؤلاء ليسوا فقط من حملوا السلاح دفاعًا عنهم، بل أيضًا من حملوا فكرهم وبرروا جرائمهم، ومن بقوا حتى اللحظة الأخيرة يحلمون بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وكأنّ دماء الأبرياء التي سُفكت لم تكن كافية لإيقاظهم من سباتهم العميق.
وبعد تحرير المدينة من تنظيم قسد وسقوط نظام الأسد، كانت الانتهازية وتعدد الأقنعة السمة البارزة عند الفئات الوظيفية التي ترتبط بهم وبمختلف المجالات، ويعتنق الكثير من شخوصها التلاعب بالولاءات، ويجيدون التنقل حسب مقتضيات مصالحهم الوظيفية.
يقدمون خطابًا وطنيًّا ظاهريًّا، لكنّه يخفي دوافع نفعية خالصة، ويستخدمونه كغطاءٍ للتمكين الوظيفي، دون إيمان حقيقي بالتحرر أو الدولة أو المبادئ والقيم، فالكرسي والوظيفة مقدمان على أيّ قيمة أخرى، ولا الوطن يعنيهم، بل يستثمرون كلّ حدث لتحقيق مكاسب مالية وسلطوية.
فنظام تحاصص الوظائف في مؤسسات منبج أدى إلى تفككها لصالح الجهة التي ترعى موظفيها، وتربى الموظفون على أنّ مدينة منبج جغرافيا مرنة، وأنّ من يسيطر هو مصدر الطاعة والشرعية.
وغاب مفهوم النظام الإداري والقانوني، وحلّ محله الولاء الوظيفي للجهة الراعية التي بدورها تتصارع داخل بنية المؤسسات وتضعفها وتشيع الفساد بها، وتنتج مؤسسات ريعية فاشلة ترى في البلاد مصدرًا للارتزاق وغنيمة ومزرعة للاستثمار.
بعد تحرير المدينة، لم يبقَ من ارتبط وظيفيًّا بنظام الأسد وقسد على الهامش، بل جرى إدماج الكثير منهم في أجهزة مؤسسات البلد من خلال تعيينات أو تسويات إدارية، دون أن يكون هناك مسار مؤسسي متكامل يخضع لرقابة وأسس قانونية.
وقد مكّن ذلك من تأسيس مجموعات تمتلك نفوذًا رسميًّا داخل مؤسسات البلد وتقصي الثوار وغير المنتمين إلى صفوفهم، وأصبح المعيار الوظيفي داخل المؤسسات يُحدد عبر معادلات الولاء والتلون والارتزاق، وليس عبر نظام مؤسساتي.
كما أعاد التذكير بأنّ هذه الفئات التي كانت ترتبط بمؤسسات قوى الأمر الواقع البائدة والسابقة تتجاوز دورها الوظيفي، وتمثل شبكة مصالح متمكنة داخل البُنى الإدارية للمؤسسات، وتعمل على إعادة توزيع النفوذ عند كلّ تغير ميداني وتبدل في السلطة الحاكمة.
بناءً عليه، يبقى مستقبل مؤسسات منبج رهينًا بإيجاد صيغة توافق قانونية تتعامل مع موقع الموظفين في المؤسسات، سواء عبر مسار دمج تدريجي أو آليات تفكيك مدروسة. أما في غياب ذلك، فستظل البلاد عرضة لجولات جديدة من إعادة التموقع بين القوى التي تحكم البلد.
فيما سبق هو توصيف لحالة المؤسسات في مدينة منبج، وإنّ استمرار هذا النهج التوظيفي يجعل تلك القوى موازية لمؤسسات الدولة الوليدة، لأنّ تلك الفئات الوظيفية تتقاسم السيطرة وتفرض نفوذها بشكلٍ متوازٍ، تفرض منطقها وتعيد تشكيل التوازنات بحسب مصالحها، وهو ما يقوّض أيّ جهود لبناء دولة القانون. وعليه يصبح تحليل الآثار المتراكمة لوجود هذه الفئات أمرًا ضروريًّا لفهم معضلة المؤسسات في منبج ومستقبلها.
وعليه فإنّ التحوّل من الفوضى إلى الاستقرار بمدينة منبج لن يتم إلا عبر هندسة خطة مدروسة تعيد الاعتبار لسلطة الدولة، وتفتح الباب أمام مرحلة تقود إلى بناء مؤسسات شرعية قادرة على تفكيك موظفيها وفق قواعد قانونية راسخة.
وثوار البلد خير من يجبر عثراتها في كل المجالات، وهناك كثير منهم أصحاب شهادات وكفاءات ولديهم خبرات، وكانوا منذ البدايات يجبرون كسور بلدهم التي تعاقبت عليها السيطرات وهُجّروا منها، وجبروا كسور كثير من مناطق الشمال السوري بدماء وعظام الشهداء، وليس المتلونين والمكوعين حديثًا، فهؤلاء يميلون مع كلّ ريح ويتذبذبون مع كلّ سلطة فرضت نفسها على البلد، ولن يجبروا عثرات البلد ومؤسساتها. ومن لم يكن جابرًا لكسور البدايات لن يساهم في الشفاء بعد كل هذه السنوات.
والمكوعون حديثًا كانوا عميانًا عن جرائم الأسد، والذين تعايشوا مع السواد والصفار وشاركوا بظلم أهل البلد كانوا طرشان وخرسان، وهؤلاء جميعًا ينظرون لتحرير البلاد كتفاحة سقطت من شجرة، ولا همّ لهم سوى أكلها.
منبج بحاجة ماسة لتجريم اللواكَة، وهو مصطلح شعبي غير معروف الجذر اللغوي الذي اشتُقّ منه، يُلفظ بتنويعات كثيرة بحسب الحالة. في اللغة الفصحى يقابله كلمات النفاق والتملق وتمسيح الجوخ، لكن هذه الكلمات، على سمو مكانتها في تشويه العلاقات الاجتماعية والإدارية، لا تعطي المصطلح الشعبي حقه الكامل.
فاللواكَة أكثر بكثير من النفاق أو التملق، في حين يعتبر مسح الجوخ دراسة أولية لنيل الماجستير في أسس اللواكَة. واللوكَي هو الشخص الذي يتقرب إلى ذوي السلطة والمال والنفوذ ليحصل على ما يريد، ويستبعد من لا يريد، بمهارة تسلقية وأسلوب فريد.
واللواكَة إرث يصيب الذين لم تكتمل مناعتهم طوال سنوات الثورة، وتخضرموا باللواكَة مع كلّ سلطات الأمر الواقع التي مرت على البلد.
لذلك نرى كثرة اللوكَية في مجالاتٍ متعددة، علمًا بأنّ هذا المرض الموروث لا دواء له إلا الإهانة وعدم احترام المصابين به، والقضاء على فيروس اللوكَية يعادل القضاء على الطغاة والمستبدين، لأنّ الأول يصنع الثاني.