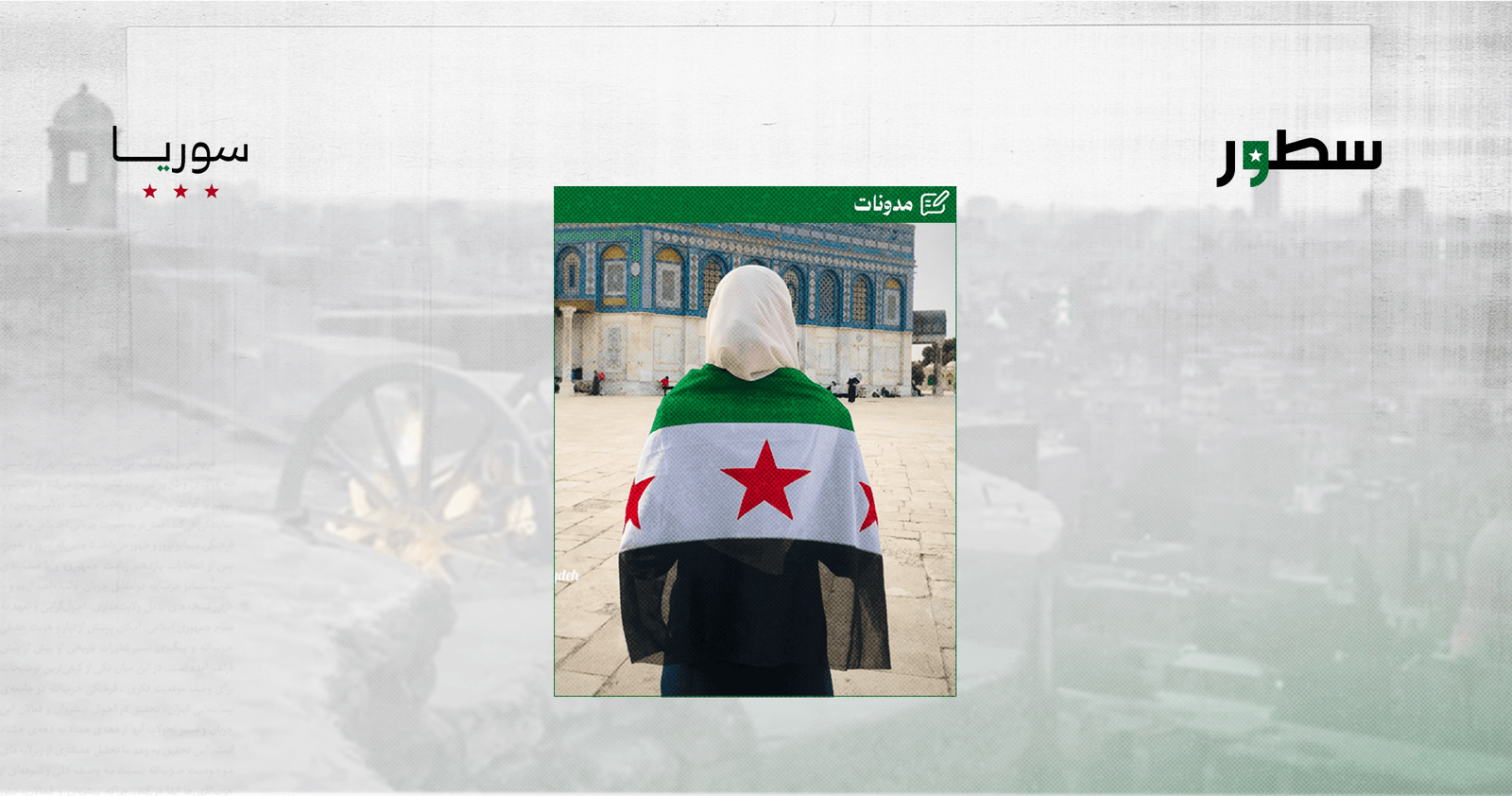مدونات
صيدنايا.. ذاكرة السوريين السوداء
صيدنايا.. ذاكرة السوريين السوداء
أسماء البري
لا يوجد سوري يسمع باسم سجن صيدنايا إلا ويشعر بغصّة في قلبه، المكان الذي تحوّل مع مرور السنوات إلى رمزٍ للرعب، لم يكن سجناً عسكرياً فقط، بل مقبرة للأحياء، يذوب فيها المعتقل بين جدران العزلة والتعذيب والجوع والخوف. كان سجن صيدنايا فضاءً مغلقاً على الألم، حيث تختفي فيه ملامح الإنسان ليبقى مجرّد رقم عالق بين الحياة والموت.
داخل جدرانه، عاشت آلاف الأرواح تفاصيل لا يمكن للعقل البشري أن يتخيّلها. أصوات صراخ مكتومة لا يسمعها أحد، أجساد تُنهك تحت التعذيب حتى تفقد القدرة على الوقوف، ووجوه تختفي فلا تعود تُرى أبداً. الداخل إلى صيدنايا كان يفقد يقينه بالخروج، وكأنّ الأبواب هناك تُغلق على الزمن نفسه. إنّه مكان يبتلع الذاكرة ويجعل المعتقل يعيش في عزلةٍ تامة عن العالم، حيث يصبح الانتظار بحد ذاته عقوبة موازية للتعذيب.
عمر الشغري… شاهد على الجحيم.
من بين الناجين، يبرز اسم عمر الشغري، الذي تحوّل إلى شاهدٍ على ذلك الجحيم. قصته ليست مجرّد حكاية فردية، بل مرآة لمصير آلاف السوريين الذين عانوا الصمت نفسه. عمر تحدّث عن صيدنايا بوصفه مكاناً يُكسر فيه الإنسان حتى النخاع، حيث يصبح الجوع أداةً للقهر، والصمت وسيلة لإذابة الأمل. ورغم ذلك، اختار عمر أن يرفع صوته عالياً ليقول إنّ الحقيقة لا تموت، وإنّ الناجين ليسوا شهوداً على الماضي فقط، بل على مستقبلٍ لا يجوز أن يعيد إنتاج الألم ذاته.
والجرح الأكبر.. مازن حمادة والصوت الذي لم يسكت عن الظلم. إلى جانب عمر، يظلّ اسم مازن حمادة محفوراً في ذاكرة السوريين. مازن حمل ذاكرة التعذيب معه إلى الخارج، وحاول أن يحوّل ألمه إلى شهادة للآخرين. لسنواتٍ ظلّ يتحدث عن المعتقلين، عن الجوع والضرب والإذلال، وعن رفاقٍ قضوا أمام عينيه ولم ينجُ منهم سوى القليل. غاب مازن قسراً ورحل في ظروفٍ غامضة، لكن ذكراه بقيت شاهدة على أنّ الحرية يمكن أن تُسلب من الجسد، بينما الكلمة قادرة على أن تبقى. إنّ رحيله لم يكن نهاية صوته، بل بداية لسؤال أكبر: كيف يمكن أن يتحوّل الألم الشخصي إلى شهادةٍ جماعية تحفظ ذاكرة وطن بأكمله؟
وجوه بلا أسماء، وحكايات لا تنتهي وما عمر ومازن إلا وجهان من آلاف الوجوه. كلّ معتقل مجهول الاسم هو حكاية كاملة لم تُكتب بعد. هناك أم تنتظر عودة ابنها منذ سنوات، أب يبحث عن مصير ولده بين القوائم المسربة، وأطفال يكبرون على غياب من كان يجب أن يكون حاضراً في تفاصيل حياتهم اليومية. صيدنايا لم يكن مكاناً عادياً، بل ندبة مفتوحة في جسد سوريا، جرح ينزف كلما استعاد السوريون ذاكرتهم الجمعية. إنّه ليس فقط سجن الماضي، بل رمز للاستمرار الموجع لغياب العدالة، وغياب الدولة التي تحمي الإنسان بدلاً من سحقه.
العدالة المؤجلة.. والذاكرة التي لا تموت
اليوم، وبعد إلقاء القبض على بعض السجّانين الذين ارتكبوا الجرائم، ولم يعد الحديث عن صيدنايا مجرّد استعادة لماضٍ مظلم، بل مطالبة حقيقية بمستقبل لا يُدفن فيه الحق. أصوات المعتقلين الذين خرجوا، والأرواح التي رحلت بصمت، تشكّل ذاكرة حيّة تُذكّرنا أنّ العدالة قد تتأخر، لكنّها لا تغيب. فالمسألة ليست مجرّد محاكمات فردية، بل بناء سردية وطنية تحفظ الحقيقة وتواجه محاولات النسيان أو التزييف.
الذاكرة هنا تتحوّل إلى قوة سياسية وأخلاقية، تُطالب السوريين والعالم على حد سواء، بأنّ ما جرى في صيدنايا ليس تفصيلاً عابراً في حرب طويلة، بل هو قلب المأساة السورية. إنّ النسيان ليس خياراً، لأنّ النسيان يعني السماح بتكرار الجريمة. لذلك تبقى الشهادات حاضرة، وتبقى الحكايات تتناقلها الأجيال، لتقول إنّ الحرية لا تُقاس بعدد الناجين فقط، بل بقدرة الشعوب على منع تكرار المأساة وعلى مواجهة الصمت بالذاكرة، والخوف بالمطالبة بالعدالة.
صيدنايا لم يعد فقط سجناً على أطراف دمشق، بل أصبح مرآة قاتمة لوجه النظام السوري البائد، ولرحلة طويلة من الألم لم تنتهِ بعد. وبينما يحاول السوريون لملمة شتاتهم، تبقى الحكايات القادمة من خلف الجدران السوداء جزءاً من هوية وطن يبحث عن عدالة حقيقية. العدالة قد تتأخر، لكنّها لا تموت، تماماً كما أنّ الذاكرة، مهما طال الزمن، لا تُمحى