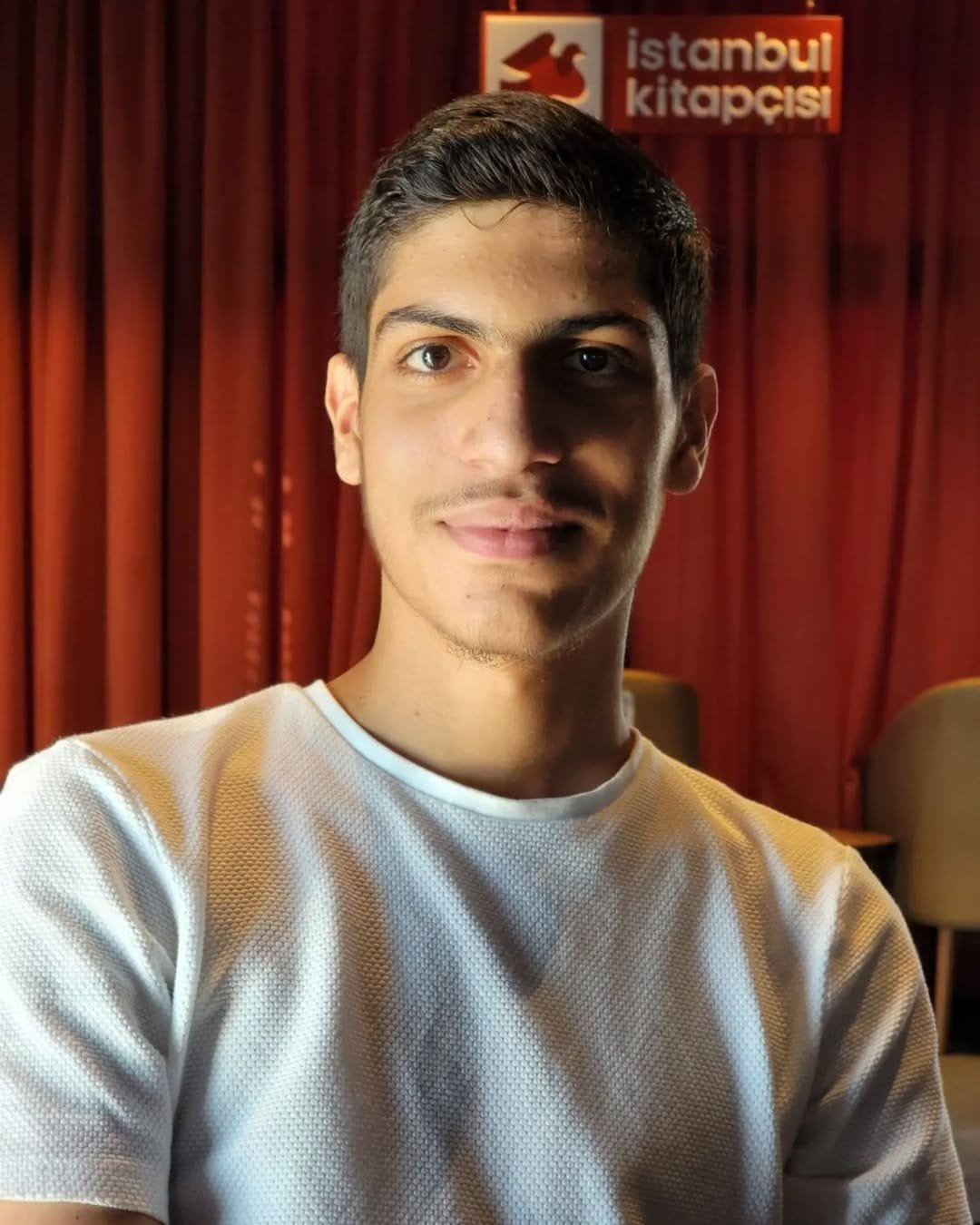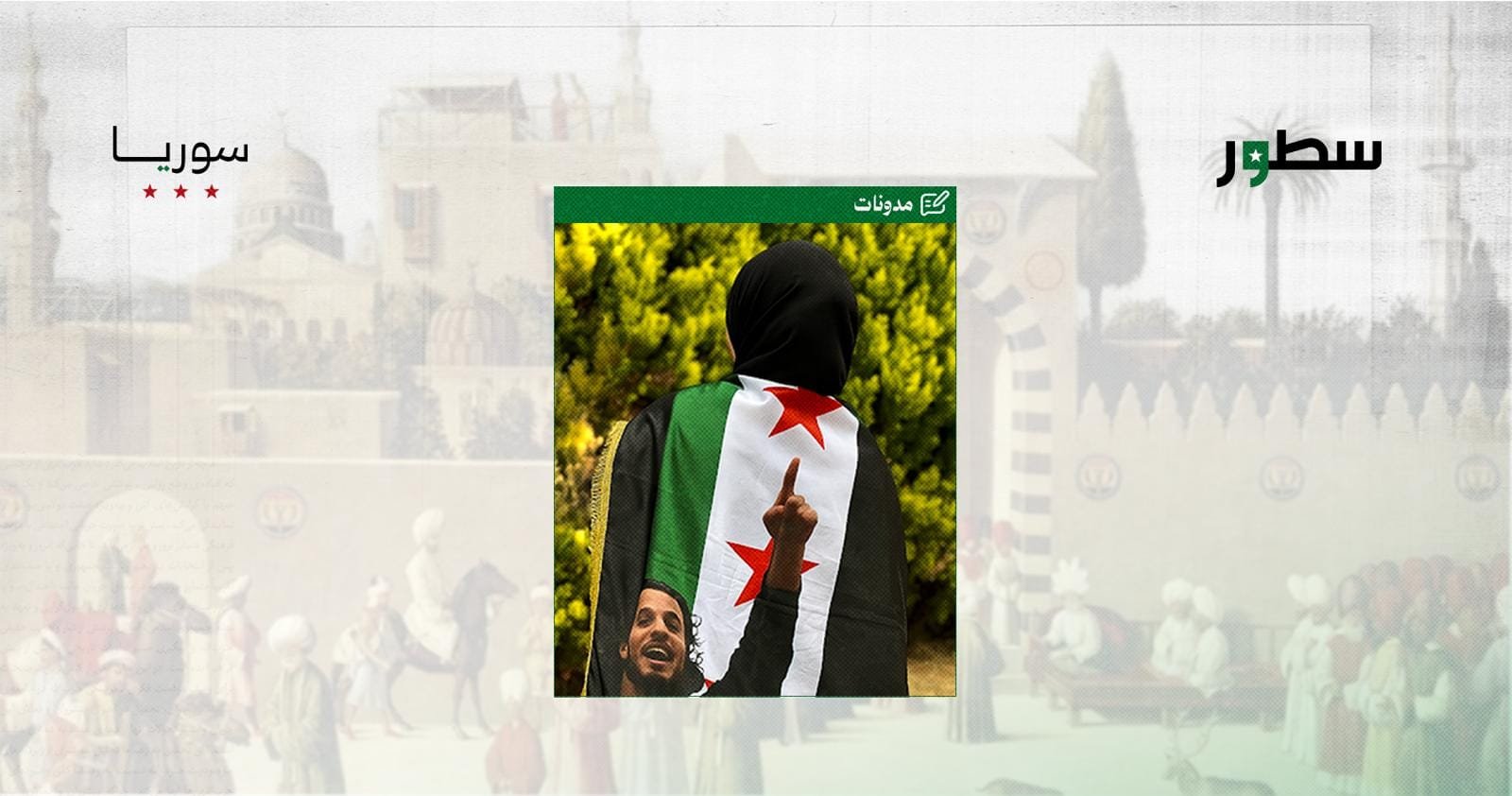سياسة
من درج موسكو إلى أبواب البيت الأبيض
من درج موسكو إلى أبواب البيت الأبيض
لم تكن العلاقة بين دمشق وواشنطن ابنة لحظةٍ سياسيةٍ عابرة، بل ثمرة صراعٍ امتدّ عقوداً بين معسكرين، تحالفت فيه سوريا مع موسكو ضدّ عالمٍ تقوده الولايات المتحدة. في تلك الحرب الباردة التي قسّمت الكوكب إلى شرقٍ وغرب، وجدت دمشق نفسها في الصفّ السوفييتيّ، تستمدّ من موسكو السلاح والغطاء والاعتراف، مقابل أن تقف في وجه واشنطن بوصفها القوة التي تهدّد هوية المنطقة وتوازناتها. ومنذ ذلك الزمن، صار موقع سوريا في العالم يُقاس بمدى بعدها أو قربها من موسكو.
لكنّ العقود اللاحقة لم تُبقِ العلاقة على صلابتها الأولى. انهار الاتحاد السوفييتي، وتراجعت أدوار الحلفاء القدامى، ووجدت سوريا نفسها في عالمٍ بلا أيديولوجيات كبرى، مضطرةً إلى أن تعيد تعريف صداقاتها وعداواتها معًا. لم تختفِ موسكو من المشهد، لكنّها تغيّرت بدورها: صارت قوّةً تبحث عن النفوذ عبر الحروب المحدودة بدل الأحلاف العقائدية، وصارت دمشق بالنسبة لها بوابةً إلى المتوسط أكثر من كونها رمزًا للمقاومة. أمّا واشنطن، فبقيت الخصم الذي لا يمكن تجاوزه، حتى وهي تتجاهل وجود سوريا على خريطتها.
وبين العاصمتين، عاشت دمشق أطول صعودٍ على درج السياسة المعاصرة: من حليفٍ للكرملين إلى طرفٍ تفاوضه واشنطن اليوم على ملفاتٍ كانت محرّمة بالأمس. لا لأنّ العداء تبدّل بالحب، بل لأنّ العالم نفسه تبدّل. فقد غابت أيديولوجيا الصراع، وبقيت الجغرافيا وحدها تملي على الجميع من يقف مع من، ولماذا.
في هذا المقال نحاول أن نوضح كيف قطعت سوريا هذا الدرج الطويل، من موسكو إلى واشنطن، من زمن الحرب الباردة إلى لحظةٍ المصافحة، وكيف تغيّر موقعها ومعناها بين الشرق والغرب في رحلةٍ أعادت تعريفها كدولةٍ وكموقعٍ في قلب الشرق الأوسط.
من الحرب الباردة إلى سقوط القطبية.
حين انقسم العالم إلى معسكرين، وجدت سوريا نفسها في قلب واحدةٍ من أبرد الحروب وأكثرها حرارةً في آنٍ واحد. منذ خمسينيات القرن الماضي، كانت دمشق الصغيرة تبحث عن سندٍ يحميها من جيرانٍ أكبر ومن توازناتٍ إقليميةٍ لا ترحم، فبدت موسكو -بما تمثّله من مناهضةٍ للهيمنة الغربية- الشريكَ الأكثر قابليةً للاحتضان. لم يكن التحالف السوري السوفييتي وليد لحظةٍ عابرة، بل نتاجًا لعقيدةٍ سياسيةٍ كاملة نشأت مع انقلاب البعث وصعود حافظ الأسد، الذي رأى في التحالف مع موسكو ضمانةً لبقاء الدولة أكثر مما هو التزامٌ أيديولوجي. فالسلاح الروسي، والفيتو في مجلس الأمن، وخبرة الضباط السوفييت في التدريب والدفاع الجوي، شكّلت معًا شبكة أمانٍ ماديّةً وسياسيةً سمحت لسوريا بأن تصمد أمام الحروب العربية -الإسرائيلية المتتالية، وأمام الضغوط الأمريكية التي كانت ترى في دمشق خطًّا أماميًّا للنفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط.
في المقابل، كانت واشنطن تنظر إلى سوريا بعينٍ مزدوجة: خصمًا سياسيًا يجب احتواؤه، ونظامًا قابلًا للتوظيف في لحظاتٍ معيّنة من الصراع الإقليمي. منذ عهد كيسنجر في السبعينيات، حاولت الدبلوماسية الأمريكية فكَّ ارتباط دمشق بالكرملين عبر بوابة السلام مع إسرائيل، لكنّ حافظ الأسد، الذي قرأ جيدًا معنى الاصطفاف الدولي، تعامل مع المفاوضات كساحة اختبارٍ لا تنازل. شارك في حرب 1973 على أمل استعادة توازن الردع، ثمّ جلس على طاولة التفاوض وهو يعلم أنّ التنازل عن موسكو يعني التنازل عن الضمانة الوحيدة لبقاء نظامه في وجه واشنطن وتل أبيب معًا.
خلال الثمانينيات، بلغت المواجهة بين المعسكرين ذروتها. سعت الولايات المتحدة إلى محاصرة النفوذ السوفييتي في المشرق عبر دعم العراق في حربه مع إيران، واحتضان مصر بعد كامب ديفيد، وتحويل الخليج إلى ساحة نفوذٍ مباشر. أمّا سوريا، فاختارت أن تملأ الفراغات: دخلت لبنان بغطاءٍ سوفييتيٍ وصمتٍ أمريكيٍّ مدفوعٍ بالحذر، لتصبح لاعبًا إقليميًا في معادلةٍ لا ترضى بها واشنطن ولكنّها لا تستطيع تغييرها. في تلك السنوات، كان السلاح الروسي يتدفّق إلى دمشق، وكانت صور الزعماء في الساحة الحمراء تُرفع إلى جانب العلم السوري في المهرجانات الرسمية، في تأكيدٍ رمزيٍّ على أنّ دمشق اختارت مكانها في العالم الجديد الذي يُرسم بين موسكو وواشنطن.
لكنّ سقوط الاتحاد السوفييتي في مطلع التسعينيات بدّل المشهد بأكمله. وجدت دمشق نفسها فجأةً يتيمةَ الحليف الأكبر، تواجه عالمًا أحاديّ القطبية تقوده الولايات المتحدة وحدها. كان حافظ الأسد يدرك أنّ زمن الأيديولوجيات انتهى، وأنّ موسكو الجديدة، التي تحاول النجاة من فوضى الانهيار، لن تكون موسكو التي عرفها. ومع ذلك، لم يقطع الجسر مع الكرملين، بل أبقاه ممدودًا باسم الذاكرة والمصلحة. وحين دُعي إلى مؤتمر مدريد عام 1991، جلس الأسد إلى طاولةٍ نظّمها الأمريكيون، لكنّه جلس عليها بثقافةٍ صاغتها موسكو: ثقافة الحذر، والتمسّك بالموقع لا بالموقف. كانت تلك لحظة انكشافٍ مضاعف: انكشاف نظامٍ فقدَ حليفه الأكبر، وانكشاف منطقةٍ دخلت زمنًا لا مكان فيه لمن لا يغيّر معادلاته.
منذ تلك اللحظة بدأت سوريا تتعلّم السير وحدها، توازن بين موسكو الضعيفة وواشنطن المتغطرسة، وتحاول أن تجد لنفسها موقعًا في عالمٍ لا يشبهها. لقد انتهت الحرب الباردة رسميًا، لكن آثارها بقيت راسخة في الوعي السياسي السوري، إذ ظلّت موسكو -ولو شبحًا- ركنًا من أركان الشرعية، وبقيت واشنطن -ولو بعيدًا- الخصمَ الذي يُعرّف وجود الدولة بكونها خارجه. تلك المعادلة الموروثة من القرن العشرين، ستظلّ تتحكّم في سلوك دمشق حتى العقود اللاحقة، حين تنقلب التحالفات ويعود الروس إلى أرض المعركة، لا كمستشارين هذه المرة، بل كقوةٍ عسكريةٍ كاملة تفرض واقعًا جديدًا في سوريا وفي الإقليم كله.
براغماتية ما بعد 11 سبتمبر.
حين انطفأت الحرب الباردة، لم تندلع صداقة جديدة. فالعالم الذي خرج من ظلّ الاتحاد السوفييتي لم يكن أقلّ قسوة، بل أشدّ براغماتية. وجدت دمشق نفسها في تسعينيات ملتبسة، تتنقّل فيها بين الانفتاح المحدود والمراوغة السياسية. شاركت في حرب الخليج إلى جانب التحالف الدولي ضدّ صدام حسين، ليس اقتناعًا بأجندة واشنطن بل إدراكًا أنّ العزلة قاتلة في عالمٍ تقوده الولايات المتحدة منفردة. ومع ذلك، ظلّت تُبقي على خطوطٍ مفتوحة مع موسكو الجديدة التي فقدت نفوذها لكنّها احتفظت بذاتٍ رمزية في الوعي السوري. كانت دمشق تفهم أنّ التوازن الخارجي جزء من بقاء النظام الداخلي، وأنّ القطيعة المطلقة مع الغرب لن تجلب سوى مزيدٍ من الحصار.
خلال تلك المرحلة، لم تتغيّر واشنطن كثيرًا في نظرتها إلى سوريا: دولة مارقة، راعية للإرهاب، تحكمها نخبةٌ أمنية تستمد شرعيتها من العداء لأمريكا. ومع وصول إدارة بوش الابن، ازداد الخطاب قسوةً وغموضًا معًا، إلى أن وقعت أحداث 11 سبتمبر 2001. تلك اللحظة التي أعادت رسم خريطة التحالفات، فاستيقظت دمشق على واقعٍ جديد: العدوّ لم يعد الشيوعية بل الإرهاب، والاصطفافات لم تعد بين الشرق والغرب، بل بين من يتعاون ومن يتمنّع. في الأيام التالية للهجمات، سارعت الأجهزة السورية إلى تمرير معلوماتٍ استخباراتيةٍ إلى نظرائها الأمريكيين عن جماعاتٍ إسلاميةٍ عابرة للحدود، وفتحت قنواتٍ أمنيةً سرّية أثبتت للطرفين أنّ الخلاف السياسي لا يمنع التنسيق حين تمسّ المصالح القومية.
كان هذا التحوّل أشبه بانعطافةٍ حذرةٍ في ذهنية النظام السوري: للمرة الأولى، تتقاطع مصالح دمشق وواشنطن في ملفٍّ واحد، لا على أرضيةٍ أيديولوجية بل أمنية صرفة. بالنسبة للقيادة السورية، كان التعاون المحدود فرصةً لإظهار النوايا الحسنة وتخفيف الضغوط السياسية، وبالنسبة للأمريكيين، كان “العدوّ القديم” يمتلك خبرةً نادرة في تفكيك الشبكات الجهادية. لكن هذا الانفتاح لم يدم طويلًا؛ فمع غزو العراق عام 2003، عادت واشنطن لتضع دمشق في خانة الخصوم. اتُّهمت بفتح الحدود للمقاتلين الأجانب، وبإيواء شخصياتٍ من النظام العراقي المنهار، ففرضت عليها عقوباتٍ جديدة، وأعادت إدراجها ضمن “محور الشر”.
في هذه السنوات المشتعلة، تمايزت موسكو مجددًا عن واشنطن. بينما كانت الولايات المتحدة تسعى لتغيير أنظمة المنطقة تحت شعار “الشرق الأوسط الكبير”، كانت روسيا -التي استعادت بعضًا من أنفاسها في عهد بوتين- تحاول العودة إلى المسرح عبر البوابة السورية ذاتها. فاستأنفت صفقات السلاح، وبدأت بالتفاوض حول استعادة موطئ قدمٍ بحريٍ في طرطوس، مقدّمةً نفسها كحليفٍ موثوقٍ في زمنٍ تتساقط فيه الأنظمة. أمّا دمشق، التي تعلّمت من التجربة أنّ الغرب لا يمنح الصداقات مجانًا، فتمسّكت بخيط موسكو ولو بدا هشًّا، واستعملته مظلّةً دبلوماسية تحتمي بها من عواصف واشنطن.
لم تكن البراغماتية في تلك المرحلة خيارًا طوعيًا بقدر ما كانت حيلةَ بقاء. فالنظام الذي بنى شرعيته على الصمود في وجه أمريكا وجد نفسه مضطرًا إلى مخاطبتها بلغة المصالح، والنظام الذي وعد شعبه بأنّ “موسكو لا تخذل حلفاءها” كان يرى موسكو تكتفي بخطابات الدعم من بعيد. بين خيبة الحليف وابتزاز الخصم، اختارت دمشق أن تسير في المنطقة الرمادية، لا قطيعة كاملة ولا انفتاحًا كاملاً، بل حضورًا محسوبًا في لعبةٍ لا تملك فيها سوى ورقة موقعها الجغرافي. كانت تلك البراغماتية الأولى التي مهّدت لاحقًا لنسخةٍ أكبر منها، حين يشتعل الحريق السوري في 2011، وتعود القوى نفسها إلى الساحة، ولكن بأدوارٍ مختلفة.
الثورة السورية والتحالف ضدّ داعش.
حين اندلعت الثورة السورية في ربيع 2011، بدا المشهد في واشنطن محكومًا بتردّدٍ غير مسبوق. كانت إدارة أوباما قد خرجت للتوّ من حربين مكلفتين في العراق وأفغانستان، فاختارت خطابًا يقوم على “دعم التغيير” دون التورّط في صنعه. بالنسبة إلى الأمريكيين، بدت سوريا نسخةً معقّدة من ليبيا، لكن من دون النفط، ومن دون إجماعٍ إقليميٍّ على التدخل. أما بالنسبة إلى النظام السوري، فكانت الولايات المتحدة “الخصم المؤجّل”، الذي ينتظر لحظةَ ضعفٍ مناسبة ليُسقطه كما أسقط غيره. وفيما كانت الشعارات الأولى تملأ الشوارع، كانت واشنطن تختبر خياراتها: هل تترك النظام يسقط على يد الشارع، أم تدفعه إلى التغيير التدريجي عبر الضغوط والعقوبات؟
في الأشهر الأولى اكتفت الإدارة الأمريكية بالعقوبات والدعوات الأخلاقية، ثمّ فتحت قنواتٍ مع أطراف المعارضة التي تشكّل لاحقاً “المجلس الوطني السوري”. إلا أنّ الرهان على بديلٍ ديمقراطيٍّ موحّد سرعان ما سقط، بعدما غرق المجلس في الخلافات الداخلية وارتهن لتجاذباتٍ إقليميةٍ متناقضة. فبين أنقرة والدوحة والرياض، تاهت المعارضة عن طريقها السياسي، لتجد واشنطن نفسها أمام سؤالٍ لم تكن جاهزةً للإجابة عليه: من سيمسك بسوريا إذا سقط النظام؟ هنا بدأت البراغماتية الأمريكية بالعودة إلى الواجهة، فالمشكلة لم تعد في سقوط الأسد أو بقائه، بل في من سيملأ الفراغ بعده.
عام 2014 شكّل صعود تنظيم الدولة الإسلامية المفصل الأكبر في تلك المرحلة. فبينما كانت واشنطن تتهيّب التورّط في الصراع الداخلي السوري، فرضت “داعش” معادلةً جديدة: خطرٌ عابرٌ للحدود يهدّد العالم بأسره. من هنا، أنشأت الولايات المتحدة “التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب”، وعادت إلى الأجواء السورية من بوابةٍ مغايرة، لا بوصفها طرفًا سياسيًا في الحرب، بل كقوةٍ عسكريةٍ فوق الجميع. نفّذت مئات الغارات الجوية ضدّ التنظيم، ونسّقت مع قوى كردية محلّية شكّلت لاحقًا “قسد”، بينما اكتفت دمشق بإصدار بيانات التنديد الرسمية دون أن تُطلق رصاصة واحدة على الطائرات الأمريكية. كان الطرفان يعرفان أنّ المواجهة بينهما ليست في مصلحتهما، وأنّ الحرب ضدّ عدوٍّ مشترك يمكن أن تكون غطاءً للتعايش المؤقت.
في الوقت نفسه، دخلت روسيا الميدان عسكرياً عام 2015 لتملأ الفراغ الذي تركه تردّد واشنطن. أعلنت أنها جاءت “بطلبٍ من الحكومة السورية” لمحاربة الإرهاب، لكنها في الحقيقة جاءت لتعيد تثبيت نفوذها المفقود منذ ثلاثة عقود. ومع أولى الضربات الروسية، تغيّر شكل الحرب وموازينها: صارت موسكو اللاعب العسكري الأول، فيما اكتفت واشنطن بدور المنسّق الأمني الذي يراقب من بعيد. ومع ذلك، ظلّ خطّ الاتصال بين الجيشين مفتوحًا لتجنّب الصدام في الأجواء السورية، في مشهدٍ يلخّص طبيعة العلاقة بين القوتين العظميين: مواجهةٌ محسوبة، وتعاونٌ من وراء الستار.
وسط هذا التشابك، كانت دمشق تدرك أنّ مصيرها صار في يد قوتين متنافستين متفقتين في الوقت نفسه. فروسيا تحمي النظام سياسيًا وعسكريًا، والولايات المتحدة تحارب عدوّه الأخطر دون أن تمسّه. وبين الطرفين، نشأت معادلة واقعية: واشنطن لا تريد سقوط النظام، لكنها لا تريد انتصاره الكامل، وموسكو لا تريد مواجهة أمريكا، لكنّها لا تقبل بوجودها الدائم في الشرق. أمّا النظام السوري، الذي استنزفته الحرب وأفقدته السيطرة على نصف البلاد، فقد وجد نفسه يعيش بفضل توازنٍ دقيق بين خصمين، كمن يتنفّس عبر رئتين متناقضتين.
لقد أنتجت سنوات الثورة شكلًا جديدًا من العلاقة بين دمشق وواشنطن، لا يقوم على الأيديولوجيا ولا على المصالح المشتركة، بل على “الضرورة الأمنية”. ومن رحم هذا التوازن غير المستقر، وُلدت مرحلة ما بعد 2019، حيث بدأت التحالفات تنقلب والأدوار تتبدّل، ووجدت أمريكا نفسها مضطرةً للتعامل مع سوريا الجديدة بعيونٍ مختلفة، أقلّ عداءً وأكثر براغماتية.
من الحرب إلى المصافحة.. التحوّل البارد.
بعد سنواتٍ من الدم والضجيج، دخلت واشنطن مرحلةً جديدة في نظرتها إلى سوريا. منذ 2019، بدا أن الحرب الكبرى انتهت دون أن تنتهي نتائجها، وأنّ الملفات التي ظلّت مجمّدة طوال عقدٍ من الفوضى بدأت تتحرّك ببطءٍ خلف الكواليس. تراجع النفوذ الإيراني بفعل العقوبات والإنهاك الاقتصادي، وانحسرت المعارك الواسعة بعد سيطرة الدولة السورية على معظم الجغرافيا. لكن الأهمّ أنّ الولايات المتحدة أدركت أنّ سياسة “التجميد والعزل” لم تعد مجدية، وأنّ التعامل مع دمشق، ولو بحدوده الدنيا، أصبح ضرورةً لضمان الاستقرار الإقليمي. لم تعد واشنطن تتحدث عن تغيير النظام، بل عن إدارة الواقع، ولم تعد تطرح أسئلة الشرعية، بل أسئلة الحدود والنفوذ واللاجئين.
في المقابل، غيّرت دمشق خطابها من المواجهة إلى الواقعية. ومع صعود القيادة الجديدة، وظهور ملامح دولةٍ تحاول إعادة تعريف نفسها، بدأت البعثات الدبلوماسية تطرق الأبواب المغلقة مجددا. أعادت روسيا تثبيت حضورها العسكري باتفاقاتٍ رسمية مع الحكومة السورية، بينما فتحت واشنطن خطوط اتصالٍ أمنية وسياسيةٍ محدودة تحت عنوان “التنسيق في ملفّ الإرهاب”. وسرعان ما تحوّل هذا التنسيق إلى حوارٍ غير معلنٍ حول ملفاتٍ أوسع، من إعادة الإعمار إلى إعادة اللاجئين، ومن مكافحة تهريب الكبتاغون إلى الترتيبات الحدودية مع الأردن والعراق.
كان التحوّل الأمريكي بطيئًا لكنّه ثابت. رفعت واشنطن جزءًا من العقوبات الاقتصادية، وسمحت بتسهيلاتٍ في التحويلات الإنسانية، ثمّ أرسلت وفودًا إلى المنطقة لاختبار “السلوك الجديد” لدمشق. ومع كلّ خطوةٍ صغيرة، كانت سوريا تستعيد جزءًا من حضورها الدبلوماسي المفقود، إلى أن بدأت مرحلة اللقاءات العلنية: لقاء الشرع بالرئيس الأمريكي على هامش القمة الثلاثية في الرياض، ثمّ خطابه في الأمم المتحدة، وصولًا إلى الزيارة المنتظرة إلى البيت الأبيض بوصفها تتويجًا لمسارٍ طويل من التفاهمات غير المعلنة.
لم يكن هذا التقارب تحوّلًا في القيم بقدر ما كان إعادة تعريفٍ للمصالح. فواشنطن التي سعت يومًا لإسقاط النظام السوري باتت ترى في استقراره النسبي ضمانةً لتوازنٍ هشّ في المشرق، ودمشق التي شيطنت الغرب لعقودٍ طويلة باتت تعتبر التفاهم معه شرطًا لبقائها السياسي والاقتصادي. بين الطرفين تقف موسكو، لا كخصمٍ ولا كحليفٍ خالص، بل كصورةٍ دائمةٍ في خلفية المشهد: الصديق الذي احتضن سوريا في الحرب، والجار الذي يراقب عودتها إلى الدبلوماسية من بعيد.
نهاية الدرج الطويل.
بين درج موسكو وأبواب واشنطن تمتدّ مسافةٌ لا تُقاس بالكيلومترات، بل بعدد التحوّلات التي غيّرت وجه سوريا والعالم من حولها. فالصعود الطويل الذي بدأ في ظلال الحرب الباردة لم يكن مجرّد انتقالٍ جغرافيٍّ من معسكرٍ إلى آخر، بل رحلةَ دولةٍ تبحث عن مكانٍ في نظامٍ لا يرحم الضعفاء ولا يصدّق الشعارات القديمة. في كلّ مرحلةٍ كانت دمشق تصعد درجةً جديدة، مرةً تحت القصف ومرةً في قاعات التفاوض، تحاول أن تبقى على الخريطة مهما تغيّر شكلها، وأن تحافظ على صوتها ولو خفت في ضجيج الآخرين.
ولعلّ اللقاء المرتقب بين دمشق وواشنطن لا يُختَبر بقدر ما يُرمز إليه؛ فهو لا يختصر خمسين عامًا من العداء بقدر ما يكشف أنّ العالم نفسه لم يعد يحتمل العداء المطلق. بين موسكو التي ضمنت البقاء وواشنطن التي منحت الاعتراف، وُلدت براغماتية جديدة لا تشبه الحرب ولا السلام، بل توازنًا هشًّا بين ماضٍ مثقلٍ وواقعٍ يفرض منطقه. قد لا يكون ما ينتظر سوريا مصالحةً كاملة، لكنّه بالتأكيد نهايةٌ لزمنٍ طويلٍ من الإنكار. فالذين صعدوا الدرج الطويل يدركون أنّ الوصول ليس ذروة الرحلة، بل بدايتها الحقيقية.