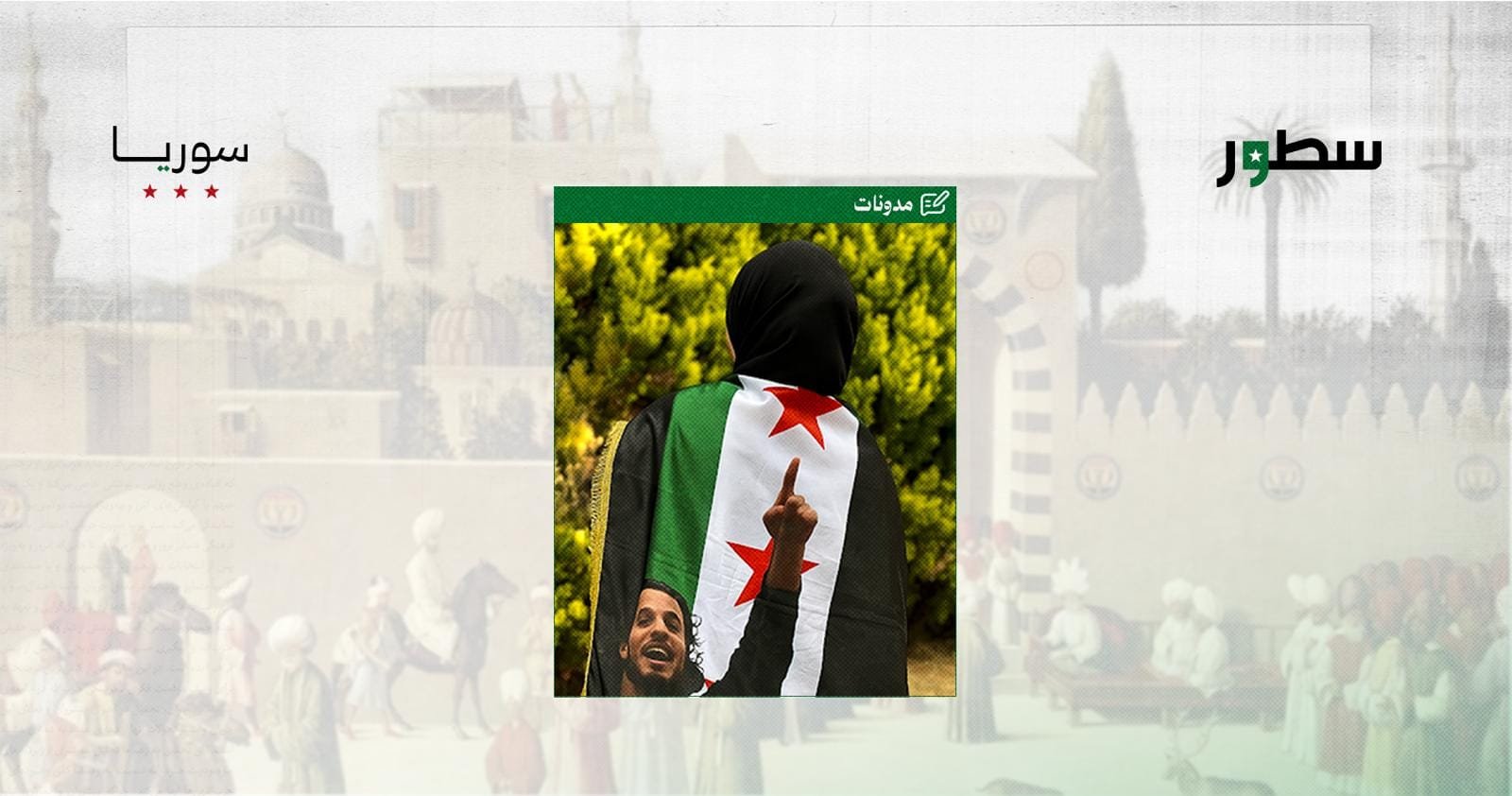أدب
مترو حلب.. الذاكرة لا تغادر المدينة
مترو حلب.. الذاكرة لا تغادر المدينة
في “مترو حلب” تنسج مها حسن رواية عن السوريين الذين بعثروا في المنافي، لا عن بطلة بعينها -وإن كان السرد يحمل الكثير من المونولوج والحوارات النفسية- تبقى الرواية عن وطنٍ انقسم بين الداخل والخارج، وعن ذاكرة لا تكفّ عن استدعاء مدينتها الأولى في قلب الشتات. المنفى هنا ليس محطة انتقالية، بل قدر يلاحق الشخصيات في تفاصيلها اليومية، يفرض نفسه على اللغة والخيال والوعي. كلّ محطة في مترو باريس تصبح مرآة لمحطة في حلب، وكلّ صورة في الغربة تنعكس بظلّها على مدينة تحوّلت إلى أنقاض، لكنّها ما زالت تضيء في الحلم والذاكرة.
الرواية ترسم وجهاً جماعياً للسوري، ذاك الذي لا يجد في المنافي خلاصاً، ولا في البقاء حماية. الثورة التي عرفها في الداخل بصورتها البريئة تتحوّل في الخارج إلى شعارات، واللجوء يضعه في مواجهة ثقيلة مع سؤال الانتماء ومع صفة “لاجئ” التي تلاحقه كوصمة. هكذا يظلّ النصّ متأرجحاً بين الوجود واللاوجود، بين ما كان وما لم يعد.
بمعمارها السردي المتنقل، تقدّم “مترو حلب” قراءةً مؤلمة لتجربة المنفى السوري، كخريطةٍ للتيه الذي يعيد تعريف المكان والهوية والذاكرة. إنّها كتابة تبدأ من الحنين، وتتخطاه لتصوغ وعياً جديداً بالمدن والناس، وتضع القارئ أمام الحقيقة العارية التي يمكن أن تقتل وتفتك: لا خلاص من المنفى ولا هروب من الأوطان.
مكاننا الأول: حلب التي تعرّف كل ما بعدها.
في “مترو حلب” لا تغيب المدينة عن البطلة لحظة واحدة، حتى وهي في قلب باريس. كلّ محطة مترو، كلّ شارع، يتحوّل إلى صدى لحلب، وكأنّ المنافي لا تفتح أبواباً جديدة بقدر ما تعيدنا دائماً إلى المكان الأول. مها حسن تسمي ذلك “خلل المنافي”، أيّ ذاك الشرخ الذي يجعل الإنسان لا ينتمي تماماً إلى مدينة اللجوء، ولا يستطيع في الوقت ذاته أن يقطع جذوره مع مدينته الأمّ.
ثورة تقول في هذا السياق : “أشعر أنّني في حلب كأنّني أسرق حلب، أضعها في باريس في حضني، وتمدّ رأسها من حين لآخر لتقول لباريس: أنا أيضاً مدينة، كنت مكتظة بالبشر والحب قبل أن أصير الآن ركاماً وأنقاضاً ودماً وكوابيس”.
النص لا يتوقف عند الحنين وحده، بل يفتح أفق المقارنة: “لن أبكي، ستعود حلب كما عادت باريس.. باريس أيضاً كانت قد تحوّلت إلى أنقاض يوماً ما”. هنا يضع السرد المدن في ميزان واحد: باريس التي نهضت من ركام الحروب تصبح وعداً بأنّ حلب أيضاً ستنهض وتزدهر.
حين تقول البطلة: “أنا أرى حلب كلّما أغمضت عيني. لا تغيب حلب هي مكاني الحقيقي”، فإنّها لا تصف حالة فردية، بل تلخّص تجربة السوري كلّه، ذاك الذي لم تستطع المنافي اقتلاع مدينته من داخله. المنفى هنا يتحوّل إلى امتحانٍ وجودي: هل نستطيع أن نعيش بلا مدينة؟ والإجابة التي تمنحها الرواية هي أنّ المدينة، مهما هُدمت، تظل كامنة في القلب، تنتظر لحظة العودة والانبعاث.
ثورة الداخل وثورة الخارج.
في “مترو حلب” يظهر التناقض بين ثورة الداخل وثورة الخارج بأوضح صوره. البطلة عاشت المشهدين معاً، فشاهدت في حلب المظاهرات الأولى التي انطلقت بعفوية وشجاعة، ورأت كيف كان الشباب يواجهون رصاص الأمن بعيونٍ يملؤها الصفاء والإيمان. تصف لقاءها بأحدهم وهو يركض هارباً من الملاحقة ليقول لها: “لا تخافي نحن على حقّ وسنحيا”، جملة تكثف براءة الثورة ونقاء دوافعها. في الداخل كانت الحياة نفسها هي الثمن، وكانت التضحية تعبيراً عن صدق الانتماء وصفتها بالبراءة التي لم تشاهدها في باريس.
في باريس اكتشفت وجهاً آخر للثورة، فالمظاهرات هناك لم تحمل حرارة الشارع السوري، بل بدت أقرب إلى مشهدٍ استعراضي. ظهر فيها من اغتنم الثورة ليصنع لنفسه مكانة، ومن حوّلها إلى وسيلة لتحقيق طموحات سياسية ضيقة، غير آبه بالدماء المسفوكة في الوطن. مها حسن تلتقط هذه المفارقة بحدة حين تقول: “تعرفين يا سارة كم منحت الثورة أشخاصاً لا أهمية لهم في الحياة. إن الذين ماتوا من أجل الثورة هم أنبل منّا جميعاً”
هكذا تضع الرواية خطاً فاصلاً بين الداخل الذي دفع أثماناً فادحة، والخارج الذي منح بعض صغار النفوس فرصة للتسلق. البراءة التي رأت البطلة في عيون الثوار داخل حلب غابت تماماً عند كثيرين في المنافي، حيث تحوّلت الثورة إلى شعار يُرفع أكثر من كونها حياة تُعاش أو موتاً يُختار.
قسوة اللجوء وثقل التسمية.
ترسم “مترو حلب” صورة اللجوء كقدرٍ يومي لا ينفصل عن السوري أينما ذهب. اللجوء هنا ليس انتقالاً إلى مكانٍ آخر فحسب، بل هو هوية مفروضة تُختزل في كلمة واحدة تدمغ السوريين: “لاجئ”. كلمة تحمل ثِقلاً يطبع حياة الإنسان وقراراته، ويجعله يعيش في منطقة رمادية بين وطن ضائع وبلاد لا تمنحه انتماءً كاملاً.
تقول البطلة: “أين نذهب نحن السوريين؟ ما من مكان في العالم يتّسع لنا. وحين يحصل ونجد مكاناً نحمل بلدنا معنا، ونقارن تفاصيل الحياة في كل مكان مع حياتنا في سوريا، فلا نعرف كيف نعيش”.
إنّها معضلة مستمرة: حمل الوطن كعبءٍ داخلي، والاصطدام بواقعٍ جديد لا يتّسع للهوية القديمة.
هذا الثقل يتضاعف حين يصبح الوجود نفسه مهدّداً بقراراتٍ سياسية واجتماعية متغيرة. حياة السوري في المنفى مرهونة بغيره، فتقول: “حين أقرّر أن أخرج إلى الشارع، ما إن أصل إلى عتبة الباب حتى أحسّ بأنّ هذا المكان ليس مكاني. في أيّ يوم قد يخرج قرار ضدك كمهاجرٍ أو كلاجئ”. اللجوء يتحول إلى قلق دائم، حياة قائمة على هشاشة لا تسمح بالاستقرار أو الطمأنينة.
تكشف مها حسن عن القسوة الأعمق حين تقول: “صرنا نحن السوريين كائنات يُنظر إليها كخطرٍ على هذا العالم، أو يتعامل معنّا كما لو أنّنا كائنات متخلّفة، ليست بمستوى مواطنيها”. هكذا تتحوّل كلمة “لاجئ” من وصف قانوني إلى وصمة وجودية، تعيد تشكيل صورة الذات، وتضع السوري في موقع المنقوص، كأنّ هويته باتت مرتبطة بالمنفى أكثر من الوطن.
الشتات وترف الاستقرار.
تقدّم “مترو حلب” رؤية حادة لمعنى الاستقرار عند السوريين، حيث لم يعد السكن في مكان أو العيش في مدينةٍ أمراً طبيعياً، بل ترفاً نادراً لا يملكه أبناء الحرب. السوري كما تصفه مها حسن محكوم بالتنقل الدائم، عالقاً في حركة لا تنتهي، كأنّه يعيش في مترو يبدل محطاته دون أن يصل إلى وجهة ثابتة. “الإقامة والاستقرار في المكان ترف لا نمتلكه نحن أبناء الحرب. نسعى من محطةٍ إلى محطة من هذه المنافي حاملين معنا محطتنا الأساسية”. هذه الجملة تلخص مأساة الشتات: وطن مفقود لا يعوَّض، وذاكرة تتحوّل إلى الملجأ الوحيد حين يغيب البيت الحقيقي.
المنفى هنا لا يمنح استقراراً بديلاً، بل يرسّخ شعوراً بالهشاشة، حيث كلّ إقامة مؤقتة، وكلّ حياة معرضة للانقطاع. ومع ذلك، تضع الكاتبة بذرة للأمل، “مكاننا الأول هو حلب، التي نستند عليها في تعريف كلّ ما يأتي بعدها”. فالمدينة، وإن غابت خلف الركام، تبقى الأصل الذي يمنح للأماكن الأخرى معناها.
نبوءة المنفى وولادة الأمل.
تغدو رواية “مترو حلب” أكثر من مجرّد عملٍ أدبي عن المنفى، فهي نصّ يختزن التجربة السورية في أكثر لحظاتها إيلاماً وتحوّلاً. الرواية تتحرّك بين طبقاتٍ متشابكة: ذاكرة مدينة لم تفارق المخيلة، ثورة وُلدت ببراءة وامتلأت بالتضحيات، لجوء أثقل الكائن السوري بصفة “لاجئ”، ثمّ نافذة أمل تتّسع رغم كلّ الخراب.
قراءتها اليوم، بعد سقوط النظام وعودة حلب إلى أبنائها، تجعل حضورها مختلفاً. ما كان في زمن الكتابة استبصاراً أو أمنية، صار اليوم ملامح واقع يتشكّل مجدداً، إذ تعود المدينة إلى مكانها الأول في قلب السوريين وحياتهم.
إنّ حلب، التي وضعتها الرواية في مركز السرد، تستعيد الآن شيئاً من روحها، فتنهض حملات مثل “لعيونك يا حلب” و”الوفاء لحلب”، وكأنّها صدى لنبوءة الكاتبة بأنّ المدينة ستنهض كما نهضت باريس من تحت الركام.
“مترو حلب” إذن شهادة على زمن الدم والدمار والشتات والمنفى، وفي الوقت نفسه إعلان عن إمكانية الانبعاث. هي تذكير بأنّ السوري، مهما ابتعدت به المنافي، لا يملك سوى مدينته الأولى مرجعاً وبيتاً ومعنى، وأنّ حلب، التي كانت أنقاضاً، قادرة على العودة لتصوغ هوية جديدة بسواعد أبنائها لتحملهم وتتّسع لأحلامهم.