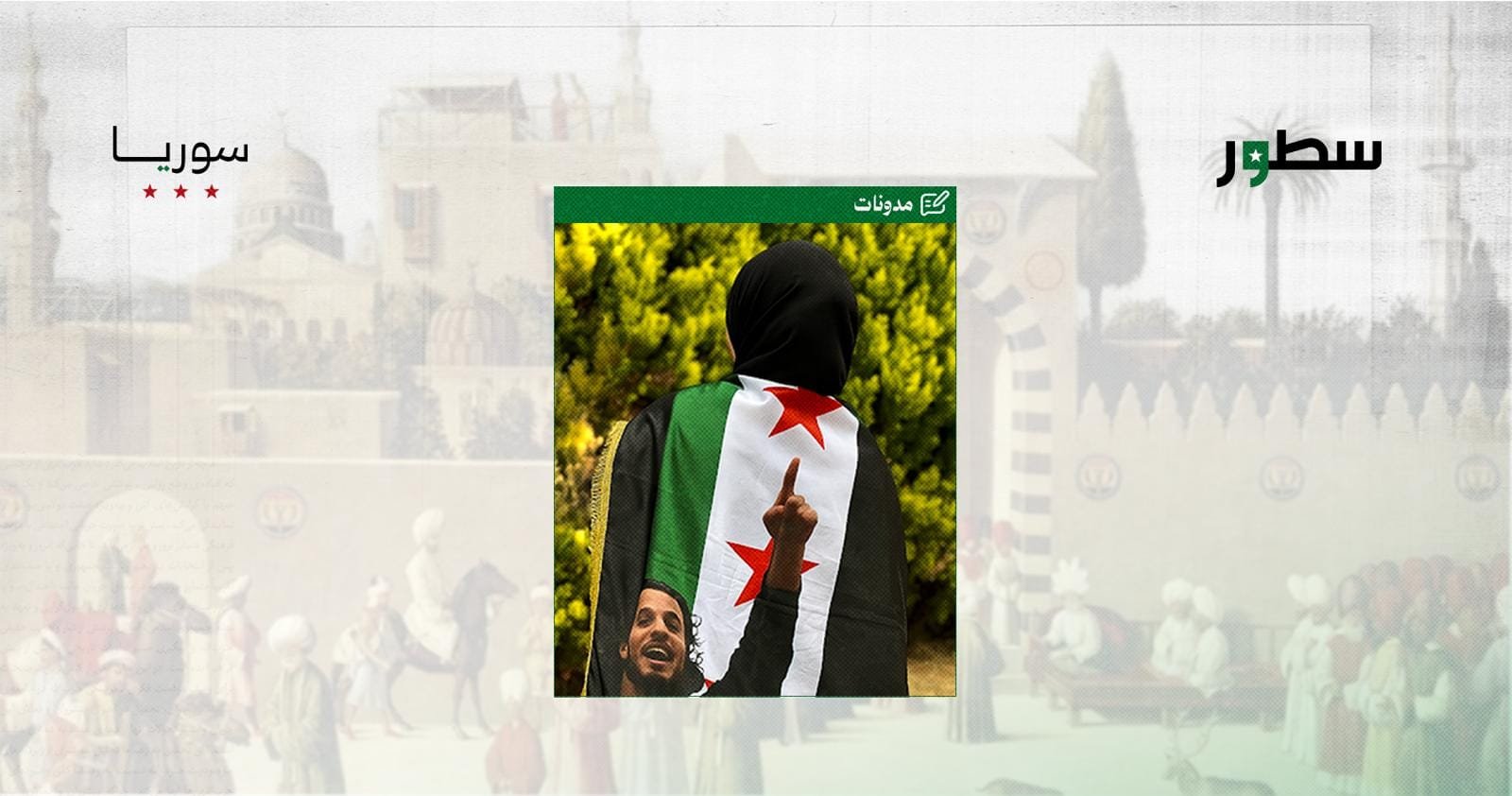أدب
رامي القادري.. الأدب السوري ضد النسيان
رامي القادري.. الأدب السوري ضد النسيان
الكاتب: أحمد الياماني
يقول مثلٌ أفريقيٌّ قديم: “إلى أن يتعلّم الأسدُ الكتابة، ستبقى كلّ القصص تمجّد الصيّاد”.
وهكذا كانت الحال في سوريا، حيث كتب الصيادون قصصهم عن أرضٍ لم تكن لهم، ومجّدوا أنفسهم في روايات النصر الزائف، بينما بقيت حكاية الضحية حبيسة الصمت والخوف والركام.
لكن مع رامي القادري، الكاتب السوري الذي وثّق لحظات الثورة بصدقٍ مؤلم في روايتيه “ملحمة الغوطة – حرملة: حبّ وقدر” و”ملحمة داريا – درع المطار”، تغيّر وجه الحكاية: لقد تعلّم الأسد أن يُكتَب عنه، لا أن يكتب هو. تحوّلت الرواية إلى سلاحٍ من نوعٍ آخر، لا يطلق رصاصاً، بل يفتح الجرح ويتركه شاهداً على الجريمة.
ملحمة الغوطة: الحبّ تحت الحصار.
في روايتيه، لا يتحدّث القادري بلسان السياسة، بل بلسان الذاكرة. يوثّق لا ليُسجّل الوقائع فحسب، بل ليمنح الأرواح التي سُحقت فرصةً ثانية للقول.
فـ “ملحمة الغوطة” ليست مجرّد عملٍ روائي عن حصارٍ أو معركة، بل مرآةٌ لوجوهٍ كانت تمشي في الشوارع المهدّمة وهي تحمل في قلبها حياةً كاملة.
بطل الرواية، يحيى، شابٌّ من حيّ جوبر الدمشقي، يرى الثورة تكبر أمامه كحلمٍ جميلٍ لا يدرك أنّه سيتحوّل إلى مأساة.
يقع في حبّ هديل، فتاة تشبه الربيع الذي لم يكتمل، ثمّ يجد نفسه بين مطرقة القمع وسندان الكرامة.
عبره، يُجسّد القادري تحوّل السوري من إنسانٍ يحلم إلى إنسانٍ يقاوم، ومن عاشقٍ إلى شاهدٍ على الانهيار الكبير.
ملحمة داريا: ذاكرة المدينة التي قاومت حتى النهاية.
أما “ملحمة داريا”، فهي الوجه الآخر للمرآة، تُكمل حكاية الثورة من المدينة التي صارت رمزاً للصمود والمجازر.
يطلّ فيها البطل هاني من منفاه في ألمانيا، متحدثاً إلى طبيبةٍ نفسية، كأنّ الرواية كلّها جلسةُ علاجٍ للذاكرة.
يستعيد فصول حياته بين داريا والأردن والمعتقل، ويكتب من خلال اعترافاته تاريخ جيلٍ كاملٍ حاول أن يحيا وسط الجحيم.
في كلّ فصلٍ، يخرج القارئ من الرواية مثقلاً بوجعٍ صادق، كأنّه هو من رأى الحصار بأمّ عينه، أو سمع صوت البراميل وهي تمزّق الحلم.
الكتابة فعل مقاومة وتوثيق.
القادري في عملَيه لا يقدّم رواية تقليدية بقدر ما يشيّد أرشيفاً وجدانياً للثورة السورية. يوثّق القهر والاعتقال والحصار، لكنّه في الوقت نفسه يحتفي بالحياة الصغيرة التي ظلّت تقاوم الموت: فنجان القهوة في الصباح، أغنية في منتصف الليل، طفلٌ يرسم علم الحرية على الجدار قبل أن يُمحى مع الغارة التالية.
إنّه لا يكتب فقط عن المقاتلين، بل عن النساء اللواتي خبأن الخبز لأبنائهن، وعن الشيوخ الذين ظلّوا يرفعون الأذان رغم الدمار، وعن الأمهات اللواتي تعلّمن كيف يدفنّ أبناءهن بأيديهنّ لأنّ المقابر امتلأت.
السرد الفني والبعد الإنساني.
على المستوى الفني، يمزج القادري بين السرد الوثائقي والنَفَس الملحمي، فهو لا يكتفي بتوثيق الأحداث بل يُدخل القارئ في تفاصيلها: رائحة الحطب المحترق في الغوطة، أصوات الطائرات في داريا، رائحة التراب المبلّل بالدم.
إنّه يكتب بلغةٍ تجمع بين الشعر والتاريخ، بين الصراخ والصمت، تتحوّل الجملة البسيطة إلى شهادة، والمشهد إلى وثيقةٍ تُدين نظاماً بنى شرعيّته على الخوف والدم، في المقابل، لا يغفل الكاتب عن الجانب الإنساني: الحبّ، الصداقة، الخيانة، الأمل.
ففي قلب كلّ حربٍ، هناك دوماً من ينتظر خبراً، أو من يكتب رسالةً لم تصل.
شهادة ضد النسيان.
جرائم النظام السوري في الروايتين ليست مجرّد خلفيةٍ درامية، بل هي الجدار الذي اصطدم به كلّ حلم.
القصف، التعذيب، الحصار، التجويع، التهجير كلّها تظهر بوضوح دون مبالغة.
القادري لا يُدين بالكلمات فقط، بل يجعل القارئ يعيش الجريمة، كأنّه واحدٌ من أولئك الذين كانوا في داريا تحت القنابل، أو في الغوطة حين أُطلقت الغازات السامة.
بهذا المعنى، تتحوّل الرواية إلى محكمةٍ أدبيةٍ للتاريخ، وإلى أرشيفٍ لا يمكن طمسه مهما حاول الجلادون إعادة كتابة الحكاية.
من يكتب يبقى.
في ختام المقال، يمكن القول إنّ “ملحمة الغوطة” و”ملحمة داريا” ليستا عملين أدبيين فحسب، بل سجلّان مفتوحان لثورةٍ حاول النظام دفنها في الصمت.
لقد منح القادري الحكاية صوتها، والضحايا أسماءهم، والذاكرة حياتها، إنّه الكاتب الذي رفض أن تُروى الحكاية من فم الصيّاد، فكتبها بمداد الذين لم يتمكنوا من الكتابة، ليقول للعالم:
“حتى وإن كان الأسد لا يعرف الكتابة، فهناك دائماً من يُمسك القلم، ويكتب الحقيقة التي لا تموت”.