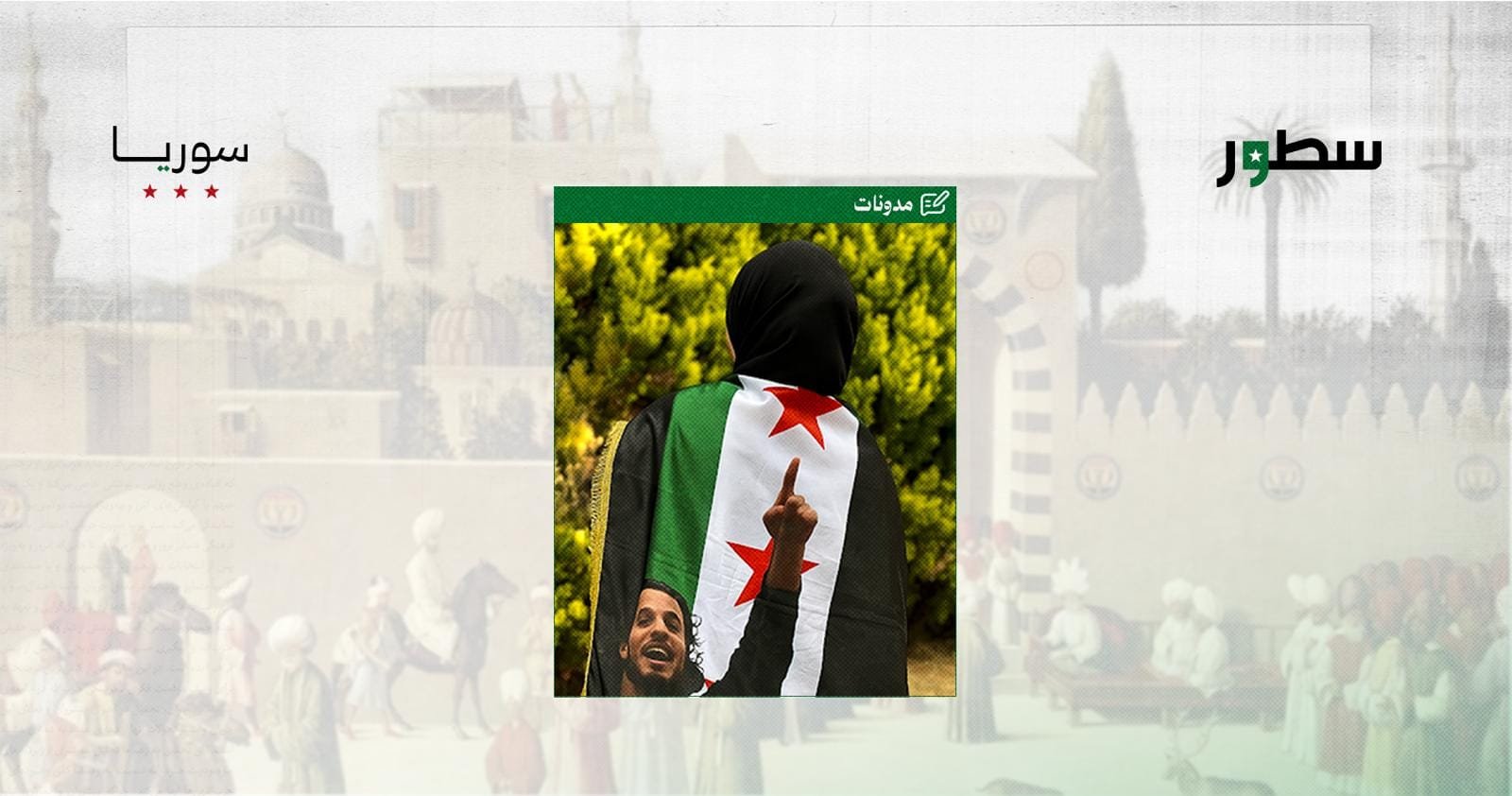فكر
من الذمّة إلى المواطنة تحوّلات الأقليات
من الذمّة إلى المواطنة تحوّلات الأقليات
منذ بدايات القرن العشرين، تفاقم الشعور في الشرق الأوسط تجاه التدخلات الغربية التي تُوّجت باستعمار المنطقة وتقسيمها لما يناسب إرادات حكومات الدول الأوروبية الاستعمارية، وزاد ذلك تصريح توم باراك حول أنّ الدول الوطنية في الشرق الأوسط هي نتاج تقسيمات استعمارية ولا يوجد دولة في المنطقة بل قبائل وقرى. إذ كانت هناك صيغ محلية أصيلة وُلدت بفعل التجربة والممارسة السياسية اندثرت لصالح صيغ غربية نشأت في سياقاتٍ تاريخية مختلفة عن سياق تاريخ المنطقة.
العلمانية وتصاعد التوترات الطائفية.
التدخّلات الغربية بدأت مع الحملة الفرنسية إلى مصر وتفاقمت لاحقاً لتجعل تعاهدات أهل الذمة طي النسيان، بعد أن صمدت قروناً طويلة في المنطقة، وعندما جاءت معها أفكار المواطنة والمساواة -أوروبية المنشأ- لمنطقة الشرق الأوسط انطلقت شرارة التوترات الطائفية والإثنية، وبدت الدولة الوطنية بما تحمله من قيمٍ عاجزة عن التعامل مع هذه التوترات.
قد يستهجن البعض الحديث عن تعاهدات أهل الذمة في زمن المواطنة ودولة القانون، وأنّ من غير المقبول أن نتحدث عن مواطنة من الدرجة الثانية رغم أنّها مواطنة على أيّ حال، خصوصاً في وضع كان فيه السوريون خلال عقود ماضية تحت حكم الأسد لا يعرفون الكثير من الحقوق، بل عاشوا تحت رحمة نظام لم يقدم أيّ مثالٍ على فكرة المواطنة بل على العكس لم يقدّم سوى القمع والبؤس وغياب القانون والحقوق.
إنّ آليات التفاهم بين المكونات الغالبة والمغلوبة، أو الحاكمة والمحكومة في منطقة الشرق الأوسط، تتغير باستمرار وليس هناك نمط ثابت للعلاقة بين هذه المكونات، والتي غالباً تتأثر بالظروف الخارجية الطارئة عليها كالغزو الخارجي أكان عسكرياً أو تجارياً بما يسبّب انزياحاً في العلاقة، ومن ثم يحتم اللجوء للعنف والعنف المضاد من قبل المكونات، هذه العلاقة الصعبة والضرورية بين المكونات السورية -أيّ باختصار بين المسلمين من جهةٍ وباقي المكونات من جهةٍ أخرى- كانت لقرون مديدة تعيش حالة ثبات واستقرار بشكل عام، خلال الفترة الممتدة ما بين الفتوحات العربية حتى أواخر الدولة العثمانية.
الاستقرار المديد في المنطقة.
الاستثناءات التاريخية لذلك الاستقرار قليلة مثلاً في عهد عمر بن عبدالعزيز الأموي وفي عهد المتوكل العباسي، حيث حدثت بعض التغيرات تشمل أهل الذمة من مسيحيين ويهود والتي لم تستمر طويلاً، ولم تؤثر في نمط العلاقة القائم على فكرة أهل الذمة والذي يشمل المسيحيين واليهود، ثمّ جاءت الحروب الصليبية متزامنة مع الغزو المغولي وخلالها جرت تغيرات في نمط العلاقة جعلت الرعايا من غير المسلمين يتبوؤون مناصب عليا.
لكن ذلك لم يستمر طويلاً بتحوّل المغول بشكلٍ جماعي نحو الإسلام وانسحاب الصليبيين من المشرق العربي، وتحت ضغط الهجوم المزدوج الصليبي المغولي على العالم الإسلامي ظهرت فتاوى متشددة تجاه مبعثها السياسي الظرفي، وإحساس شديد بالخطر وتحالفات من مكونات بعينها مع الطرفين المهاجمين، وعلى هذه الحقبة بالذات بنيت دعاية عداء الدولة الإسلامية للمختلفين معها دينياً، وجرى التركيز على شخصيات دينية إسلامية متأخرة بشكلٍ فج كما في حالة ابن تيمية.
من الملاحظ أنّ العلاقات بين المسلمين وغيرهم شهدت استقراراً في العهود الذهبية الأولى فيما بدأت العلاقات تسوء في القرون المتأخرة من عمر السلطنة العثمانية آخر دول المسلمين قوة، حيث تعتبر حرب استقلال اليونان (1821-1832) والتي لاقى فيها اليونانيون دعماً غربياً كبيراً ضد الدولة العثمانية، بداية التغير الكبير في العلاقة مع الرعايا المسيحيين في البلاد العثمانية.
وقد تحرّكت الأقليات في سوريا مباشرة بعد ثورة اليونانيين، مدعومة بتقدم محمد علي باشا الألباني نحو سوريا وسيطرته عليها لمدة 7 سنوات، لتتبوأ مناصب في الدولة وتغيّر من شكل النظام القديم والذي يُكرّس تفوق المسلمين في الدولة العثمانية، وقد حاول الباشا الألباني خلالها فرض ما قد فرضه سابقاً في مصر وهو إلغاء تعاهدات أهل الذمّة وإعلان المساواة بين جميع المكونات لينتج عنه انطلاق الاضطرابات الطائفية في بلاد الشام بعد رحيله عنها بعقود قليلة.
وخلقت التغيرات في النظام القديم حالة عدم رضا من الطرفين فقد رآها المسلمون نزولاً عن حالة التفوق السياسي التي كانوا فيها، وكذلك لاحظت بعض الشخصيات في الأقليات أنّها تلغي خصوصيات هذه الجماعات ومن ثمّ الامتيازات التي كانت لديها بضرورة هذه الخصوصيات، ويعتبر دخول إبراهيم باشا لسوريا فاتحة ظهور الحروب الطائفية في سوريا والتي لم تعرفها من قبل، خصوصاً مع الجماعات الذمية والتي لديها كتاب وبينها وبين المسلمين تعاهد.
انتهت حقبة أهل الذمة تماماً في سوريا بفرمان عثماني بعد ما يقارب 15 عاماً من خروج محمد علي من سوريا، وبقيت حية ضمنياً عندما أصبح بدل الخدمة العسكرية في الدولة العثمانية مفروضاً على أبناء الأقليات كونهم لا يخدمون في الجيش العثماني معادلاً للجزية المفروضة سابقاً، وقد ألغي البدل عن العسكرية مع اقتراب الحرب العالمية الأولى، لتنتهي حقبة هذه التعاهدات فعلياً.
ورغم النظرة التي يحملها أبناء الأقليات تجاه تعاهدات أهل الذمّة وصعوبة الفهم بمفردات عصرنا لفكرة المواطنة من الدرجة الثانية، إلا أنّها كانت مواطنة، وهي أفضل من لا شيء بالنسبة لمناطق أخرى من العالم لم يكن فيها سوى مكون واحد، وليس فيها مكان لمكون مختلف كأوروبا حتى تاريخ قريب جداً، فرغم بعض المشاكل الطائفية البسيطة لم تظهر نظريات إبادية للمختلف، ولم يكن هناك حاجة إليها طوال مراحل الحضارة الإسلامية، ولم يكن وجود المختلف من عدمه محلاً للنقاش عند المسلمين.
أدى تغير موازين القوى عالمياً بين الشرق والغرب، إلى انهيار المنظومة الحاكمة لهذه العلاقة، والتي لم يعد بإمكانها الصمود أمام الضغوط الخارجية من الأوروبيين والضغط الداخلي من الأقليات، هذا الانهيار للمنظومة القديمة في أواخر حياة الدولة العثمانية فتح الباب واسعاً للاضطرابات الإثنية والطائفية في بلاد الشام، فيما بدا أنّ السعي لحياة تسودها المساواة والتسامح يدفع بالاتجاه المعاكس نحو الانعزال والاستقلال أو العنف أو التناقض والتضارب ما بين كل ذلك.
التسامح والمساواة والمواطنة.
قبل ذلك السقوط لتلك المنظومة كانت العلاقة بين هذه المكونات تجد دوماً محلياً صيغاً وآليات لا بأس فيها للتعايش، رغم أنّها صيغ غير محبذة حالياً في زماننا، كوننا نعيش زمناً استثنائياً من تاريخ البشرية بحيث أصبحت المساواة والتسامح شيئين دالين على التحضر، وبحيث تجر أضدادهما من المصطلحات كالتمييز والتعصب تجر الويلات أحياناً في ظل هيمنة قيم نظام عالمي، أما قبل هذه الفترة القريبة من تاريخنا كبشر فقد كان التسامح والمساواة بين الغالب والمغلوب وعند كل الأعراق والأديان أمرين غير ذي أهمية، فلم يكن يُفتخر بالمساواة والتسامح مع الآخر على النمط الدفاعي الذي نراه اليوم في العالم الثالث لدرء غضب الدول المتقدمة وعقوباتها وحرمانها، ولم يذم التعصب ولم يكن يسبّب إحراجاً كون أنّ الآخرين أو أنفسهم متعصبون، لم يكن أحد يشيد بالتسامح حتى الذين دلت الشواهد على تسامحهم وعدالتهم مع الخصوم، لم يشد أحد في زمانهم بذلك بل نبش التاريخ بأثرٍ رجعي للدلالة على تسامحهم، وبالتالي تسامح حضارة بعينها أو دين بعينه في وقت تشير فيه المؤشرات التاريخية أنّ حالة الفوقية بين الغالب والمغلوب بقيت موجودة دائماً حتى إن كانت صورية معنوية فقط.
إنّ التعاهدات مع أهل الذمة والتي بدأت أساساً بين أقلية عربية مسلمة فاتحة وأكثرية مسيحية وأقل منها يهودية في بلاد الشام، كانت إحدى تلك الصيغ التي جاءت مع الأقلية العربية المسلمة التي حكمت سوريا ومناطق أخرى شاسعة، والتي بدأت من الحجاز أثناء الدعوة الإسلامية في بداياتها أثناء تجاورها مع المجتمعات اليهودية، ومن ثم المسيحية العربية على الأطراف الشمالية لشبه الجزيرة العربية.
كان العرب المسلمون أقلية مسيدة على أغلبية مسيحية في سوريا يشير باحثون متحمسون إلى أنّها -الأغلبية المسيحية- بقيت صامدة بتفوقها العددي في بلاد الشام حتى الحروب الصليبية، بحيث بدأت بالاختفاء في أعقاب هذه الحروب الطويلة والتي استمرت لما يقرب 200 عام، ويمكن رد هذا التفاهم بين الحاكم والمحكوم، إلى عدم اهتمام المسلمين بتغيير عقائد اليهود والمسيحيين، إضافة إلى الصراعات الطائفية بين المسيحيين أنفسهم في الفترة السابقة على الفتح ممّا جعل الفتح العربي مرحباً به وبشدة في أوساطهم بحسب ما أوضحت المصادر التاريخية السريانية في بلاد الشام في تلك الحقبة.