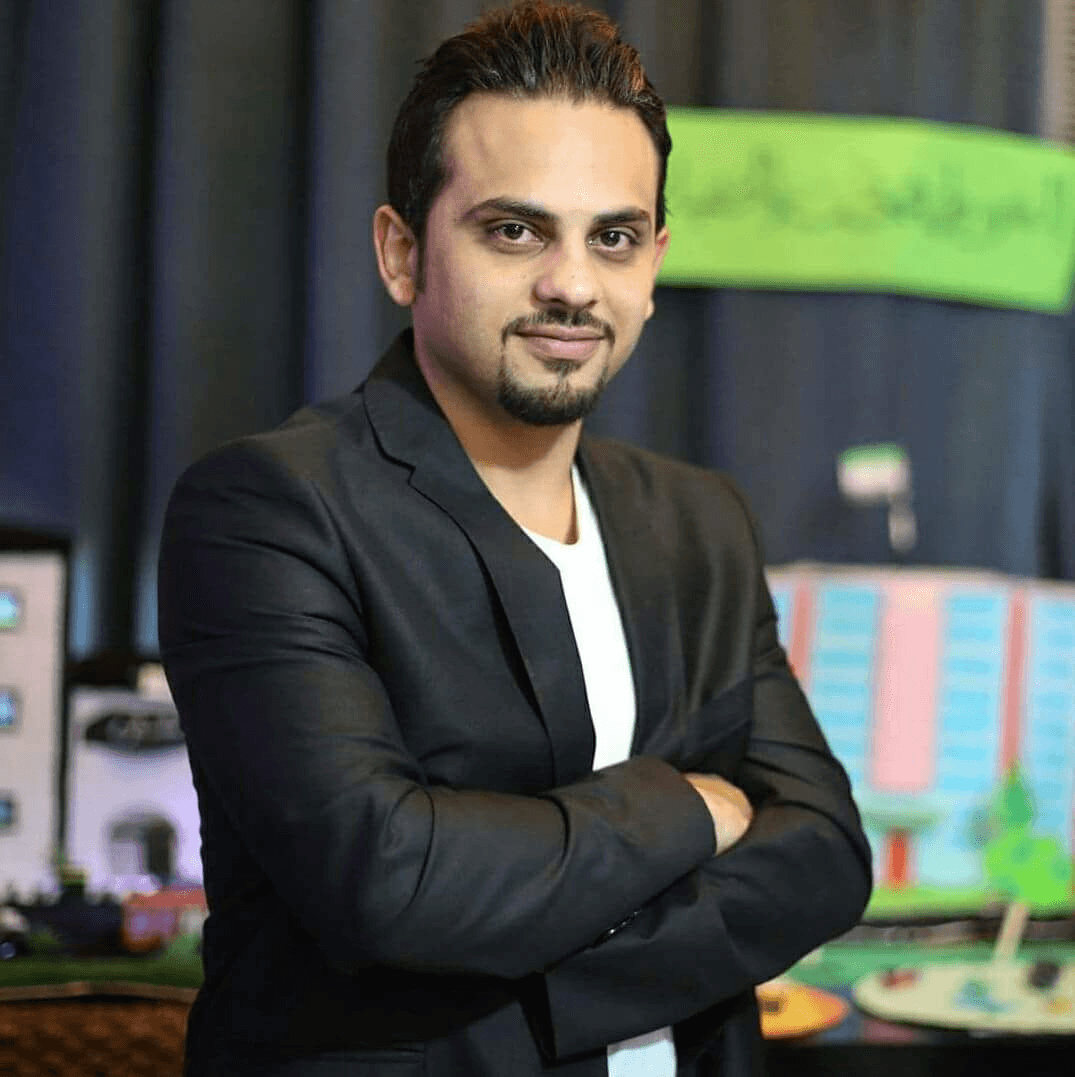مجتمع
صراع العودة بين الذاكرة والعدالة
صراع العودة بين الذاكرة والعدالة
منذ خروجي من الغوطة الشرقية، لم يغِب عني سؤال العودة. لم يكن سؤالاً سياسياً، بل سؤالاً شخصياً يتصل بالذاكرة أكثر مما يتصل بالمكان. فالخروج لم يكن خياراً، بل نهاية مفاجئة لحياةٍ كاملة، وبداية أخرى بلا ملامح واضحة.
عشت سنوات الحصار في الغوطة، في بيئة مغلقة على الخوف والعزيمة في آنٍ واحد، كنت أعمل وأتنقّل في أماكن مختلفة تتيح لي اختبار ما يحدث من أقرب نقطة.
في الـ21 من آب 2013، حين استُهدفت الغوطة بالسلاح الكيماوي، انكشفت حدود الفاجعة الإنسانية. كنت متطوعاً في مشفى الكهف في كفربطنا، أنهَيت نوبتي قبل أن تصل النداءات عبر اللاسلكي تطلب المساعدة الفورية. عدتُ، فوجدت المكان مكتظاً بالمختنقين، بلا جروح ظاهرة ولا دماء، في مشهدٍ لم يمنحنا وقتاً للفهم.
تلك الساعات القليلة غيّرت إدراكي للعالم، لم تعد الحرب أصوات قصف وركاماً، بل مواجهة مباشرة مع أقصى ما يمكن أن يبلغه الخوف والعجز، ومع حدود ما يمكن للإنسان احتماله وهو يرى الحياة تتسرب ببطء.
في مطلع عام 2018، ومع تصاعد الحملة العسكرية الأخيرة على الغوطة، بلغت المدينة لحظة الانهيار الكامل. كانت السماء تمطر قذائف بلا انقطاع، وكانت الحياة تسير في حدّها الأدنى تحت الخطر المستمر. في تلك الأيام فقدتُ أخي إثر قصفٍ جويٍّ، بحثنا عنه طويلاً قبل أن ننتشله من تحت الأنقاض. ظلّ في العناية المركزة أياماً قليلة ثم رحل، تاركاً وراءه طفلين لم يكتمل وعيهما، وعائلة تكسّرت من غيابه. لم يكن موته حادثاً معزولاً، بل ذروة الخسارة التي سبقت تهجيرنا الجماعي.
بعد أيامٍ قليلة، بدأ الإخلاء القسري، صعدنا إلى الحافلات التي نقلتنا إلى الشمال السوري، كانت القوافل تمرّ عبر مناطق موالية يتعالى منها كلام جارح ونظرات عدائية. لم يكن التهجير انتقالاً جغرافياً فحسب، بل ختاماً طويلاً لسنواتٍ من الحصار ونهايةٍ مريرة لوطنٍ لم يعد قادراً على احتواء أبنائه. عند الوصول إلى “قلعة المضيق” كانت الوجوه شاحبة والإنهاك عاماً. مئات العائلات، حقائب قليلة، وعيون تبحث عمّا تبقّى من معنى للنجاة.
من هناك بدأت رحلتي الطويلة في المنفى: إدلب، ثم تركيا، وأخيراً فرنسا. في كلّ محطةٍ كنت أتعلم شكلاً جديداً من النجاة، لكنّني لم أتعلم كيف أضع الذاكرة في مكانها الصحيح، فالذاكرة لا تُترك عند الحدود، ولا تنطفئ بالمسافة.
اليوم، بعد سقوط النظام، يعود سؤال العودة إلى الواجهة. البعض يراها واجباً، والبعض الآخر يراها خطراً على ما تبقّى من استقرارٍ شخصي. بالنسبة لي، العودة ليست قراراً إدارياً ولا ردّ فعل سياسياً، بل اختباراً للذاكرة.
الذاكرة لا تُغلق بقرار، لأنّها تعيش في تفاصيلنا الصغيرة، في الأصوات التي لا يمكن نسيانها، وفي الفراغ الذي خلّفه الغياب.
العودة ليست حنيناً فحسب، بل مواجهة مع الذات. من عاش الحصار والتهجير لا يمكن أن يعود كما كان، كما لا يمكن لوطنٍ انهكت ذاكرته أن يستقبل أبناءه كما تركوه. ومع ذلك، تبقى العودة فكرة حاضرة، لأنّها ترتبط بالعدالة، وبالرغبة في أن يكون لما حدث معنى. العودة، في معناها الأعمق، ليست فقط إلى البيت أو المدينة، بل إلى الإحساس بأنّ ما فُقد لم يذهب سدى.
لا يمكن لأيّ عودةٍ أن تكون ممكنة من دون أن يُحاسب مَن أمر وأشرف ونفّذ، ليس رغبة في الثأر، بل وسيلة لاستعادة الإحساس بأن للحياة منطقاً يمكن فهمه. أن يُعترف بما جرى، وأن يُسمّى الضحايا بأسمائهم، هو الحد الأدنى من الإنصاف. العدالة، في معناها الإنساني، أن تُفتح الملفات لا لتجديد الألم، بل لإغلاقه بصدق. بدونها، تبقى العودة مجرّد انتقالٍ جسديّ فوق أرضٍ لم تتصالح مع ذاكرتها.
ربما لا تكون العودة قريبة، لكنها تبقى احتمالاً قائماً إذا قامت على أساس العدالة والاعتراف والمحاسبة. العدالة لا تعيد الغائبين، لكنّها تمنح الأحياء حقّهم في وطنٍ يمكن النظر إليه دون خوف، وذاكرة يمكن احتمالها دون أن تتحوّل إلى عبءٍ دائم.
في فرنسا، يبدو أنّ المسافة تمنح فرصة للتأمل، لكنّها لا تمحو ما حدث. أتعلّم لغة جديدة، أعمل، وأشارك في حياة أخرى، لكن شيئاً في داخلي يبقى هناك، في الغوطة، حيث بدأت الأسئلة التي لم تنته. في المنفى تتسع الأسئلة أكثر ممّا تضيق، ويتحوّل كلّ مكان جديد إلى اختبارٍ للقدرة على التكيّف دون التخلّي عمّا يشكّل جوهرك.
الغربة ليست واحدة، بل طبقات متراكمة من الانفصال: عن الأرض، وعن الناس، وعن الذات. نحن نحاول أن نبدو طبيعيين، أن نتماهى مع إيقاع المدن الجديدة، لكن في الداخل تظل هناك منطقة صامتة لا يطالها أحد. تلك المسافة بين ما أتذكره وما أعيشه هي ما يصنع الغربة الحقيقية، لا اللغة ولا الجغرافيا. في المجتمعات التي استقبلتنا نحاول أن نُعيد تعريف أنفسنا، لا ناجين فقط، بل أناس يسعون لحياة طبيعية بعد زمنٍ طويل من الاستثناء.
في النهاية، ليست العودة وعداً سياسياً ولا حلاً فردياً، بل محاولة لاستعادة التوازن بين ما كُنّا وما أصبحنا عليه. المنفى يعلّمنا أنّ العدالة لا تُقاس بالمكان، بل بالقدرة على مواجهة الحقيقة دون خوف. وعندما تصبح الذاكرة جزءاً من وعيٍ جمعيّ يسعى للإنصاف ، يمكن للعودة أن تحدث لا بالضرورة كرحلةٍ إلى المكان، بل كتصالحٍ مع أنفسنا ومع ما حولنا.