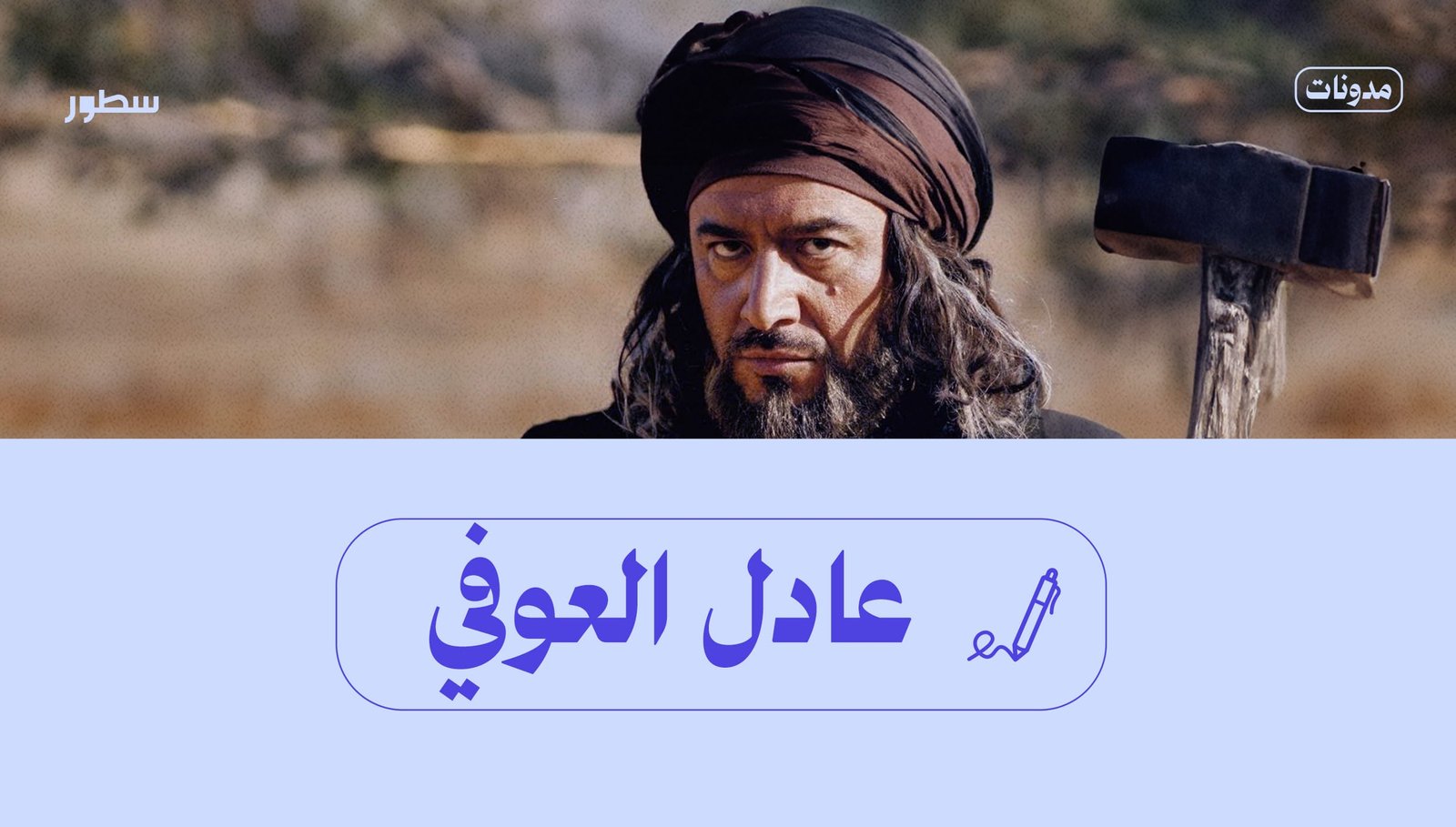مدونات
جدلية التذكر وبناء المعنى: من يحلم فينا حين نحلم معًا؟
جدلية التذكر وبناء المعنى: من يحلم فينا حين نحلم معًا؟
يقول جورج أورويل في روايته «1984»:
«من يسيطر على الماضي يسيطر على المستقبل، ومن يسيطر على الحاضر يسيطر على الماضي.»
من الذي يتذكّر حين تتذكّر أمة بأكملها؟ ومن الذي يحزن حين تبكي مدينة على أطلالها؟ وهل يمكن أن تكون للذاكرة روحٌ جماعية، كما للإنسان ذاكرة فردية وصوت داخلي؟ ثمّ ما الذي يجعل ملايين الأفراد المختلفين، في طبائعهم وثقافاتهم وأزمنتهم، يشعرون بأنّ لهم ماضيًا واحدًا وجرحًا مشتركًا؟
أهي المصادفة، أم أنّنا نحيا نوعًا من الحلم الجمعي الذي لا يصحو منه أحد؟
تفتح هذه الأسئلة باب النقاش على مفهوم الذاكرة الجمعية بوصفها ميدانًا للفكر الاجتماعي والفلسفي، حيث تتقاطع السردية التاريخية مع تشكّل الوعي الجمعي. فالذاكرة لا تُختزن في العقول الفردية وحدها، بل تُعاد صياغتها داخل الأطر الرمزية والثقافية التي تحدّد ما يُروى وما يُنسى، وما يُحفظ وما يُمحى.
يرى موريس هالبفاكس في كتابه «الذاكرة الجمعية» أنّ الذاكرة الفردية لا تنفصل عن الذاكرة الجماعية، إذ يتذكّر الإنسان داخل الجماعة لا خارجها، لأنّ الأطر الاجتماعية تمنح التذكر معناه واتجاهه. فالماضي لا يعود كما كان، بل كما يُعاد استحضاره في ضوء منظومة القيم والمعتقدات السائدة. وهكذا، يتجاوز فعل التذكر حدوده النفسية ليغدو فعلاً ثقافيًّا تُبنى داخله هوية الجماعة وتُعاد صياغة سرديتها التاريخية.
أما إميل دوركايم، فيرى في الوعي الجمعي «مجموع المعتقدات والمشاعر المشتركة بين أفراد المجتمع»، وهو الضمير الأخلاقي الذي ينظّم العلاقات ويجعل من الجماعة كيانًا متماسكًا. وكلما ازدادت رسوخًا الذاكرة الجمعية، ازداد حضور هذا الوعي الذي يحفظ الهوية ويمدّها بالاستمرارية عبر الزمن. فالتاريخ المشترك يتحوّل إلى نسيج من المعاني المتداخلة التي تُبنى عليها مفاهيم الانتماء والشرعية والمصير.
ويضيف بول ريكور في كتابه «الذاكرة، التاريخ، النسيان» أنّ الذاكرة ليست استحضارًا آليًا للأحداث، بل «فعل تأويلي يستعيد الماضي في ضوء الحاضر». وهذا البعد التأويلي يجعل من الذاكرة مجالًا لبناء المعنى أكثر من كونها استعادة للوقائع. فكلّ جيلٍ يعيد قراءة تاريخه من موقعه الزمني والسياسي، ويُعيد صياغة ذاكرته وفق حاجاته الرمزية. ومن ثمّ، يصبح الوعي الجمعي فعلًا تأويليًّا متجدّدًا يربط بين الماضي والحاضر، بين التجربة والتأمل.
التجارب التاريخية تُظهر أنّ الذاكرة الجمعية ليست مجرّد تراثٍ ثقافي، بل قوة رمزية تُوجّه السلوك الجماعي وتشكّل وعي الأمم. ففي ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، أُعيد بناء الوعي الجمعي على أساس «الاعتراف بالذنب»، وهو ما عبّر عنه يورغن هابرماس حين دعا إلى «ذاكرة نقدية لا تمجّد الماضي، بل تحاكمه». لقد مثّلت تلك الذاكرة التحليلية محاولة لإعادة تأسيس الذات الجماعية على مبادئ المسؤولية الأخلاقية، لا على أمجاد زائفة.
وعلى النقيض من ذلك، قدّمت التجربة الرواندية بعد عام 1994 نموذجًا آخر، حيث جرى توظيف الذاكرة كآليةٍ للشفاء الاجتماعي عبر طقوس الاعتراف الجماعي. هنا لم تعد الذاكرة حنينًا، بل ممارسة علاجية تسعى إلى ترميم الثقة داخل الجماعة. وهكذا، تتخذ الذاكرة الجمعية أشكالًا متعددة بحسب السياقات الثقافية والسياسية، وتتحوّل إلى مرآةٍ دقيقة تعكس وعي الأمم بذاتها في كلّ مرحلةٍ من تاريخها.
أمّا كارل غوستاف يونغ فقد قدّم تصورًا أعمق لما سماه اللاوعي الجمعي، وهو طبقة سحيقة من النفس الإنسانية لا تنتمي إلى جماعةٍ محددة، بل تعبّر عن ميراث رمزي مشترك للبشرية جمعاء. يحتوي هذا اللاوعي على الأنماط الأصلية (Archetypes) التي تتكرّر في الأساطير والأديان والأحلام — مثل صورة الأم، والظل، والبطل، والشيخ الحكيم. هذه الرموز ليست حصيلة تجارب فردية، بل هي بنى فطرية تسكن وجدان الإنسان وتوجّه رؤيته للعالم.
يمكن النظر إلى مفهوم يونغ بوصفه ذاكرة كونية تتجاوز حدود الزمان والمكان، ذاكرة لا تشير إلى حدثٍ تاريخي محدد، بل إلى تجربةٍ وجودية ممتدة في لاوعي النوع البشري. حين تتذكّر جماعةٌ ما أسطورتها المؤسسة، فإنّها لا تستعيد وقائع ماضية، بل تُفعّل رموزًا موروثة من لاوعيها الجمعي. وهنا يلتقي تصور يونغ بالطرح الاجتماعي لهالبفاكس في نقطةٍ جوهرية: فكلاهما يرى أنّ التذكّر فعلٌ جماعي لا يمكن فصله عن بنية الوعي الجمعي، غير أنّ يونغ يوسّع الجماعة من حدود الأمة إلى الإنسانية بأسرها.
بهذا المعنى، تصبح الذاكرة الجمعية جسرًا بين التاريخ والنفس، بين الوعي الاجتماعي واللاوعي الرمزي. فالأسطورة القديمة –مثل ملحمة جلجامش أو أسطورة الطوفان– تمثّل ذاكرة إنسانية تتجاوز حدود الثقافة، وتعيد إنتاج نفسها في كلّ عصرٍ من خلال رموز جديدة. وهذه الرموز تمنح الوعي الجمعي بعدًا أنثروبولوجيًا يوحّد بين التجربة التاريخية والتجربة النفسية في بنية رمزية واحدة.
لكن الذاكرة ليست حكرًا على المنتصرين، فهي أيضًا فعل مقاومة لدى الجماعات المهمّشة التي تسعى إلى استعادة تاريخها المنسي. وكما يقول ميشيل فوكو: «حيث توجد سلطة، توجد مقاومة». وهكذا، تصبح الذاكرة ساحةً لمواجهة الخطاب الرسمي الذي يحتكر سرد الماضي. فاستعادة الأصوات المقموعة وإحياء الأحداث المحجوبة يُعيدان التوازن إلى الوعي الجمعي، ويفتحان المجال أمام سردية أكثر شمولًا وعدلاً.
من زاويةٍ فلسفية، يمكن القول إنّ العلاقة بين الذاكرة الجمعية والوعي الجمعي تمثّل دينامية مستمرة بين التذكّر والتمثّل: فالتذكّر يمنح الجماعة استمراريتها في الزمن، والتمثّل يمنحها القدرة على إعادة إنتاج ذاتها في الحاضر. وكلما اتّسع المجال التأويلي للذاكرة، ازدادت مرونة الوعي الجمعي وقدرته على التكيّف مع التحولات التاريخية.
وعلى ضوء ما سبق، يمكن القول إنّ الذاكرة الجمعية تُسهم في تشكيل الوعي الجمعي من خلال إنتاج سردياتٍ مشتركة تمنح الأفراد شعورًا بالانتماء والمعنى، فيما يقوم الوعي الجمعي بتوجيه عملية التذكّر ضمن منظومات رمزية تحدّد ما يُستدعى وما يُهمَل. هذه العلاقة الدائرية بين الذاكرة والوعي تشكّل جوهر الهوية التاريخية، وتجعل من التذكّر فعلاً أخلاقيًّا وثقافيًّا في آنٍ واحد.
وفي الختام، تُتيح دراسة الذاكرة الجمعية والوعي الجمعي فهم المجتمعات لا بوصفها تجمعات بشرية فحسب، بل ككائناتٍ رمزية تتذكّر وتؤوّل وجودها عبر الزمن. وكما قال بول ريكور:
«أن نتذكّر هو أن نعيش مرتين، أن نعيد حضور ما كان ليمنح ما سيكون معناه.»
فالتذكّر، بهذا المعنى، ليس استعادةً للماضي، بل إحياءٌ دائمٌ للحياة في الوعي، والوعي الجمعي هو الإطار الذي يمنح لهذه الحياة معناها المشترك واستمراريتها عبر الأجيال.