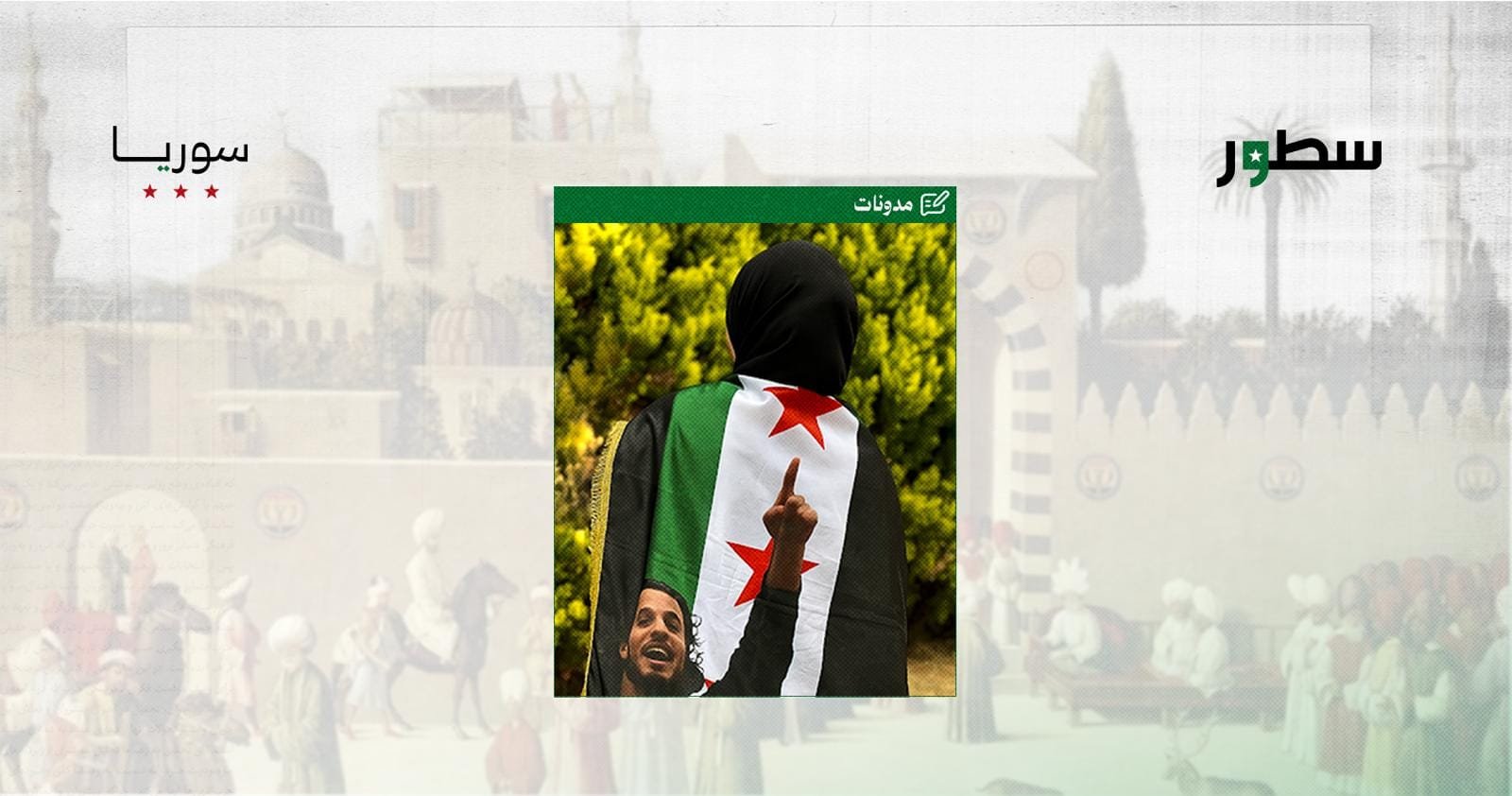مشاركات سوريا
الهوية السورية.. تاريخ من الفرض والإنكار
الهوية السورية.. تاريخ من الفرض والإنكار
الكاتب: محمد مجحم الهويدي
سايكس بيكو وأزمة الهوية: حين يصبح الانتماء عبئاً
منذ أكثر من قرن، خُطّت حدودنا بإملاء مصالح الآخرين. لم يرسم سايكس وبيكو مجرّد خرائط جديدة، بل أطلقا شرارة أزمة هوية ما تزال تحكمنا حتى اليوم. فالدول التي نشأت عن هذه الاتفاقية لم تكن ثمرة إرادة شعوبها، بل وُلدت ككيانات سياسية هجينة، مفروضة من أعلى، وغريبة في كثيرٍ من الأحيان عن واقعها الاجتماعي والثقافي. وهكذا، نشأنا في دولٍ لم تُنجز بعد تعريفها الذاتي، ولا صيغت وفق عقد اجتماعي توافقي، بل فُرضت وفق معادلات استعمارية.
في حالة سوريا، كما في كثيرٍ من دول المنطقة، تشكّلت الدولة الحديثة من دون مراعاة للتنوع الديمغرافي والعمق التاريخي لمجتمعاتها. فبدلاً من أن تكون إطاراً جامعاً، أصبحت عاملاً لإنتاج صراعات بنيوية داخلية. الهويات الفرعية العرقية، الطائفية، الدينية غالباً ما طغت على شعور الانتماء إلى الدولة، لأن هذه الدولة لم تُبنَ على أساس شراكة طبيعية بين مكوناتها، بل استُخدمت أحياناً كأداة للتهميش أو القمع.
من الخطأ اختزال الهوية في بُعد إثني أو حزبي، كما لا يجوز السعي إلى دمجها قسراً في سردية قومية أو إيديولوجية فوقية. إنّ الخطوة الأولى نحو تجاوز هذا المأزق تكمن في خلق هوية وطنية جامعة تنطلق من الواقع المحلي وتعترف بتعدديته، بدل الاكتفاء بإعادة إنتاج تنميط مركزي يفرض نفسه من أعلى.
القومية العربية: من حلم الوحدة إلى أداة الإقصاء
لم تكن استجابة شعوب المنطقة للتقسيمات الاستعمارية خجولة. بل جاء الخطاب القومي العربي كحالة مقاومة، تدعو إلى تجاوز الحدود المصطنعة وبناء وحدة شاملة. لكن هذه القومية لم تكن جامعة كما أُريد لها؛ بل تحوّلت في كثيرٍ من الحالات إلى خطابٍ إقصائي.
في سوريا، طُبّقت القومية العربية من خلال حزب البعث على نحو ألغى الهويات الكردية والسريانية والآشورية، متجاهلاً أنّ التعدد لم يكن حالة طارئة، بل جوهراً من تكوين سوريا التاريخية.
حين ارتبطت الهوية الوطنية بالانتماء القومي العربي، تمّ استبعاد كلّ من لا يُصنَّف ضمن هذه الهوية، بما في ذلك الجماعات العرقية والدينية التي لم تجد لنفسها مكاناً ضمن خطاب “الأمة الواحدة”. هكذا، تحوّلت القومية من مشروع تحرري إلى أداة سلطوية، تُستخدم لضبط التنوع لا للاعتراف به.
تجربة الوحدة السورية المصرية
مركزية قاهرة وهوامش مهمّشة شكّلت الوحدة بين سوريا ومصر (1958–1961) لحظة محورية في تشكّل الهوية السياسية في سوريا. فرغم النوايا الوحدوية التي حملها المشروع، كشف تطبيق الوحدة عن اختلالات عميقة في العلاقة بين المركز والهوامش. فُرضت قرارات مركزية من القاهرة، منها إصلاحات زراعية جذرية، مثل تأميم الأراضي وتوزيعها، ما ساهم في إضعاف البنية الاقتصادية للطبقة الوسطى السورية التي كانت تشكل ركيزة للحياة الاجتماعية والسياسية آنذاك.
تغيّرت معالم الهوية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة تلك الإجراءات، وبدأ الانفصال بين المواطن والدولة يزداد عمقاً، خاصة حين تحوّلت الدولة إلى جهازٍ إداري فوقي يتعامل مع المجتمع المحلي بوصفه متلقياً، لا شريكاً. وساهم هذا في تقويض الثقة بالمركز، ودفع باتجاه إعادة إنتاج هويات محلية أكثر ارتباطاً بالجغرافيا والانتماء الاجتماعي.
سقوط الطبقة الوسطى وصعود البعث: من الاحتواء إلى الاحتكار
مع انكماش الطبقة الوسطى خلال مرحلة ما بعد الوحدة السورية المصرية والانقلابات العسكرية، بدأ حزب البعث بإعادة تشكيل الدولة والمجتمع وفق منطق الهيمنة لا الشراكة. لم يعد المواطن السوري مواطناً، بل “بعثياً” بالهوية والسلوك والانتماء. شملت هذه السيطرة مختلف القطاعات: التعليم، الإعلام، النقابات، وحتى الفضاء الديني، الذي خضع بدوره لمنطق السلطة.
رغم ادّعاء النظام العلمانية، لم يُفصل الدين عن الدولة، بل جرى توظيفه أمنياً وإيديولوجياً. حظيت المؤسسات الدينية الرسمية بشرعية شكلية مقابل خضوعها الكامل، بينما همِّشت الطوائف الأخرى أو وُظفت في لعبة التوازنات السلطوية، لا الاعتراف المتكافئ. هكذا، لم تُمأسس الحيادية الدينية، بل احتُكرت الروحانية وحُوصرت ضمن أطر سياسية محددة، مما أفرغ الفضاء الديني من استقلاليته الرمزية وحوّله إلى ذراع لضبط المجتمع.
في الوقت ذاته، تمّ تهميش الهويات غير العربية، واحتُكرت اللغة والتعبير الثقافي، وأُعيد تعريف الوطنية وفق معايير الولاء للإيديولوجيا البعثية لا للمواطنة التعددية. أصبح الانتماء مقروناً بالصمت والامتثال، لا بالمشاركة والتعدد. هذا التسلط الإيديولوجي والديني أنتج هوية رسمية مفروضة، هشّة وغير قادرة على الصمود أمام التحولات الكبرى، وساهم في خلق فراغ شعوري استغلته لاحقاً تيارات متطرفة قدّمت نفسها كبديل روحاني أو سياسي عن أنظمة قمعية وفاشلة في بناء مشروع وطني جامع.
ما بعد 2011: انفجار الهوية في الداخل والمنفى
لحظة الانفجار السوري عام 2011 لم تكن مجرّد انتفاضةٍ سياسية، بل انفجاراً لهوية مأزومة ومكبوتة. خلال الشهور الأولى للثورة السلمية، بدأت تظهر بوضوحٍ ملامح الاضطراب في تعريف الهوية بين صفوف المعارضة، سواء المدنية أو العسكرية. لم يكن هناك تصور جامع أو سردية موحّدة تعبر عن جميع أطياف المجتمع، وهو ما خلق فراغاً سرعان ما ملأه التيار الإسلامي الأكثر تنظيماً، فبرزت القوى الجهادية وتقدّمت المشهد العسكري، على حساب الأصوات المدنية واليسارية التي تراجعت تحت ضغط القمع وتفتت الخطاب.
في الوقت ذاته، بدأت الأحزاب الكردية بتنظيم نفسها ضمن مناطق سيطرتها، وسرعان ما فرضت واقعاً سياسياً مختلفاً عن الخطاب المركزي، ما أضاف بعداً جديداً لتعقيد الهوية الوطنية السورية. كثير من الناشطين والسياسيين المدنيين انسحبوا أو هاجروا، بعضهم بدافع الخوف، وبعضهم نتيجة الشعور بعدم الجدوَى والفعالية، إضافةً إلى الإحساس بانعدام الوجود الحقيقي لهم في المشهد الجديد.
أما في المنافي الأوروبية، فقد تجلّت أزمة الهوية بحدة مضاعفة. لم يكن الاغتراب جغرافياً فحسب، بل وجودياً. يقول أحد اللاجئين في برلين: “في البريد أنا سوري. في الجامعة عربي. في العمل لاجئ. وفي البيت أب لطفلين ألمانيين لا يفهمان ما تعني سوريا”. هذه المفارقة تلخص معاناة جيل كامل نشأ على هوية معلقة بين عالمين. قانونياً هم أوروبيون، لكن وجدانياً مشرقيون. البعض أعاد إنتاج الهوية من جديد، من خلال العمل الثقافي أو المدني، والبعض الآخر اختار الصمت أو الذوبان. الهوية في المنفى لم تعد منفى عن الأرض فقط، بل عن السردية ذاتها.
نحو هوية مدنية جامعة
كي نبني هوية وطنية موحدة فعلاً، لا بد من تجاوز التفكير المركزي الذي ساد في مرحلة ما بعد الاستقلال ثم ترسّخ خلال حكم شمولي طويل الأمد، وأفضى في النهاية إلى انقسامات حادة، وصلت في بعض مراحلها إلى ما يشبه الاحتراب الأهلي. الخروج من هذه المأساة لا يمر عبر فرض “ثقافة وطنية موحدة” هشّة، بل من خلال الاعتراف بالهويات العرقية والثقافية والاجتماعية للمجتمعات المحلية في كل منطقة من سوريا.
في هذا السياق، لا بد من الاعتراف بأنّ الهوية في سوريا لم تكن يوماً واحدة أو متماثلة، بل متعددة ومتجذّرة في سياقاتها الجغرافية والثقافية. في منطقة الجزيرة السورية، على سبيل المثال، نجد تداخلاً فريداً بين المكونات الكردية والعربية والسريانية والآشورية، وهو تداخل لم يُصنّع في مختبر سياسي، بل نما عبر قرون من التعايش والتداخل الثقافي والاقتصادي. إنّ هذه الهوية المركبة لا يجب اختزالها أو ذوبانها في مشاريع قومية أو أيديولوجية، بل الانطلاق منها نحو تطوير عقد اجتماعي يعترف بتعدديتها، ويمنحها موقعاً مركزياً في بناء مستقبل وطني جامع.
لا نحتاج إلى ثقافة فوقية تجمع الجميع قسراً، بل إلى تواصل أفقي بين الثقافات، قائم على الفهم المتبادل والاحترام المتبادل. إنّ التعددية ليست تهديداً بل شرطاً للتعايش، والفهم المتبادل بين المكونات هو ما يُمكّن من إعادة بناء العقد الاجتماعي. من هذا التعدد، تولد إمكانية لهوية وطنية مدنية قادرة على أن تتسع للجميع، دون إلغاء أو تهميش. فالوطن ليس مجرّد خريطة، بل سردية يتشاركها الجميع، وما لم نُعِد كتابة هذه السردية من جديد، ستبقى الحدود الجغرافية قائمة، لكن الأوطان غائبة.