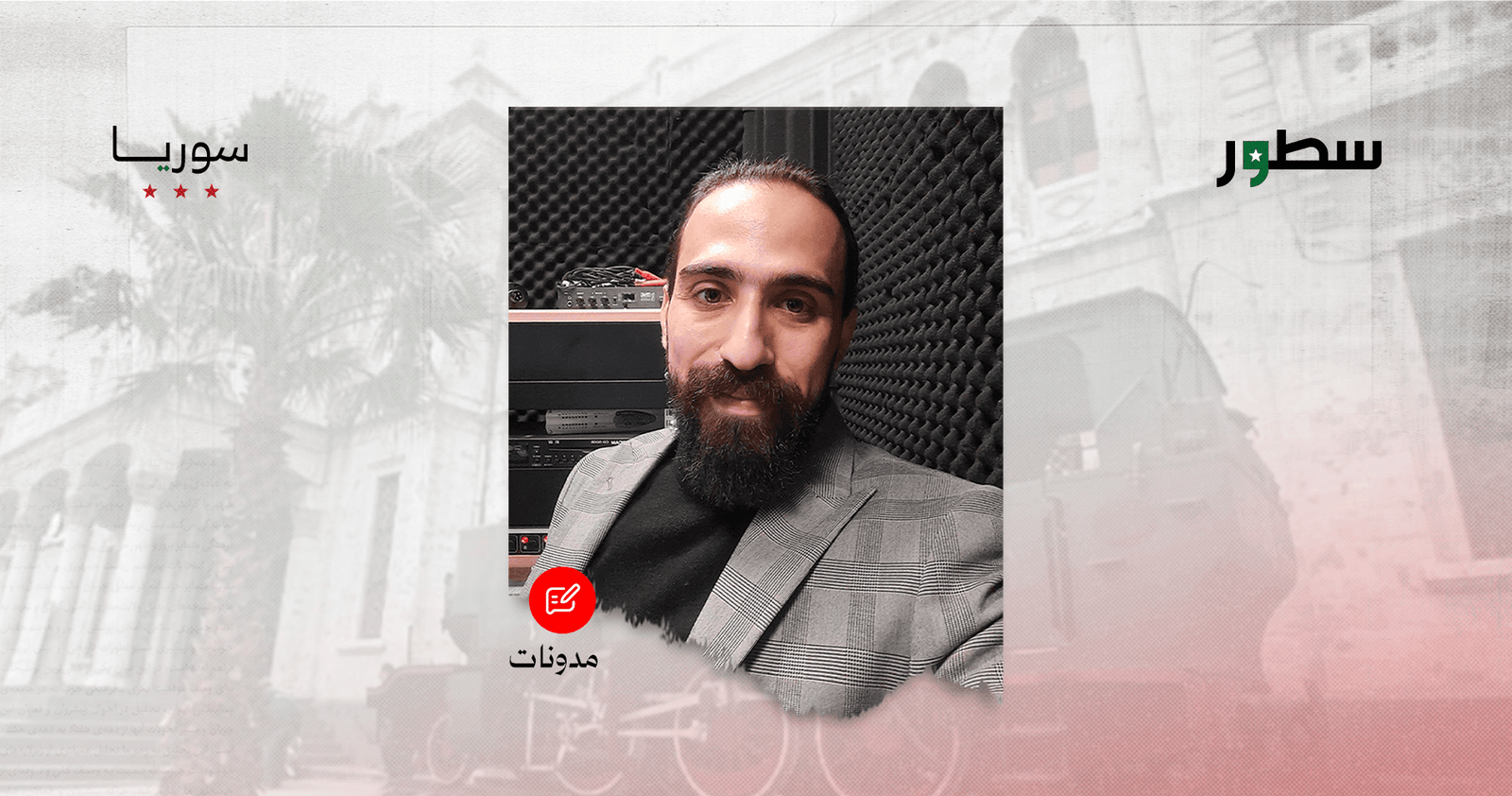فكر
سياسات الذاكرة الوطنية.. مسارات لتعافي الإنسان والمجتمع
سياسات الذاكرة الوطنية.. مسارات لتعافي الإنسان والمجتمع
عادة ما تلجأ الدول والأمم عقب الثورات وأحداث العنف التي تطال المدنيين إلى بناء ذاكرة وطنية، تُعيد خلالها الاعتبار للضحايا وتفتح المجال أمام المجتمع كي يتأمل تاريخه ويعيد صياغة روايته الوطنية، ذاكرة وطنية ترسخ ذكرى الماضي في الحاضر لتمنع تكرار المأساة في المستقبل.
في الحالة السورية، بدأت أولى محاولات بناء الذاكرة الوطنية من أكثر قضايا الذاكرة مأساة ومعاناة، من عذابات السجون وآلامها، حيث أطلق عدد من الصحفيين وصانعي الأفلام في “مؤسسة الشارع الإعلامية”، من داخل المتحف الوطني بدمشق، متحفاً افتراضياً يوثّق سجون سوريا وما تعرّض له المعتقلون داخلها خلال فترة حكم الأسد البائد، عبر صور وشهادات وتقنيات ثلاثية الأبعاد، في خطوة رمزية لحفظ الذاكرة الجماعية ودعم مسار العدالة الانتقالية. بالتوازي مع خطوات مماثلة وفعاليات لإحياء ذكرى أبرز الانتهاكات والمجازر التي حدثت خلال سنوات الثورة.
لكن مثل هذه الخطوات إذا ما توقفت عند حدود الرمزية، قد تتحوّل إلى طقسٍ سنوي أو معلم حجري بلا أثر ملموس في حياة الناس، وبلا قدرة على بناء ذاكرة ممتدة غير قابلة للنسيان. فالضحايا لا يحتاجون فقط إلى نصبٍ تذكاري يحمل أسماءهم، بل إلى دعمٍ نفسي يعيد لهم بعضاً من قدرتهم على العيش، وأطفال المدارس لا يحتاجون إلى حضور مراسم رسمية بقدر حاجتهم إلى مناهج ودروس تبني وعياً يحميهم من تكرار المأساة.
وعليه يصبح السؤال الجوهري: كيف نجعل سياسات الذاكرة أداة عملية للتعافي الفردي والمجتمعي، لا مجرد رموز ساكنة؟ وكيف تتحوّل الذاكرة الوطنية إلى سياسة عملية تعزّز الصحة النفسية، وتدعم التعليم، وتعيد الثقة بين المواطن والدولة؟
ذاكرة وطنية أم ذاكرة متنازع عليها؟
من نافلة القول إنّ الأنشطة الرمزية تقدم لحظة اعتراف ضرورية لكنّها قد تعيد فتح الجراح إذا لم تُرافق بخدمات عملية. وكثيراً ما تتحول هذه الأنشطة إلى مساحات استقطاب سياسي أو تنازع سرديات بدلاً من أن تكون ساحة جامعة للتعافي.
وفي سورية حيث المجتمع المهشم، تبدو الانقسامات الاجتماعية والسياسية جسيمة وحادة، وقد زاد من فظاعتها استمرار دوامةالعنف حتى بعد سقوط نظام الأسد، حيث فتحت أحداث الساحل والسويداء المجال أمام تضارب الروايات وتناقض الرموز.
وقد تُفهم الرموز المجسدة في فعاليات الذاكرة الوطنية على أنّها منحازة لطرفٍ دون آخر، ممّا يزيد الانقسام. ويدفع التنازع حولها إلى تحويل الذاكرة من مساحة اعتراف وإنصاف إلى ساحة صراع جديد على الشرعية والمعنى. وحين تصبح الرموز محل تنافس، تفقد قدرتها على أن تكون أداة للشفاء الجماعي وتتحوّل إلى أداة لإعادة إنتاج الخصومة. من هنا تبرز أهمية اعتماد مقاربة جامعة للذاكرة الوطنية، تضع الضحايا في المركز وتُصاغ بلغةٍ لا تميز بينهم ولا تُقصي أحداً.
حدود الرمزية في الذاكرة الوطنية
على أهميتها تُقيد الرموز في سياق بناء الذاكرة الوطنية بقيود ثقيلة، وتكمن حدود الرمزية في أنّها تمنح اعترافاً سريعاًبالضحايا لكنها تظل عاجزة عن مداواة الجراح العميقة إذا لم تقترن بخطوات عملية. فالنُصب التذكارية والمتاحف وأيام الذكرى قد توفر لحظة للتأمل الجماعي، لكنّها قد تتحول إلى طقس شكلي يتكرر سنوياً من دون أثر ملموس على حياة الناجين. بل قد تعيد بعض هذه الرموز فتح الصدمات القديمة بدلاً من معالجتها.
والرمزية، مهما بدت مؤثرة، لا تكفي وحدها. إنّها أشبه بإشارة ضوئية تُلفت الانتباه لكنها لا تُغيّر الطريق. وهنا تكمن خطورتها: إذا توقّفنا عند الرموز فقط، فإنها تفقد معناها العملي وتتحوّل إلى مجرّد لافتة صامتة، تذكّر بالماضي من دون أن تفتح الطريق إلى المستقبل.
تتحقق قيمة الذاكرة الرمزية فقط إذا كانت جزءاً من منظومة أوسع تشمل الدعم النفسي الاجتماعي للضحايا، وإدماج قصصهم في المناهج التعليمية، وخلق مساحات للحوار المجتمعي، بما يحوّل الرموز من مجرّد إشارات صامتة إلى أدوات حيّة للتعافي وإعادة بناء الثقة. هنا تصبح الرمزية مدخلاً للعمل، لا نهاية له، وتتحول الذاكرة الوطنية من طقس ساكن إلى مشروع إنساني يعزّز الهوية المشتركة ويُعيد نسج العلاقات الممزقة بين الأفراد والجماعات.
من الرمزية إلى الخدمة المجتمعية
لكي تصبح سياسات الذاكرة الوطنية مؤثرة؛ لا بد أن تنطلق من الرمزية إلى العملية، ومن بناء المعنى إلى تقديم الخدمة. على المستوى النفسي، يمكن أن تترافق زيارة المتاحف أو حضور الفعاليات مع جلسات يقودها مختصون نفسيون، ومع خطوط هاتفية مخصصة لتقديم الدعم والاستماع للناجين وأسرهم. هذه الخطوات تضمن ألا تتحول التجربة إلى إعادة صدمة، بل إلى فرصة للتعافي.
على المستوى التعليمي، يمكن إدماج فعاليات الذكرى في المناهج، لا بشكل رسمي جامد، بل عبر أنشطة مبسطة مثل قصص ضحايا معممة الهوية، أو مشروعات مدرسية مرتبطة بفكرة العدالة وحقوق الإنسان. بذلك يصبح التذكر أداة تربوية تغرس في الأجيال الجديدة قيماً تحميهم من إعادة إنتاج العنف.
وعلى المستوى المجتمعي، يمكن تحويل النصب التذكارية إلى مساحات تفاعلية، مجهزة بشاشات أو رموز إلكترونية، تسمح للزوار بقراءة الشهادات أو تسجيل رسائل تضامن، مما يعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية الجماعية.
يمكن تخيل متحف للذاكرة الوطنية في دمشق أو حلب لا يكتفي بعرض صور ووثائق، بل يتيح للزائر التفاعل مع الشهادات عبر تقنيات الواقع الافتراضي. يدخل الزائر إلى غرفة افتراضية تعيد بناء مشهد من السجون أو المدن المدمرة، مع خيار الخروج في أي لحظة إذا شعر بالضغط النفسي. في نهاية الجولة، يمكنه أن يتواصل مباشرة مع خط دعم نفسي، أو يحصل على كتيب يشرح الخدمات المتاحة للناجين، هذا الربط بين التوثيق والدعم النفسي يحوّل الزيارة من تجربة صادمة إلى فرصة للشفاء.
كذلك يمكن تخصيص يوم وطني للذكرى في المدارس، حيث يقضي الطلاب ساعات دراسية متنوعة يستمعون فيها إلى قصة قصيرة عن ضحية مجهولة الهوية، يناقشون معنى العدالة، يرسمون خطاً زمنياً لمراحل الثورة أو ينفذون نشاطاً فنياً يجسد أيقوناتها، ثم يختتمون الجلسة بتمرين بسيط للرفاه النفسي يقوده المدرس بدعم من مختصين؛ بهذه الطريقة يصبح التذكر وسيلة تربوية عملية.
مجتمعياً، يمكن إقامة نصب تذكاري في كل حي، مرتبط بقاعدة بيانات رقمية، وحين يزور الأهالي النصب التذكاري، يقرؤون شهادات عن ضحايا منطقتهم، ويتركون رسائل تضامن تُضاف إلى أرشيف وطني رقمي؛ هذه الرسائل لا تبقى مجرّد كلمات، بل تُستخدم في دراسات عن التعافي المجتمعي.
في واقع الأمر، نجاح الانطلاق من الرمزية إلى العملية لا يمكن أن يتحقق دون وجود مؤسسات واضحة تُدير العملية وتشرف وتنسق الفعاليات. فيمكن أن تكون هناك لجنة وطنية للذاكرة تنسق بين هيئة العدالة الانتقالية، ووزارات الصحة، والتربية، والثقافة. هذه اللجنة تضع السياسات وتضمن التكامل بين القطاعات المختلفة. إلى جانبها، يمكن تأسيس مجلس أخلاقي يضم ممثلين عن الضحايا وخبراء نفسيين وقانونيين، يراقب عملية جمع الشهادات وعرضها ويضمن حماية الضحايا من إعادة الإيذاء.
كما تعد الشراكات مع المجتمع المدني أساسية أيضاً، خصوصاً المنظمات التي راكمت خبرة في التوثيق الرقمي أو الدعم النفسي؛ وبهذا يتحوّل ملف الذاكرة من مشروعٍ رمزي تديره الدولة إلى شبكة متكاملة من المؤسسات الرسمية والفاعلين المدنيين والمحليين.
ولتنفيذ هذه السياسات لا بدّ من موارد مالية مخصصة. حيث يمكن إنشاء صندوق وطني للذاكرة بميزانية سنوية واضحة، يخضع لرقابة مستقلة ويعلن تقاريره للعموم. هذا الصندوق يموّل الأنشطة الرمزية والخدمات المرافقة لها، من خطوط الدعم النفسي إلى إنتاج المواد التعليمية. ويضمن وجود مراقبة مستقلة ألا تُستخدم هذه الموارد لأهداف سياسية ضيقة، بل تبقى مكرّسة لخدمة الضحايا والمجتمع.
ولكي تنجح سياسات الذاكرة، يجب أن تُقاس نتائجها بشكلٍ دوري وشفاف. هل ساعدت هذه الأنشطة على تخفيف أعراض الصدمة لدى الضحايا؟ هل عزّزت معرفة الطلاب بحقوق الإنسان؟ هل رفعت مستوى الثقة بين المواطنين والمؤسسات؟ يمكن استخدام أدوات بسيطة مثل استبيانات عن مستوى الرفاه النفسي قبل وبعد المشاركة، أو قياس مستوى المعرفة المدنية لدى الطلاب بعد الأنشطة. والأهم هو أن تُنشر نتائج هذه التقييمات بشكلٍ دوري، بحيث يرى الناس أنّ سياسات الذاكرة ليست مجرّد شعارات، بل مشروعاً حيًّا يخضع للمساءلة ويُقاس أثره باستمرار.
في المحصلة، ليست الذاكرة الوطنية حجراً أو متحفاً أو احتفالاً، بل هي خدمة عامة إذا صُممت بشكل صحيح. هي دعم نفسي للضحايا، وتعليم للأجيال، وجسر لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. وفي سوريا، حيث الجراح عميقة والملايين يحملون ندوب الحرب، لا يكفي أن نتذكر الماضي، بل يجب أن نُحوّل التذكر إلى طاقة تنفيذية للتعافي وبناء المستقبل. بشكل تصبح فيه سياسات الذاكرة جسراً بين الرمزية والمعنى العملي، وبين الماضي والمستقبل.