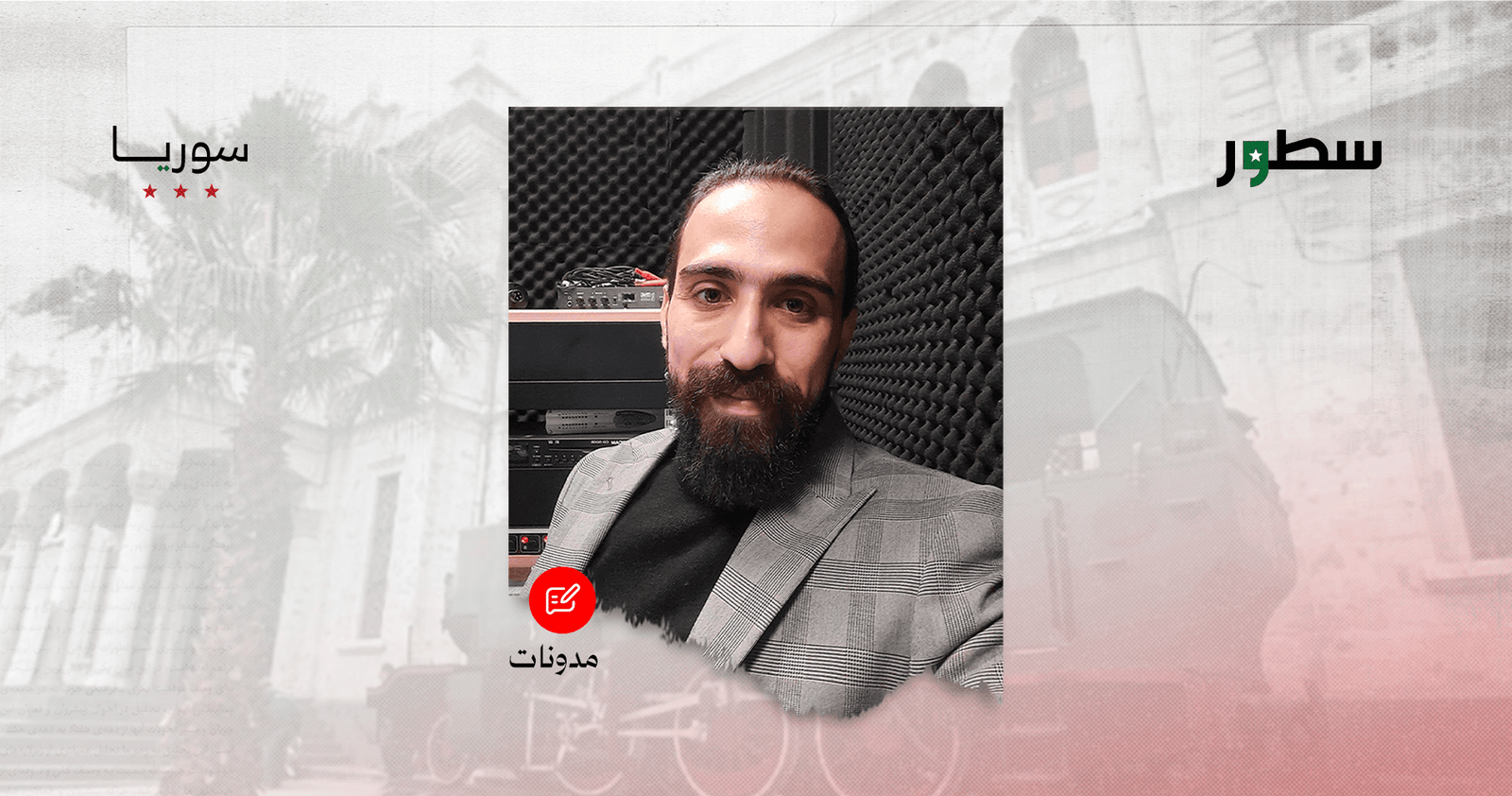مشاركات سوريا
سكة حديد الحجاز: مشروع وحدوي طموح انتهى تحت أنقاض الصراعات
سكة حديد الحجاز: مشروع وحدوي طموح انتهى تحت أنقاض الصراعات
الكاتب: عصام يزبك
في أوائل القرن العشرين، كانت الدولة العثمانية تخوض سباقًا مع الزمن لإثبات مكانتها كقوةٍ إسلامية مركزية في وجه الضغوط الأوروبية المتزايدة. ومن رحم هذا التحدي، خرج مشروع سكة حديد الحجاز؛ خطّ سكك حديدية لم يكن مجرد وسيلة مواصلات بل رؤية استراتيجية، دينية واقتصادية، أرادت من خلالها الدولة العثمانية أن توحد أطرافها، وتقوّي تواصلها مع العالم الإسلامي، وتُيسّر أداء مناسك الحج للمسلمين من كافة أنحاء الإمبراطورية. فكيف نشأت هذه الفكرة؟ ولماذا لم تكتمل؟ وماذا بقي منها اليوم؟
النشأة: عندما تتحوّل الفكرة إلى مشروعٍ واقعي
كان السلطان عبد الحميد الثاني، الذي تولّى الحكم في زمنٍ عصيب، مدركًا لحجم التحديات التي تواجهها دولته. فإلى جانب النزاعات الداخلية والتوتّرات العرقية، كانت القوى الأوروبية تتسابق على اقتسام العالم الإسلامي. رأى السلطان في سكة حديد الحجاز فرصةً لربط قلب الدولة العثمانية بمقدّساتها الإسلامية، وتثبيت السيادة على الأراضي العربية، وتقوية التواصل السياسي والاقتصادي والعسكري معها.
بدأت الأعمال الإنشائية عام 1900 بتمويلٍ عثماني خالص، مع تبرعات من المسلمين حول العالم، ما أضفى على المشروع بُعدًا دينيًّا وشعبيًّا. شارك في تمويله مسلمون من الهند، مصر، وشمال أفريقيا، وحتى مسلمو روسيا، معتبرين أنّ هذا المشروع ليس ملكًا للدولة العثمانية فقط، بل لكلّ الأمة الإسلامية.
الخط والامتداد الجغرافي
امتدّ الخط من دمشق حتى المدينة المنورة، بطولٍ يتجاوز 1320 كيلومترًا، مرورًا بمحطاتٍ مهمة في درعا، معان، تبوك، ومدائن صالح. وقد تفرّعت منه خطوط فرعية نحو حيفا، بيروت، وغيرها، مما وسّع نطاق الاستفادة منه. كما كان من المخطّط أن يصل الخطّ إلى مكة المكرمة، إلا أنّ الحرب العالمية الأولى حالت دون إتمام هذا الامتداد الحيوي.
استُخدم في بنائه أحدث ما توصلت إليه تقنيات السكك الحديدية آنذاك، مع تحديات كبيرة في التضاريس الصحراوية، والمناخ القاسي، وصعوبة تأمين الإمدادات.
الأبعاد السياسية والعسكرية
لم يكن البُعد الديني وحده كافيًا لتفسير الأهمية الاستراتيجية للمشروع. فالسلطان عبد الحميد كان يهدف أيضًا إلى تعزيز سلطته في المناطق العربية التي بدأت تشهد مؤشرات على التمرد والنزعة الانفصالية. وقد مكّنت السكة الجيش العثماني من الانتقال السريع إلى الحجاز أو الشام في حال اندلاع أي اضطرابات.
كما خافت القوى الأوروبية من هذا المشروع، لا سيما بريطانيا وفرنسا، اللتين اعتبرتاه تهديدًا لمصالحهما في المنطقة، خصوصًا أنّه قد يُستخدم لنقل الجيوش بسرعةٍ إلى قناة السويس أو للسيطرة على الخطوط التجارية.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية
لم يقتصر دور السكة على النقل العسكري أو الحجّ. بل ساعدت في تنشيط التجارة الداخليّة، وساهمت في خلق مجتمعاتٍ صغيرة حول المحطات الرئيسية، وتبادل السلع بين المناطق البعيدة. ظهرت أسواقٌ ومرافق خدمية جديدة، كما بدأ السكان المحلّيّون بالاستفادة من الوظائف التي أوجدها المشروع، سواء في التشغيل أو في الخدمات اللوجستية المرتبطة به.
كما قلّصت السكة مدة رحلة الحجّ من شهرين أو أكثر إلى 4 أو 5 أيام فقط، ممّا خفّف التكاليف والمشقة عن الحجاج، وساهم في رفع أعداد القادمين إلى المدينة المنورة بشكلٍ ملحوظ.
الانهيار: من الثورة إلى الحرب
مع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، أصبح الخطّ هدفًا واضحًا لقوات الحلفاء، لا سيما بعد اندلاع الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين عام 1916. وقد أدى لورنس العرب دورًا مهمًّا في تنسيق الهجمات على السكة، من خلال عمليات تفجير متكرّرة استهدفت الجسور والمحطات والقطارات.
بحلول عام 1920، كانت السكة قد خرجت عن الخدمة بالكامل في الجزء الجنوبي، بينما استمرت أجزاء منها تعمل في الشمال لعدة سنوات قبل أن تتوقف هي الأخرى.
الإرث المعماري والرمزي
اليوم، ما يزال العديد من محطات سكة حديد الحجاز قائمة، خاصة في الأردن والسعودية وسوريا. وقد تم ترميم بعضها وتحويلها إلى متاحف، كالمتحف الحجازي في المدينة المنورة، ومحطة عمان التي تُعد من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة الأردنية.
تمثل هذه المحطات اليوم شاهدًا على مشروع طموح جمع بين الدين، السياسة، والهندسة، وحمل في طياته حلمًا بوحدة العالم الإسلامي لم يتحقق.
مشاريع الإحياء والمستقبل
رغم مرور أكثر من قرن على توقفها، تعود فكرة إحياء السكة إلى الطاولة من وقتٍ إلى آخر، سواء كمشروعٍ سياحي ثقافي، أو وسيلة نقل حديثة تربط بين الدول الإسلامية في المنطقة. في السنوات الأخيرة، جرى الحديث عن ربط سكة حديد بين المدينة المنورة والعلا، تمر على نفس المسار القديم جزئيًّا، ما يعيد الروح إلى الفكرة القديمة بروحٍ حديثة.
سكة حديد الحجاز لم تكن مجرّد خطّ سكة حديد، بل كانت مشروعًا حضاريًّا متكاملًا، جمع بين قدسية المكان، وحكمة التخطيط، وروح النهضة الإسلامية. ورغم أنّ الحرب أنهت هذا الحلم الكبير، إلا أنّ إرثه ما زال حيًّا في الذاكرة والوجدان، وربما يحمل المستقبل مفاجآت تُعيد هذا المشروع إلى الحياة بطريقةٍ جديدة، تلائم تطلعات اليوم، وتحافظ على رمزية الماضي.