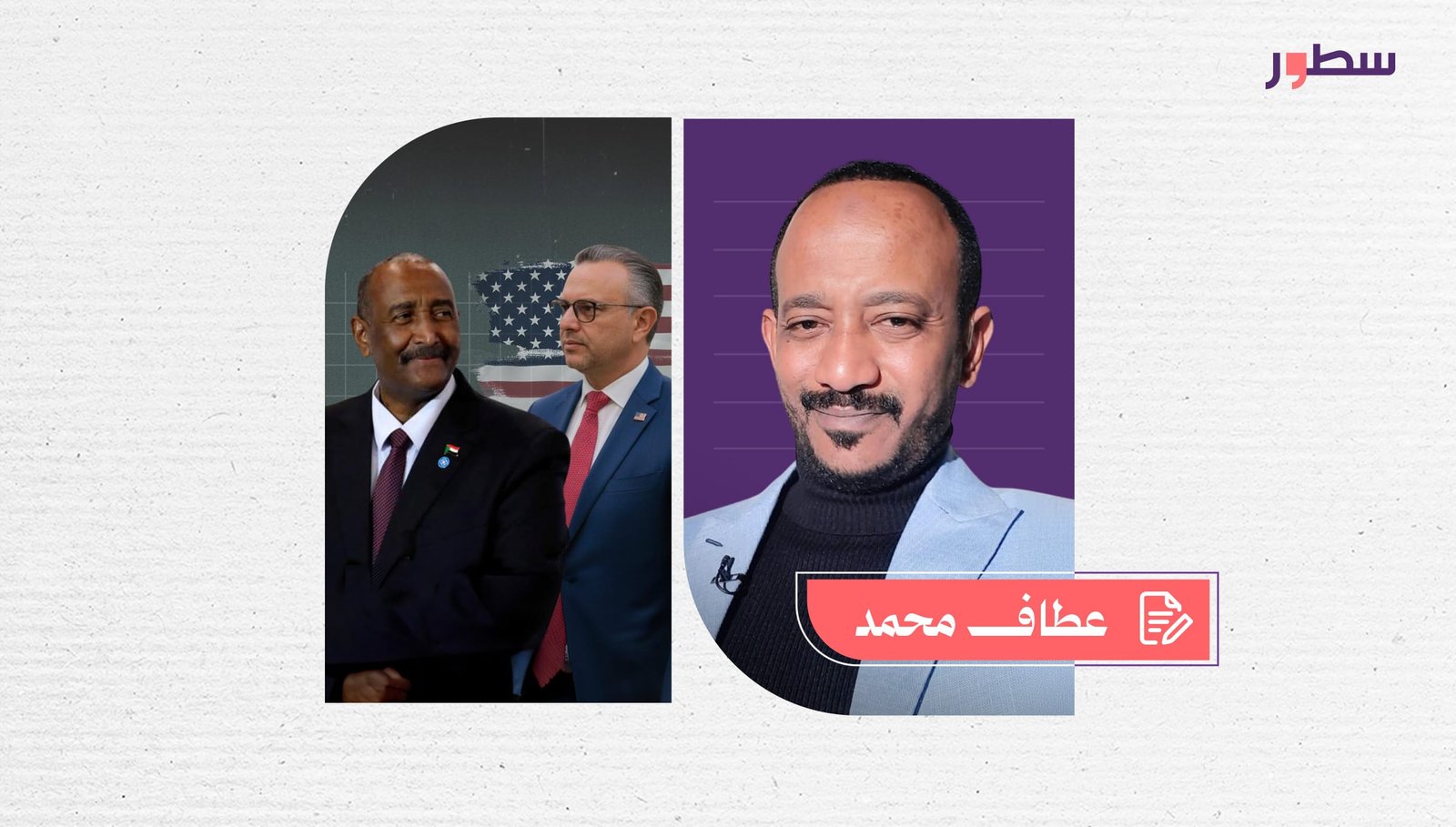سياسة
الدفاعُ العربيُّ المُشترك: الاستحالة والأفق
الدفاعُ العربيُّ المُشترك: الاستحالة والأفق
«إنّ هذا العدوان إنّما يعكس بجلاء، أنّ الممارسات الإسرائيليّة تجاوزت أيّ منطقٍ سياسي أو عسكري، وتخطت كافة الخطوط الحمراء.» «إنّ الانفلات الإسرائيلي، والغطرسة الآخذة في التضخم، تتطلب منا كقادة للعالميْن العربي والإسلامي، العمل معًا نحو إرساء أسس ومبادئ تعبر عن رؤيتنا ومصالحنا المشتركة، وخلق آلية للتنسيق والتعاون الإقليمي».
هكذا أطّر السيسي بتسطيح مُخلِّ ما يجري في فلسطين، ثمّ مناشدًا في قمة الدوحة الأخيرة الحكام العرب العودةَ للدفاع المشترك ضد ”العدوّ“ كما وصفه مرّة واحدة على مضضٍ دون تسميته، ثمّ وجه نداءً لما سماه ”شعب إسرائيل“ محذرًا إيّاه من مغبة بقائه تحت الحكومة الحالية، وأطال بعدها في الحديث عن السلام ومقتضياته دون أيّ حديثٍ عن المقاومة.
لافت في توازناتٍ إقليمية لزجةٌ كالزُلال منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ أن يعيد السيسي استحضار فكرة الدفاع العربي المشترك؛ فقد سبق أن طرحها بوضوحٍ في قمة شرم الشيخ ٢٠١٥ وتمّ إقرار إحيائها دون أن ترى النور. لافت أيضًا أنّ المنطقة تمرّ بأشد مراحلها اضطرابًا؛ حروب أهلية متزامنة، انهيارات سيادية، تهديدات عابرة للحدود من الميليشيات والجماعات المسلحة، وأدوار متصاعدة لقوى إقليمية ودوليّة تتعامل مع الأمن العربي كفراغٍ مفتوح الأمد. ومع ذلك، بقيت الاستجابة العربية على حالها: بيانات عمومية، إحالة الملف إلى لجانٍ فنية، ثمّ صمت.
اتفاقية الدفاع العربية المشترك قائمة وسارية ياسادة.. منذ ١٨ يونيو ١٩٥٠!
بين نصوص الاتفاقية وخُطب القمم مساحةٌ فارغةٌ أوسعُ من الصحارى العربية، كلّ ما يملؤها هو اللجان والبيانات المكررة. الدفاع العربي المشترك صار مثل أطلال معبد قديم؛ تُقام فيه الطقوس البروتوكولية بلا خشوع أو ورع.
منذ توقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام ١٩٥٠، ظلّت هذه الوثيقة أشبه بوعْدٍ مُرَحّل أكثر منها التزامًا مُفعّلًا. على مدى سبعين عامًا، لم تنجح أيّ قمةٍ عربية في تحويل النصوص إلى قوة دفاعيّة حقيقية تتجاوز البيانات الختامية واللجان الدائمة. وفي الأيام القليلة الماضية. هذا البرود يكشف عن تحوّل بنيوي في صُلب النظام العربي نفسه. فبعد ٢٠١٣ تحديدًا، انكفأ معظم الدول العربية إلى الداخل، منشغلين بضمان استقرار أنظمتهم، وتوجّهوا لتحالفاتٍ انتقائية مع قوى خارجية بدلًا من الاعتماد على إطار جمعي عربي.
من العدو؟!
بعد أن توحد العرب جميعا لعشرات العقود في مواجهة عدو واحد في الإقليم ولا غيره وهو إسرائيل طبعًا، تباينت تعريفات “التهديد” الآن من نظام سياسي (لا أقول شعبي أبدًا) لآخر؛ فبالنسبة لبعض الأنظمة إيران هي الخطر الأول، ولآخرين الجماعات المسلحة، ولثالث النزاعات على الحدود والموارد. هذا التناقض جعل الاتفاقية نفسها غير قابلة للتفعيل؛ إذ كيف يمكن بناء قوة مشتركة بينما لا يوجد إجماع حتى على العدو المفترض أو على أولويات المواجهة؟
النتيجة أنّ دعوة السيسي الأخيرة جاءت في فراغِ سياسي حقيقيّ. إذ فقدت جامعة الدول العربية وزنها العمليّ كإطارٍ تنفيذي، وصارت أقرب إلى منصّة دبلوماسيّة للتصريحات المتوازنة حينا والمتشاحنة أحيانًا بل والمتقاتلة حتى في حال سورية إبان الثورة التي حالت لمجزرة أهلية بمحركاتٍ إقليميّة ودولية لأكثر من عشرة أعوام. في المقابل، ترسّخت ثقافة “الميني لتراتيرالية” Minilateralistic أو التحالفات المصغّرة المؤقتة (مثل التحالف العربي في اليمن أو اتفاقات أمن البحر الأحمر) التي تتجاوز الجامعة تمامًا. أيّ أنّ المنطق السائد بات “مَن يقدر ينفذ” لا “كلّنا ننفذ معًا”. هذا النمط يتناقض جذريًّا مع روح اتفاقية ١٩٥٠ القائمة على الدفاع المشترك والتضامن الجماعي.
هكذا يمكن قراءة التجاهل الحالي لدعوة السيسي كعَرَضٍ لمرضٍ أعمق؛ موت فكرة الأمن العربي الجماعي أو على الأقل دخولها غيبوبة طويلة. فالمؤسسات قائمة شكليًّا، لكن الإرادة السياسية غائبة، والعقيدة العسكرية المشتركة لم تتشكّل قط، والتمويل لم يُرصد، والقيادة لم تُحدَّد. وما لم تعالج هذه القضايا الجذريّة، ستظلّ أيّ دعوةٍ جديدة – مهما كانت مخلصة أو ملحّة – تواجه المصير ذاته، الصمت أو التأجيل إلى أجلٍ غير مسمّى.
الفرضية هنا بسيطة وصادمة، اتفاقية الدفاع العربي المشترك ماتت سريريًّا، وما دعوة السيسي الأخيرة إلا محاولة إنعاش متأخرة لجثة سياسية باردة. بعد سبعين عامًا من توقيعها، لم تعد الاتفاقية سوى ورق قديم يُستحضر في خطب القمم لإضفاء جدية شكلية، بينما الواقع أنّ كلّ دولةٍ عربية بنت منظومتها الأمنية وفق تحالفاتها الخارجية وأولويات نظامها الداخلي. غياب الإرادة السياسية، وتباين تعريف “العدو”، والانكفاء إلى الداخل جعل الدفاع العربي المشترك مجرّد شعارٍ يُرفع في البيانات، لا أداة تُفعَّل في الميدان.
لماذا لم تجد دعوات السيسي الرخوة (لتفعيل قوة/آلية عربية مشتركة) سوى صفر الريح في القمم الثلاث الأخيرة التي طرح فيها الأمر، فلماذا؟
خلصت بعد تدقيق تحليلي منضبط إلى أنّ تضارب العقائد الأمنيّة للدول العربية ثم أولويات الأنظمة الداخلية وارتباطات التحالفات الإقليمية والدولية أسباب متداخلة يفضي إليها هذا السؤال؛ فمبدأ السيادة الحذِر و التعطيل المنهجي لأيّ تفعيلٍ جماعي أديا لعدم الالتفات لدعوة السيسي لا اليوم ولا بعد غد. إلى حضراتكم ما استندت إليه لاستخلاص ذلك:
الفرضية الجوهرية التي ينطلق منها هذا المقال أنّ اتفاقية الدفاع العربي المشترك ماتت سريريًّا منذ عقود. فدعوة السيسي الأخيرة لم تقع على آذان صمّاء فقط لأنّها ركيكة التشخيص أو تفتقر إلى التفصيل أو التمويل، بل لأنّ الواقع العربي نفسه لم يعد يستوعبها. غياب القيادة الموحدة، الخلاف على قواعد الاشتباك، حساسية السيادة، التكلفة السياسية والمالية، وتراكم خبرات فشل سابقة (مثل قرار ٢٠١٥ بإنشاء قوة عربية مشتركة الذي لم يُنفّذ حتى اليوم) كلّ ذلك جعل من الدفاع العربي المشترك شعارًا بلا مضمون. وحتى عندما يُستحضر الاتفاق في البيانات الختامية، فإنما يُستحضر لإغلاق النقاش لا لفتحه.
من هنا فإنّ النداء الخافت للسيسي في القمم الثلاث هو في حقيقته عرض مرضي لبنية ميتة أكثر ممّا هو فرصة ضائعة. أيّ إحياءً لهذا المرض العضال أو حتى الموات السريري يحتاج إلى إعادة تأسيس كاملة: من تحديد تهديد موحد، إلى آليات اتخاذ قرار بالأغلبية، إلى إنشاء قيادة وتمويل دائمين، إلى قبول سياسي بتقليص السيادة لصالح العمل المشترك. ما لم يحدث هذا التحوّل البنيوي، ستظل كل دعوة جديدة –مهما كانت مخلصة أو مدعومة بخطب قوية– تواجه المصير ذاته: صمت، إحالة إلى لجان، ثم نسيان.
هذه خلفية سريعة لميلاد وسير الاتفاقية:
- هزيمة عربية ثقيلة في فلسطين ١٩٤٨ فجّرت الحاجة لإطار دفاعي مشترك يحمي الأمن القومي العربي.
- ١٩٥٠: توقيع “اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي” ضمن جامعة الدول العربية، وإنشاء مجلس الدفاع المشترك ولجنة الشؤون العسكرية الدائمة.
- ١٩٦٤: محاولة تأسيس “القيادة العربية الموحدة” في قمة القاهرة وتحديد خطط دفاعية مشتركة لكنّها تعطّلت سريعًا.
- ١٩٧٣: التنسيق العسكري والسياسي في حرب أكتوبر تمّ خارج التفعيل الرسمي للاتفاقية واعتمد على تنسيق ثنائي بين مصر وسورية.
- ١٩٩٠-١٩٩١: غزو العراق للكويت كشف هشاشة الاتفاقية؛ لجأت الدول لتحالف دولي بقيادة أميركية بدل تفعيل الدفاع العربي.
- ٢٠٠٣-٢٠١١: الغزو الأميركي للعراق، وحروب ما بعده، ثمّ الربيع العربي؛ انكفاء الدول وانقسامها سياسيًّا وأمنيًّا.
- ما بعد ٢٠١٣: السلطة في مصر تعيد طرح فكرة القوة المشتركة وتدعو لتفعيل الاتفاقية في ضوء تصاعد التهديدات الإقليمية والإرهاب.
- ٢٠١٥: في قمة شرم الشيخ، أُقر مبدئيًا مشروع “القوة العربية المشتركة” لكن دون تنفيذ عملي حتى اليوم.
- القمم الثلاث الأخيرة: السيسي يكرر الدعوة لتفعيل الدفاع العربي المشترك لكن البيانات الختامية تتجاهل التنفيذ الفعلي.
- اليوم: الاتفاقية باقية شكليًّا كوثيقة جامعة لكن بدون أيّ قدرة تنفيذية، بينما تحالفات مصغّرة ووظيفية تتجاوزها.
نص الاتفاقية: ماذا تقول بالضبط؟
«يُعتبر أيّ اعتداءٍ مسلح على أيّ دولةٍ أو أكثر من الدول المتعاقدة اعتداءً عليها جميعًا، وتتعهد هذه الدول بأن تبادر إلى التعاون لدرء الخطر ورد العدوان بكلِّ الوسائل الممكنة بما في ذلك استخدام القوة المسلحة»
(المادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربي المشترك – ١٨ يونيو ١٩٥٠)
«يُنشأ مجلس للدفاع المشترك يتكون من وزراء الخارجية والدفاع أو من ينوب عنهم، لتنسيق الخطط العسكرية والسياسية وتنظيم التعاون في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية»
(المادة الخامسة من الاتفاقية نفسها)
اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي أُبرمت في ١٨ يونيو ١٩٥٠ بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، جاءت على خلفية حرب فلسطين وتصدّع الأمن العربي، بهدف وضع إطار مؤسسيّ للتعاون العسكري الجماعي. نصّت الاتفاقية على أنّ أيّ اعتداءٍ على دولة عضو يُعدّ اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، وأنّ الدول تتعهد بالتعاون في صد هذا الاعتداء بجميع الوسائل بما فيها استخدام القوة المسلحة.
الأجهزة والآليات الرئيسة في الاتفاقية:
- مجلس الدفاع المشترك: يتكوّن من وزراء الخارجية والدفاع أو من ينوب عنهم، ويختص بوضع السياسات الدفاعية العامة وتنظيم التعاون العسكري وتنسيق الخطط.
- اللجنة العسكرية الدائمة: تضم رؤساء أركان الجيوش أو ممثلين عنهم، وتكلَّف بإعداد الخطط العملياتية المشتركة وتقديم المشورة الفنية لمجلس الدفاع المشترك.
- إمكان إنشاء قيادات مشتركة: الاتفاقية أتاحت صراحة تشكيل قيادات أو هيئات ميدانية مشتركة، ووضع خطط عملياتية وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتنظيم تمارين ومناورات مشتركة لتعزيز الجاهزية القتالية.
لكن طبيعة الالتزام القانوني كمنت في تفاصيلها شياطين وليس شيطانٌ واحد؛ إذ إنّ الاتفاقية ألزمت الدول الأعضاء بالتدخل عند وقوع “اعتداء” على أيّ دولةٍ عربية أخرى، لكنّها اشترطت المرور بسلسلة من الإجراءات: إخطار الجامعة، تقييم الموقف عبر المجلس، إصدار قرار جماعي، ثمّ تفعيل القوة. أيّ أنّ التدخل ليس تلقائيًّا، بل مشروط بموافقة جماعية وبإجراءات يمكن أن تستغرق وقتًا طويلًا.
الواقع أيضّا فرض نفسه على النص: لماذا تعطّلت اتفاقية الدفاع المشترك؟
على الرغم ممّا تبدو عليه اتفاقية الدفاع العربي المشترك من وضوحٍ وحزم على الورق، فإنّ الواقع السياسي والأمني العربي منذ الخمسينيات حتى اليوم أثبت أنّ النص شيء والتنفيذ شيء آخر تمامًا. فالاتفاقية افترضت وجود إرادة سياسية متماسكة وتهديد خارجي واحد ومؤسسات بيروقراطية فاعلة، لكن النظام العربي لم يوفّر يومًا هذه الشروط الثلاثة معًا.
أولًا – تعارض العقائد الاستراتيجية:
لكلّ دولة عربية تعريف مختلف “للتهديد” و”العدو”. بالنسبة للبعض إيران هي الخطر المركزي، بالنسبة لآخرين الجماعات الإسلامية المسلحة، وبالنسبة لآخرين النزاعات على الموارد أو الحدود أو حتى تدخلات القوى الكبرى. هذا التباين جعل من المستحيل صياغة عقيدة عسكرية مشتركة أو خطط عملياتية جماعية.
ثانيًا – أولوية أمن النظام الداخلي:
منذ الستينيات وحتى ما بعد ٢٠١٣، تعاملت معظم الأنظمة العربية مع جيوشها وأمنها باعتبارهما أدوات لحماية النظام السياسي أولًا ثمّ سيادة الدولة وحدودها ثانيًا. فكرة التضامن الدفاعي الجماعي صارت ثانوية أمام هاجس الاستقرار الداخلي والخشية من انتقال عدوى الصراعات أو النفوذ السياسي من دولة لأخرى.
ثالثًا – تحالفات خارجية متضاربة:
منذ حرب الخليج الثانية، لجأت معظم الدول العربية إلى تحالفاتٍ أمنية ثنائية أو متعددة الأطراف مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا)، ما جعل “الأمن العربي” نفسه رهينة لشبكات معقدة من المصالح والاتفاقيات العسكرية خارج الجامعة العربية. وهكذا صار الدفاع العربي المشترك منافسًا ضعيفًا لاتفاقيات دفاع أوسع وأكثر جدية مع الخارج.
رابعًا – غياب التمويل والبنية التنفيذية:
الاتفاقية لم تحدد صندوقًا ماليًّا أو نسبة مساهمة واضحة. لا قيادة دائمة، لا قوات جاهزة، ولا مراكز قيادة وسيطرة مشتركة. هذا يعني أنّ كلّ خطوةٍ تحتاج إلى قرارٍ سياسي جديد، فيتآكل الزخم بين الاجتماعات وتضيع القرارات في دوامة البيروقراطية.
خامسًا – دروس فشل متراكمة:
فشل محاولات سابقة مثل مشروع “القيادة العربية الموحدة” في الستينيات، ثم القوة العربية المشتركة في ٢٠١٥، عزز ثقافة الشك وعدم الثقة. كل دولة ترى أنّ أي التزام دفاعي جماعي قد يجرّها إلى حروب أو مواقف لا تريدها.
سادسًا – البيروقراطية العربية القديمة:
قرارات الجامعة تحتاج موافقات، لجان فنية، ثمّ لجان وزارية، ما يجعل أيّ استجابةٍ لتهديد سريع غير ممكنة. في عالم يُقاس بالأيام والساعات، تعمل الآليات العربية بمنطق الشهور والسنوات.
كل هذه العوامل حولت الاتفاقية إلى أداة ديكور دبلوماسي. فالنصوص موجودة، والمؤسسات قائمة اسمًا، لكن “الآلة” نفسها بلا وقود، بلا خطة، وبلا سائق. والنتيجة أنّ كلّ دعوةٍ جديدة – بما في ذلك دعوات السيسي المتكررة بعد ٢٠١٣ – تجد نفسها أمام جدار من الأعذار واللجان، ولا تترجم إلى تحركٍ عملي.
اتفاقية الدفاع العربي المشترك – ما بعد ٢٠١٣: دراسة الحالة المصرية
منذ يوليو ٢٠١٣ دخلت مصر مرحلة جديدة من إعادة ترتيب أولوياتها الأمنية والعسكرية. انتقلت من سياسة خارجية تسعى إلى التوازن مع القوى الكبرى إلى سياسة تقوم على تأمين الداخل أولًا ثمّ الإقليم المحيط. تغيّرت العقيدة الأمنية المصرية لتتمحور حول مكافحة الإرهاب في سيناء، ضبط الحدود الغربية مع ليبيا، مراقبة البحر الأحمر وممرات الملاحة، وتأمين العمق الجنوبي تجاه السودان وحوض النيل. هذا التحوّل الداخلي انعكس مباشرة على طريقة تناول القاهرة لفكرة الدفاع العربي المشترك.
دعوات السيسي العلنية:
عبد الفتاح السيسي منذ قمة شرم الشيخ ٢٠١٥، مرورًا بالقمم التالية، دعا مرارًا إلى إنشاء أو تفعيل “القوة العربية المشتركة” باعتبارها استجابة جماعية للتحديات الإقليمية المتصاعدة. في خطاباته الأخيرة بالقمم الثلاث، استخدم لغة واضحة عن “الأمن القومي العربي” و”الخطر الوجودي” و”ضرورة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال”. إلا أنّ هذه الدعوات لم تجد استجابة حقيقية تتجاوز البيانات.
لماذا لم تُستجب؟
- تباين أولويات العواصم: ما تراه القاهرة خطرًا عاجلًا (إرهاب عابر للحدود، فراغات أمنية في ليبيا والسودان) قد لا تحتله الأولوية نفسها في الخليج أو المغرب العربي.
- التكلفة السياسية والمالية: إنشاء قوة مشتركة يعني تمويلًا كبيرًا، وقواعد اشتباك واضحة، وتنازلًا جزئيًّا عن السيادة لصالح قرارات جماعية؛ وهي أمور لا تتحمس لها الأنظمة خاصة في الخليج.
- الخلاف على القيادة: من يقود القوة العربية المشتركة؟ أين مقرها؟ هل تكون تحت قيادة دورية أم دائمة في دولة معينة؟ أسئلة لم يُحسم أي منها بسبب تراجع دور مصر القيادي في المنطقة تراجعًا مشينًا في عهد السلطة الحالية.
- حساسية التحالفات الخارجية: دول عربية كثيرة مرتبطة بتحالفاتٍ أمنية ثنائية مع قوى كبرى ولا تريد تقويض هذه الترتيبات أو مضاعفة الالتزامات.
- إرث الفشل السابق: قرار ٢٠١٥ بإنشاء القوة العربية المشتركة بلا تنفيذ جعل الدعوات الحالية تبدو تكرارًا لشعار بلا مضمون.
النتيجة:
رغم قوة القاهرة الرمزية ومحاولاتها “جرّ” النظام العربي نحو تنسيق دفاعي جماعي، ظلّ المشهد على حاله: بيانات تضامن، إحالة إلى لجانٍ وزارية، ثمّ صمت. فغياب الإرادة السياسية العربية الجمعية أكبر من قدرة أيّ دولة بمفردها – حتى مصر – على تغييره. في المقابل، لجأت القاهرة إلى بناء تحالفات مصغّرة في ملفات محددة (أمن البحر الأحمر، التعاون الاستخباراتي الثنائي) بدلًا من انتظار تفعيل الاتفاقية الشاملة.
خلاصة هذه المرحلة:
أنّ الدعوات المصرية المتكررة بعد ٢٠١٣ كشفت –من حيث لا تقصد– أنّ الدفاع العربي المشترك تحوّل إلى أسطورة بروتوكولية، وأنّ أي إحياء له يحتاج إلى قفزة نوعية في التفكير العربي الجماعي، لا إلى مزيدٍ من الخطب.
اختبارات تفعيل الاتفاقية عمليا:
الحالة الأولى: غزو العراق للكويت١٩٩٠-١٩٩١
كان من المفترض أن تكون هذه اللحظة الاختبار الأكبر للاتفاقية. العراق –دولة عضو– اجتاح الكويت –دولة عضو أخرى. لو كان الدفاع العربي المشترك آلية فعّالة، لكان التدخل العربي تلقائيًّا. لكن ما حدث هو انقسام عربي واسع بين مؤيد ومعارض، وانتهى الأمر بتحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، بينما مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية الدائمة غائبَين عن أيّ دور مباشر.
الحالة الثانية: القيادة العربية الموحدة ١٩٦٤-١٩٦٧
محاولة مبكرة لإنشاء هيكل عملياتي حقيقي تحت مظلة الجامعة. جرى وضع خطط دفاعية مشتركة وتعيين قيادة موحدة، لكنّها تعطلت مع أول اختبار عملي (حرب ١٩٦٧)، ثمّ اختفت تمامًا بعد النكسة. تركت هذه التجربة إرثًا من الشك بأنّ أيّ هيكلٍ عربي موحّد قابل للاستمرار.
الحالة الثالثة: حرب أكتوبر١٩٧٣
رغم التنسيق السياسي والعسكري الكبير بين مصر وسوريا ودعم مالي خليجي وحجب النفط جزئيًّا، جرى كلّ ذلك خارج الآليات الرسمية للاتفاقية. بمعنى أنّ ما تحقق كان نتيجة إرادة ثنائية/ثلاثية، وليس بفضل تفعيل حقيقي للنصوص الجماعية. عزّز هذا الفهم بأنّ الدفاع العربي المشترك “حالة ظرفية” لا آلية مؤسسية.
الحالة الرابعة: القوة العربية المشتركة – قمة شرم الشيخ ٢٠١٥
اعتماد مبدئي لإنشاء قوة عربية قوامها عشرات الآلاف بتمويل مشترك، لكن دون اتفاق على القيادة أو قواعد الاشتباك أو التمويل. النتيجة: تجميد القرار في اللجان الفنية إلى أجلٍ غير مسمّى. هذه المحاولة الأخيرة كانت أوضح مثال على الفجوة بين الخطاب والتطبيق.
الحالة الخامسة: حروب ما بعد ٢٠١٣ (ليبيا/اليمن/سوريا)
الدول العربية اختارت تشكيل تحالفات محدودة المهام (التحالف العربي في اليمن، مبادرات أمن البحر الأحمر) بدلًا من انتظار مظلة الجامعة. هذا الاتجاه أكد أنّ الدفاع العربي المشترك صار إطارًا بروتوكوليًّا لا عمليًّا.
الحالة السادسة: غزة ٢٠٢٣ – ٢٠٢٥
تصاعد التهديدات وجرائم الحرب والإبادة على غزّة جعل مصر والسعودية وقطر وغيرهم يتحركون إنسانيًّا ودبلوماسيًا، لكن دون أيّ تفعيلٍ لآليات عسكرية مشتركة. أي أنّ حتى في أخطر الملفات القومية، ظلّ الدفاع العربي المشترك خارج المعادلة.
ما العمل؟ خيارات واقعية بدل الأمنيات
بعد سبعين عامًا من الوعود واللجان، لم يعد السؤال كيف نُفعِّل اتفاقية الدفاع العربي المشترك كما هي، بل كيف نعيد تعريف الأمن العربي نفسه بما يتجاوز الشعارات. التجربة الطويلة كشفت أنّ البناء فوق هياكل ميتة لا يُنتج قوة حقيقية. إذا كان العرب يريدون أداة دفاعية جماعية، فعليهم التحرك في اتجاه مختلف: براجماتية، مرونة، وتدرّج بدل الأمنيات الكبرى والخطب الرنانة.
أولًا – تحالفات وظيفية مصغّرة (Minilateralism):
بدل انتظار توافق ٢٢ دولة، يمكن تشكيل قوات مهام إقليمية محدودة المهام والمدة: قوة للبحر الأحمر، قوة للدفاع الجوي في الخليج، قوة للتدخل السريع في النزاعات الحدودية. هذا النموذج أثبت نجاحًا في أطر أخرى مثل مجلس التعاون (درع الجزيرة) والاتحاد الإفريقي.
ثانيًا – تحديث الاتفاقية أو إقرار ملحق تنفيذي:
إذا كان من المستحيل إلغاؤها، يمكن على الأقل تحديث نصوصها بإدخال قواعد اشتباك موحدة، صندوق تمويل دائم، قيادة دائمة خفيفة، وجدول تدريبات سنوي. هذا يجعل الاتفاقية أداة مرنة بدل أن تظل نصًا مقدسًا لا يُمس.
ثالثًا – تكامل استخباراتي–تقني:
حتى لو غابت القوة العسكرية الموحَّدة، يمكن على الأقل ربط مراكز الإنذار المبكر، الدفاع الجوي، الأمن البحري، والقدرات السبرانية بين الدول العربية. هذا يقلل فجوة الثقة ويخلق أساسًا لمستقبل مشترك.
رابعًا – مبدأ “القدرة قبل الإعلان”:
بدل الإعلان عن قوة عربية مشتركة ثمّ العجز عن تنفيذها، يمكن بناء وحدات جاهزة فعليًّا بشكلٍ سريّ أو محدود، ثم إعلانها عندما تصبح قادرة على التحرك. هذا يقلب معادلة “الخطب أولًا” إلى “القوة أولًا”.
خامسًا – الاعتراف بالواقع السياسي:
لا يمكن لأيّ قوةٍ مشتركة أن تنجح دون تقليص جزئي للسيادة لصالح العمل الجماعي. هذا يتطلب قرارًا سياسيًّا شجاعًا من القادة العرب، وتحمّل تكلفة سياسية أمام الجمهور الداخلي. من دون ذلك ستظل كل الدعوات حبرًا على ورق.
سادسًا – تقوية الدور المصري عبر النماذج المصغرة:
بدل انتظار الجامعة، تستطيع القاهرة بناء تحالفات صغيرة في ملفات محددة تضع فيها نموذجًا عمليًّا يمكن توسيعه لاحقًا. هذا ما حدث مع مبادرات أمن البحر الأحمر مثلًا، ويمكن تكراره في ملفات أخرى.
في النهاية، الحقيقة الصارخة هي أنّ اتفاقية الدفاع العربي المشترك بصيغتها القديمة انتهت عمليًّا. ما بقي أمام العرب ليس إحياؤها كما هي، بل ابتكار أدوات جديدة تتناسب مع واقع التهديدات والتحالفات الحالية. من دون ذلك سيبقى “النداء الخافت” للسيسي وغيره مجرّد صدى في قاعات القمم، لا خطة عمل في الميدان.
المستخلص
لماذا قوبلت دعوة السيسي الرخوة بصفر الريح؟ ليست مجرّد سؤال بل خلاصة واقع. بعد هذا الاستعراض يتضح أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي صيغت في خمسينيات القرن الماضي كأداة ردع جماعي تحوّلت إلى واجهةٍ شكلية في بيانات القمم. دعوة السيسي الأخيرة لم تُقابل بالتجاوب لأنّها اصطدمت بنظام عربي لم يعد يعترف أصلًا بوجود أمن جماعي أو تهديد موحّد. فكل دولة تضع أولوياتها، تحالفاتها، وهواجسها الداخلية قبل أيّ التزام جماعي، والجامعة العربية باتت ساحة للتصريحات لا للتنفيذ.
إنّ “صفر الريح” الذي واجه دعوة السيسي ليس فقط نتيجة ماجوجية الخطاب أو ضعف ورخوية الطرح، بل هو مرآة لنظامٍ دفاعي عربي هو نفسه مات سريريًّا. ومن دون قرارات سياسية شجاعة تُعيد تعريف العدو، تُحدّد التمويل، وتبني قيادة دائمة، سيبقى كل نداء جديد – مهما كان مرتفعًا أو “رطبًا” – يذوب في هواء القاعات المغلقة، ويُحال إلى لجانٍ باردة، ثمّ يُنسى حتى القمة القادمة. هكذا تتحوّل الدعوة إلى شاهد على القصور البنيوي لا إلى بداية تغيير حقيقي، وتبقى اتفاقية الدفاع العربي المشترك عنوانًا لحقبة انتهت أكثر مما هي مشروعًا لمستقبل قادم.