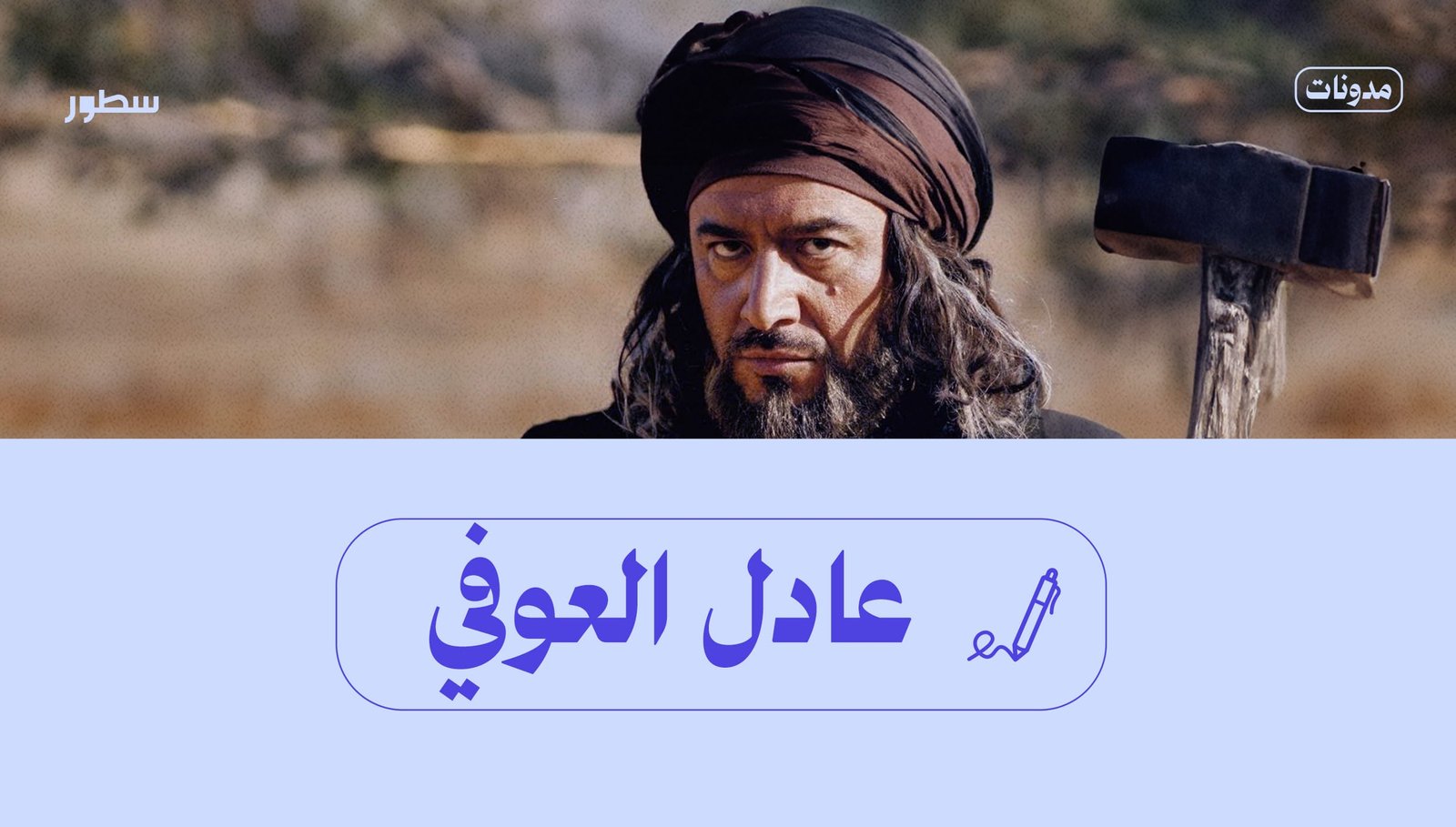مدونات
موت بلا شاهد.. فلسفة التفاوت الأخلاقي في مأساة الفلسطينيين
موت بلا شاهد.. فلسفة التفاوت الأخلاقي في مأساة الفلسطينيين
الكاتب: عبدالرحمن حسنيوي
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحوّل قطاع غزّة إلى ما يشبه مختبرًا للدمار البشري، مساحة مغلقة تختبر فيها الإنسانية حدود صبرها وصمتها في آنٍ واحد. فوفقًا لصحيفة هآرتس بلغ عدد القتلى الفلسطينيين بفعل الهجمات الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة نحو مئة ألف إنسان، بينما تشير المعطيات الرسمية الإسرائيلية إلى خمسةٍ وخمسين شخصًا بين قتيلٍ وأسير لدى المقاومة الفلسطينية. ومع ذلك، لا يظهر أنّ العالم يتعامل مع هذه الأرقام بوصفها مأساة كونية متساوية في القيمة، بل كأنّ الضحايا ينقسمون إلى طبقات: هناك ضحايا يُبكى عليهم، تُنشر أسماؤهم وصورهم وتُكتب عنهم المقالات، وهناك ضحايا يُمحى موتهم في صمتٍ لا يقطعه سوى أصوات الانفجارات المتكررة.
هذا التفاوت الصارخ يفرض علينا سؤالًا يذهب أبعد من حدود السياسة والإعلام: لماذا لا تُقاس حياة العرب، أو الفلسطينيين تحديدًا، بالمعايير نفسها التي تُقاس بها حياة الآخرين، لا سيّما في المنظور الغربي الذي يهيمن على سرديات الإعلام والسياسة والضمير العالمي؟ هذا السؤال يكشف ما أشار إليه نيتشه حين تحدّث عن «إرادة القوّة» التي تُعيد تعريف القيم وفقًا لمصالح القوى المهيمنة. فالحياة والموت في عالم اليوم لم يعودا مجرّد حقائق بيولوجية، بل تحوّلا إلى وقائعٍ سياسية تُقرَّر قيمتها بناءً على موقع الضحية من شبكة المصالح العالمية، وعلى قربه أو بعده من مراكز القوة والهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية.
إنّ موت الفلسطينيين، مهما بلغ عدده أو فداحته، يظلّ خارج إطار السردية التي تصوغها القوى الغربية الكبرى عن الحضارة والتقدّم والديمقراطية. فهذه القوى تحتاج إلى صورة ناصعة لنفسها، إلى قصة أخلاقية تبرّر سلطتها وهيمنتها باسم القيم الكونية، ولهذا يصبح الاعتراف بإنسانية الضحايا الفلسطينيين تهديدًا مباشرًا لخطابها. ومن ثَمّ، فإنّ مشاهد الدمار في غزّة تكسر وهم المدنية الذي تتباهى به هذه العواصم الغربية، وتكشف أنّ شعاراتها عن الحرية وحقوق الإنسان مشروطة بالخرائط والتحالفات والمصالح، لا بالعدالة أو المساواة. وفي الجهة الأخرى، يُصوَّر مقتل جندي إسرائيلي أو أسير مدني كزلزال أخلاقي يهزّ الضمير العالمي، لأنّ القوة المهيمنة لا تكتفي بالسيطرة على الأرض والسياسة، بل تفرض كذلك تعريفها للإنسانية ذاتها، تحدّد من هو الضحية «الحقيقي» ومن هو الضحية القابل للنسيان، فتتحوّل مشاعر العالم ومؤسساته الحقوقية إلى أداةٍ انتقائية تحضر حين يكون القتيل من الدائرة الحضارية المألوفة أو المقبولة، وتغيب حين ينتمي إلى الهامش الذي تعوّد العالم أن يرى فيه الألم أمرًا طبيعيًّا أو حتى حتميًّا.
تتضاعف المأساة عندما نتأمل في البعد الرمزي للموت. ترى الفلسفة الوجودية عند سارتر وكامو أنّ موت الفرد يكشف عبثية العالم وهشاشة الإنسان أمام العدم، لكن هذا العبث يصبح أكثر قسوة حين ندرك أنّ موت شخص في مكان ما لا يُقاس بموت شخص آخر في مكان مختلف. الجسد الفلسطيني، في سرديات الإعلام الغربي، يُختزل إلى رقم بلا ملامح، صورة باهتة تتوارى في زاوية صغيرة من الصحف، بينما يُقدَّم الجسد الغربي أو الإسرائيلي للعالم ككائن كامل له اسم وحياة وذكريات وقصة وصوت يُسمع من خلال تقارير مطوّلة وشهادات شخصية وصور مؤثرة من طفولته. بهذا المعنى، لا يقتصر الأمر على مأساة إنسانية فحسب، بل يتحوّل إلى إلغاء رمزي للوجود ذاته، إذ إنّ الإنسان لا يختبر موتًا كاملاً إلا حين يُمحى أثره من الذاكرة الجمعية والخيال العام.
ويذكّرنا هذا الإرث بطبقات الاستعمار التي وصفها فرانز فانون في معذبو الأرض حين أشار إلى أنّ الاستعمار لا ينتهي بانسحاب الجيوش، بل يمتد ليغرس نفسه في البنية الذهنية للعالم وفي أنماط التفكير التي تحدد قيم البشر وأولوياتهم. ما نراه اليوم ليس سوى استمرار لهذه المنظومة القديمة بصياغة جديدة، حيث تتجسد طبقية أخلاقية دقيقة تقرر من يستحق الحياة ومن يُترك للفناء. هناك شعوب يُصنّفها العالم على أنها «متحضّرة»، تُعتبر حياتها امتدادًا طبيعيًّا لقيم التنوير والحداثة وحقوق الإنسان، فتتحوّل معاناتها إلى قضية أخلاقية تتلقّى التعاطف الدولي وتملأ صفحات الصحف والمجلات، بينما تُوضع شعوبٌ أخرى في خانة «البرابرة»، حياة أفرادها أقل قيمة في منظومة القيم العالمية، ويُنظر إلى موتهم على أنّه أمرٌ طبيعي أو محتوم، متوافق مع صورة تاريخية مسبقة صاغها الاستعمار في وعي العالم. هذا التفاوت لا يقتصر على مجرّد سردية إعلامية، بل يمتد ليصبح معيارًا أخلاقيًّا متداولًا يعيد إنتاج هيمنة القوى الإمبريالية الكبرى على قيم الإنسانية نفسها، فتتحوّل حياة الفلسطيني إلى تفصيل لا قيمة له في السياسة الدولية، إلى رقم في سجلات حقوق الإنسان، إلى ظلّ بلا صدى، فيما تُستعاد حياة الآخر كاملة بكلّ ثقلها الرمزي والإنساني لتصبح مادة سردية تضيف شرعية للقيم التي تفرضها السلطة المهيمنة.
في هذا المشهد تتجلّى فلسفة العبث التي تحدّث عنها ألبير كامو، فالتمرّد كما يراه يبدأ حين يرفض الإنسان هذا العبث ويصرخ في وجه اللامعنى. لكنّ الضحايا الفلسطينيين اليوم يُحرمون حتى من هذا الحقّ، لأنّ موتهم يُمحى من الذاكرة قبل أن يتحوّل إلى قضية أخلاقية عالمية. إنّهم يموتون مرّتين: مرّة تحت القصف، ومرّة في صمت الضمير الإنساني الذي لا يرى في دمائهم ما يستحق الحزن أو الغضب. ربما آن الأوان لطرح السؤال من جديد: كيف يمكن بناء منظومة أخلاقية كونية جديدة تُحرّر الإنسان من هذه الطبقية في الحزن، من هذا التفاوت في القيمة الذي يقيس الحياة بمقاييس القوة والجغرافيا والسياسة؟ إنّ المطلوب ليس تعاطفًا سطحيًّا أو وقتيًّا، بل إعادة تأسيس لفلسفة تعترف بأنّ إنسانية البشر لا تتجزأ، وأنّ دم طفل في غزّة يعادل دم طفل في باريس أو تل أبيب أو نيويورك، لأنّنا جميعًا نتقاسم الهشاشة ذاتها أمام الموت والفناء، ولأنّ الحياة في جوهرها قيمة لا يمكن إخضاعها لمقايضات القوة والمصالح.
في الأخير، إنّ مأساة الفلسطينيين اليوم ليست مأساة محلية تخصّ شعبًا واحدًا، بل هي مرآة تعكس انهيار المنظومة الأخلاقية التي يتغنّى بها العالم المعاصر. فطالما استمر تقسيم الضحايا إلى مهمّين وغير مهمّين، ستظلّ الحضارة الحديثة تعيش تناقضها الأكبر: حضارة تتحدّث بلا انقطاع عن حقوق الإنسان، لكنّها تصمت حين يُباد البشر في الأماكن التي تنتمي إلى الهامش، وحين يحدث الموت في الضفة غير المرئية من هذا الكوكب. وهكذا، ما لم يُكسر هذا الصمت من طرف الرأي العام العالمي، سيبقى العالم يكرّر الجريمة نفسها في كلّ حرب، وسيبقى موت البعض مجرّد خبر عابر على شاشات الأخبار، بلا شاهد، بلا ذاكرة، وبلا معنى.