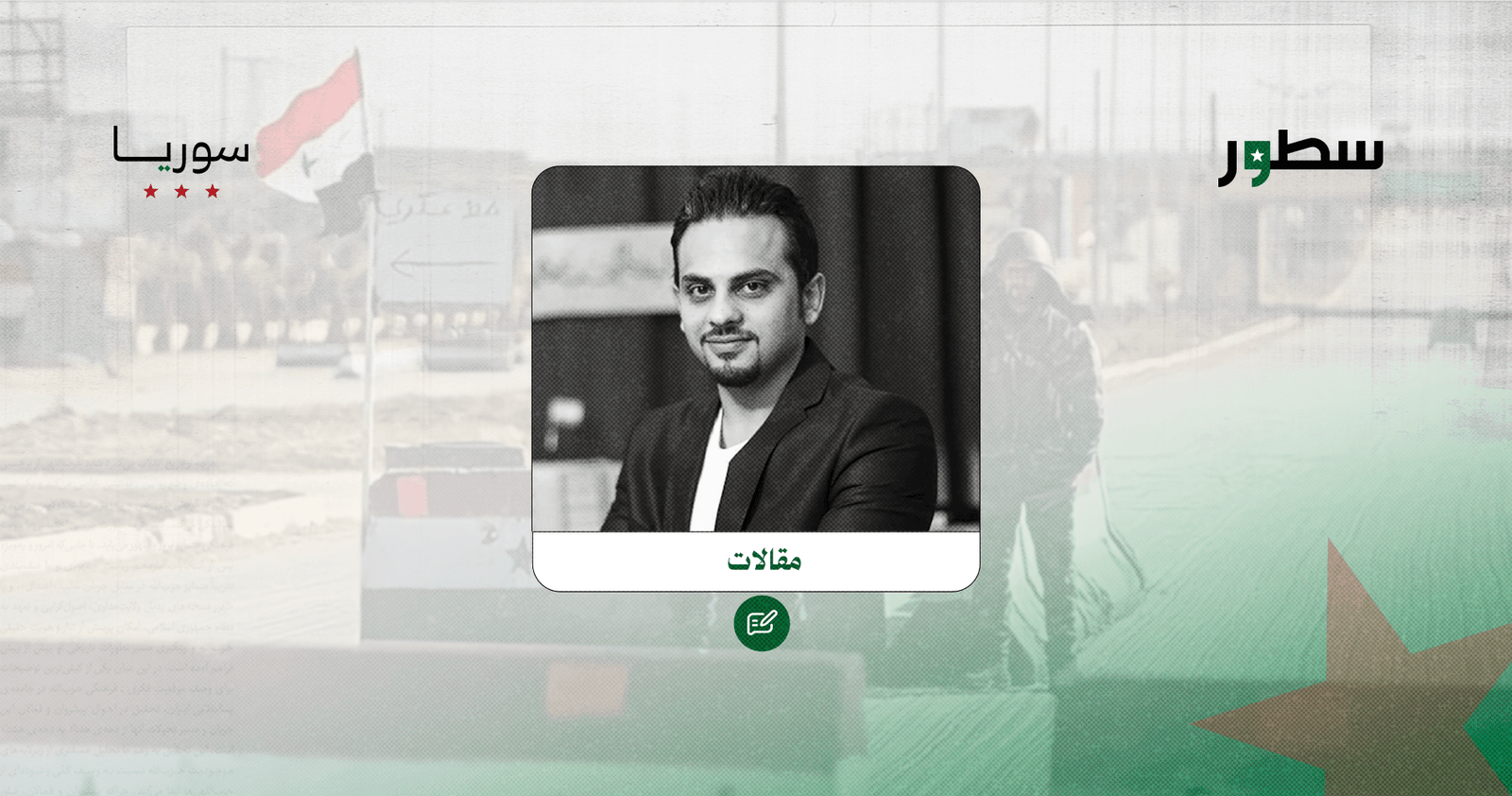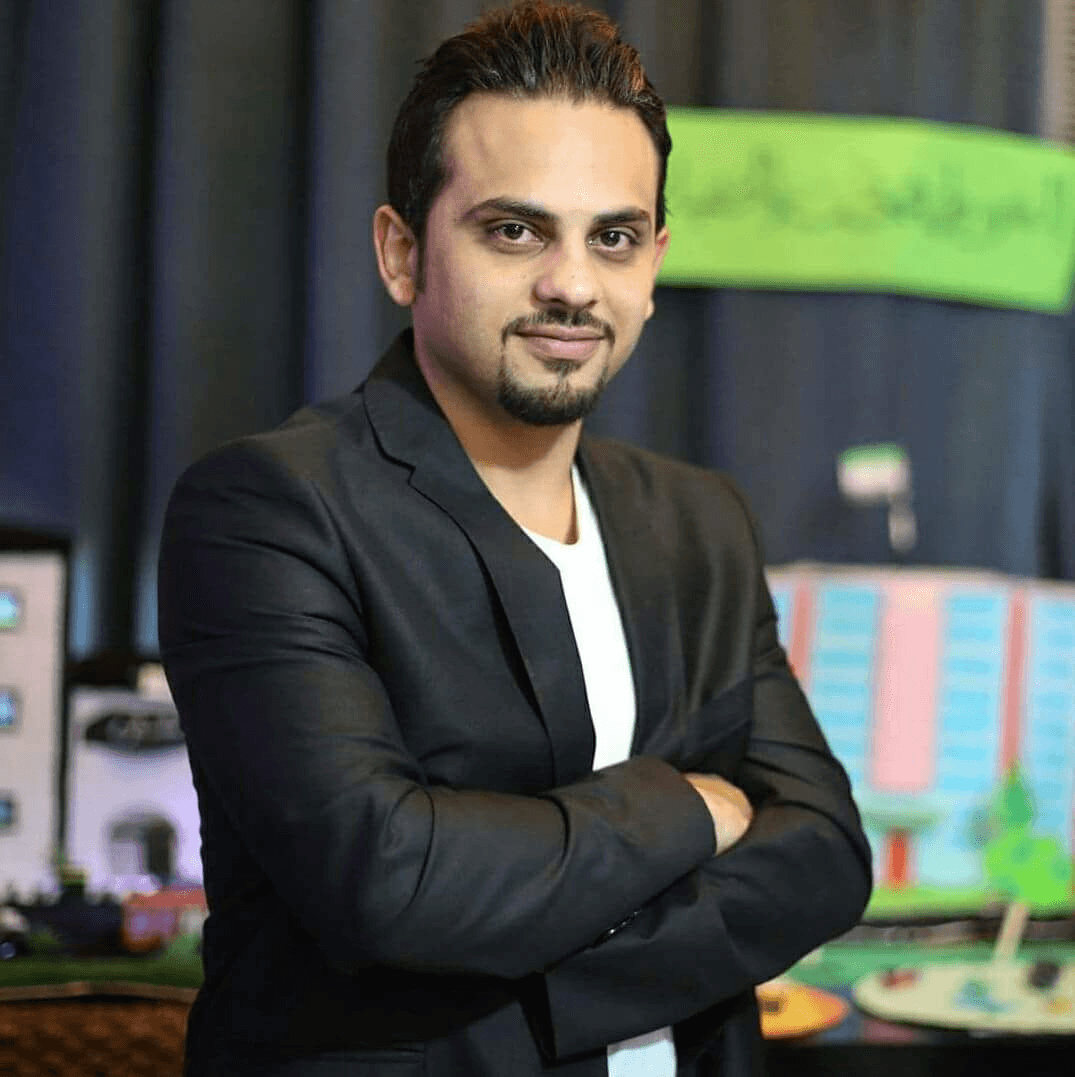فكر
من الظهور إلى الشرعية: أي تأثير نريد في سوريا؟
من الظهور إلى الشرعية: أي تأثير نريد في سوريا؟
الكاتب: محمد أديب عبد الغني
انفجر نقاشٌ واسع في سوريا حول دعوات وُجِّهت لمؤثّرين وصنّاع محتوى للمشاركة في مناسبات ترعاها جهات حكومية. بدا المشهد مركّباً: من افتتاح الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي وما رافقه من حضور إعلامي ومؤثّرين في أجنحةٍ رسمية، إلى لقاءات محافظ دمشق مع صنّاع محتوى محليين لتحسين “صورة الخدمات”، ثم مؤتمر للمؤثّرين وصنّاع المحتوى في حلب قُدِّم بوصفه منصّة تشبيك مع الجهات العامة والقطاع الخاص. وفي مقابل أسماءٍ حظيت بالحضور، برزت شكاوى علنية من تغييب إعلاميين وصناع محتوى محليين بوصفهم “مؤثرين فعليين” عن مؤتمر حلب تحديداً، مع انتقادات لطريقة الانتقاء ومعاييره. كما طفت إلى السطح قضية سحب بعض الدعوات بعد جدلٍ عام حول المعايير والشفافية، ضمن مشهدٍ أوسع من سجالاتٍ سبقت الأسابيع الأخيرة منذ 2022–2023 حول دور “مؤثّري السفر” في تقديم صورةٍ ترفيهية تُتهم أحياناً بتبييض واقعٍ سياسيّ واجتماعيّ معقّد.
وسط هذا السياق، يغدو سؤال المؤثّر سؤالاً في الشرعية لا في الأرقام فحسب؛ فالخوارزميات تمنح الظهور، والسوق يمنح الرعاية، والدولة تمنح منصّات الاعتراف، أمّا الشرعية الاجتماعية فتُختَبَر من أسفل: في أثرٍ لا يُضلِّل ولا يُؤذي ويصنع منفعةً عامة قابلةً للقياس، ولا سيّما في بلدٍ خارجٍ من نزاعٍ طويل كسوريا. ومن هنا يسعى هذا المقال إلى تعريف المؤثّر، وتمييز المؤثّرين الحقيقيّين عمّن يُوصَفون بالمؤثّرين، واستكشاف الأدوار المأمولة للمؤثّر في مرحلةٍ تسعى فيها البلاد إلى الانتقال نحو الاستقرار.
كيف تُصنع شرعية التأثير؟ من الوصول إلى الثقة
التأثير في جوهره موقعٌ اجتماعي شبكي يتيح لفاعلٍ ما أن يغيّر آراء جماعة أو سلوكها. هو عقدُ ثقةٍ ومعنى بين صاحب الرسالة وجمهوره، لا مجرّد عدد مشاهدات أو براعة إخراجية. لذلك يُقاس بما يحدث في الواقع: اتّساع الوعي، تبدّل العادات، ارتفاع المشاركة المدنية، أو تحسّن الخدمة العامة.
هذه الشرعية لا تأتي من مصدر واحد. تتشارك فيها 4 قوى تتحرّك بوضوح في السياق السوري. الخوارزميات تقرّر من يُرى أولاً، وتميل إلى مكافأة المحتوى الأكثر إثارة وتفاعلاً، فتدفع المحتوى الرصين إلى الخلف. السوق يدفع لمن يثبت قدرته على الإقناع والتحويل، لكنّه معيارٌ نفعي قصير الأجل ما لم تُضبط حوافزه أخلاقياً. المؤسسات العامة تمنح اعترافاً ومنابر؛ يفيد ذلك حين تُحفظ مسافةٌ قواعدية وشفافية كافية، ويضرّ حين يتحوّل إلى تماهٍ دعائي. ويبقى المجتمع مصدر الشرعية الأعمق عبر ثقةٍ تُبنى ببطء من التجربة والسمعة والاستعداد لتصحيح الخطأ. فإذا تآكلت هذه الثقة تبخّر معها ما قبلها من وصولٍ ورعاياتٍ واعترافٍ رسمي.
عندما تتناسق هذه القوى ويتقاطع مقصدها في وصولٍ مستحق تدعمه شفافية السوق وضمانات المؤسسات وثقة الناس، تتكوّن شرعية متينة. وعندما تتصادم، كما يحدث عند اعترافٍ رسميّ يقابله ارتياب اجتماعيّ أو عند تضخّم الأرقام بلا إفصاح عن التمويل والعلاقات، تنشأ شرعية هشة تنهار مع أول أزمة. القاعدة بسيطة: الثقة الاجتماعيّة هي محكّ ديمومة التأثير، أما الخوارزميات والسوق والدولة فمجرّد رافعات لا مصادر أصلية للشرعية.
المؤثّر وصانع المحتوى: التمييز، التداخل، ومعيار الحقيقة
انطلاقاً من هذا الفهم يسهل الفصل بين “المؤثّر” و”صانع المحتوى”. المؤثّر يملك رأس مال اجتماعياً ورمزياً وشبكياً يمكّنه من تغيير السلوك أو المواقف لدى جمهور بعينه. معيار نجاحه يظهر في الواقع لا على لوحة التحكّم: سلوك يتبدّل، قرار يُتَّخذ، مشاركة ترتفع. أمّا صانع المحتوى فهو مُنتِجٌ يتقن صياغة الرسائل، والوسائط بجودة، واتساق، وتنوّع. معيار نجاحه صناعي: انتظام النشر، زمن المشاهدة، معدّل الاحتفاظ. قد يتداخل الدوران، لكن الفارق الجوهريّ يبقى واضحاً: المؤثّر يُقاس بما يحدث خارج الشاشة، وصانع المحتوى بما يُنجَز داخلها.
العلاقة بينهما علاقة تغذية متبادلة. صانع محتوى متين يمكن أن يصير مؤثّراً حين يبني سردية واضحة وهوية قيمية ويقترح أفعالاً يمكن قياسها ويُراكم شهادات نفع. والمؤثّر صاحب النفوذ الاجتماعي يمكن أن يصبح صانعاً محترفاً حين يستثمر في التحرير والإخراج وفِرَق العمل وجداول النشر ومعايير التحقّق. وبين الطرفين حالات وسطى مألوفة: أثر قوي بإنتاج متواضع يذبل إن لم تُطوَّر الأدوات، أو صناعة رفيعة بأثر محدود إن لم تُبنَ جماعة ثقة ورسالة تتجاوز الإمتاع إلى المنفعة.
ليس كلّ واسع الوصول مؤثراً يصلح لبناء الجسور بين السلطة والمجتمع أو لتعزيز الاستقرار بعد النزاع. فالأرقام تمكّن ولا تُشرعن. التأثير الحقيقي مشروط بارتباط صادق بالمجال، وبأهلية معرفيّة وأخلاقيّة تسمح بتحويل الرسالة إلى منفعة عامة. لذلك يختلف أثر صاحب الحضور التجاري الذي يحفّز الشراء، عن أثر الفاعل الاجتماعي السياسي الذي يستند إلى الثقة والعدالة والذاكرة، وعن أثر الفاعل العلمي الذي يقوم على البرهان والمنهج. قد يفتح الحضور خارج الاختصاص باباً إلى الحدث، لكنّه لا يمنح قدرة حقيقية على التأثير فيه.
في القضايا التي تمسّ العقد الاجتماعي لا يكفي وصول الصوت؛ يجب أن يكون لصاحبه مكان في المجال، ومعرفة تطمئن الجمهور، وصلات اجتماعية تتيح الكلام باسم المنفعة العامة لا باسم الخوارزميات، عند هذه العتبة تنتقل المشاهدة من سطحها الرقمي إلى عمقها الاجتماعي، ويصير الوصول ممهّداً للأثر لا قناعاً له.
وللتمييز بين من يُوصَفون بالمؤثّرين والمؤثّرين الحقيقيين نحتاج “بوصلة” لا مقياساً واحداً. المؤثّر الحقيقي تظهر له آثار متعددة تتجاوز التفاعل إلى منافع قابلة للإسناد. لغته وصوره محكومة بحساسية النزاع فلا تعيد إنتاج الوصم ولا تستدرج الذاكرة الجريحة. حضوره مسنود باستقلال نسبي تُثبته القدرة على الرفض والإفصاح الصريح عن التمويل والعلاقات والمواقف. أثره يبني جسوراً بين جماعاتٍ متباعدة بدل تعميق الهوّات. ويزداد رسوخاً كلما أعلن أخطاءه وصحّحها بدل الهرب إلى الأمام.
بهذا المعنى قد يمتلك شخص ملايين المشاهدات ويظل ضعيف الشرعية إن جاء حضوره على حساب كرامة الناس وثقتهم، بينما يراكم فاعل محلي بوسائل متواضعة تأثيراً معتبراً حين يحمي عقده الأخلاقي والمعرفي مع مجتمعه ويحوّل وصوله إلى منفعة ملموسة في الحياة اليومية.
الطاقة المزدوجة للتأثير: شروط تحويل الوصول إلى أثر
في البيئات الخارجة من نزاع يكون التأثير طاقةً مزدوجة. يمكن أن يرمّم الثقة بدل أن يضاعف هشاشتها. حين يعمل المؤثّر بمصادر موثوقة وبلغة الناس، يصبح حاجزاً أمام الشائعة لا مسرّعاً لها. يقدّم معرفة مبسّطة ويربط الجمهور بخدمات الصحة، والتعليم، والإجراءات البلدية، والقنصلية. ويساعد اقتصادياً عبر إبراز الحِرَف والمتاجر الصغيرة وفتح قنوات تواصل تحرّك السوق المحلي. ويتسع دوره في الاستحقاقات الوطنية إذ يشرح مفاهيم العدالة الانتقالية كالحقيقة وجبر الضرر وعدم التكرار واحترام كرامة الضحايا، ويميّز بين المساءلة المؤسسيّة والتشهير الانفعاليّ. وفي بناء السلام يخفّف الرموز الملتهبة، يفتح مساحات إنصات، ويعرض أمثلة تعاون يومي عابر للهويات. وفي التوعية بالمخاطر يقدّم محتوى عملياً، ويعلّم أدوات التحقّق بدل الاكتفاء بالتحذير العام.
لكن الطاقة نفسها قد تؤذي. يحدث الضرر عندما يستسلم المؤثّر للخوارزميات ويجعل التفاعل هدفاً بذاته. تظهر مبالغات وادعاءات بلا تحقّق، ويُقتطع السياق، وتُستغل آلام الناس لاصطياد التعاطف، وتنتهك الخصوصية بالتصوير في أماكن حسّاسة أو بتسويق مضلّل لجمهور هشّ. يغيب ميزان حساسية النزاع فيُعاد إنتاج الوصم والكليشيهات، ويُستدعى الاستقطاب وقوداً للنمو، وتُخفى تضارُبات المصالح ويُشترى التفاعل فتتحول المنصّة إلى محكمة شعبية بلا ضمانات.
ويقع ضرر آخر حين تستخدم السلطة المؤثّرين واجهات ترويجية: تختزل الشؤون العامة في استعراض، ويُوزَّع الوصول على أساس الولاء لا الكفاءة، وتُبرم شراكات غامضة، وتنشأ بيئة ثواب وعقاب تعاقِب الاستقلال. عندها تُصادَر الثقة وتُقصى أصوات الضحايا، فتغدو العدالة الانتقاليّة عرضاً دعائياً، والسلام تهدئة لفظية، وتُلمَّع الصورة الخارجية بلا إصلاح حقيقيّ أو إتاحة للمعلومة.
حتى لا ننزلق إلى هذه الممرّات، يلزم تحويل رأس المال الرمزي إلى قيمة عامة بشروط واضحة وبسيطة: استقلال قابل للتحقّق يتيح للمؤثّر أن يرفض أو ينتقد من دون أن يُقصى؛ شفافية تامة في التمويل والعقود وحدود المحتوى مع اعتماد مبدأ “الذراع الطولى” للحفاظ على المسافة النقدية؛ إتاحة عادلة للمعلومة والمنابر، خاصةً لأصوات المتضرّرين والخبراء؛ حساسية نزاع صارمة تقوم على قاعدة عدم الإضرار في اللغة والصورة، ثم قياس قبل/بعد، ونشر نتائج التعلّم والتصحيح علناً، وتفعيل آلية شكاوى يشارك فيها المجتمع. عندها تصبح الأرقام مؤشّر خدمة عامة لا قناعاً دعائياً، ويغدو الوصول طريقاً إلى الأثر لا بديلاً عنه.
من حساسية النزاع إلى توزيع المسؤوليات: كيف نُحوّل التأثير إلى عهدٍ اجتماعي؟
تصبح حساسية النزاع في سوريا، الخارجة من تجربة طويلة ومركّبة، شرطاً تأسيسياً. لا تقتصر على الامتناع عن التحريض، بل تشمل انتقاء المفردات والصور وأمثلة القصص بعناية، ومعرفة ما يصلح للترفيه وما يستدعي مراعاة إضافية، واليقظة حتى لا تتحوّل المنصّة إلى قناة لأذى غير مقصود في المجال العام. وعلى المستوى المهني لا تستقيم هذه الحساسية من دون “حقّ الرفض” بوصفه جزءاً أصيلاً من الاستقلال؛ فالمؤثّر الذي يستطيع أن يقول “لا” لتعاونٍ يخرق معاييره، مهما كان مغرياً، إنما يحمي رأس ماله الأثمن: الثقة. وإذا تصدّعت الثقة انهار فوقها كل ما تمنحه الخوارزميات من وصول، وما تعد به الرعايات من عوائد، وما توفّره المنابر من اعتراف.
سؤال المؤثّر هنا سؤال في العقد الاجتماعي الجديد: أيّ تأثير نريده كسوريين؟ هل نقيسه بالتفاعل وحده، أم بما يبنيه من جسور ثقة؟ الأرقام مفيدة لإدارة الصناعة، لكنها لا تمنح شرعية بذاتها، فالشرعية تُستعار من الناس وتُستردّ عند الإساءة. وكلما احترم المؤثّر ذكاء جمهوره وكرامته بإفصاح صادق، واستقلال نسبي، وحساسية نزاع، واستعداد للمساءلة تحوّل ظهوره إلى ثقة، وصخبه إلى معرفة نافعة، ومحتواه إلى لبنة في جدار الاستقرار.
ولتحويل هذا التصوّر إلى ممارسة لا بد من توزيعٍ واضح للمسؤوليات. المؤثّرون فاعلو معرفة لا مجرّد صانعي صور؛ عليهم الإفصاح عن التمويل والعلاقات، والتحقّق المسبق من الادعاءات، واحترام كرامة المتأثّرين بالنزاع في اللغة والصورة، وتصحيح الخطأ علناً عند وقوعه. هذا ليس ترفَ علاقات عامة، بل حوكمة ذاتية تحمي المنصّة من غواية الخوارزم ومن إثارة تجرح أكثر مما تنفع. ومن دون هذا الضبط الداخلي يتحوّل التأثير إلى ضوء عابر لا يخلّف أثراً صالحاً.
ويقع على المجتمع دور موازٍ: المطالبة بالشفافية بدل الولاء، تثمين الممارسة الرشيدة وفضح الخلل، والمشاركة في المساءلة بنقد مسؤول لا بمحاكمات شعبية تستبدل الحقائق بالانفعال. ومع ترقية محو الأمية الإعلامية وتعلّم أدوات التحقّق والتمييز بين الرأي والمعلومة، ينتقل الجمهور من متلقٍ مستثار إلى شريك يضبط جودة الخطاب ويقلّص هامش الإشاعة.
أما السلطة، وهي القادرة على ترجيح ميزان السمع والرؤية، فعليها ضمان إتاحة متكافئة للمعلومة والخدمات، والالتزام بشفافية العقود والتعاونات مع المؤثّرين، ونشر شروط الشراكات وحدودها مسبقاً، واعتماد مبدأ “الذراع الطولى” لحفظ المسافة النقديّة، وحماية مساحة القول المسؤول كي لا يُخنَق النقد بردعٍ غير معلَن. عند احترام هذه القواعد تصبح الشراكة مع المؤثّرين وسيلة لخدمة عامة قابلة للقياس، لا قناعاً تجميلياً لمشهد ثابت. وعند انتهاكها تتحوّل المنصّات إلى امتداد دعائي يصادر الثقة ويُضعف إمكان عدالة انتقالية وبناء سلام ذي مضمون.
إذن، ليس السؤال: “هل نريد مؤثّرين؟” فوجودهم تحصيل حاصل ما دامت المنصّات والأسواق. السؤال: “أيّ نمطٍ من التأثير نُشجّع وبأيّ قواعد؟”. تبدأ الإجابة من المؤثّر حين يعلن معاييره ويختبرها أمام الناس، ومن المجتمع حين يكافئ المعايير لا الضجيج، ومن السلطة حين تكفّ عن مصادرة الرمزي لصالح الخطابي وتلتزم بالإتاحة والشفافية. عند هذا التقاطع فقط يصبح التأثير أكثر من ضوء خوارزمي عابر، ويتحوّل إلى عهدٍ اجتماعيّ يخدم الحقيقة والكرامة والمنفعة العامة، ويقاس أثره بما نبنيه من ثقة لا بما نحصيه من نقرات.