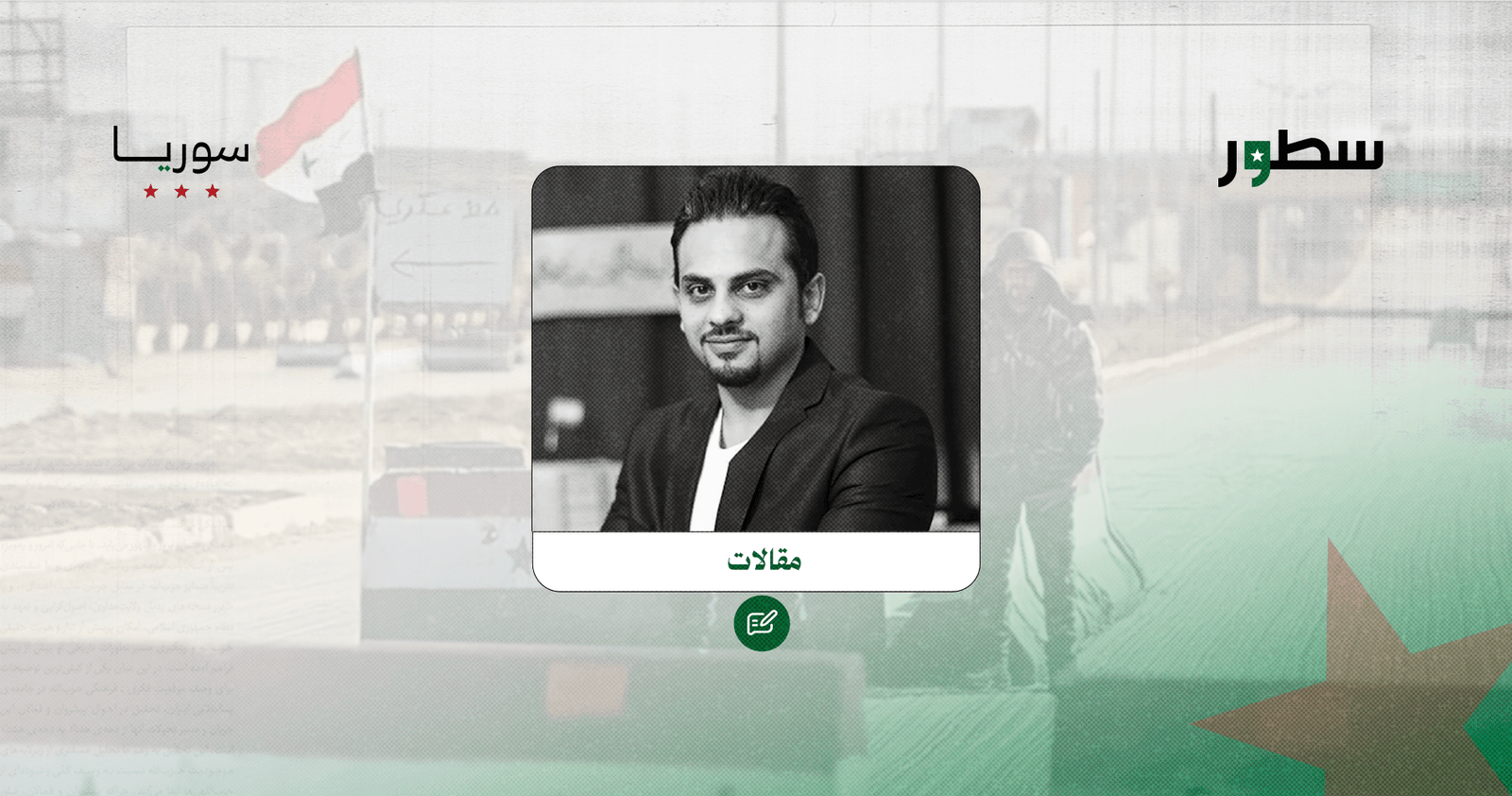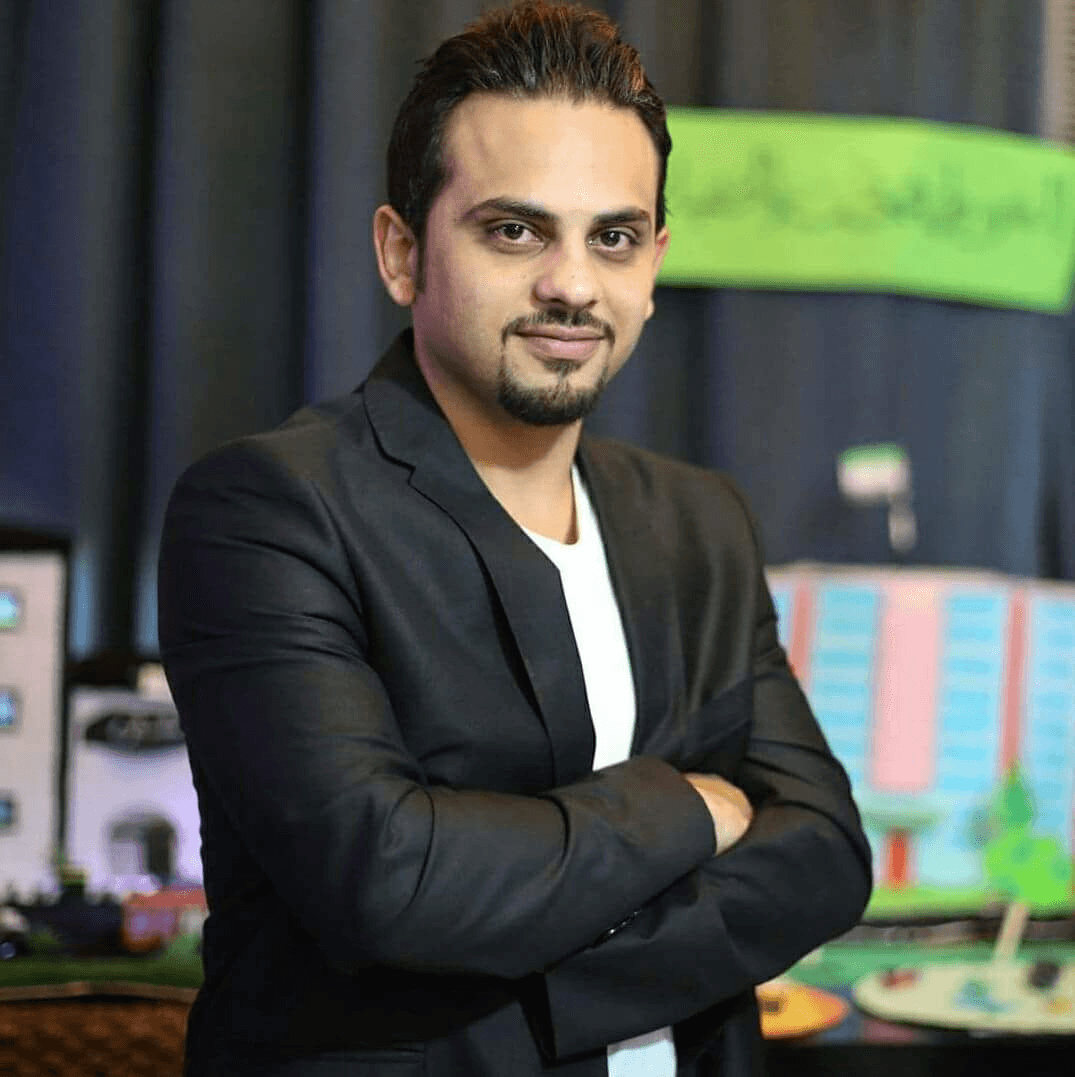فكر
دير الزور: تحولات الهوية وبنية الصراع
دير الزور: تحولات الهوية وبنية الصراع
الكاتب: عبد الرحمن الحميدي
خلال العقدين الأخيرين
تُعد محافظة دير الزور من أكثر المحافظات السورية ضعفاً في التمثيل على المستويين الاجتماعي والسياسي. فهي منطقة حدودية ذات روابط عميقة مع العراق، وثروات نفطية وزراعية كبيرة، لكنها في الوقت ذاته عانت من تهميش مزمن من قبل الدولة المركزية. هذا التهميش ساهم في تشكيل هوية ملتبسة ومركّبة لأبنائها، وهو ما انعكس بوضوح خلال العقد الأخير من الصراع السوري.
الجذور التاريخية والارتباط بالعراق
منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، برز أبناء دير الزور كفاعل أساسي في تسهيل عبور المقاتلين نحو الداخل العراقي، بدفع مباشر من النظام السوري آنذاك الذي أراد توظيفهم كورقة ضغط في مواجهة واشنطن. وقد جاءت النسبة الأكبر من هؤلاء المقاتلين من دير الزور، في دلالة على عمق الروابط الاجتماعية والثقافية الممتدة بين شرق سوريا وغرب العراق.
هذا الارتباط عبر الحدود كان، في الوعي الجمعي لأبناء المنطقة، أقوى من شعورهم بالانتماء إلى الدولة السورية نفسها. ويُفسَّر ذلك بهوية محلية مأزومة، نتجت عن عقود من التهميش والعزل عن المركز، إلى جانب استغلال ثروات المنطقة وتسويقها بصورة بدائية في الإعلام والدراما السورية، كما تجلى مثلاً في لوحة “ديركندا” ضمن مسلسل بقعة ضوء. وقد ساهم تكريس وصمة “الشوايا” في تعميق هذا الإحساس بالدونية.
في هذا السياق، وجد كثير من أبناء دير الزور أنفسهم أقرب ثقافياً واجتماعياً إلى المجتمع السني العراقي، وهو ما انعكس في مظاهر التأييد الشعبي السابق لصدام حسين، وكذلك في الأنماط الثقافية اليومية؛ إذ يكاد لا يخلو شارع في دير الزور من صوت أغنية عراقية، سواء للياس خضر أو غيره من الفنانين العراقيين.
الثورة السورية وتحوّل الحراك
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، شارك أبناء دير الزور في حراك سلمي واسع، رغم وفرة السلاح في الأرياف. إلا أن النظام واجه المدينة مبكراً بالقصف والتهجير، ما أدى إلى نزوح مبكر لمئات الآلاف منذ عام 2012. في تلك المرحلة، تمكنت فصائل الجيش الحر من السيطرة على معظم المحافظة، غير أن القوى الإقليمية حالت دون استكمال التحرير عبر منع اقتحام المطار العسكري، والتي تجاهلت الأهمية الاستراتيجية لدير الزور.
صعود التنظيمات الإسلامية
عام 2013 شهد دخول جبهة النصرة بقوة، بداية عبر شبكات المقاتلين العائدين من العراق. سرعان ما تحولت المنطقة إلى ساحة تنافس بين النصرة وداعش، وصولاً إلى مجزرة الشعيطات عام 2014 التي شكّلت نقطة مفصلية في ذاكرة المحافظة. هنا، تبلورت أول مواجهة كبرى بين العشائر المحلية وتنظيم الدولة، حدث فيها ما حدث من سبي وقتل ونهب بعد فتوى التكفير الشهيرة بحق أبناء الشعيطات وانتهت بانضواء الجزء الأكبر من المقاتلين تحت راية داعش قسراً، ما عمّق الطابع الأصولي للمشهد المحلي.
ما بعد داعش
رغم هزيمة داعش عسكرياً، لم تنتهِ مأساة دير الزور. فقد أُعيد إنتاج الانقسام عبر مشهد جديد: قوات النظام وحلفائه يسيطرون على الضفة الغربية للفرات، بينما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الضفة الشرقية. هذا الواقع عزّز الانقسام الجغرافي والطائفي، مع بروز نفوذ إيراني-شيعي من جهة، وأوجلاني كردي من جهة أخرى، ما جعل المجتمع المحلي أكثر تفككاً وضعفاً.
استغلال العشائر في الصراع الراهن
خلال الصراع الحالي ومطالبة الدروز بالتدخل الخارجي في الفترة الأخيرة برز اسم جديد في المعادلة وهو العشائر، والذي كان نتاج كل التحولات السابقة ولعل شعور الكثيرين بالتهميش سابقاً والشعور بالنشوة بعد إسقاط النظام وكذلك الخوف من العودة إلى الماضي الأسود دفع الكثيرين للتفكير في فرض نفسهم في مقدمة المجتمع السوري باعتبارهم قد عانوا أكثر بكثير من بقية المجتمعات السورية.
تجربة دير الزور خلال العقدين الأخيرين تكشف عن هشاشة البنى الاجتماعية والسياسية في المناطق الحدودية المهمشة، وعن قابلية المجتمع لأن يكون ساحة لتصفية الحسابات. اليوم، يختلف المشهد بين ضفتي الفرات: شرق الفرات حيث يسيطر النفوذ الكردي، وغرب الفرات حيث مشروع الدولة موجود ولكن بمؤسسات مفككة وضعيفة، مما يترك المجتمع المحلي بلا قدرة حقيقية على اتخاذ قراراته السياسية.
ولذلك، يظل ولاء العشائر والفصائل المحلية مرتبطاً بالقوة المسيطرة على الأرض أكثر من ارتباطه بالقرار الوطني المستقل، كما أن بعض الأحياء والمجتمعات ما زالت تعاني من تأثير أفكار بقايا داعش والأيديولوجيات المتطرفة، مما يزيد من هشاشة النسيج الاجتماعي ويعيق إعادة البناء المحلي.
من هنا، يحتاج أبناء دير الزور بشكل عاجل إلى تمثيل سياسي حقيقي وطني يعكس مصالحهم ويحمي حقوقهم، ويُمكنهم من المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل سوريا ضمن الدولة السورية. كما يحتاج المجتمع إلى إصلاح ثقافي وبنيوي شامل لإزالة ما تبقى من تأثيرات التطرف وإعادة بناء هوية محلية متماسكة، بحيث يتحرر السكان من أي تبعية للقوى المسيطرة أو الأيديولوجيات المتطرفة، ويصبحون شركاء متساوين في القرار الوطني