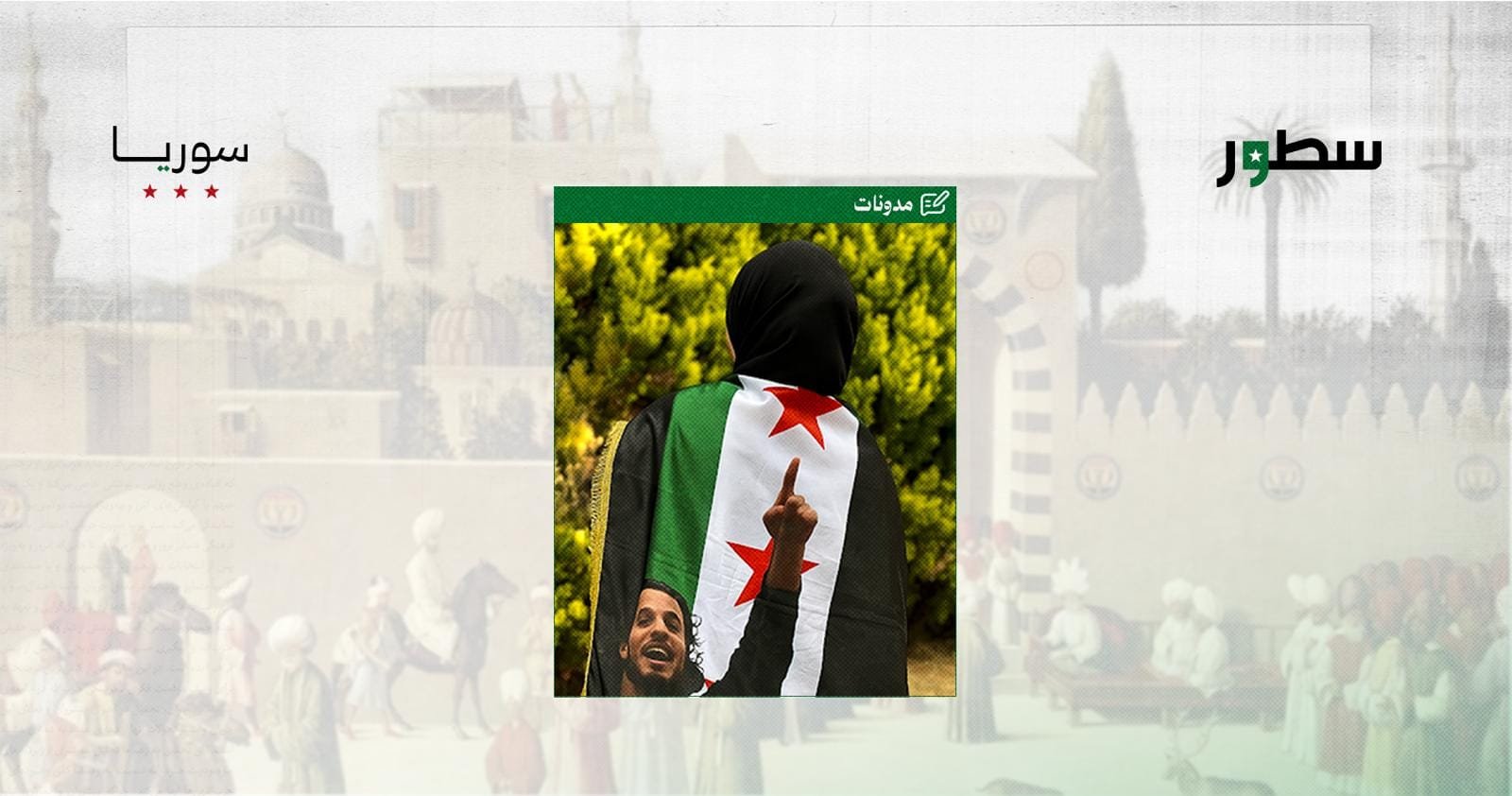فكر
حين يتحول الخوف إلى لغة وطنية.. قراءة في تحديات المرحلة الانتقالية السورية
حين يتحول الخوف إلى لغة وطنية.. قراءة في تحديات المرحلة الانتقالية السورية
حين يخرج الخوف إلى العلن، فإنه لا يبقى مجرد انفعال عاطفي عابر أو إحساس داخلي مكتوم، بل يتحول إلى قوة جمعية تُعيد تشكيل وعي المجتمع وتحدد ملامح المرحلة الانتقالية بكل ما تحمله من تناقضات. فالمراحل الانتقالية في حياة الشعوب لا تُقاس فقط بمدى ما تتيحه من إصلاحات سياسية أو تغييرات دستورية، بل تُقاس أولاً بعمق التحولات النفسية والاجتماعية التي ترافقها.
وفي هذه اللحظات الحساسة، يتجاوز الخوف حدوده الفردية ليصبح جزءاً من لغة الناس اليومية، من ردود أفعالهم، ومن تصوراتهم عن المستقبل. إنه خوف متعدد الأوجه: خوف من الفوضى والانهيار، من فقدان الأمن والاستقرار، من الآخر المختلف، من ضياع الهوية، أو من أن تُختطف المرحلة لصالح قوى جديدة تعيد إنتاج الاستبداد بأدوات وصور مختلفة.
وما يزيد الأمر تعقيداً أن الخوف لا يقتصر على العلاقة العمودية بين المجتمع والدولة، بل يمتد أفقياً داخل النسيج الاجتماعي ذاته. ففي غياب ثقافة سياسية مشتركة وآليات ديمقراطية متينة لإدارة الخلافات، يصبح الخوف الوسيط الأساسي بين المكونات الاجتماعية: خوف من الإقصاء، من فقدان الامتيازات، أو من عودة الماضي بثقل ظلاله. وهنا يبرز جوهر اللحظة الانتقالية: هل يتحول الخوف إلى شلل جماعي يجمّد الإصلاح ويعمّق فجوة عدم الثقة، أم يغدو دافعاً للبحث عن عقد اجتماعي جديد يقوم على الاعتراف المتبادل والعدالة والتوازن؟ إن خروج الخوف إلى العلن يكشف هشاشة المجتمع، لكنه يكشف أيضاً فرصة نادرة لإعادة بناء العلاقة بين أفراده ودولته على أسس أكثر رسوخاً وإنصافاً.
المعادلة المزدوجة للخوف: سلطة عمودية وهواجس أفقية
في قلب المراحل الانتقالية، يتجلى الخوف كلغة مزدوجة؛ تصوغه الدولة عمودياً عبر خطابها السياسي، ويعيد المجتمع إنتاجه أفقياً عبر هواجسه المتبادلة. ولا يظهر فقط باعتباره استجابة طبيعية لحالة الاضطراب وعدم اليقين، بل كثيراً ما يتحول الخوف إلى أداة تُسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين المجتمع والدولة. فالسلطات، في لحظات التوتر، قد تلجأ إلى استدعاء خطاب يرتكز على التحذير من الفوضى أو الخطر الخارجي، ليس بالضرورة بغرض القمع المباشر، بل أحياناً كوسيلة لإقناع الناس بجدوى التريث وتأجيل الإصلاح. بهذا المعنى، يغدو الخوف لغة سياسية تسعى إلى تثبيت الاستقرار وإعادة ضبط المجال العام، حتى وإن أدى ذلك إلى إبطاء عملية التغيير أو الحد من مساحة المشاركة.
غير أن الأمر لا يقف عند هذا الاستخدام الرسمي للخوف. ففي بعض السياقات كما في الحالة السورية، يصبح المجتمع نفسه منتجاً له عبر مكوناته المختلفة، كل جماعة تعبّر عن خوفها الخاص: من التهميش، من فقدان الامتيازات، أو من الذوبان في هوية جامعة لا تضمن التمثيل العادل للجميع. وبهذا يأخذ الخوف شكلاً مزدوجاً، عمودياً حين يُستعمل من الدولة لتنظيم العلاقة مع المجتمع، وأفقياً حين يتجلى بين المكونات الاجتماعية ذاتها.
هذا الازدواج يجعل الخوف حاضراً في صميم المراحل الانتقالية، يصبح عامل تعطيل إذا كرّس الارتياب والجمود، لكنه قد يتحول أيضاً إلى فرصة للتلاقي إذا ما جرى الاعتراف به والتعامل معه بآليات جديدة تعزز الثقة المتبادلة وتفتح أفقاً لبناء عقد اجتماعي أكثر شمولاً وعدالة.
أزمة الثقة في المراحل الانتقالية.. حين يخاف الجميع من الجميع
ليس الخوف في المراحل الانتقالية شعوراً فردياً معزولاً، بل معضلة بنيوية حين يتخذ طابعاً متبادلاً بين المكونات المختلفة، والخوف المتبادل أزمة صامتة لكنها حاسمة في تحديد مآلات المستقبل. والمجتمعات الخارجة من الاستبداد لا تبدأ هذه المراحل كصفحة بيضاء، بل محمّلة بإرث طويل من الارتياب والريبة بين مكوناتها الفكرية والاجتماعية والسياسية. وغالباً ما تدخل التيارات المختلفة اللحظة الانتقالية وكأنها تتحسس خطراً من الآخر أكثر مما تنشغل ببناء أرضية مشتركة.
هذا النمط من الخوف لا يقتصر على علاقة المجتمع بالدولة، بل يتجسد أفقياً بين الجماعات نفسها. الأغلبية قد تشعر بقلق من فقدان موقعها التقليدي أو تفكك مركزيتها التاريخية، فيما تعيش الأقليات تحت هواجس مرتبطة بالتمثيل وضمانات الحماية من أي انتقام محتمل. وفي خضم ذلك، تتحول الساحة الانتقالية إلى شبكة من المخاوف المتقاطعة، حيث يسعى كل طرف إلى تحصين موقعه بدل الانفتاح على عقد اجتماعي جديد.
ويزداد المشهد تعقيداً عندما تدخل القوى الإقليمية والدولية على الخط، مستثمرة هذه المخاوف لتغذية الانقسامات أو إعادة رسم التوازنات بما يخدم مصالحها. والنتيجة هي تكريس منطق الرهانات الصفرية وفق معادلة “إما نحن أو هم”، دون حلول وسطية تتيح للمرحلة الانتقالية أن تتحول إلى فضاء لبناء الثقة بدل تعميق الفجوة.
بهذا المعنى، لا يُختزل الخوف المتبادل في كونه مجرد عرض جانبي للأزمات، بل هو معضلة جوهرية تحدد ما إذا كانت المجتمعات الخارجة من الاستبداد قادرة على تأسيس شراكة وطنية متوازنة، أم محكومة بإعادة إنتاج الاستقطاب القديم في صياغات جديدة. وعند هذه النقطة يصبح الخوف المتبادل هو المعيار الفعلي لمدى نضج الانتقال، فإما أن يُدار كمساحة للتفاهم وبناء الثقة، أو يتحول إلى جدار يعيد إنتاج الانقسام.
خريطة الخوف السوري بين هويات منقسمة وذاكرة مثقلة
الخوف في سوريا ليس شعوراً عاماً يوزَّع بالتساوي، بل هو خريطة معقدة تتقاطع فيها الجغرافيا بالهويات، وتجارب الماضي بمخاوف المستقبل. ففي الشرق السوري، تتخذ الهواجس شكل مطالب بالحكم الذاتي، لا كتعبير عن نزعة انفصالية محضة، بل كاستعادة لذاكرة طويلة من التهميش والحرمان، تجعل من غياب الضمانات الدستورية سبباً لتحويل الخوف إلى مشروع سياسي قابل للتصعيد.
وفي السويداء، تبدو النزعات الانعزالية للدروز ومطالب الانفصال متشابكة مع قلق أعمق يتصل بالحفاظ على الهوية والخصوصية، حيث يتحول الخوف إلى بحث عن حماية ولو على حساب التماسك الوطني. أما في الساحل السوري، فإن الطائفة العلوية تواجه قلقاً مزدوجاً من فقدان الامتيازات التي ارتبطت بالماضي، وخشية من انتقام محتمل، ما يجعل التوترات المحلية انعكاساً لذعر جمعي من مستقبل غامض لا يقدم ضمانات.
غير أن الخوف لا يتوزع طائفياً فقط، بل يتقاطع مع البنى الاجتماعية والسياسية. فالأغلبية السنية تحمل ذاكرة مثقلة بالمجازر والعنف، وتطالب بضمانات صلبة لعدم تكرار الماضي. بينما تخشى الفئة الثورية فيها من ضياع أهدافها أو اختطافها.
وعلى نحو مماثل يتغذى الخوف السوري على ثنائيات اجتماعية وثقافية متشابكة. فالريف والمدينة يعيشان قلقاً متبايناً، حيث يخشى الريف الذي كان خزان الثورة التهميش مجدداً بعد أن دفع الكلفة الأكبر، بينما تنظر المدن الكبرى بقلق إلى التحولات التي قد تضعف مكانتها التاريخية. وعلى المستوى السياسي الجغرافي، يتكرر الانقسام بين المركز والأطراف؛ إذ تخشى المناطق المهمشة من إعادة إنتاج سلطة مركزية تهمّشها، فيما يرى المركز في أي نزعات استقلالية تهديداً لوحدة الدولة.
ويبرز الانقسام أيضاً بين الأجيال. جيل عاش التجربة الاستبدادية ويتوجس من الفوضى، مقابل جيل شاب يعتبر الخوف حاجزاً يجب كسره لصناعة مستقبل جديد. إلى جانب ذلك، يتعمق الانقسام بين الداخل والخارج والنازح والمقيم؛ فالمقيمون في الداخل يخشون من تغيرات مفاجئة تهدد ما تبقى من استقرار هش، بينما يعيش اللاجئون قلق العودة إلى وطن مدمَّر يغيب فيه الأمان وتنقطع سبل العيش، فيما يواجه النازحون شبح استمرار النزوح وحياة المخيمات واستحالة العودة. كما لا يمكن إغفال البعد الطبقي؛ إذ يواجه الفقراء والمهمَّشون خوفاً يومياً من فقدان أبسط مقومات الحياة، بالمقابل تخشى النخب الاقتصادية من إعادة توزيع جديد للموارد.
بهذا، تتضح خريطة الخوف السوري كشبكة متداخلة من الهويات والانقسامات، حيث تتقاطع الطائفية والقومية مع الريف والمدينة، المركز والأطراف، الأجيال والطبقات، والمقيمين والمهجّرين. وما يجمعها جميعاً أن الماضي بثقله لم يغادر، والمستقبل لم يقدم بعد ضماناته. هذه الشبكة من المخاوف تكشف أن الخوف في سوريا لا يُختزل في ثنائية أكثرية/ أقلية، بل هو منظومة مترابطة من الهواجس المتقاطعة، تجمعها في النهاية حاجة ملحة إلى نظام عادل يضمن الأمن والكرامة، ويمنع أن يبقى الماضي شبحاً يطارد المستقبل.
الخوف رافعة للوعي: من شرارة الثورة إلى أفق العقد الاجتماعي
ليس الخوف بالضرورة قيداً يكبّل المجتمعات، بل قد يصبح الشرارة التي تكسر الصمت وتفتح الطريق نحو وعي جماعي جديد، ورغم أن الخوف غالباً ما يُنظر إليه باعتباره عائقاً أمام التغيير، تكشف التجارب الانتقالية جانباً آخر أكثر تعقيداً يسمح بتحول الخوف إلى طاقة إيجابية تدفع نحو التحرر. فلحظة كسر حاجز الخوف كانت هي الشرارة التي سمحت بتحول الخوف الفردي إلى فعل جماعي منظم، من عجزٍ يشلّ إلى قوة تدفع. وهو ما تجسد أيضاً في اللحظات الأولى للثورة السورية، حين تحدى الناس الرصاص وخرجوا إلى الشوارع، ليحوّلوا خوفهم إلى شجاعة جماعية أعادت صياغة العلاقة بين المواطن والسلطة.
لكن هذا البعد الإيجابي للخوف لا يتوقف عند لحظة الانفجار الثوري، بل يتطلب استمرارية في إعادة توجيهه من مجرد رد فعل إلى وعي نقدي. وهنا تكمن المعضلة: كيف يمكن استعادة تلك اللحظة، ولكن بطريقة جديدة تُفضي إلى بناء عقد اجتماعي جامع بدل العودة إلى دوامة الصراع؟
الإجابة تكمن في آليات قادرة على تحويل الخوف إلى وعي مؤسس. أولها الاعتراف المتبادل بالمخاوف بوصفها جزءاً مشروعاً من النقاش العام، لا كاتهام أو علامة ضعف. ثانيها، تقديم ضمانات دستورية حقيقية تحمي حقوق جميع فئات المجتمع وفق ثنائيات مجتمعية لا طائفية أو قومية، بما يقلل من نزعات الانعزال والانفصال. وثالثها، ترسيخ ثقافة سياسية جديدة تُعلي من قيمة المواطنة والمشاركة على حساب الانتماءات الضيقة والهويات المغلقة.
بهذا المعنى، لا يعود الخوف مجرد قيد على الانتقال، بل يصبح محفزاً لإعادة التفكير في أسس التعايش، ومورداً لتوليد وعي سياسي واجتماعي أكثر نضجاً يفتح الطريق نحو صياغة مستقبل أكثر توازناً وعدالة.
إعادة تعريف الخوف: من قيد الانقسام إلى لغة التلاقي
الخوف ليس قدراً مكتوباً على الجباه، وليس عارضاً طارئاً ولا ظلاً عابراً، بل حقيقة تلازم المجتمعات في المراحل الانتقالية خلال رحلة بحثها عن أبواب الخروج من أزمنتها الثقيلة. فإما أن يكرّس هشاشة الانقسام إذا ما تُرك أداة بيد القوى المتنازعة لتعيد إنتاج الانقسام والريبة. أو أن يُصاغ كمدخل للتلاقي والتأسيس عبر لغة مشتركة تقول: نحن جميعاً نخشى التهميش والإقصاء، فلنصغْ معاً نظاماً يحمينا جميعاً بدل أن يُقصي بعضنا بعضاً.
إن التحدي أمام سوريا اليوم لا يقتصر على إعادة بناء المدن المهدّمة، بل على إعادة تعريف الخوف نفسه. فإذا بقي مجرّد مبرر للانغلاق والانقسام، فسوف يواصل إنتاج الماضي بأقنعته المختلفة. أما إذا جرى تحويله إلى وعي نقدي، فسيصبح فرصة لتأسيس ثقافة سياسية جديدة، تقوم على المواطنة والاعتراف المتبادل، وتجعل من التنوع مصدراً للقوة لا مدخلاً للهشاشة.
والعقد الاجتماعي الجديد، في جوهره، لن يكون نصاً مكتوباً فقط، بل عملية مستمرة لإدارة هذه المخاوف بعدالة وإنصاف. عندها لا يُقاس مستقبل سوريا بغياب الخوف، بل بقدرتها على تحويله من عبء يشلّ الحاضر إلى طاقة تبني الثقة. هكذا فقط تتحول المرحلة الانتقالية من زمن هشاشة وارتباك إلى لحظة تاريخية لإعادة التأسيس على أسس أعدل وأكثر إنسانية. عند تلك اللحظة فقط، لا يصبح الخوف عبئاً يطارد الحاضر، بل بوابة يعبر منها السوريون إلى مستقبل يليق بتضحياتهم وآمالهم، وتتحول جذور العزلة إلى جسور للتلاقي وتفتح المراحل الانتقالية أفقها كفرصة نادرة لإعادة بناء الدولة والمجتمع معاً.