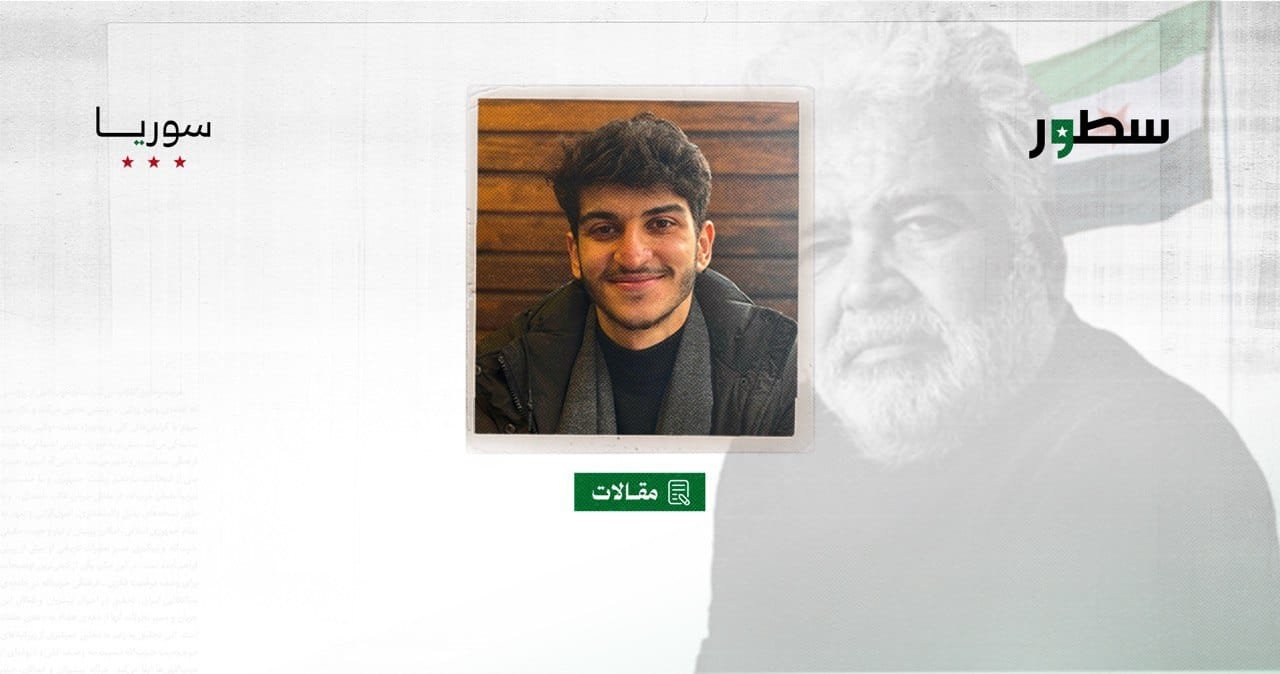أدب
وجع الثورة وذاكرتها: قراءة في ثلاثية عبد الله مكسور بعد سقوط الأسد
وجع الثورة وذاكرتها: قراءة في ثلاثية عبد الله مكسور بعد سقوط الأسد
أن تقرأ ثلاثية عبد الله مكسور “أيام في بابا عمرو، عائد إلى حلب، طريق الآلام” يعني أن تدخل تجربة روائية مكتوبة من قلب النزيف السوري، لا تسعى إلى تقديم إجابات، بل إلى استحضار الأسئلة التي وُلدت تحت القصف، في زنازين التعذيب، وعلى قوارب الهاربين. لا يُخضع السردُ الثورةَ لسياق تقليدي، بل يجعل من الكتابة نفسها استمراراً للحياة في مواجهة المحو، حيث تصبح الرواية وسيلة للنجاة، وشهادة على من لم يعودوا قادرين على الكلام. تُروى الحكاية من خلال شخصية صحفي، عاش الحصار، وجرّب الغربة، وشهد انهيار المدن، ليصوغ رحلته بلغة حادة، صادقة، ومشحونة بالحقيقة. من بابا عمرو المحاصرة، إلى حلب الممزقة، ثم إلى البحر كخاتمة وجودية للخذلان، تتحرك الروايات في مسار تصاعدي من الألم، يعكس انحدار الحلم السوري وتحطمه، وتحوّلاته من السلمي إلى المسلح، ثم إلى الهروب القاسي عبر المجهول.
هذه نصوصٌ لا تزعم الحياد، بل كتابة ملتزمة بالمبدأ والناس، بالدم، بالحق في الذاكرة. تسمي الأشياء بمسمياتها وتوجه أصابع الاتهام، إنها الأدب حين يقرر أن لا يكون ديكوراً، بل ضميراً حيّاً في زمن الخراب والموت، ومرآة دقيقة للتغيّرات التي عصفت بسوريا، وفضحت كل من تسلق على آلامها، من مهربي آثار إلى الاتجار بالبشر والدين.
وفي لقاء صوّره الكاتب مع بودكاست مشارب أجاب عن سؤال حول جدوى كتابة هذه الروايات في زمن حدوثها بقوله: “إن الكتابة كانت واجباً، شكلاً من أشكال العلاج الداخلي، ووفاءً للناس الذين كانوا يدفعون الفاتورة اليومية وقد يُنسَون تماماً. لم يكن الأمر توثيقاً بالمعنى الجامد، بل كتابة جزء من التاريخ، تاريخ المسحوقين والمهمشين، حيث تصبح مهمة الأدب أن يروي قصة العائلات التي قُصفت وماتت، لا مجرد أن يُقال إن بيتاً انهار”.
من الحكايات المتكسّرة تولد الثورة: أيام في بابا عمرو
تتميّز “أيام في بابا عمرو” بخرقها للسرد التقليدي، واعتمادها بنية الكولاج، لا مجرد تقنية شكلية، بل خياراً يعكس التشظي الداخلي للواقع السوري. فالرواية لا تتبع خطّاً زمنياً واحداً، بل تُبنى من مقاطع متفرقة، أصوات متعدّدة، وصور تتكامل كلوحة موزعة على صفحات، مما يضفي على النص طابعاً توثيقياً حياً وانفعالياً في آن. إنها رواية لا تبحث عن البطل، بل تمنح البطولة للناس العاديين، لأولئك الذين يكتبون اللافتات، للشباب الحالم بالتغيير، يهتفون للحرية، ثم يسقطون في الميدان تحت وابل الرصاص من العصابات الأسدية والجيش الحامي!
من خلال هذه البنية المفتوحة، ينجح النص في نقل نبض اللحظة الثورية كما عايشها الصحفي (بطل الرواية)، بدءاً من تفاصيل التنظيم السلمي: كتابة الشعارات، التنسيق للخروج من المساجد، إلى اللحظة التي يتحول فيها الحلم إلى رعب مع أول رصاصة. في الخلفية، تتردّد لازمة “إنها الحرب” كتذكير قاسٍ بأن كل ما يُروى كان واقعاً مشهوداً، ووصفاً دقيقاً لما آلت إليه البلاد تحت حكم الأسد.
المدينة الممزقة في مرآة الذاكرة: عائد إلى حلب
في “عائد إلى حلب”، الرواية الثانية في الثلاثية، تتعمّق المأساة وتتقدّم خطوة جديدة نحو النضج الفني والإنساني. يعود الصحفي إلى حلب، باحثاً عن ملامح وطن لم يبقَ منه سوى الركام. المدينة التي كانت رمزاً للتاريخ والهوية تحوّلت إلى أطلال، تحاصرها المخيمات، وتطاردها الخيبة، وتتقاطع في أحيائها سلطات متنازعة، فيما الناس يسكنون الألم قدراً لا خياراً.
تُظهر الرواية تطوراً واضحاً عن سابقتها، من حيث البناء المتماسك، واللغة المكثفة، والحبكة المدروسة التي تمضي بالتوتر حتى الذروة، حين يجد الصحفي نفسه داخل مدرسة قديمة في قلب حلب، تحت سيطرة جنود من جبهة النصرة. يتخلل السرد أصوات البكاء، وصور النساء المعذبات، والرجال الذين تكسّرت صرخاتهم في الزنازين. إنها رواية الفقد المركّب، والخسارة المتراكمة، وسرد الذاكرة المقاوم والفاضح.
لم تعد الثورة هنا حدثاً طارئاً، بل قدراً يومياً، يرافق الشخصيات في حركاتها وسكونها، ويعيد تشكيل ملامح اللغة ذاتها. كل مشهد هو حقل ألغام شعوري: البرد في المخيم، الحنين في الخراب، الصمت في المدرسة، والتحديق الطويل في مدينة لم تعد تعرف نفسها. تتعامل الرواية مع الوطن ككائن هشّ، يكاد يتلاشى. وبين ثنايا هذا الخراب، يلمع وميض الكتابة كسلاح أخير متغنياً بعظمة البلاد ومأساة ما آلت إليه.
طريق الآلام: حين يصبح البحر معبراً إلى الحياة والمنفى معاً
في “طريق الآلام”، الرواية الأخيرة في الثلاثية، تبلغ الحكاية السورية ذروتها الأكثر قسوة: لا عودة، ولا ملجأ، بل طريق واحد يتجه نحو البحر. الصحفي، الذي تنقّل بين شوارع الثورة ومعتقلات النظام وخرائب المدن، يجد نفسه الآن مطارداً من كل الجهات، بلا أرض تحميه، ولا سقف يقيه. لم يبقَ له إلا البحر، ذلك الامتحان الأخير للنجاة، والعتبة الفاصلة بين وطن لفظ أبناءه، وعالم لا يعدهم بشيء.
تتحوّل رحلة اللجوء هنا إلى سردية مكتملة عن الخسارة، والانهيار الداخلي، والبحث عن حياة جديدة في عزّ التهالك. السرد لا يرصد الحدث من الخارج، بل ينصت إلى رجفة الجسد، وتقلّب الذاكرة.
خُتمت الرواية بعبارة موجعة وقاسية وصارخة في معناها : لقد كانت سواحل أوروبا برغم الموت أقرب إلينا من أبواب مكة المكرمة.
جملة تختزل صدمة الوعي، وتفضح الخلل الروحي والخذلان السياسي.. كم كنت وحدك يا ابن أم، كم كنت وحدك أيها السوري في مواجهة العالم .
يقول عبد الله مكسور في حواره مع بودكاست مشارب أنه كتب هذه الرواية في ظروف قاسية، وهو يعيش في أحد مخيمات اللاجئين المكدّسة بضحايا الحرب، حيث كان يجاور المعطوبين جسداً وحكاية. وهناك، بين الخيام، صاغ الفصول الأخيرة للعمل.
“المتجذر في التراثين المسيحي والإسلامي VİA DOLOROSA وعن اختيار العنوان يوضح أنه استخدم” طريق الآلام.
حيث يستحضر المتلقي العربي عند سماعه صورة المسيح في القدس وهو يصعد نحو تلة الجلجلة، بينما يتشارك المتلقي الأوروبي المعنى ذاته بوصفه رمزاً كونياً للألم. بهذا المعنى، يصبح العنوان جسراً ثقافياً يربط التجربة السورية بالذاكرة الإنسانية العامة، ويحوّل النص إلى استعارة عابرة للحدود.
نهاية تبدأ من الذاكرة: حين تنتصر الثورة وتبقى الرواية
لم تعد ثلاثية عبد الله مكسور مجرد صرخة في وجه القمع، بل غدت اليوم سجلاً حارّاً لذاكرة جماعية، نعود إليه بعد أن انكسر الجدار وسقط الطاغية. نقرأ “أيام في بابا عمرو”، “عائد إلى حلب”، و”طريق الآلام” بعد التحرير، لا لنسترجع جرحاً داملاً، بل كمن يلمّ بقايا الحلم ويقول: لقد كنا على حق، وها نحن انتصرنا.
هذه الروايات، التي كُتبت من قلب الموت، أصبحت اليوم وثائق انتصار، تُذكّرنا بالثمن، وتعلّمنا كيف نبكي بكرامة، دون أن ننسى أن الدموع وحدها لا تكفي. تذكير قاسٍ بما لن يُمحى.
وهكذا، حين نصغي إلى صدى هذه الثلاثية بعد أن هدأ الرصاص، ندرك أن عبدالله مكسور كان يكتب سوريا بكل وجعها، وهشاشتها، وكرامتها. والآن، وقد تحررت البلاد، تبقى الرواية لتشهد، وتؤرّخ، وتقول للعالم: لم ننسَ، ولم نُكسر.
نقرأها بدموع غزيرة، نعم، لأن الذين رحلوا لن يعودوا، يجاور الدمع ابتسامة داخلية، لأن القاتل الذي هجّرنا، واغتصبنا، وذبحنا، لم يعد هنا. سقط، وسقط معه جدار الخوف، وتحطّمت أسطورته المزيّفة. نقرأ الثلاثية الآن لنحزن على من فقدناهم، و نحتفل بمن بقوا، بمن صمدوا، بمن قاوموا، وبمن كتبوا الذاكرة نيابة عنّا.
طارحين السؤال الأهم : كيف نبني ما بعد الثورة؟ كيف نحفظ الذاكرة دون أن نُبتلع فيها؟ كيف نعيد صياغة الحياة بعدما جُبلت بالتشظي والنزوح والمنفى؟.