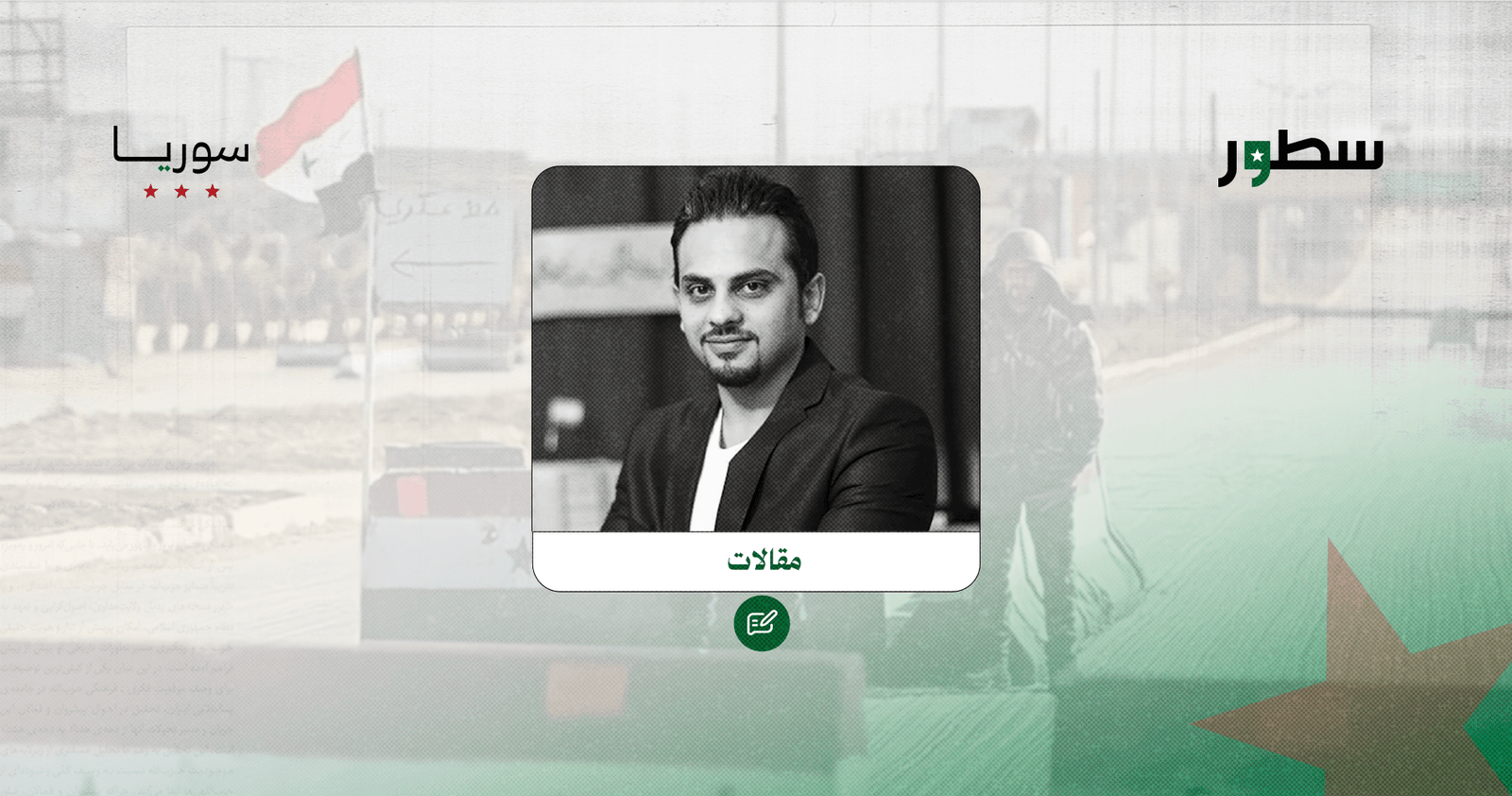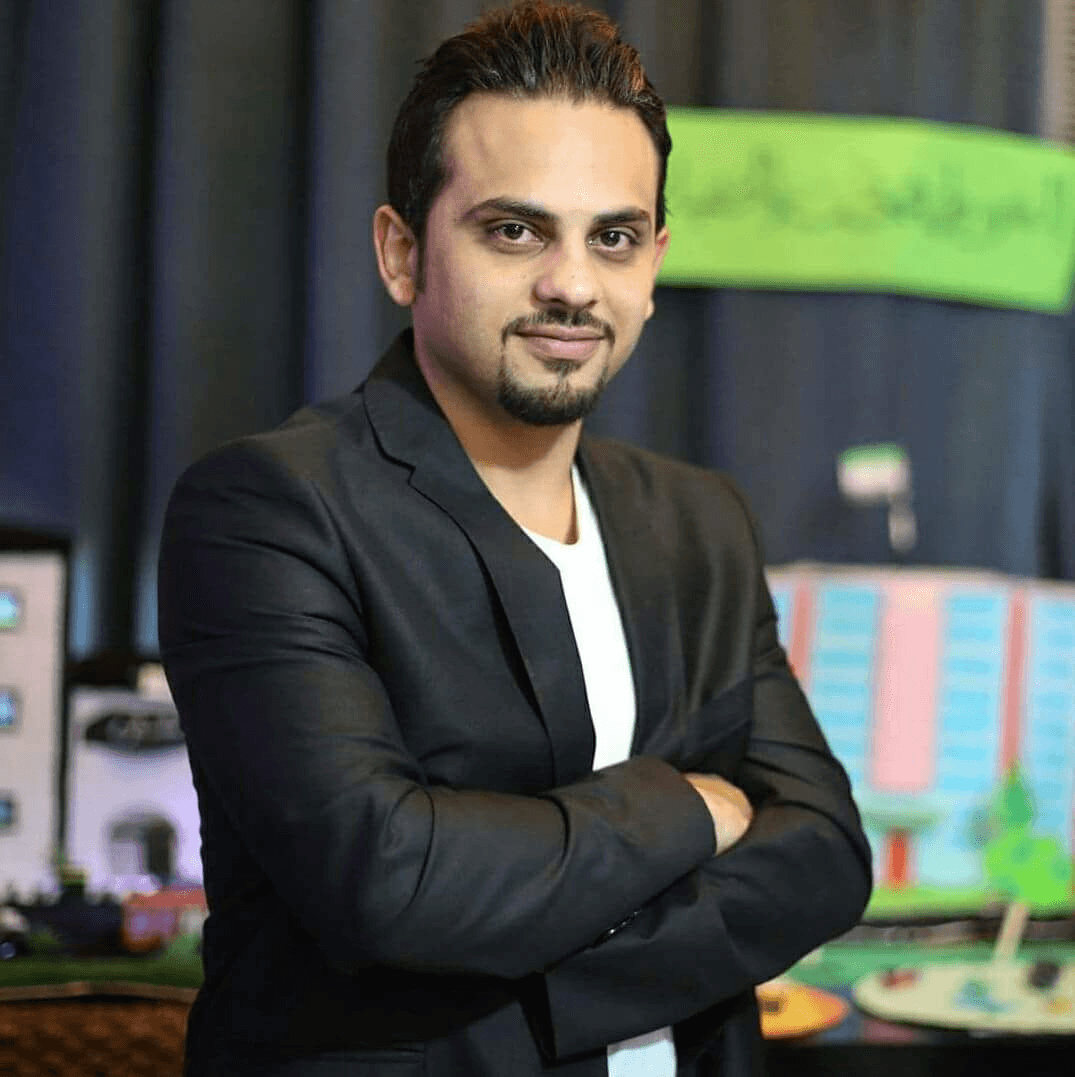فكر
من الحروب الطائفية إلى الوحدة: التجربة الأوروبية ودروسها لسوريا
من الحروب الطائفية إلى الوحدة: التجربة الأوروبية ودروسها لسوريا
الطائفية ليست مجرد انتماء ديني أو مذهبي، بل تتحول حين تُستغل سياسياً إلى أداة تقسيم وتفجير للمجتمعات من الداخل. إنها عقلية ترى الآخر المختلف تهديداً بدلاً من أن تراه جزءاً من التنوع البشري. وحين تتجذر الطائفية، فإنها تزرع الشك والكراهية في النفوس، وتفتح الطريق أمام صراعات لا تهدأ بسهولة، صراعات تلتهم الدول وتفتك بمستقبل الأجيال.
أوروبا التي صدرت نفسها نموذجاً للتعاون والوحدة وحرية التعبير، لم تكن كذلك دائماً. إذ دفعت ثمناً باهظاً من الدماء والدمار وسنين طويلة من الحروب الدموية قبل أن تدرك أن الطائفية ليست حلاً، وأن المستقبل والازدهار يكمن في التعايش والبناء المشترك.
فرنسا تحترق، الحروب الدينية الفرنسية
بين عامي 1562 و1598 عاشت فرنسا إحدى أكثر صفحاتها دموية في التاريخ، فيما عُرف بالحروب الدينية الفرنسية، والتي اندلعت بين الكاثوليك والبروتستانت (الهوغونوت). لم تكن هذه الحروب صراعاً عقائدياً فحسب، بل تداخلت فيها حسابات النفوذ بين عائلات النبلاء الكبرى وسط ضعف العرش الفرنسي في زمن الملوك الصغار من آل فالوا.
وصل العنف الطائفي ذروته في مذبحة ليلة القديس بارثولوميو عام 1572، حيث قتل ما يقارب 30 ألف بروتستانتي في باريس والمدن الفرنسية الأخرى، والشوارع التي تشهد احتفالات مشتركة أصبحت ساحات قتال، الجيران الذين عاشوا جنباً إلى جنب لعقود أصبحوا أعداء، والهوية الدينية طغت على كل القيم الإنسانية الأخرى. هذا المشهد يذكرنا بما حدث في بعض المدن السورية، حيث.تحولت أحياء مختلطة كانت تعيش في وئام إلى مناطق منقسمة طائفياً بينها قتال وسلاح ودم.
حرب الثلاثين عاماً: أوروبا في بحر من الدماء
أحد أبرز تجليات تلك المرحلة كانت حرب الثلاثين عاماً (1618-1648)، التي اندلعت في قلب أوروبا و انخرطت فيها قوى كبرى من الإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى فرنسا وإسبانيا. استمرت ثلاثة عقود كاملة، وحصدت أرواح نحو ثلث سكان ألمانيا آنذاك، ودمّرت مدناً وقرى بكاملها، الأراضي الزراعية تحولت إلى صحارى قاحلة، والأطفال نشؤوا وهم لا يعرفون سوى الحرب والقتال.
معاهدة وستفاليا: الإرهاق يولد التحول
بعد عقود من الصراعات الدموية، بدأ الأوروبيون يدركون أن الثمن أصبح باهظاً جداً، الاقتصاد منهار والمجتمعات ممزقة، والأجيال الجديدة تولد في عالم من العنف والكراهية، هذا الإرهاق الجماعي كان نقطة تحول حاسمة.
معاهدة وستفاليا (1648) لم تكن مجرد اتفاقية سلام، بل كانت إقراراً بمبدأ جديد، فقد أنهت المعاهدة حرب الثلاثين عاماً والثمانين عاماً، وأقرت استقلال دول مثل سويسرا والسويد وبولندا، وفرضت سيادة الدولة، عملت المعاهدة على تعزيز فكرة التوازن الدولي، أي منع هيمنة دولة على البقية عبر تحالفات أو اتفاقات دولية.
أصبح تبادل السفراء والعلاقات الدبلوماسية المباشرة قاعدةً متبعة، بدلاً من الاعتماد على الزواج الملكي، وانتهت هيمنة الكنيسة على الحكم، ما مهد لظهور الدولة الوطنية الحديثة وبزوغ عصر القانون الدولي.
في سوريا، نرى بوادر إرهاق ممثال، فالسوريون تعبوا من التهجير والنزوح والفقدان، والشباب يريد فرصة للبناء والعمل، هذا الإرهاق قد يكون بداية الحقيقة للبحث عن حلول سلمية.
التنوير: العقل فوق العقيدة
مع بداية القرن الـ18، ظهر في أوروبا فكر التنوير الذي دعا إلى تقديم العقل والحوار على العنف والتعصب. مفكرون مثل فولتير ولوك دعوا إلى التسامح الديني والفصل بين السلطة الدينية والسياسية.
فولتير، الذي عانى من الاضطهاد الديني، كتب: “قد أختلف معك في الرأي، لكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في التعبير عنه”. هذه الفكرة الثورية وضعت أسساً جديدة للتعايش.
في السياق السوري، نحتاج إلى نهضة فكرية مماثلة. مثقفون وأكاديميون سوريون من مختلف الطوائف يمكنهم أن يقودوا حواراً جديداً يؤكد على القيم المشتركة والهوية السورية الجامعة، متجاوزين الانقسامات الطائفية الضيقة.
ولادة الحلم الأوروبي
في عام 1951، وُلدت المجموعة الأوروبية للفحم والصلب بمبادرة من روبرت شومان. الفكرة كانت بسيطة لكنها عبقرية: إذا ربطنا اقتصاديات الدول الأوروبية ببعضها البعض، فإن الحرب ستصبح مستحيلة اقتصادياً قبل أن تصبح غير مرغوبة سياسياً.
هذه النواة الصغيرة نمت تدريجياً لتصبح الاتحاد الأوروبي، الذي يضم اليوم 27 دولة تشارك عملة واحدة وسوقاً مشتركة، وتحل نزاعاتها بالحوار والقانون بدلاً من السلاح.
الدروس السورية: من التجربة الأوروبية إلى الواقع العربي
تُعيد التجربة السورية اليوم إلى الأذهان ما عاشته أوروبا قبل قرون من صراعات دينية وقومية دامية، حيث تحوّل التنوع من مصدر غنى إلى وقود للحروب، تماماً كما حدث بين الكاثوليك والبروتستانت. وكما أدت القوى الخارجية دوراً في تعقيد المشهد الأوروبي، فإن التدخلات الإقليمية والدولية اليوم تزيد من تعقيد الأزمة السورية.
رغم ذلك، تمتلك سوريا إرثاً حضارياً عريقاً في التعايش، فالمدن السورية مليئة بالتنوع الديني والثقافي، حيث عاش المسلمون والمسيحيون والدروز والأكراد والعلويون في أحياء وأسواق مشتركة. هذه الذاكرة الشعبية يمكن أن تشكّل نقطة انطلاق نحو مصالحة وطنية.
التجربة الأوروبية تفتح أمام السوريين ثلاثة دروس مركزية
أولها أن السلام يبدأ من القاعدة الشعبية عبر مبادرات تعليمية وشبابية ومشاريع مشتركة، ثانيها أن الاقتصاد يمكن أن يكون جسراً للوحدة، حيث تمتلك سوريا موقعاً جغرافياً وموارد طبيعية تجعلها قادرة على بناء اقتصاد يخدم الجميع، ثالثها أن يكون للمؤسسات الحديثة دستور عادل، قضاء مستقل، وجيش وطني وهو الضامن الوحيد للتعايش الحقيقي.
ورغم الدمار المادي والجروح العميقة والتدخلات المستمرة، تبقى بذور الأمل حاضرة: تعب السوريين من الحرب، جيل جديد أكثر انفتاحاً، أدوات التواصل الحديثة، والإرث الثقافي المشترك الذي يتجاوز الانقسامات. كلها عناصر تجعل طريق المصالحة صعباً لكنه ليس مستحيلاً.
من الدرس الأوروبي إلى الحلم السوري
التجربة الأوروبية تعلمنا أن التغيير ممكن، لكنه يحتاج إلى وقت وصبر وإرادة سياسية. أوروبا احتاجت إلى قرون وشلالات من الدماء، لتتعلم أن الطائفية ليست حلاً، وعقود لتبني وحدتها الحديثة.
سوريا لا تحتاج إلى أن تكرر نفس الأخطاء أو تدفع نفس الثمن الباهظ. يمكنها أن تتعلم من التجربة الأوروبية وتطبق الدروس المستفادة منها.
الحلم السوري ليس مستحيلاً: سوريا موحدة وديمقراطية، يعيش فيها العلوي والسني والمسيحي والدرزي والكردي والعربي كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. أن تكون سوريا جسراً للتعاون بدلاً من أن تكون ساحة للصراع، وتساهم في بناء شرق أوسط أكثر استقراراً وازدهاراً.
هذا الحلم يحتاج إلى جهود كل السوريين، في الداخل والخارج، من كل الطوائف والخلفيات. يحتاج إلى قيادات حكيمة تضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الضيقة، ومثقفين شجعان يقولون كلمة الحق حتى لو كانت مرة، ومجتمع مدني قوي يبني الجسور بين المجتمعات المختلفة.
أوروبا أثبتت أن العدو القديم يمكن أن يصبح صديقاً وشريكاً. ألمانيا وفرنسا، اللتان حاربتا بعضهما البعض لقرون، تقودان اليوم مشروع الوحدة الأوروبية. إذا استطاعت أوروبا أن تحقق ذلك، فلماذا لا تستطيع سوريا؟
الجواب في أيدينا جميعاً. والتاريخ ينتظر أن نكتب صفحة جديدة من صفحات التعايش والسلام، وليس المهم أن نتذكر من أين جئنا، بل المهم إلى أين نريد أن نصل معاً.