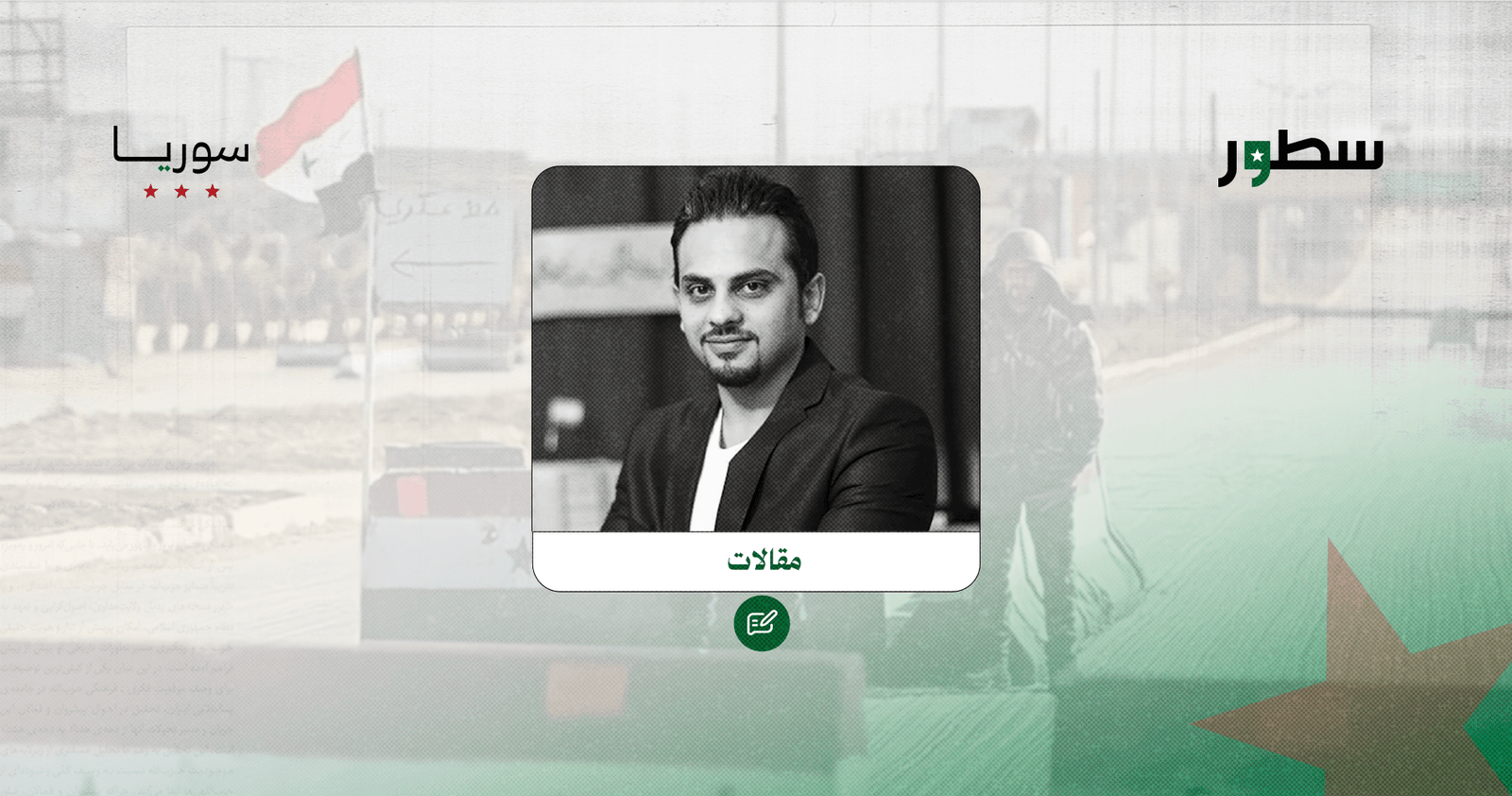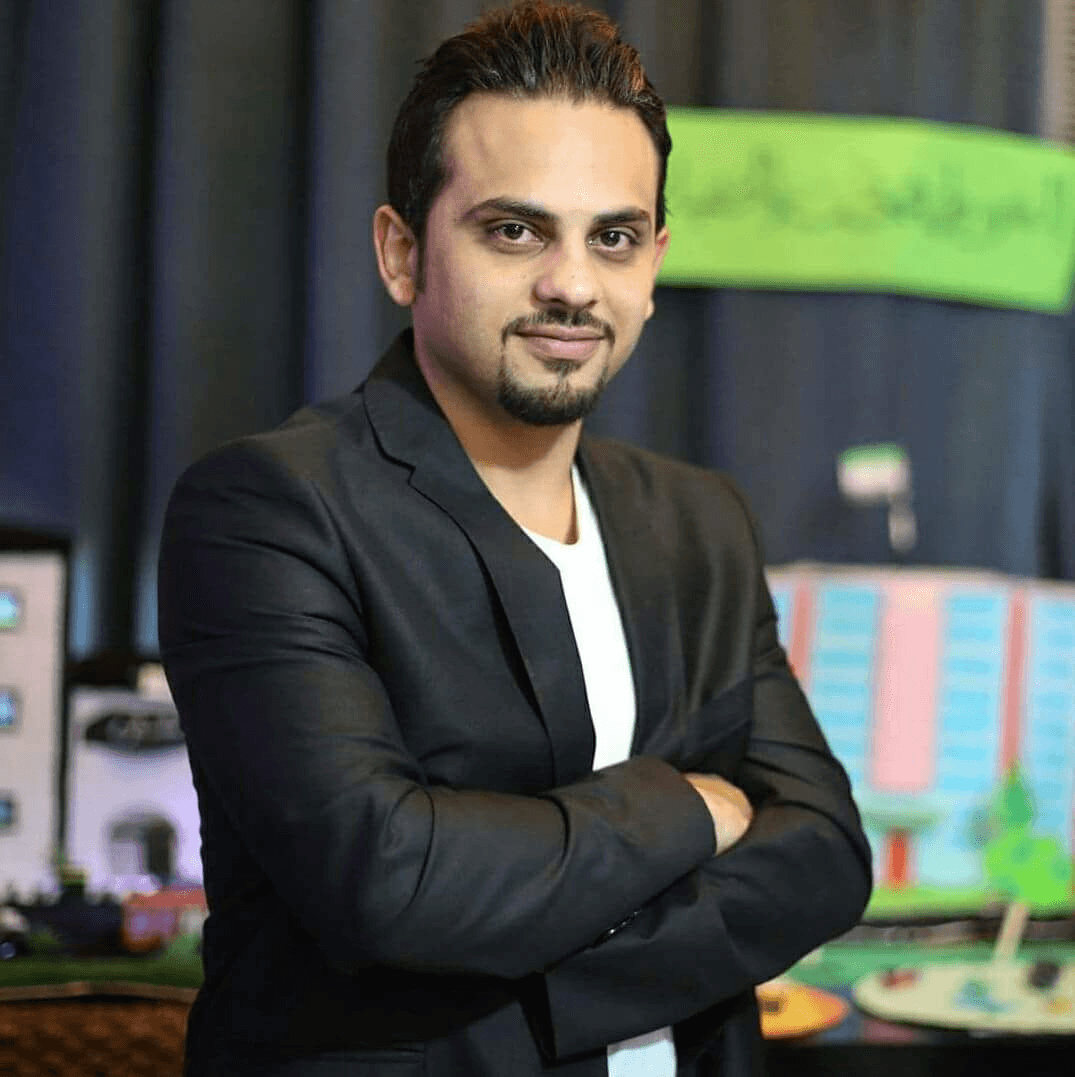تكنولوجيا
الإعلام السوري.. من قبضة الرقابة إلى فضاء الرقمنة
الإعلام السوري.. من قبضة الرقابة إلى فضاء الرقمنة
يُعد الإعلام أحد الركائز الأساسية في بناء المجتمعات الحديثة، فهو ليس مجرد أداة لنقل الأخبار والمعلومات، بل يؤدي دوراً محورياً في تشكيل الوعي الجمعي للرأي العام وصياغة التصورات السياسية والاجتماعية والثقافية. في سوريا، يعكس الإعلام تاريخياً تقاطعاً معقداً بين سلطة الدولة ورغبات المجتمع في الوصول إلى المعلومات، وهو تقاطع تزايدت حدة ملامحه مع بداية الثورة السورية ضد نظام الأسد، تزامن ذلك مع التحول الرقمي في الإعلام وظهور منصات التواصل الاجتماعي، التي وفرت وصولاً سهلاً للمعلومة، كذلك مساحة واسعة للتعبير، وتخليص الإعلام من سلطة الدولة.
فمنذ تأسيس الدولة السورية الحديثة، أدى الإعلام الرسمي دور أداة للدولة أكثر من كونه وسيلة لنقل المعرفة المستقلة. بدأت هذه السيطرة منذ منتصف القرن العشرين، حيث تبنت الحكومات المتعاقبة سياسات الرقابة الصارمة على الصحافة والإذاعة والتلفزيون، لتضمن بقاء الخطاب العام ضمن حدود ما تعتبره الدولة مقبولاً سياسياً وأيديولوجياً. كانت هذه الرقابة مدفوعة بفلسفة أن الإعلام مسؤول عن تعزيز الاستقرار الوطني ومنع انتشار ما قد يهدد وحدة الدولة، وهو ما يعكس موقفاً سياسياً وأيديولوجياً قائماً على مركزية الدولة، وتقديس الحاكم الأوحد وتبني رواية نظام الأسد ورؤيته.
في المقابل، كانت تجربة الإعلام في بعض الدول العربية الأخرى أكثر مرونة نسبياً، مثل لبنان في مرحلة ما قبل الحرب الأهلية، حيث ازدهرت الصحافة المستقلة وسمحت بمساحة واسعة للنقاش السياسي والاجتماعي، وهو ما خلق بيئة إعلامية أكثر تنوعاً. بالمقارنة مع الغرب، ظل الإعلام السوري تاريخياً متأخراً عن معايير حرية التعبير الإعلامية، حيث يضمن القانون في دول مثل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية حرية واسعة للصحافة مع وجود حدود قانونية واضحة فقط لمنع التحريض على العنف أو التشهير.
شهد الإعلام السوري تغيراً نوعياً منذ منتصف العقد الأول من القرن الـ21، مع انتشار الإنترنت وظهور منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب. لقد فتح هذا التحول الرقمي باباً جزئياً للانفتاح الإعلامي، حيث أصبح بإمكان المواطن السوري الوصول إلى مصادر معلومات متعددة خارج إطار الإعلام الرسمي. هذا الانفتاح الرقمي خلق بيئة إعلامية هجينة، حيث يوجد الإعلام التقليدي الخاضع للرقابة إلى جانب منصات رقمية شبه حرة تسمح بتداول الأخبار والآراء بحرية أكبر، إلا أنها قبل الثورة كانت خاضعة للرقابة المشددة من قبل أجهزة المخابرات، الأمر الذي جعل من تلك المساحة نافذة صغيرة في سجن كبير، بالمقابل فقد النظام الأمني السوري، جزءاً من هيمنته على النقاش العام.
من منظور فلسفي، يمكن اعتبار هذه الظاهرة تجسيداً لمفهوم “العقل الجمعي الرقمي”، حيث تتفاعل الأفكار والمعلومات بين الأفراد في فضاءات افتراضية تتجاوز حدود الدولة والسيطرة التقليدية. ومع ذلك، يبقى هذا الانفتاح محدوداً من حيث الوصول والمصداقية، إذ تواجه وسائل الإعلام الرقمية تحديات التحقق من المعلومات وانتشار الأخبار الكاذبة أو المضللة، مما يعقد عملية تشكيل الرأي العام بطريقة موضوعية.
أصبح لوسائل التواصل الاجتماعي دور محوري في صناعة الرأي العام السوري، لاسيما منذ بداية الثورة السورية عام 2011. فقد مكنت هذه المنصات السوريين من التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية والاجتماعية، ونشرت صوراً وفيديوهات توثق الأحداث في مناطق لم تصل إليها وسائل الإعلام التقليدية. ومن الناحية السياسية، أصبحت هذه المنصات أدوات ضغط جماهيري على السلطات، وأحياناً أدوات لصناعة الرأي العام الدولي تجاه الوضع في سورية.
وفي الوقت الذي مثل فيه الإعلام الرقمي جسماً بديلاً موازياً لإعلام النظام، حول فيه الفرد من متلقٍ سلبي إلى مشارك فاعل في صناعة المحتوى وتداول المعلومات، ما أدى إلى تقليص الفجوة بين صانع الخبر والمستهلك، معيداً تعريف مفهوم “السلطة الإعلامية” في سوريا، إلا أنه ما زال يتعرض لضغوط اقتصادية تؤثر على موضوعيته أحياناً، وهو ما يعكس شكلاً مختلفاً من السيطرة على الرأي العام.
مقارنة بالدول الأخرى، يظهر أن الإعلام السوري تأخر في التكيف مع حرية الإعلام والصحافة المستقلة، لكن الثورة الرقمية شكّلت فرصة لمواكبة العالم في زمن المعلومات، تظهر تجارب مختلفة للإعلام بين الرقابة والانفتاح. في الصين وروسيا، يظل الإعلام التقليدي والرقمي تحت مراقبة الدولة بشكل صارم، في حين أن الولايات المتحدة وأوروبا تعتمد على سوق إعلامي حر، مع تقنين محدود للرقابة، لكنها تواجه تحديات جديدة مثل التضليل الرقمي وتأثير شركات التكنولوجيا الكبرى على شكل النقاش العام.
السياق السوري يجمع بين الرقابة التقليدية والانفتاح الرقمي الجزئي، وهو ما يجعل التجربة السورية فريدة من نوعها، إذ تشهد الدولة صراعاً مستمراً بين الحفاظ على السيطرة السياسية والمجتمع الذي يسعى للحصول على معلومات حرة ومتنوعة.
يمكن القول إن الإعلام السوري يعكس صراعاً دائماً بين الرقابة والانفتاح، بين سلطة الدولة وحقوق المواطن في الوصول إلى المعرفة والمعلومة. ومع ظهور الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، تغيرت موازين القوى في تشكيل الرأي العام، حيث أصبح المواطن السوري لاعباً نشطاً في صياغة وعيه الجماعي، رغم استمرار التحديات القانونية والسياسية. إن دراسة الإعلام السوري في ضوء التاريخ والفلسفة والسياسة والإعلام تكشف تعقيد العلاقة بين السلطة والحرية الرقمية، وتوضح أن مستقبل الإعلام يعتمد على مدى قدرة المجتمع والدولة على التكيف مع التحولات الرقمية دون فقدان التوازن بين الحقيقة والمصلحة العامة.
وفي الوقت الذي تُعد فيه حرية الإعلام جزءاً من أهداف الثورة السورية وحقاً أساسياً من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعبير والوصول إلى المعلومات، تظل الرقابة القانونية ضرورة لحماية المجتمع والدولة. ويُفترض أن تُعتمد قوانين تجرم التحريض على العنف أو نشر المعلومات المضللة والخطاب الطائفي، على أن تكون هذه القوانين واضحة وشفافة، بحيث يَعرِف الجميع ما يُعتبر تحريضاً وما أشكاله.
كما ينبغي تشكيل هيئات رقابية مستقلة يشارك فيها المجتمع المدني، بدلاً من التدخل المباشر للسلطة التنفيذية، بحيث تركز هذه الهيئات على المحتوى الفعلي دون تسيس الإعلام، بما يضمن عدم فرض خطاب الدولة على الرأي العام، كما يحمي المجتمع من استغلال الإعلام البديل عن جهل أو من قبل أي طرف كأداة تأثير وضغط بهدف زعزعة الأمان الاجتماعي أو تقويض سلطة الدولة.