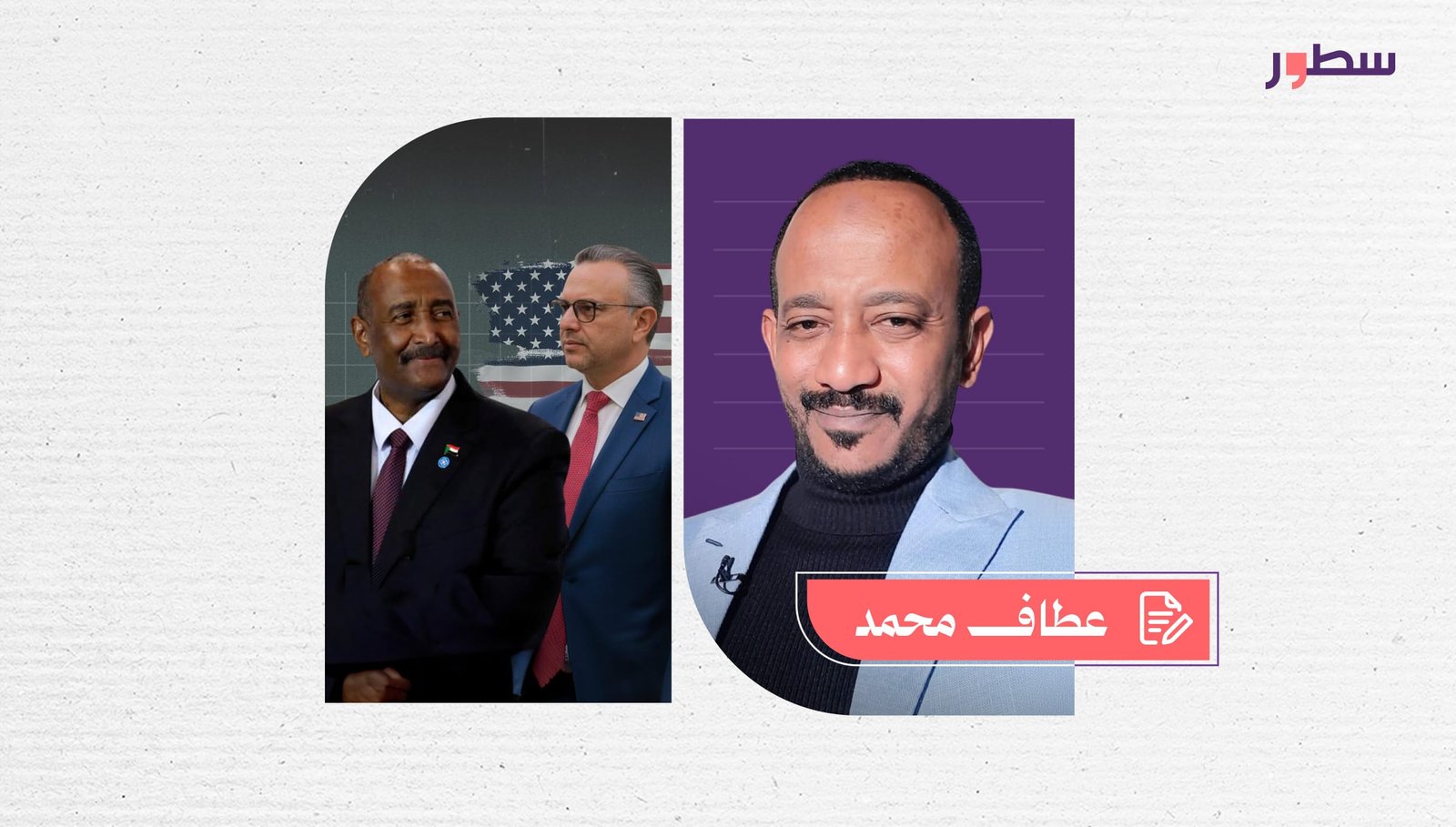سياسة
إغلاق الجمعيّة الأفريقيّة بالقاهرة: نهاية ذاكرة وبداية فراغ في التعاون الجنوبيّ–الجنوبيّ!
إغلاق الجمعيّة الأفريقيّة بالقاهرة: نهاية ذاكرة وبداية فراغ في التعاون الجنوبيّ–الجنوبيّ!
كان خبر إغلاق الجمعية الأفريقيّة بالقاهرة في الشهر المنصرم، إعلان رسميّ عن فقدان ذاكرة سياسية وثقافية شكّلت لعقودٍ جسرًا متينًا بين شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. هذا المكان، الذي تأسّس عام 1955، كان بمثابة جامعة غير رسميّة للثوار الأفارقة، ومنصة للتلاقي الفكريّ والثقافيّ بين حركات التحرّر التي صنعت ملامح القارة بعد الاستقلال.
فضاء ثوريّ وصوت للتحرّر
وُلدت الجمعية الأفريقيّة في زمن جمال عبد الناصر، حين كانت القاهرة مركزًا للعالم الثالث، ومختبرًا لتجارب التضامن بين شعوب الجنوب. سرعان ما تحوّلت إلى بيتٍ للمناضلين الأفارقة الذين لفظتهم عواصم الاستعمار الأوروبيّ، فوجدوا في القاهرة ملاذًا ومسرحًا للعمل. في عام 1957، أسّس فيليكس مومييه من الكاميرون مكتبًا دائمًا داخل الجمعية بعدما حظر الاستعمار الفرنسيّ حركة اتحاد شعوب الكاميرون (UPC). وفي العام ذاته، وصل الأوغنديّ جون كاليكزي، ممثل المؤتمر الوطنيّ الأوغندي (UNC)، إلى مقر الجمعية بعد رحلة شاقة عبر السودان هربًا من الاعتقال البريطانيّ. وفي 1958 تبعه الكينيان – من كينيا- جيمس أوتشواتا و”ويرا أمبيثو” اللذان أسّسا “مكتب كينيا”، ليتحوّل لاحقًا إلى نواةٍ للعمل الخارجي لـ الاتحاد الوطنيّ الأفريقيّ الكيني (KANU)، الحزب الذي قاد كينيا إلى الاستقلال عام 1963.
وخلال عقد الستينيّات، أصبحت الجمعية فضاءً ثوريًّا استضاف أكثر من 24 حزبًا قوميًّا أفريقيًّا. قادة كبار مرّوا من هنا: أميلكار كابرال من غينيا بيساو والرأس الأخضر، مؤسّس الحزب الأفريقيّ لاستقلال غينيا والرأس الأخضر (PAIGC)، وسامورا ميشيل من موزمبيق، قائد جبهة تحرير موزمبيق (FRELIMO)، وأغوستينيو نيتو من أنغولا، زعيم الحركة الشعبيّة لتحرير أنغولا (MPLA). هؤلاء وجدوا في القاهرة ملجأً آمنًا، بل ومدرسةً للتنظيم السياسيّ، ومنصة إعلاميّة عبر إذاعة القاهرة التي بثّت بلغاتٍ أفريقيّة محليّة، ومجلات هُرّبت إلى بلدانهم تحت الاستعمار. ولاحقًا تجاوزت الجمعية كونها فضاءً مصريًّا داخليًّا، لتتحوّل إلى ما يشبه “الأمم المتحدة المصغرة” كما وصفها الصحفيّ النيجيريّ أولابيسي أجالا، جامعةً بين طلاب، سياسيين، ومثقفين حملوا حلم الحريّة إلى أبعد مدى.
لكن مسار الجمعيّة بدأ بالتراجع مع عهد أنور السادات منذ السبعينيّات، حين تراجع البعد الأفريقيّ في السياسة المصريّة لصالح التوجُّه نحو الغرب والانفتاح الاقتصاديّ مع إسرائيل واتفاقية كامب ديفيد. رويدًا رويدًا، غاب الدعم الرسميّ لها، وتآكل الحضور الشعبيّ، ليتحوّل هذا الفضاء الثوري إلى مجرّد مبنى بلا روح، حتى جاء خبر الإغلاق ليضع النقطة الأخيرة في سطرٍ طويل من الإهمال. المؤسف أنّ ذكرى الجمعية ظلّت حيّة في جنوب القارة أكثر ممّا هي في شمالها. فأحد الطلاب من جنوب أفريقيا، مثلًا، عبّر عن رغبته في زيارتها لأنّه قرأ عن دعمها لرفاق نيلسون مانديلا وروبرت سوبوكوي، زعيم مؤتمر عموم الأفريقيين (PAC)، خلال سنوات الكفاح ضد نظام الفصل العنصريّ.
إضافيًّا، لم يقتصر دور الجمعيّة على السياسة وحدها، بل سما دورها إلى التعليم والثقافة. فقد منحت الطلاب الأفارقة منحًا دراسيّة ساعدتهم على الالتحاق بالجامعات المصريّة، فكانوا يجمعون بين الدراسة الأكاديميّة والخبرة النضاليّة المباشرة. كما نظّمت الجمعية ندواتٍ فكريّة ولقاءات ثقافيّة أتاحت للشباب الأفريقيّ والمصريّ تبادل الأفكار والخبرات، ممّا رسّخ إحساسًا بهويّة مشتركة تتجاوز الحدود الاستعماريّة. ومن أبرز أدواتها الثقافيّة إصدار مجلات مثل مجلة “نهضة أوغندا” ومجلة “زيمبابوي اليوم”، التي وُزعت في القاهرة وسُربت سرًا إلى المستعمرات لتغذية الوعي الوطنيّ. كما مثّلت إذاعة القاهرة الموجّهة باللغات الأفريقيّة، كلغتي “السواحيلية” و”الزولو،” منبرًا حيويًّا لنقل رسائل التحرّر والتضامن مباشرة إلى شعوب القارة. بهذا كلّه، تحوّلت الجمعيّة إلى جسرٍ حيّ للتبادل الثقافيّ والفكريّ، وأسهمت في بلورة هويّة أفريقيّة جامعة قادرة على مواجهة التفكّك الذي فرضته القوى الاستعماريّة.
واليوم، يطرح إغلاق الجمعيّة سؤالًا مريرًا: من سيحفظ هذه الذاكرة؟ ومن سيعيد إنتاج هذا النوع من التعاون الفكريّ والسياسيّ بين شعوب الجنوب؟ إذا كان التاريخ يذكّرنا بأنّ القاهرة كانت يومًا ما عاصمة التضامن الأفريقيّ، فإن الحاضر يشير إلى انسحابها من هذا الدور، وترك الفراغ لقوى أخرى تتحرك بوعيٍ وإصرار.
من يملأ الفراغ؟
إنّ القوى الغربية، التي قاومت الجمعيّة في الخمسينيات والستينيات، عادت اليوم بأساليب ناعمة أكثر دهاءً. بريطانيا وفرنسا اللتان حظرتا حركات التحرّر، تستثمران الآن في الجامعات ومراكز الأبحاث في نيروبي الكينيّة، وداكار السنغاليّة، وأبيدجان الإيفواريّة، وتقدّمان برامج تبادل أكاديميّ تمنح آلاف الطلاب الأفارقة منحًا في باريس ولندن، بما يعيد إنتاج الارتباط الثقافيّ والفكريّ بالمتروبول القديم. كما تبنّت الولايات المتحدة بدورها نفوذًا ثقافيًّا عبر برامج مثل مبادرة الشراكة الأفريقيّة ومؤسسة “فولبرايت”، وتُوظّف الإعلام الرقميّ ومؤسسات المجتمع المدنيّ في تشكيل النخب الأفريقيّة الجديدة.
على نحوٍ مُماثل، لم تفوّت القوى الصاعدة الفرصة هي الأخرى. فالصين مثلًا، لم تكتفِ بالمشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، بل زرعتْ معاهد كونفوشيوس في أديس أبابا وكمبالا، وتقدّم منحًا جامعيّة ضخمة، بما يجعل اللغة والثقافة الصينيّة حاضرة في الأفق الأفريقيّ. كما تمزج تركيا خطابها الدينيّ والتاريخيّ مع حضور جامعاتها ومنحها الدراسيّة، وتجذب الطلاب إلى إسطنبول وأنقرة. حتى دول الخليج، مثل قطر والإمارات، تستثمر في الإعلام والتعليم والدعم الماليّ، محاوِلة تكريس حضور جديد لهما في القارّة. وفي كلِّ هذا المشهد، يتضح أنّ غياب القاهرة عن ساحات الثقافة والفكر الأفريقيين يفتح أبواب الفراغ لمن يملؤه.
صراع الذاكرة والفراغ الجديد
مع توسُّع المدارك، وتجاوزنا قراءة إغلاق الجمعية الأفريقيّة بالقاهرة من زاوية محليّة، يمكن أن نستدعي استحضار أدوات التحليل النظريّ التي صاغها مفكّرون معاصرون لتداعيات الإغلاق. فوفقًا لمفهوم القوة الناعمة عند جوزيف ناي، فإنّ النفوذ الحقيقيّ لا يقوم فقط على السلاح أو الاقتصاد، بل على القدرة في تشكيل التفضيلات والخيارات من خلال الثقافة والقيم والرموز. ومن هذه الحيثيّة كانت الجمعيّة أحد أعمدة القوة الناعمة المصريّة في أفريقيا، إذ جعلت القاهرة مركزًا جاذبًا للنخب الطلابيّة والسياسيّة، وأنتجت سرديّات بديلة للاستعمار. فقد أوضح بنديكت أندرسون، في كتابه الشهير عن الهويّة المتخيلة كيف أنّ الأمم تُبنى عبر فضاءات تخيّل مشتركة من خلال الصحافة واللغة والمؤسسات. ولعبت الجمعيّة المصريّة هذا الدور بامتياز، إذ أتاحت للأفارقة من مشاربٍ مختلفةٍ أن يتصوروا أنفسهم جماعة سياسيّة واحدة تتجاوز حدود الاستعمار. ومن زاوية موريس هالبواكس، فإن الذاكرة الجمعية (collective memory) لا تعيش بمعزلٍ عن مؤسّسات تحفظها وتنقلها بين الأجيال، ومحو الجمعيّة يعني عمليًّا محو أحد أوعية هذه الذاكرة، وهو ما قد يؤدي إلى انقطاع السلسلة التي كانت تربط جيل المناضلين في الخمسينيات والستينيات بجيل الشباب الأفريقيّ اليوم. والنتيجة، أنّ الفراغ الناشئ لن يُفقد مصر رصيدها الرمزيّ فحسب، بل سيضعف أيضًا قدرة القارة على استعادة قصصها الخاصّة كجزءٍ من مشروعٍ جنوبي–جنوبي مستقل.
لذلك، إنّ النظر النقدي إلى هذا الإغلاق يقودنا إلى فهم أنّ القرار ليس فقط إداريًّا، بقدر ما هو انعكاس لتحوّلات أعمق في بنية القوة الناعمة المصريّة. وفي عالم اليوم، القوة الناعمة ليست ترفًا، بل هي شرطٌ لبناء نفوذ ثقافيّ طويل المدى. ومصر حين فقدت الجمعيّة، فقدت معها إحدى أهمّ أدواتها الرمزيّة في القارة. فغنيٌّ عن البيان أنّ التعاون الفكري ّبين شعوب الجنوب يحتاج إلى فضاءاتٍ تتجاوز الاقتصاد والسياسة الأمنيّة، لأنّه من دون الثقافة والفكر والذاكرة المشتركة، يتحوّل الجنوب إلى مجرّد “سوق” مفتوح أمام الآخرين، لا إلى فاعلٍ مستقلّ في النظام الدولي.
ومن هنا تكمُن الخاتمة المؤلمة في أنّ خسارة الجمعيّة صحيحٌ هي خسارة أرشيف، لكنّها أيضًا خسارة ذاكرة كاملة من التعاون الجنوبيّ–الجنوبيّ. ذاكرة كانت تحمل قصص مانديلا وسوبوكوي، كابرال ونيتو، ميشيل ونكومو، وآلاف الطلاب الأفارقة الذين تعلّموا في القاهرة ووجدوا فيها بيتًا ثانيًا. ومع الإغلاق، يظلّ السؤال مفتوحًا: هل يمكن لمصر وشمال أفريقيا أن يستعيدا هذا الدور، أم أنّ الفضاء الفكريّ والثقافيّ للقارة سيُعاد تشكيله في باريس، واشنطن، أو حتى دلهي الهنديّة التي دخلت القارة -راهنًا- بقوة ثقافيّة؟ الإجابة ستحدّد ليس فقط مكانة مصر، بل أيضًا قدرة الجنوب على صياغة مشروعه الفكريّ والسياسيّ المستقلّ في عالم تتسابق فيه القوى على الذاكرة بقدر ما تتسابق على الأسواق.