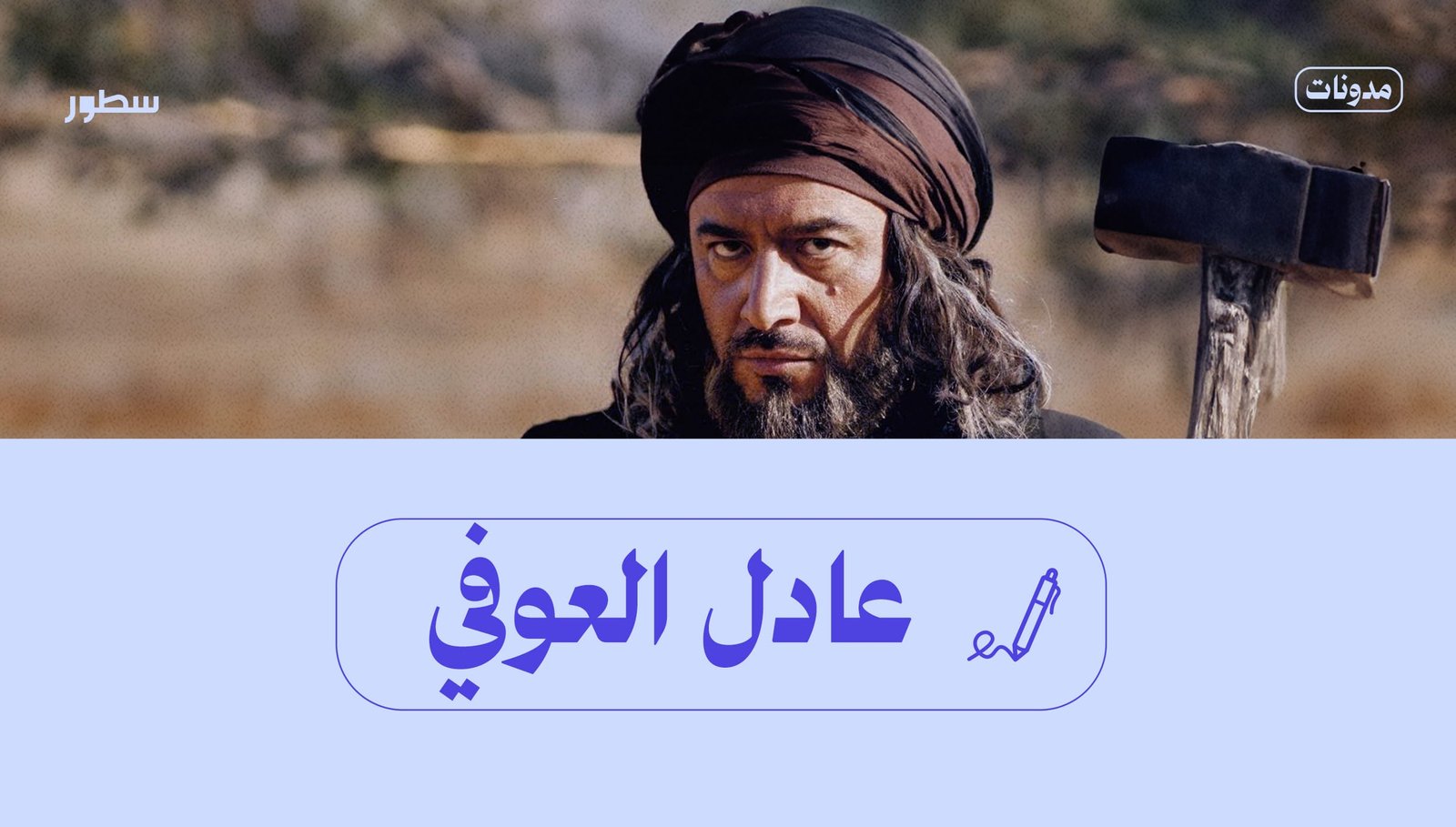مدونات
ليست سيوفًا ولا صواريخ… لماذا أصبح الإعلام أخطر الحروب الحديثة؟
ليست سيوفًا ولا صواريخ… لماذا أصبح الإعلام أخطر الحروب الحديثة؟
للكاتبة: كوثر قلقازي
بخوذة فوق الرأس ودرع يحمي الصدر، يد تحمل مايكروفونًا وأخرى ترتعد من شدة الوهن، وجسد ثابت أمام كاميرا وصوت قوي بلغة فصيحة. هذا الجسد وإن كان كالجبل شامخًا، إلا أن القصف والدمار أنهكه وشعث روحه. هكذا يقضي الصحفي يومه في بؤر الحرب، ينقل الحقائق ويروي القصص ويحمل المعاناة، لا يكل ولا يمل، يحمل المهمة كأنما يحمل سلاحًا، ويقص الخبر قبل أن يسقط بقذيفة أو رصاصة، فيصبح هو الخبر.
تشريح القوة الناعمة: الإطار النظري للحرب الإعلامية الحديثة
في يومنا هذا، تعدى مفهوم القوة ما يتعارف عليه من هيمنة صلبة في العلاقات الدولية (القوة السياسية، الاقتصادية، العسكرية…) بل امتد ليشمل ما يطلق عليه “القوة الناعمة” التي تتمركز أساسًا حول القدرة على الجذب والإقناع بدل التهديد والإكراه، ويُعتبر الإعلام الأداة الأكثر فعالية في تطبيق هذه القوة.
يرى ماكومب وشاو من خلال نظرية “وضع الأجندة” أن وسائل الإعلام لا تخبرنا “كيف” نفكر، ولكنها تخبرنا “في ماذا” نفكر، وذلك من خلال قوتها غير المباشرة في تشكيل تصوراتنا للواقع والتحكم في أولويات النقاش وترتيب القضايا، بتوجيه الرأي العام نحو قضايا تخدم أهدافًا محددة.
وبينما تخبرنا نظرية وضع الأجندة “فيما نفكر”، تخبرنا نظرية “التأطير” كيف نفكر. فيقول غوفمان من خلال هذه النظرية إن وسائل الإعلام، بدل أن تنقل الحقائق فقط، تغلفها بإطار معين يوجه طريقة فهم المتلقي وتقييمه لها، الأمر الذي يؤثر على مشاعره اتجاهها، فتتحكم في أولويات النقاش العام وترتيب القضايا، ثم توجيه الرأي العام.
وتعتمد وسائل الإعلام كذلك على تكتيك خاص يسمى “حروب الجيل الرابع”، يعمد من خلالها إلى توجيه الحروب إلى معركة إرادات تجري في عقول السكان وعلى شاشات الهواتف والتلفزيون. النصر لا يُحدد بهزيمة العسكر في الميدان، بل بكسب التأييد الشعبي وتقويض شرعية الخصم، مما يجعل هذه الحروب طويلة، ومعقدة، ومكلفة جدًا للدول النظامية.
هندسة اللغة: السلاح الخفي في الحروب الإعلامية
ليست كل الأسلحة رصاصًا، وليست كل الإصابات قاتلة. فإن كان الرصاص يخترق الجسد فيسقطه صريعًا، فإن كلمات الصحفي تخترق العقل والوجدان وتسقط الحياد عن المتلقي.
كَرُقعة أحجار شطرنج، تحركها وسائل الإعلام بتلاعب الألفاظ والكلمات، وتحول اللغة إلى ساحة حرب خفية. يعيد الصحفي تعريف المصطلحات ويحملها دلالات عاطفية، يشوه صورة العدو ويبرر العدوان، فيصير – بين إعلامي غزة وإعلامي الاحتلال مثلًا – المقاوم إرهابيًا، والقصف العشوائي استهدافًا دقيقًا.
وتلطخ وسائل الإعلام اللغة باستخدام لغة تقنية محايدة لتغطية أفعال عنيفة وتجردها من جانبها الإنساني باستخدام عبارات مثل: تنظيف، عمليات، أضرار جانبية، وتصحيح المسار… وتمتد الهندسة اللغوية إلى بناء إطار ثنائي بسيط يقسم العالم إلى “خير” و”شر”، مما يعطل التفكير النقدي المعقد.
يكتمل هذا البناء عبر “التضليل الانفعالي” باستخدام شعارات عاطفية تحول الصراع إلى قضية وجودية. النتيجة النهائية هي تحويل اللغة من أداة للتواصل إلى سلاح للهيمنة الفكرية، حيث تصبح الكلمات قادرة على تبرير القتل وإضفاء الشرعية على العدوان.
إدارة الانتباه: معركة السيطرة على العقل الجمعي
في عصر التحول المعلوماتي، أصبح التحكم في انتباه الجمهور سلاحًا استراتيجيًا يقلب موازين الحروب الإعلامية. ويعتمد بذلك على مبدأ “الندرة الانتباهية” الذي يتجسد بتفسير السلوكيات التي نراها في العالم الرقمي اليوم. فهو يذكرنا بأننا لسنا مستخدمين مجانيين لهذه المنصات، بل نحن المنتج، حيث إن انتباهنا هو الذي يتم بيعه للمعلنين، حيث تتنافس الروايات على مساحة محدودة من وعي المشاهد.
فمن خلال وضع الأجندة، تتحكم وسائل الإعلام فيما يفكر الناس بدل كيف يفكرون، من خلال التركيز المكثف على قضايا محددة وتكرارها، بينما يتم تغييب قضايا أخرى من الخطاب الإعلامي.
ثم إن الفيض الإعلامي من المعلومات الهائلة التي نتعرض لها يوميًا، يجعل المشاهد يتشتت ذهنه ويغرق، مما يؤدي إلى إضعاف القدرة على التركيز على معلومة واحدة وقضية واحدة.
تتعمد وسائل الإعلام حجب بعض المعلومات والحقائق والوقائع عن قضية معينة، مستخدمة لهذا “التعتيم الإعلامي”، عبر إهمال تغطيتها أو دفنها في توقيتات غير مناسبة، كأن حدثًا كبيرًا لم يحدث قط.
تستغل هذه الآليات محدودية القدرة الانتباهية للإنسان، وتحول الإعلام من ناقل للحدث إلى مُصمم للواقع، حيث يصبح التحكم فيما نراه وما لا نراه أداة لتوجيه الرأي العام وصناعة القناعة.
إن أردنا إسقاط هذه النظريات على واقعنا الحالي، فالحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة خير مثال. في الحالة الأوكرانية نجحت الوسائل الغربية في تركيز الانتباه على “العدوان الروسي” و”المقاومة البطولية”، بينما في الحالة الفلسطينية، تم تحويل الانتباه بعيدًا عن جذور الصراع نحو تصنيفات “الإرهاب” و”الأضرار الجانبية”.
المقارنة الإعلامية: أوكرانيا وغزة نموذجان متعارضان
الحرب الأوكرانية والعدوان على غزة كشفا عن تناقض صارخ في الآلة الإعلامية العالمية، إذ برزت معايير مزدوجة في تغطية الصراعات وفقًا لهوية الضحية والجلاد.
فحسب الأزمة الأوكرانية، توحدت المصطلحات (غزو روسي، مقاومة أوكرانية بطولية…) في إجماع غربي غير مسبوق، حيث استخدمت وسائل الإعلام لغة عاطفية في محاولة منها لتأطير الأحداث وتوجيه فهم المتلقي من خلال التركيز مثلًا على معاناة المدنيين وشجاعة الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ثم أطلق نشطاء وإعلاميون حملات رقمية على مواقع التواصل في تضامن عالمي. وكان للولوج السهل للمراسلين الدوليين دور أساسي في التغطية لهذه الحرب على نطاق أوسع.
في أوكرانيا، كانت الرواية الأوكرانية (الضحية التي تدافع عن أوروبا) مسيطرة إلى حد كبير على الإعلام الغربي منذ اليوم الأول، مما أدى إلى إجماع غربي واسع ضد روسيا.
أما في غزة، فسيطرت الرواية الإسرائيلية على الإعلام الغربي في الأيام الأولى، ولكن المحتوى الذي أنتجه الصحفيون والمواطنون الغزاويون نجح بشكل غير مسبوق في كسر هذا الاحتكار الإعلامي وتغيير الرأي العام العالمي، خاصة الشباب.
إعلام الاحتلال يعتمد بدرجة أولى على لغة تبريرية لجرائمه في الحرب ضد غزة، واصفًا القصف الإسرائيلي بالضربات الدقيقة، واستهداف المدنيين أضرار جانبية حتمية في العمليات العسكرية. ثم يحاول التعتيم الممنهج للرواية في غزة.
هذا التعتيم لم يكن سياسيًا فقط، بل ماديًا كذلك بشكل صارخ. فيتعمد قطع الإنترنت والكهرباء، ويفرض حصارًا إعلاميًا بمنع الصحفيين من الدخول واستهدافهم (أنس الشريف، مريم أبو دقة، محمد سلامة…) ويقصف مباني تحتوي على وسائل إعلام (مثل قصف مبنى الجزيرة والأسوشيتد برس) ويتهم وسائل الإعلام المنحازة إلى الجانب الفلسطيني بمعاداة السامية.
في غزة، الصراع غير متماثل بشكل حاد بين جيش نظامي ومقاومة تعمل من أحد أكثر الأماكن كثافة سكانيًا وتحت حصار. هذا أنتج فجوة في القوة الإعلامية، حاول الفلسطينيون تعويضها بالمحتوى الرقمي. ولأول مرة بهذا الحجم، تستطيع قضية عربية كسر الهيمنة التقليدية للرواية الغربية عبر المحتوى الموثوق والمباشر القادم من أرض المعركة.
المقارنة بين الأزمتين الأوكرانية والغزاوية تثبت أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح طرفًا فاعلًا في الصراع، يحدد من الضحية ومن الجلاد، ومن يستحق التعاطف ومن يستحق الإدانة.