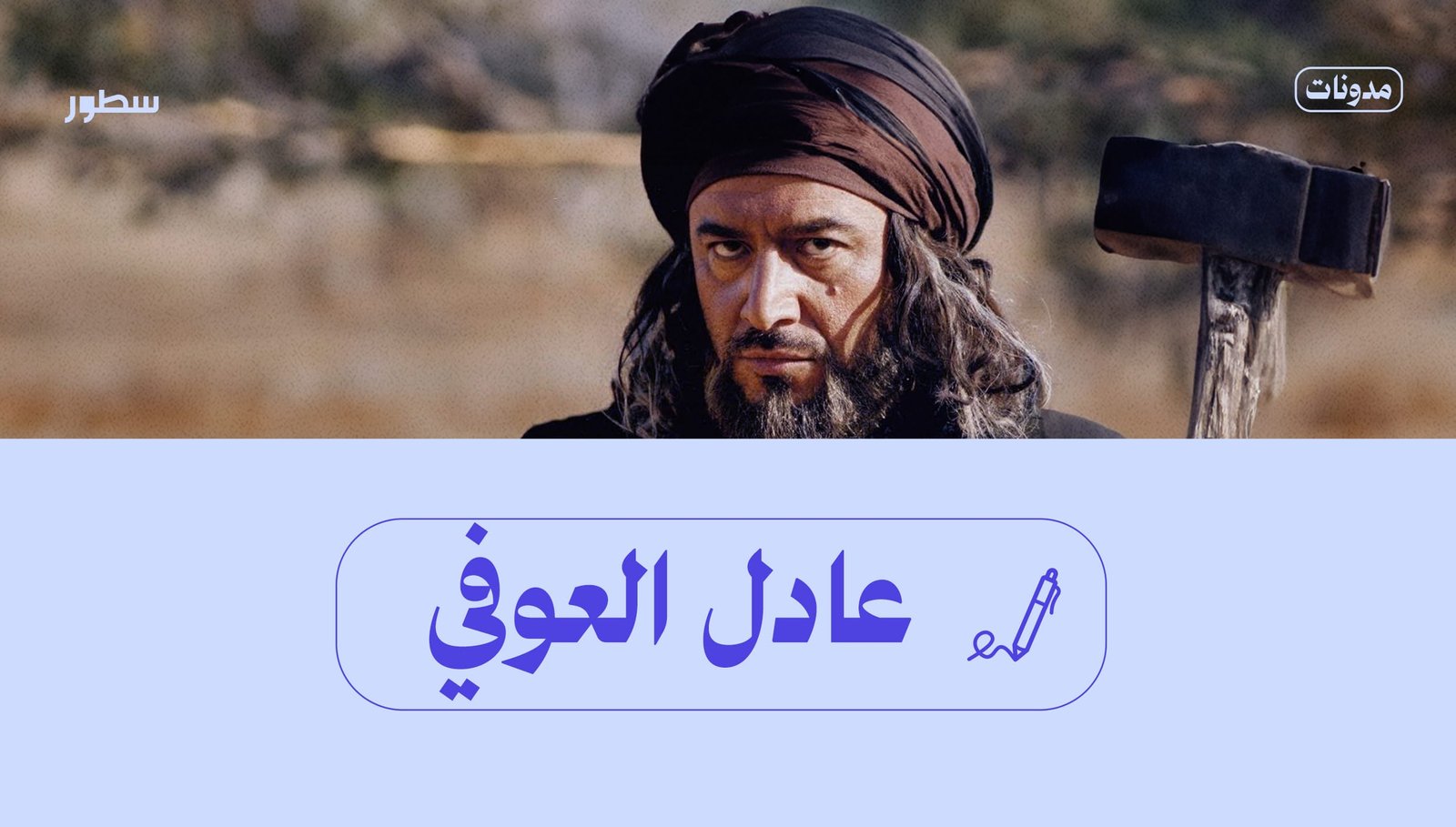مدونات
بحرٌ واحد… وشواطئُ كثيرة!
بحرٌ واحد… وشواطئُ كثيرة!
مقالة في التشابه عبر الاختلاف، ووظيفة المطلق، وسيرة العقل الجمعي
للكاتب: عمر عبد الوهاب الحازمي
يبدو السؤال بسيطًا وملغومًا معًا: إذا صار السعي إلى الاختلاف شعارًا عامًا، ألا يتحوّل إلى تشابهٍ من نوعٍ آخر؟ كأن العالم قاعة مرايا: كل وجهٍ يزعم فرادته، لكنه يتكرّر بزوايا مختلفة. هنا تولد أرثوذكسية الهرطقة: نمطٌ موحّد للمخالفة، ومعيارٌ صامتٌ لما يُعدّ «اختلافًا صحيحًا» وما يُقصى لأنه «اختلافٌ في غير موضعه».
ليس الأمر لعبًا لفظيًّا؛ إنه آلية اجتماعية متكرّرة. حين يعمّ «التفرّد»، يصبح هو المشترك. لا يتشابه الناس في المضامين، بل في منهج النظر والتلقي: «كن مختلفًا… هكذا بالضبط». وإذا كان هيراقليطس قد رأى أن التغيّر ثابت، فإن الاختلاف حين يُعمَّم يغدو ثابتًا منهجيًّا: ميزانًا تُوزن به الآراء، لا مضمونًا للأفكار.
من المظهر إلى المنهج
التجليات السطحية مفهومة: أزياء، مفردات، و«ستايلات» تتمرّد ثم تستقرّ كموضة. الأعمق هو ما يجري تحت الجلد: توحّد طريقة الوعي. السلطة الحديثة لا تحتاج دائمًا إلى المنع؛ أذكاها ما صنع القاعدة وأدار بواباتها. والسوق لا تلزمها المصادرة؛ يكفيها أن تسلّخ المعنى وتحيل الاختلاف إلى علامة قابلة للبيع: «كُن مختلفًا مثل الآخرين».
عندها يصبح شعار التحرر بطاقة دخول، ويصير التمرّد إطارًا مصنّعًا؛ يسع الجميع شريطة أن يظلّ الجميع داخله.
ذوقٌ مُمَوَّل ورأسمال رمزي
ليس كل اختلافٍ فضيلة؛ كثيرٌ منه رفاهيةٌ مُموّلة تُشترى كبطاقة امتياز. يتبدّل «الذوق» إلى رأسمال رمزي يفرز الطبقات بلغة أناقةٍ وتعالٍ؛ ساعةٌ لامعة، لكن عقاربها تتقدّم بخطى التمايُز الاجتماعي.
تدجين الطليعة
وما إن ينجح الجديد حتى يُخاط له بدلةٌ رسمية: يُحفظ في المتحف، يُدرَّس في الأكاديمية، فيغدو معيارًا. طليعة الأمس بروتوكول اليوم.
النفس… حيث تتكسر اليوتوبيات
كل مدينة فاضلة تُهزم عند العتبة النفسية. الإنسان ليس آلة عقلانية مستقرة، بل كائنٌ هشّ، متقلّب المزاج، محتاجٌ إلى الاعتراف، خائفٌ من العزلة، وسريع الملل من الحرية إذا لم تجد قيدًا معنويًا يبرّرها. لذلك تتعثر نسخ «السوق الحرّة للأفكار» حين تُعامل البشر كعقولٍ معزولة عن رغباتها وقلقها، وتتهاوى المدن المحكومة بالحكمة حين تُفصَّل أدوارها على مقاس «إنسانٍ مثالي» لا يعيش بيننا.
بين الانتماء والفرادة
النفس تطلب جرعةَ فرادةٍ تقيها الغرق، لا جرعةً تعزل حتى عن الموج. لهذا يتشابه المختلفون عند حدٍّ معيّن: كي لا يفقدوا دفءَ الانتماء.
ألعابٌ مضادّة للتنسيق
وما إن يحاول الجميع اختيار ما لا يختاره الآخرون حتى تبدأ لعبة المقاعد الشاغرة: المقعد الخالي يمتلئ بمن قصدوه لأنه خالٍ. اختلافٌ يُنتَج في دوراتٍ متوقَّعة. نيتشه لمح إلى أن قلةً فقط تحتمل سعة الحرية والاختلاف، وأن البقية ستعود—من خوفها—إلى «القطيع». كيركغارد وصف قلق الاختيار الذي يدفع المرء إلى الحضن الجماعي حتى وهو يعلن فردانيته. وعلى الضفة الأخرى، يكشف منطق الرغبة المحاكاتية أن حتى «التميّز» يُستعار غالبًا من نموذجٍ سابق: اختلافٌ ينبت من تقليد؛ وهكذا لا يفارق المختلفون ظلَّ سلفٍ ما، وإن خلعوا أزياءه.
المطلق والنسبية: قناعان يتبادلان الأدوار
على الأرض ينزل «المطلق» عبر قناتين عريضتين: مطلقٌ دينيّ يزوّد خرائطَ الخير والشر، ويغرسها كبوصلةٍ وجودية. مطلقٌ سلطويّ يصنع ثنائيات الطاعة والعقاب، الوطنية والخيانة، ويحوّلها ردود فعل شبه تلقائية. وظيفة الاثنين نفسية بقدر ما هي فكرية: تأمينٌ ضدّ دوار النسبية.
لا تُشيطن هذه الملاحظة معنى الإيمان ولا ضرورة السياسة؛ إنها تفكّك آلية الاشتغال: حين يجتمع احتكار المعنى مع احتكار القوة، يتألّه المطلق ويصير جهاز ضبطٍ شامل. وعلى الجهة المقابلة، تتألّه النسبية حين تُعلَن عقيدةً كاسحة: «لا مطلق» تتحوّل إلى مطلقٍ سلبي يدير الأحكام من الظلّ، ويسوّي بين الصدق والوهم باسم «الحياد».
هكذا يُبدَّل الشاطئ ويبقى البحر واحدًا: تتغيّر الأسماء، وتظلّ الأدوات.
العقل الجمعي: المنبوذ الذي يقود الجميع
يُلعَن «العقل الجمعي» في الخطابات، ويُستعمل في اليوميّات. اللغة التي يُنتقد بها، والرموز التي تُقاوَم بها، من صنعه. تقطع الجماعات أزياء القطيع الأول لتخيط قطيعًا بزيّ الانفلات: طقوس ومصطلحات وإشارات انتماء. من هنا تبدو مفارقة التشابه عبر الاختلاف ليست حادثًا عارضًا، بل نظام تشغيلٍ للعلاقات: حين يصير الاختلاف قاعدة جمعية، يتفرّق الناس مضمونيًا ويتوحّدون منهجيًا.
لقطاتٌ تاريخية لا لتزكية الماضي بل لفهم القانون
الإصلاح الديني فكّ احتكارًا كهنوتيًّا، فأنجب أرثوذكسياتٍ جديدة وحدودَ هرطقةٍ أخرى. تفكُّكُ مطلقٍ يولّد مطلقاتٍ بديلة إذا غابت الكوابح. الثورة الفرنسية رفعت «عبادة العقل» ثم فتحت باب «عهد الإرهاب» باسم الفضيلة نفسها؛ المطلق حين يتديّن بالعقل لا يقلّ خطرًا عن سواه. الثقافة المضادّة الستينية بشعار «السلام/الحب/الحرية» انتهى شطرٌ منها إلى صناعة اختلاف قابلة للتسويق؛ تمرّدٌ خرج من الشارع إلى الواجهة الإعلانية. الهدف ليس النوستالجيا ولا التبكيت؛ بل تثبيت قانون الحركة: تفكيك مطلقٍ بلا هندسة واعية لمصارف القوة يُنتج مطلقاتٍ بديلة بلبوسٍ أجمل.
اختلافٌ صالحٌ للخوارزمية
الخوارزمية لا تُحبُّ غرابةً لا تُقاس؛ تُحبُّ نسختها القياسية من الغرابة: ما يُشاهَد بسرعة، ما يُقتبس بلمح البصر، ما يُعاد إنتاجه بلا كلفة. هكذا تُوحِّد المنصّات نماذج «التفرّد»، فتمنح المختلفين قالبًا لافتًا للنظر… ومُعادًا.
ضدّ البرامج… ومع اليقظة
لا يحتاج هذا النص إلى «حلول». البرامج الخلاصية—حتى وقد صيغت باسم «إدارة الاختلاف»—تنقلب سريعًا إلى يوتوبيا بديلة. ما يلزم ليس مرفأً، بل حِرَفة ملاحة لا تدّعي إيقاف الموج: تسمية أدوات المطلق: ما لا يُسمّى يتألّه سرًّا؛ تسميةُ وسائط الضغط (القوانين، المناهج، الرقابات) تُعيد الفكرة من مقام القداسة إلى ساحة المساءلة. مراقبة تألّه النسبية: «لا مطلق» تتحوّل جهاز حكمٍ حين تتمأسس؛ الحياد الزائد قناعٌ يتصرّف من وراء ستار. كشف نزعة المحاكاة: اختلافٌ لا يرى مرجعَه يعيد إنتاج قطيعٍ جديد باسم الفرادة؛ والاختلاف الذي لا يدفع ثمنًا معلومًا، يبقى شعارًا مجانيًا على قميصٍ باهظ. بناء ما يمكن تفكيكه: ترتيبٌ لا يحمل مفاتيح هدمه تمثالٌ في الطريق؛ الكوابح تأجيلٌ للعطب لا وعدَ خلاص. الحذر من بلاغة المُسكّن: الشاعرية تُنير حين تكشف، وتخدّر حين تُجمّل القسوة تحت لافتة «حكمة التأرجح». هذه «اللاءات» ليست وصفة، بل علامات خطر على الشاطئ، حتى لا يتخفّى التيار في هيئة خلاص.
خاتمة لا تُغلق الباب
يتشابه المختلفون حين يصبح الاختلاف قاعدةً عامة؛ يتفرّقون في القول ويتّحدون في المنهج. لا يُعاش المطلق بلا قسر، ولا تُعاش النسبية بلا أقنعة. والإنسان، مهما أعلنت خطاباتُه، لا يبرح يتأرجح بين الاعتراف والصراع، بين التسليم والتمرّد؛ لا يملك خيار الخلاص النهائي، بل يملك أشكال مقاومته وتسليمه.
يبقى تحذيران في الحاشية لا في المتن: مفارقة التسامح تقول إن قبول كلّ اختلافٍ يذبل إذا شمل من يرفض مبدأ القبول أصلًا؛ تُستقبل البذرة التي تكره معنى الحديقة فتأكل الحديقة. وقانون غودهارت يذكّر أن ما إن صار «الاختلاف» مقياسًا معلنًا حتى يفسد كمؤشّر: يُنتَج ما يُقاس، لا ما يصدق.
البحر واحد. تتبدّل الشواطئ، تتغيّر أسماء الريح، وتبقى الحِرَفةُ هي الفارق بين الغرق والطفو. ليس المقصود نزع المعنى ولا بثّ العدمية؛ المقصود يقظةٌ لا تبيع عزاءً رخيصًا ولا تعدُ ببرٍّ لن يُرى. وإذا كان لا بدّ من جملةٍ تُذكِّر ولا تُخدِّر: فلْيُدار الاختلاف كي لا يصبح قناعًا جديدًا للقطيع، ولْتُكشَف المطلقات كي لا تتألّه في العتمة. هكذا فقط يستردّ الفكر حقّه: لا ليُنقِذ، بل ليُضيء الطريق من غير أن ينصب على حوافه تماثيل للنجاة.