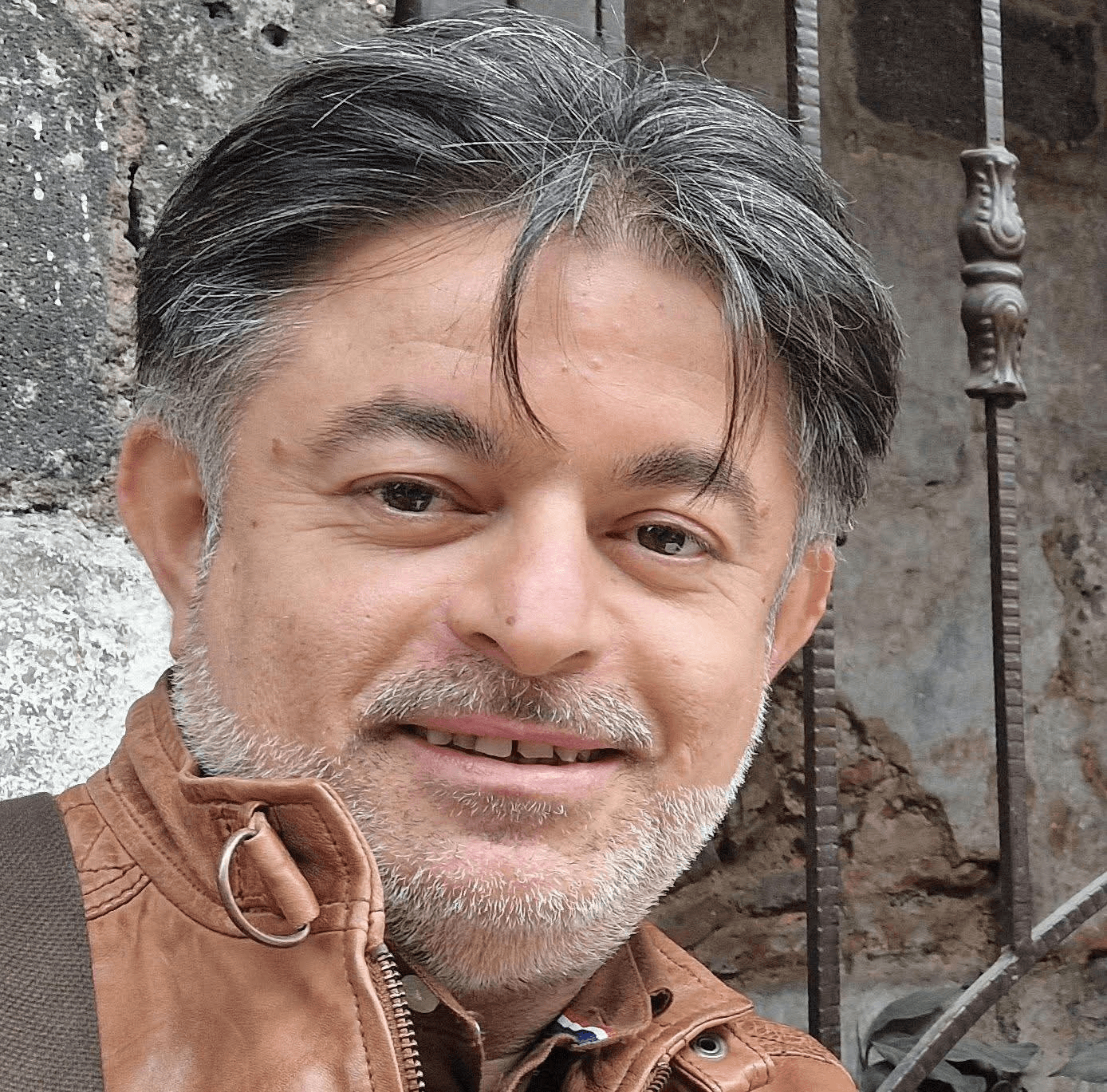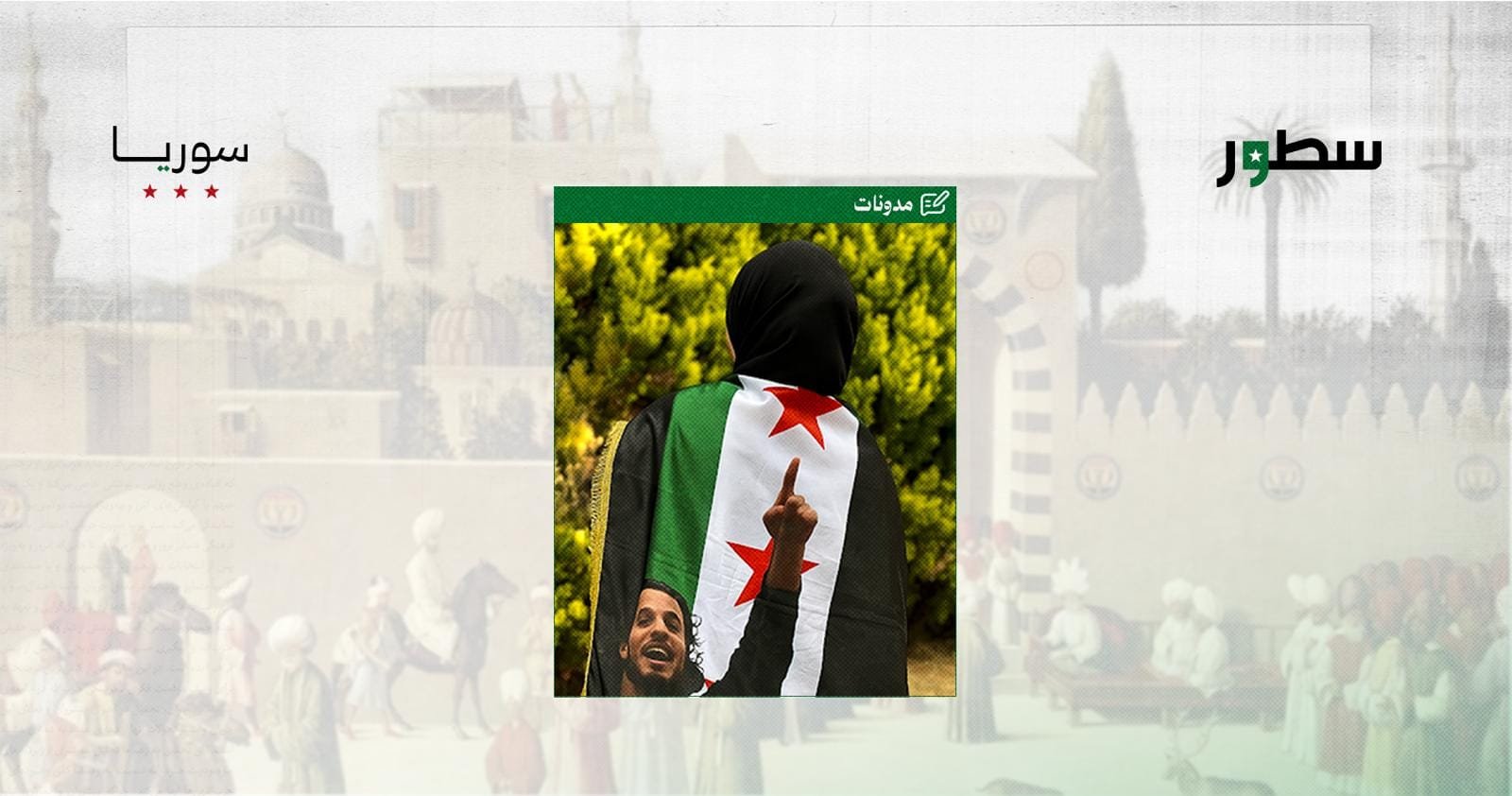مشاركات سوريا
بين غربتين: حكاية الزمن المفقود
بين غربتين: حكاية الزمن المفقود
في آذار/ مارس 2013، اجتاحت مدينة الرقة موجة من الأمل، بعد معركة فرضتها فصائل إسلامية وكتائب الجيش الحر، حيث هُزمت فيها قوات النظام البائد، وانسحبت من المدينة تجر ذيول الخيبة. بدت تلك اللحظة بداية حياة جديدة. صارت الرقة تزهو حرة بلا دكتاتور، وبدأنا نلتقي في ساحاتها العامة، نتحاور حول مشاريع لإعمارها بأيدينا، عن مدارس خالية من الشعارات الحزبية، وعن إعلام حر يروي قصتنا نحن، لا يملي علينا رواياته.
تحولت ساحات المدينة إلى فضاءات يعمها النشاط والفرح، كأنها استعادت أنفاسها بعد طول اختناق. نظفنا الشوارع من الركام ومخلّفات الدمار الذي تركته مقاتلات نظام الأسد، وأطلقنا حملات توعية للشباب عن قيم المواطنة والتعاون. تشكلت مجالس محلية منتخبة، وبدأت منظمات المجتمع المدني عملها، مثل زهور برية نمت في قفر. انطوى العمل على تنظيم المبادرات، توزيع المساعدات، وافتتاح ورش العمل للنساء والشباب. تحولت المدينة إلى ورشة بناء كبيرة. لا يعلو فيها صوت إلا صوت الحلم بالمستقبل.
لم تصمد الأحلام إلا 10 أشهر تقريباً. في السادس من كانون الثاني/ يناير 2014، سيطر تنظيم “داعش” على الرقة. خيم السواد الذي جلبوه على المدينة، التي سقطت وكأنها تعرضت لحادث سير مروّع في لحظة خاطفة. تسللت رائحة الدم إلى الشوارع، معلنةً بداية زمن آخر، زمن أدارت فيه الأحلام ظهرها لنا. وقع الأمر عليّ مثل زلزال شق وجه الأرض.
بعد 21 يوماً غادرت المدينة، هذه المرة مرغماً مسافراً. يعلق صديقي خلف الملا على اللحظة، المهجَّر هو الآخر من المدينة، بلهجتنا الفراتية: “إحنا ما طلعنا سياحة، إحنا طلعنا محيودين (مطرودين) من داعش.” لم يكن ذلك اليوم مجرد تاريخ عابر، بل لحظة انكسار كبرى في حياتي، وكأنني شجرة اقتلعت من جذورها. لم يكن الرحيل عن المدينة فحسب، بل كان رحيل الروح عن الجسد. فارقتني الأحلام واستوطنت نفسي موحشات الغربة.
لم يكن دخولي إلى تركيا سهلاً، فقد عبرت الحدود خلسة في جنح الظلام عبر اتفاق مع مهرّب. تسللت مع مجموعة كبيرة من منطقة “الراعي”، عبر وادٍ عميق يتبعه جدار مرتفع، وكل ذلك تحت تهديد مراقبة حرس الحدود أو ما يُعرف بـ “الجندرمة” التركية. كانت ليلة محفوفة بالخطر، ينبض قلبي مع وقع خطواتنا الحذرة، وكان كل صوت في العتمة إنذاراً بكشف أمرنا.
كانت وجهتي الأولى مدينة غازي عنتاب التركية. وكان اختيارها على عجل، فلم أكن حينها أملك رفاهية الاختيار. لكن أملاً هشّاً بالعودة ظل يرافقني. كانت الأشهر الثمانية التي قضيتها هناك كفيلة بقتل تلك الآمال. هناك ذابت تلك الآمال وسط يوميات قاسية: غلاء المعيشة وضيق الحال، وانشغالي بتأمين لقمة العيش عن هواجس العودة.
أسير بلا هدف، مستنزفًا، وجيوبي يملؤها الضجر، وصار المستقبل محض فكرة محبطة. خففت صحبة أبناء مدينتي ورفاق النضال ثِقل الغربة عني، وكذلك رفقة كثيرين من محافظات سورية أخرى. كلنا مقيدون بالحنين إلى مدننا وأهلنا، التي بدا أن العودة إليها محض وهم.
وسط هذا كله، ومع ضغط الأصدقاء الذين ألحّوا عليّ للخروج من حالة الركود، اتخذت قراراً جريئاً: ركوب قوارب الموت نحو اليونان، رحلة محفوفة بالمخاطر، لا أحد منا يعرف ما هي النهاية، النجاة أو الغرق. لم تغب عن ذهني صورة صديقي محمود الشنان الذي حاول إقناعي بكل الوسائل لأرافقه، خططنا أن نعبر معاً، لكن الظروف المالية حالت دون ذلك. فابتلعه البحر ولم يرحمه؛ ابتلعه في رحلة الموت التي لم نعرف تفاصيلها، وكانت خسارته صدمة عميقة تركت في قلبي جرحاً لا يُمحى. وزاد يقيني بمرارة المخاطر التي تنتظرني.
حين اقترب الموعد، كان القارب المطاطي “البلم” ينتظرنا، ساكناً كأنه يعرف أننا على وشك أن نضع حياتنا بين يديه. مضيت مع مجموعة صغيرة نحو نقطة الانطلاق، وهناك وجدنا وجوهاً متعبة، أغلبها لنساء وأطفال سوريين، يضمّون قلوبهم إلى صدورهم كأنها الشيء الوحيد الذي بقي لهم. تحرّك القارب نحو ضوء بعيد في الجهة المقابلة، ضوء بدا للوهلة الأولى قريباً، يخال لك أنك تستطيع لمسه. قطعنا نصف الطريق، لكن المسافة اتسعت فجأة، وكأن البحر تمدد وابتلع المسافة. توقفنا، ثم عدنا من حيث أتينا، نحمل في صدورنا شعور الخسارة قبل أن نبلغ الشاطئ الآخر. كانت المحاولة الأخرى عبر قارب سريع، لا يقف لمن قد يسقط منه. كان الموج يصفع القارب بعنف، يرفعه عالياً ثم يلقيه إلى الأسفل، وكان قلبي يوشك أن يخلع صدري ويهرب مع كل ارتطام. حين وصلنا أخيراً إلى جزيرة “ساموس” اليونانية، أُغلق علينا باب موقع عسكري، 18 يوماً من الانتظار، كانت تمر بطيئة، وكأن الزمن هناك كان يتعمد أن يجرّنا على مهل. ظل البحر يطاردنا فيها حتى ونحن على اليابسة.
لم تكن رحلة اللجوء سيراً على الأقدام أقل خطورة من قوارب الموت. ففي غابات مقدونيا وصربيا الواسعة، التي تشبه محيطًا لا نهاية له، ترافقك هواجس الضياع. تجد نفسك لوهلة وسط الغابة وحيداً، وكأنك في نهاية العالم. نمشي في الظلام الدامس، وفي النهار نختبئ بين الأشجار. أكثر من 100 شخص، معظمهم من السوريين. كنا نسير لساعات طويلة بلا توقف تحت سماء تمطر برداً وقسوة. وكان علينا أن نتبع “الريبر”، ذلك الدليل الذي لم يكن إلا ظلاً قاتماً يسير أمامنا، لا بد أن نلازمه، فبدونه مصيرنا الضياع في تلك المتاهة الخضراء. مع كل خطوة، كان الجوع ينهش أجسادنا، والبرد يتسلل إلى العظام، تحولت الغابة إلى خصم لا يرحم، تختبر قوة صبرنا وتحملنا حتى نقطة النهاية، نقطة نأمل أن تكون بداية للحياة الجديدة التي نسعى إليها.
من هناك وصلت إلى هولندا، “أجمل بلاد الله” أو “جنة الله على الأرض”، كما يصفها كثيرون، بلاد تبدو كأنها مرسومة على برامج الفوتوشوب، بدقة لا تشوبها شائبة. هنا تتناغم البيوت بألوانها الزاهية مع قنوات الماء التي تتلألأ تحت أشعة الشمس، فيما تمتد الحقول الخضراء بلا نهاية، تتمايل أزهارها على إيقاع نسيم رقيق يعانق السماء. كل شيء يبدو أشبه بلوحة فنية حيّة، بريشة الفنان فان كوخ، أحد أبرز رموز الفن التشكيلي في هولندا في القرن التاسع عشر.
لا مكان فيه للفوضى أو التشويه، كل شيء في مكانه، بل انسجام تام بين الطبيعة والبشر، وبين الماضي والحاضر. هولندا ليست فقط جمالاً طبيعياً ساحراً، بل هي أيضاً دولة القانون والحريات. هنا، يُضمن لكل فرد حق التعبير عن رأيه دون خوف أو قيد، وتُحترم الحريات الشخصية والدينية والاجتماعية. يمكنك أن تشعر بعمق هذا الشعور بالحرية في الهواء نفسه، حيث تتحرك بلا قيود، وتتحدث بصراحة، وتعيش بكرامة. هنا، الحرية ليست شعاراً يُرفع، بل واقعاً ملموساً يُعاش يومياً بتفاصيله.
لكن رغم هذا السحر، بقيت أنا غريباً في هذا المكان. لم أكن ابناً له، ولا جزءاً من إيقاعها المتناغم. أتنفس هواءها، وأرى جمالها بعيني، لكنني لا أستنشق إحساس الانتماء الذي يجعل من الأرض وطناً. بقيت على الهامش، على هامش كل شيء تقريباً، ضيفاً لا يعلم متى ستنتهي إقامته، يبحث عن شيء يتجاوز فيه هذا التشظي وهذا التخبط.
عدت أخيراً إلى الرقة، كنت أحمل في حقيبتي الصغيرة حلماً كبيراً بالعودة، لكنني وجدت واقعاً مختلفاً تماماً. لم تكن مدينتي كما تركتها، وجدت أن الزمن قد تجاوزني، وكأن حياتي انقطعت عند لحظة الرحيل لتستأنف فجأة في مكان تغير كثيراً، شعرت بأني فقدت حلقة من سلسلة عمري لا يمكن استعادتها. لم أعد أنتمي هنا ولا هناك، فتشظت هويتي بين غربتين، غمرني حنين مخلوط بالخذلان، وحزن صامت على ذاتي التي لم تجد مأواها، فلا أنا عشت كما أردت، ولا عدت كما كنت. فأدركت أن ما أصابني مزمن لا شفاء منه.
كان في استقبالي ابن عمي “أبو فيصل”، صديق الطفولة وأيام الصبا، الذي كان له الفضل الكبير في تخفيف هول الصدمة، ومشاطرتي ثِقل المشهد الذي واجهناه معاً. لكن المفارقة كانت هنا، إذ بدأت الغربة تتسلل إلى أعماقه أيضاً، رغم أنه لم يغادر المكان يوماً.
منذ أن نزلنا في محطة الحافلات، بدت المدينة كأنها تحاول أن تخفي وجهها الحقيقي. في الطريق إلى حي المشلب، الحي الذي نشأت فيه وعشت، لم أعرفه. لم يكن ذلك الحي الذي احتضن طفولتي وأحلامي، أصبح غريباً، وكأني أزوره للمرة الأولى. بدا الهواء أثقل، وكأنه يحمل عبء كل ما حدث من خراب، كان الحي مشوّهاً حيث تصدعت جدرانه وأهملت أرصفته، وفقد بريقه، رغم أنه كان أجمل أحياء مدينة الرقة على الإطلاق. كانت “الدكاكين” مغلقة، إلا من بائع دخان يجلس على كرسي معدني صدئ، يراقب العابرين بنصف عين، وكأن المدينة تنظر إلينا بلا شغف أو ترحيب.
لم تكن العودة تشبه ما كانت تنقله الصور التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حين يُصوَّر اللاجئون وهم يعودون وسط أهازيج وورود. لم يكن والدي ووالدتي في استقبالي كما تمنيت، ولا كانت هناك حفاوة تُذكر. كل ما كان هناك… أبواب مغلّقة، جدران رمادية فقدت لونها مع الزمن، وصمت ثقيل يخيم على الأجواء، يختلط برائحة الغبار التي لا تفارق المكان.
لم أجد الرقة كما تمنيت، أو كما كان يروّج لها موالو “قسد” في منشوراتهم الملوّنة. وجدتها مثقلة بالهموم، شاحبة الملامح، طرقها كما لو أنها لم تُجدَّد منذ عقود، وأبنيتها يكسوها اللون الرمادي من دخان عوادم السيارات التي تتزود بوقود مكرّر محلياً. زرت كل الأماكن التي كانت مألوفة قبل الرحيل: المقهى الذي اعتدت ارتياده، بيوت أصدقائي التي مررت بها من الخارج فقط، لأني أعلم ألا أحد فيها.. كلهم رحلوا. حتى المطاعم الشعبية التي كنت أرتادها، أصبحت شبه خاوية. وقفت أمام سور الرقة المتهالك، باب بغداد العتيق الذي بدا هو الآخر وكأنه يتهيأ للرحيل، والمسجد القديم الذي حمل يوماً أصوات المصلين، ولم يبقَ فيه الآن سوى صدى الغياب.
وسط هذا الخراب، وجدت البيت كما تركته، وكأن الزمن لم يدخله أو يمر عليه منذ تركته. الستائر نفسها، شجرة الزيتون الوحيدة في برهة البيت، الأبواب، لون الوسائد، الجدران، صورتي المعلّقة على جدار غرفتي، حتى الرصيف أمام البيت على حاله. كل هذه التفاصيل واجهتني وكأنها تتهمني بالغياب، وتعيد إلى صدري ثِقل السنوات التي قضيتها بعيداً.
دخلت باب البيت ببطء وحذر شديد، كأنني أخشى أن أوقظ أحداً من نومه، أو أن أوقظ ذكريات لا أريد مواجهتها. صمت ثقيل ملأ المكان، صمت ليس كأي صمت، يثقل القلب والروح معاً. لم يكن هناك صوت أمي في المطبخ، ولا وقع خطوات أبي في الممر. غابت الوجوه التي كانت تسكن تفاصيل حياتي، صار البيت الذي اعتدت أن أجد فيه دفء الحياة فجأة مكاناً بارداً لا ينبض إلا بذكرياته المثقلة بالألم.
أمي، التي كانت بالنسبة لي معنى الوجود وأمل العودة، غادرت بعد مرارة الأيام التي قضتها تنتظر رجوعي بلا جدوى. تركت المكان محملاً بصمتها الحزين، كأنها رحلت تاركة وراءها جزءاً من روحي مع كل زاوية في البيت. وأبي، الذي كنت أمني نفسي باحتضانه أولاً، رحل بصمت، دون وداع، رحل دون أن أكون هناك لأمسك بيده في لحظة الرحيل.
يا لها من وحشة… شعرت وكأنني مكبَّل، كأن شيئاً ما يقيدني في مكاني. كنت أخشى هذه المواجهة منذ اللحظة التي قررت فيها العودة. أمي، التي لطالما خشيت عليّ من الرجوع إلى الرقة خوفاً من تنظيم داعش، كانت تلتقي بكل أصدقائي حين كانوا يزورونني في البيت. التقت مع إبراهيم الغازي، الذي خطفه التنظيم عند خروجه من أحد مقاهي الرقة، ومع مهند حاج عبيد، الذي كنا نناديه “مهند حبايبنا” نسبة إلى مجموعة محلات “حبيبنا” الشهيرة.
كانت أمي تقول لي دائماً عبر مكالمات الفيديو: “المهم إنك بخير يا ابني، حتى ولو كنت بعيد عني”. كم كانت تؤلمني هذه العبارة… كنت أبتسم أمامها كي لا أزيد وجعها، لكنني في داخلي كنت ألوم نفسي وأعاتبها، لماذا تركت أمي وحيدة؟ هي التي ضحت وصبرت من أجل ابنها الوحيد، وعندما احتاجت وجودي إلى جانبها لم تجدني.
في تلك الليلة، حين انفضّ الناس من حولي واحداً واحداً، وتركوني وحيداً في الغرفة التي كنت معتاداً أن أنام وأحلم فيها، انتابني شعور غريب بالخذلان العميق. لوهلة، بدا لي أن سقف الغرفة قد انهار فوق رأسي، وكأن العالم كله ضاق بي فجأة. ارتبكت أفكاري، واحتدمت ذكرياتي، وتدفق زخم الصور المؤلمة من الماضي، جاعلاً رأسي مشوشاً لا يستطيع أن يستوعب الواقع المرير.
كأن الوحدة تتغلغل في أعماقي، تلك الوحشة التي تملأ الفضاء الفارغ، فتشعر وكأنها شخص آخر يصارعك في داخلك، وحش لا يرحم. فراغ لا يكاد يُطاق. كل لحظة تمر، تزداد ثقلاً، ويزيد معها شعور الغربة حتى داخل غرفتي الخاصة. في تلك اللحظة، لم أكن وحدي مع نفسي فقط، بل مع ألم لا يُقال، مع صمت لا يُقهر، ومع حزن يتسلل إلى أعماقي كلص لا يهاب شيئا.
إلى جانب فقداني أمي وخسارتي الكبيرة التي لا تُعوَّض، أُضيف خسارتي الأكبر بوالدي، الذي كنت أستند عليه في كربتي. كان هو صخرتي وسط العاصفة، عزائي الأخير حين انهار كل شيء حولي، وفقدانه تركني في عمق وحشة لا تُحتمل، حيث يصبح الألم ثقيلاً، ويغدو الحزن بحراً لا ساحل له. لقد كان وجوده نوراً يضيء لي الطريق في ليالي اليأس، وفقدانه جعلني أمشي وحيداً في ظلام لا ينتهي.
فقط في تلك اللحظة، أدركت أن الغربة لم تكن محصورة في المدن أو الأماكن البعيدة وحدها، بل تسللت بهدوء لكنها بلا رحمة إلى بيتي الأول، إلى مكان كان من المفترض أن يكون ملجئي الأخير. وجوه اعتدت رؤيتها تغيّرت، وأماكن طالها الإهمال اندثرت، ونشأت أماكن جديدة لا أعرفها ولا أستطيع أن أنتمي إليها.
بدا المشهد أمامي غريباً ومبتوراً، كما لو أن حياتي توقفت تماماً يوم رحيلي، ثم استؤنفت فجأة، لكن في عالم آخر لا يشبه ذلك الذي تركته خلفي. تشظّت هويتي بين غربتين لا ملجأ لهما؛ غربتي في وطن لم يعد كما كان، وقد صار يتناثر بين أنقاض وجراح عميقة، وغربتي في بلاد لم تتحول بعد إلى وطني، حيث الأمل فيها يتخبط بين البحث عن انتماء ضاع وعودة لا تتحقق.