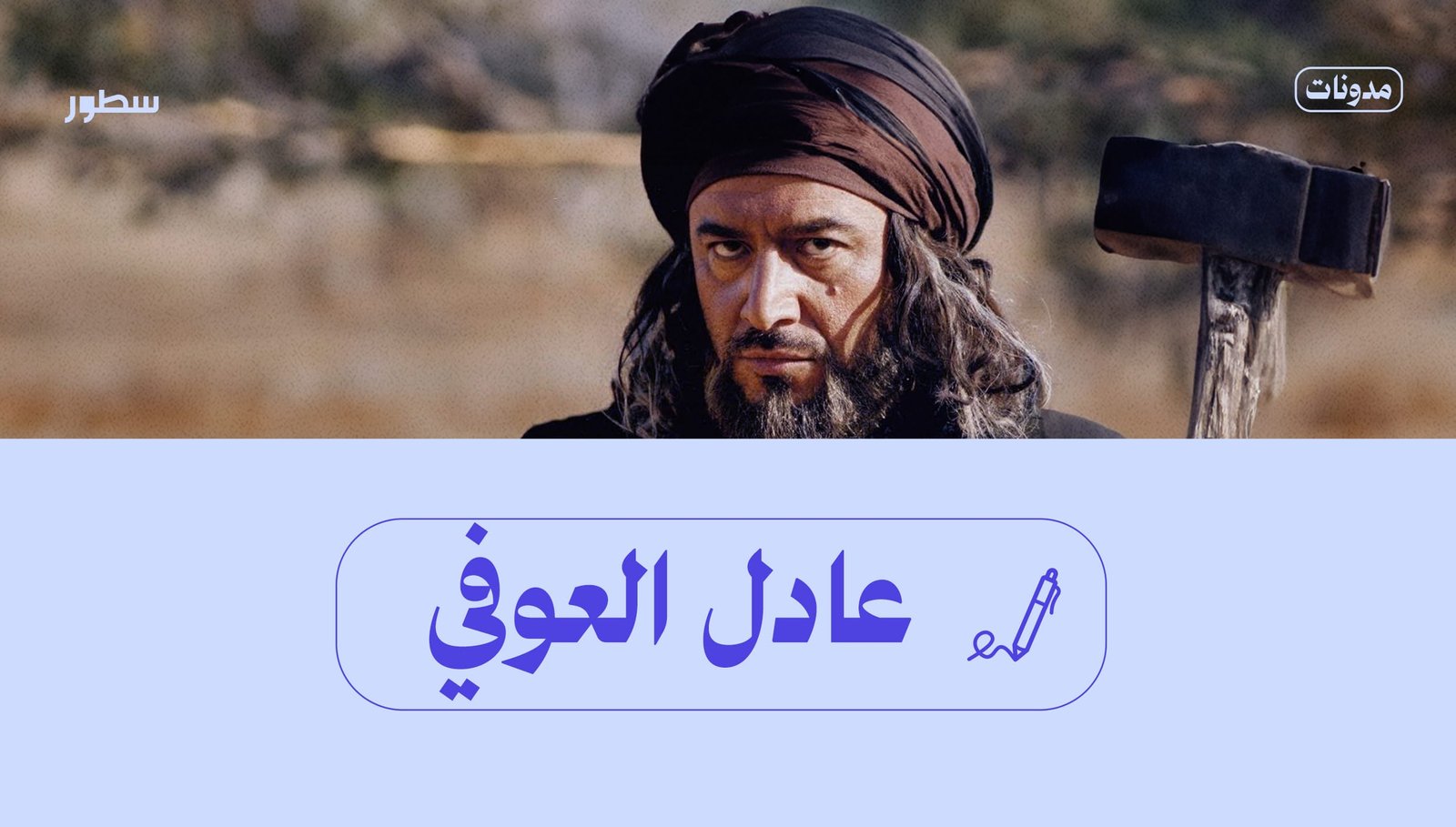مدونات
حرب القانون: السلاح الصامت لتدمير الأمم من الداخل!
حرب القانون: السلاح الصامت لتدمير الأمم من الداخل!
للكاتب: عبد الله النعمة
عندما يتحول المعبد إلى ساحة قتال في ضمير كل حضارة، تمثل قاعة المحكمة مكانًا مقدسًا. إنها المعبد الذي يُفترض أن تُحتَرَم فيه الحقيقة، وتُصان فيه الحقوق، وتُحل فيه النزاعات سلميًا. القانون هو الميثاق الذي يحول التجمعات البشرية من قطعان متناحرة إلى مجتمعات منظمة. لكن ماذا يحدث عندما يُدنس هذا المعبد؟ وماذا يحدث عندما يتحول الميثاق نفسه إلى سلاح، ويصبح القضاة والمحامون جنودًا في حرب أهلية باردة؟
نحن نشهد اليوم، بوتيرة متسارعة ومقلقة، هذا التحول الكارثي. الظاهرة المعروفة استراتيجيًا بـ “حرب القانون” (Lawfare) — أي استخدام الأدوات القانونية كسلاح لتحقيق أهداف سياسية وثقافية — لم تعد مجرد تكتيك هامشي، بل أصبحت استراتيجية مركزية في الصراعات الداخلية التي تعصف بالغرب. إنها ليست مجرد علامة على الاستقطاب، بل هي نذير بتفكك أعمق، وعَرَضٌ لمرض وجودي يهدد بتدمير أسس العقد الاجتماعي.
تسارع هذه الظاهرة ليس صدفة، بل هو النتيجة الحتمية لـ “الطوفان الثقافي” الذي أعاد تشكيل الولاءات وفكك الثقة المشتركة، ممهدًا الطريق أمام أخطر أسلحة الدمار الداخلي.
الأرضية الفكرية: لماذا انضم الحَكَم إلى المعركة؟
لكي نفهم خطورة ما يحدث، يجب أن نعود إلى الجذور الفكرية للأزمة. أي مجتمع صحي يعتمد على ركيزتين أساسيتين: وجود قواعد لعب واضحة ومقبولة، وإيمان مشترك بأن “الحَكَم” (النظام القضائي) سيطبق هذه القواعد بحيادية. لقد تآكلت هاتان الركيزتان بشكل منهجي على مدى عقود.
تحوّل الحقوق من “درع” إلى “سيف”: كما شخصت بدقة أستاذة القانون بجامعة هارفارد ماري آن غليندون، فإن لغة “الحقوق” في الغرب تحولت من كونها “درعًا” يحمي الفرد من طغيان الدولة، إلى “سيف” هجومي يستخدمه كل طرف لفرض رؤيته الأخلاقية على المجتمع بأسره. عندما تُصاغ كل قضية ثقافية (من المناهج المدرسية إلى الهوية الجندرية) كلغة “حقوق” مطلقة وغير قابلة للتفاوض، يصبح الحوار مستحيلاً والتسوية خيانة. في هذه البيئة، لا يعود القانون وسيلة لإيجاد أرضية مشتركة، بل يصبح أداة لـ “الحق” المنتصر لسحق “الباطل” المهزوم.
فقدان اللغة الأخلاقية المشتركة: يذهب فلاسفة التيار الجماعي (Communitarianism)، مثل ألسدير ماكنتاير، إلى ما هو أبعد من ذلك، فيجادلون بأننا فقدنا الإطار الأخلاقي المشترك و”الفضائل” التي كانت توجه حياتنا العامة. في غياب هذه اللغة المشتركة، تصبح نقاشاتنا العامة حوار طرشان، حيث تصرخ كل مجموعة بمفاهيمها الخاصة عن العدالة والحق، دون أي قدرة على فهم الآخر. هذا الفراغ الأخلاقي هو ما يسمح لـ “حرب القانون” بالازدهار، لأن القوة القانونية البحتة تحل محل الإقناع الأخلاقي.
انهيار “رأس المال الاجتماعي”: على المستوى العملي، وثّق عالم الاجتماع روبرت بوتنام تآكل “رأس المال الاجتماعي” — أي شبكات الثقة والمشاركة المدنية التي تمثل الصمغ الذي يربط المجتمع ببعضه. عندما تتوقف الثقة بين المواطنين، فإنها حتمًا ستتوقف بينهم وبين المؤسسات. يصبح يُنظر إلى الشرطة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل، والمحاكم ليس كهيئات محايدة، بل كأدوات تابعة للقبيلة السياسية الموجودة في السلطة. في بيئة انعدام الثقة هذه، يُفسر كل إجراء قانوني ضد شخصية من “معسكرنا” على أنه اضطهاد سياسي، وكل إجراء ضد “معسكرهم” على أنه عدالة مستحقة.
“الطوفان الثقافي”: المسرِّع الأكبر للحرب القانونية
هذه الأرضية الفكرية والاجتماعية المتصدعة كانت مهيأة للانفجار، وقد جاء “الطوفان الثقافي” ليكون عود الثقاب. لقد أدى تفاعل مجموعة من العوامل التاريخية والتكنولوجية إلى تحويل الصراع الثقافي الكامن إلى حرب شاملة، أصبحت فيها “حرب القانون” السلاح المفضل.
فقدان العدو الخارجي: بعد نهاية الحرب الباردة، التفتت الأمم الغربية إلى الداخل، وتحولت حروبها الأيديولوجية من صراع ضد الشيوعية إلى صراع حول تعريف “الأمة” نفسها.
صعود سياسات الهوية: تفكك المجتمع إلى “قبائل” أو “عصبيات” جديدة قائمة على العرق والدين والجندر والأيديولوجيا. أصبح الولاء لهذه القبائل أحيانًا أقوى من الولاء للدولة، وأصبحت كل قبيلة تنظر إلى القانون كوسيلة لتعزيز قوتها وحماية مصالحها ضد القبائل الأخرى.
وسائل التواصل الاجتماعي: عملت هذه المنصات كمُفاعل نووي للانقسام. لقد خلقت غرف صدى عززت الكراهية، وكافأت الغضب، ودربت جيلاً كاملاً على المطالبة بـ “عدالة” فورية وعقابية. لقد أصبحت المحاكمات على تويتر مقدمة للمحاكمات في قاعات القضاء.
في خضم هذا الطوفان، أصبحت “حرب القانون” الخيار المنطقي. لماذا تحاول إقناع خصمك في حوار عام إذا كنت تستطيع إسكاته بدعوى قضائية؟ ولماذا تتنافس معه في صندوق الاقتراع إذا كنت تستطيع تجريمه ومنعه من الترشح؟
السلاح النووي الداخلي: لماذا “حرب القانون” أخطر من القنابل؟
هنا نصل إلى جوهر الخطر الوجودي الذي تمثله هذه الظاهرة. غالبًا ما يُنظر إلى السلاح النووي على أنه التهديد الأعظم للحضارة. لكن السلاح النووي، على خطورته، هو سلاح للردع الخارجي. منطقه قائم على “الدمار المتبادل المؤكد”، مما يمنع الدول من استخدامه. أما “حرب القانون” فهي سلاح الدمار الشامل للاستخدام الداخلي. إنها النسخة المدنية من الدمار المتبادل المؤكد، ولكنها أكثر غدرًا لأنها لا تدمر المباني، بل تدمر الثقة والشرعية، وهي الأساس غير المرئي الذي تقوم عليه أي حضارة.
دورة الانتقام التي لا تنتهي: إنها تخلق حلقة مفرغة ومدمرة. الحزب (أ) يستخدم مدعيًا عامًا للتحقيق مع قادة الحزب (ب). عندما يصل الحزب (ب) إلى السلطة، فإنه لا يكتفي بالرد بالمثل، بل يصعّد الهجوم لمنع الحزب (أ) من العودة. تصبح السياسة عملية انتقام لا نهاية لها، وتتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات في هذا الثأر القبلي.
تدمير الشرعية بشكل لا رجعة فيه: كل استخدام للقانون كسلاح يترك ندبة على جسد شرعية الدولة. مع مرور الوقت، يفقد المواطن العادي إيمانه بأي مؤسسة. يتوقف عن رؤية الفرق بين العدالة والانتقام، وبين تطبيق القانون والاضطهاد السياسي. عندما يحدث ذلك، فإن العقد الاجتماعي يتمزق. لماذا أطيع القانون إذا كان مجرد أداة بيد الأقوى؟
شلل المجتمع: يؤدي هذا السلاح إلى شلل تام. يصبح المسؤولون خائفين من اتخاذ قرارات جريئة. يخشى رواد الأعمال من الاستثمار في بيئة قانونية غير مستقرة. ويخاف المواطنون من التعبير عن آرائهم خوفًا من الملاحقة. المجتمع الذي ينخرط في “حرب قانونية” شاملة هو مجتمع يستهلك نفسه بنفسه حتى يتوقف عن الحركة تمامًا.
الخاتمة: عندما يصبح صوت المطرقة أخطر من دوي المدافع
إننا نعيش في لحظة تاريخية خطيرة حيث تحولت أداة السلام — القانون — إلى محرك للحرب. إن “الطوفان الثقافي” لم يغير فقط ما نؤمن به، بل غيّر أيضًا الطريقة التي نحارب بها من أجل معتقداتنا. لقد تخلينا عن ساحات الحوار المقبولة وانتقلنا إلى ساحة القضاء، ليس بحثًا عن الحقيقة، بل سعيًا لتدمير الخصم.
التهديد الأكبر للحضارة الغربية اليوم قد لا يأتي من صواريخ عدو خارجي، بل من الاستخدام المنهجي لدساتيرها وقوانينها لتفكيك نفسها من الداخل. في هذه الحرب الصامتة، لا توجد قنابل أو دبابات، لكن الخسائر فادحة بالقدر نفسه. فكل دعوى قضائية تُرفع بدوافع سياسية، وكل لائحة اتهام تُستخدم لإقصاء خصم، هي طلقة تُطلق على قلب فكرة “دولة القانون”. وعندما يموت هذا القلب، لا يتبقى شيء يستحق الدفاع عنه. لقد أصبح صوت مطرقة القاضي، في بعض الأحيان، أخطر من دوي المدافع.