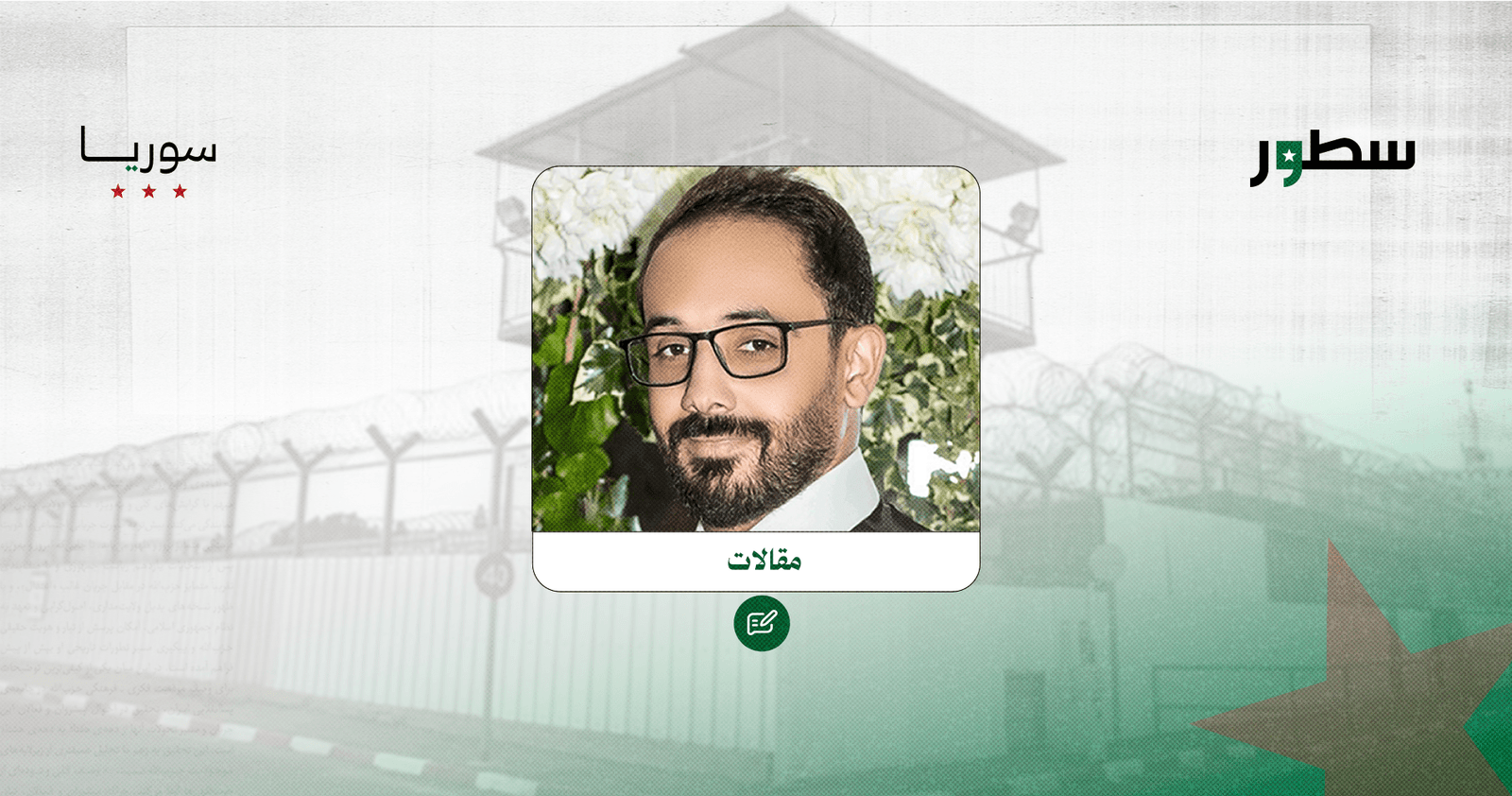مشاركات سوريا
الناجي والذاكرة: الصحفي شاهداً على ما لا يُحتمل
الناجي والذاكرة: الصحفي شاهداً على ما لا يُحتمل
منذ أن أطاحت منظومة الفساد الأسدية بسوريا في انقلاب 1970 تحولتِ السجون إلى ممرٍّ إجباريّ لكلِّ من فكّر خارج النص المرسوم، جدرانها لم تكن تحاصر الجسد فقط، بل كانت تخنق العقل وتكسر الكلمة وتئد الحلم في مهده.. حرية التعبير والرأي صارت تهمة جاهزة، والاختلاف تحوّل إلى جريمة، حتى صار الخوف جزءاً من النسيج اليومي للمجتمع السوري.
ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، لم يُفتح باب القمع على مصراعيه فجأة، بل استُكملت منظومة راسخة أُسست منذ عقود؛ ما تغيّر فقط هو أن الأمل في الحرية صار أكثر وضوحاً، والمواجهة مع الاستبداد أكثر علنية، في تلك اللحظة باتت الكلمة والصورة والموقف أعداءً مباشرين لسلطةٍ تعرف جيداً أن فضحها يعني نهايتها.
الناجي من هذا الجحيم لا يخرج كما دخل، فهو يعود إلى العالم وهو يحمل ذاكرةً مثقلة بالموت، لكنه أيضاً يحمل وصيةً غير مكتوبة: أن يروي ما رأى.. وحين نقرأ في حياة هؤلاء الناجين، فإننا لا نتتبع مجرد قصص فردية، بل نفكك تاريخاً طويلاً من الإجرام المنظّم، ونقفُ أمامَ السؤال الأثقل: كيف يمكن للإنسان أن يظل حيًّا وهو محاط بكل هذا العدم؟
الحقيقةُ أنّ هناك من كانَ يعبُرُ إلى الجحيمِ بعذاب أشد من غيره، الصحفي الذي دخلَ أقبيةَ نظامِ الأسد البائد لم يكن أسير جسدٍ وحسب، بل أسيراً للكلمة الحرّة التي قررَ إطلاق عنانها في فضاءِ الخوف، وفي رأي الجلّاد لم يكن الصحفي أسير رأي بل هو مصدرٌ للخطر وخائنٌ ومثير فتنة، أما في عين الحقيقة، فكان ضميراً حيًّا يفضح جرائم منظومةٍ بُنيت على الكذب والدم.
الكاميرا جريمة كبرى
في سوريا الأسد، لم تكن الكاميرا مجرد أداة لنقل الحقيقة، بل صارت تهمة تُدخل صاحبها إلى عوالم العدم.. الصحفي الذي يلتقط صورة أو يوثّق كلمة، كان في نظر أجهزة المخابرات أخطر من المسلح، لأنه يفضح الجريمة ويكسر جدار الصمت.
هكذا كان حال الصحفي إبراهيم الحلبي الملقب بأبي الطيب، المنحدر من محافظة الحسكة السورية، البالغ من العمر 44 عاماً، والذي اعتُقل بتاريخ 12 أيار/ مايو 2012.. يقول لموقع سطور سوريا: “تم اعتقالي في تل أبيض، ونُقلت أولاً إلى الأمن السياسي في الرقة، ثم الحسكة، وبعدها على متن طائرة إلى دمشق، خلال الرحلة كبّلونا من الخلف بشدة حتى تورمت يداي، وأغلقوا أعيننا بقمصاننا، كنا 50 معتقلاً يُشحنون كالحقائب من الرقة والحسكة، وفي دمشق استقبلتنا المخابرات الجوية بالضرب والإهانات.. هناك، يأتي كل فرع ومعه قائمة بأسماء من يريد، وكان نصيبي فرع المخابرات العامة 291.. دخلت أطول وأقسى فترة في حياتي، قرابة 9 أشهر من الجحيم المتواصل”.
داخل الفرع، تحوّل جسد أبو الطيب إلى حقل تجارب للتعذيب، استقبلوه بالضرب حتى العري، ثم حُشر في منفردة ضيقة متر ونصف بمتر، ليبدأ الانهيار النفسي الأول: “شعرت أن رسالتي انتهت، أن لا أمل في النجاة”، ومن هناك، أخذوه إلى الجنزير؛ عُلّق كآلة صدئة على باب حديدي، وانهالت الكابلات على جسده، والصواعق الكهربائية على رأسه، أصابعه جميعها كُسرت، أضلاعه هشمت تحت أحذية العساكر، ثم تُرك ملقى في غيبوبة.
لم يكن الطعام طعاماً، بل إهانةً جديدةً، كل يومين فقط، يقدّمون له حفنة رُز أو حبةَ بطاطا وهو مقيّد من الخلف، يُجبر على الأكلِ كالحيوان، وأحياناً على النباحِ أمامَ رفاقه، “لم يكن صوتي يخرج، كان مبحوحاً من الصراخ تحت التعذيب”، وحتى تلك اللقيمات القليلة كانت تتحول إلى مشهد إذلال جماعي.
العذاب لم يكن جسدياً فقط؛ كان اغتيالاً بطيئاً للكرامة، أرادوا من الصحفي أن يُمحى من داخله أولاً، أن ينسى الكاميرا والصوتَ والصورة، وأن يتحولَ إلى مجردِ جسدٍ مطيعٍ، لكن مقاومته لم تكن صاخبة، بل في كل مرة يصرّ أن يبقى شاهداً على ما يحدث، أن يسجّل بذاكرته ما مُنع من تسجيله بالكاميرا.
على حافة الذاكرة
لم تكن الزنزانة عند أبي الطيب مجرّد جدران ضيّقة وأسلاكٍ مَعدَنية، بل كانت عالماً موازياً ينكشفُ فيه وجهُ الإنسان حين يُسلب منه كل شيء: الحرية، الطعام، الصوت، وحتى الاسم، في عتمة الأقبيةِ الأسدية، يتحوّل الجسدُ إلى خشبةٍ متعبة، والذاكرةُ إلى شظايا، والعقلُ إلى مسرحِ صراعٍ بين الأمل والجنون.
كل ما فعله أبو الطيّب، ابن محافظة الحسكة، أنه حمل كاميرا صغيرة ليصوّر تظاهرات المدنيين السلمية في الحسكة بمدينة عامودا، لكن آلة القمع التي تحكم سوريا منذ نصف قرن تعاملت معه كخطر وجودي، 4 سنوات و8 شهور لم تُقَس بالساعات، بل بالتعذيب، بالكهرباء، بالجنزير، وبالانتظار الطويل بين جدران صامتة.
الكاميرا التي كانت شاهداً على الثورة، عوقب من أجلها بكسر أصابعه واحداً واحداً، وكأن النظام أراد أن يكسر “العين” التي ترى و”اليد” التي توثّق، أصابع الصحفي لم تعد أصابع، بل علامات محفورة بالعذاب على جسد رجل لم يساوم على صوته.
في شهادته يروي أنه دخل مرحلة “ما بعد الإنسانية”، حين يصبح السجين مجرد غريزة تبحث عن فتات خبز أو رشفة ماء، كل شيء ينقلب إلى رموز حيوانية: السجّان الذي يصرخُ “انبح”، المعتقلُ الذي يقلّد صوتَ الحمار، والآخر الذي يغنّي لأم كلثوم كي يضحك الجلّاد.. الإنسان يفقدُ صورتهُ الأولى ويتحوّلُ إلى دورٍ مرسومٍ في سيركِ الموت.
لكن وسطَ هذا الظلام، كانت الرؤى تداهمُ أبا الطيّب، يرى حوتاً يصعدُ به إلى الشاطئ، وحصاناً يأخذه إلى الجبل، وأصواتاً تبشره بالنجاة، هو لم يكن يملك سوى هذه الرؤى ليواجه بها حقيقة السجن: الجوع، التعذيب، الروائح العفنة، والرفاق الذين يموتون واحداً تلو الآخر، حين يسمع لاحقاً أغنية لأم كلثوم في مقهى، لا يتذكر قصة حب، بل يتذكر المهجع الأخير في السجن، حيث كان الصوت الجميل يخرج من فمِ مُعتقلٍ يُغني كي ينجو من ضربةِ سوط.
إنها مفارقةٌ رهيبة: الأغنيةُ التي تُكتب للحياةِ تُصبح مرادفاً للموت، والبطاطا التي يأكلها أي إنسان بلا تفكير، تصبحُ لدى المعتقلِ لقمةَ نجاةٍ يُنتزع ثمنها من حفرةِ الخلاء، التفاصيلُ الصغيرةُ هنا ليست عابرةً، إنها تختزلُ معنى التجربة كلها.
أبو الطيّب عاشَ 9 شهورٍ متواصلةٍ في المنفردة، جسدهُ مقيّد بالجنزير إلى باب حديدي، يتلقى الصدمات الكهربائية حتى يفقد بصره، ثم يعودون ليوقظوا قلبه كي يعذبوه من جديد، “الشبح”، “الكبلات”، “الحرمان من النوم”، “الطعام كطعام الحيوانات”، كلها لم تكن مجرد أدوات تعذيب، بل فلسفةً متكاملة لإلغاء الإنسان.
ومع ذلك، لم ينهزم تماماً، صحيح أن ذاكرته تكسرت، وأن وزنه هبط إلى 40 كيلوغراماً، وأنه خرجَ من المعتقلِ هيكلاً عظمياً، لكنه بقي يصِرّ على كونهِ شاهداً، خرجَ ليقولَ إن الكاميرا التي كسروها في أصابعهِ لم تنكسر في داخله، خرجَ ليذكّر السوريينَ أن ما يجري في سجونِ الأسد ليس اعتقالاً سياسياً عادياً، بل منظومةَ إبادةٍ بطيئة.
تجربة أبي الطيب هي مرآة لجيلٍ كاملٍ من السوريين: جيل حلم بالحرية ودفعَ الثّمن مضاعفاً، إن قصة الصحفي البسيط تحوّل إلى رقم في فرع 291 ثم إلى هيكل عظمي في سجون عدرا وحمص وطرطوس واللاذقية، وهي ليست قصة فردية، بل قصة وطنٍ كاملٍ تحوّل إلى زنزانةٍ كبيرة، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: “بعد أن سقطت الجدران الحديدية وخرج الناجون إلى الضوء، كيف يمكن تحويل تجربة الألم والاعتقال إلى طاقة تصنع صحافة أكثر حرية ومسؤولية، لا مجرد حكاية من الماضي؟”.