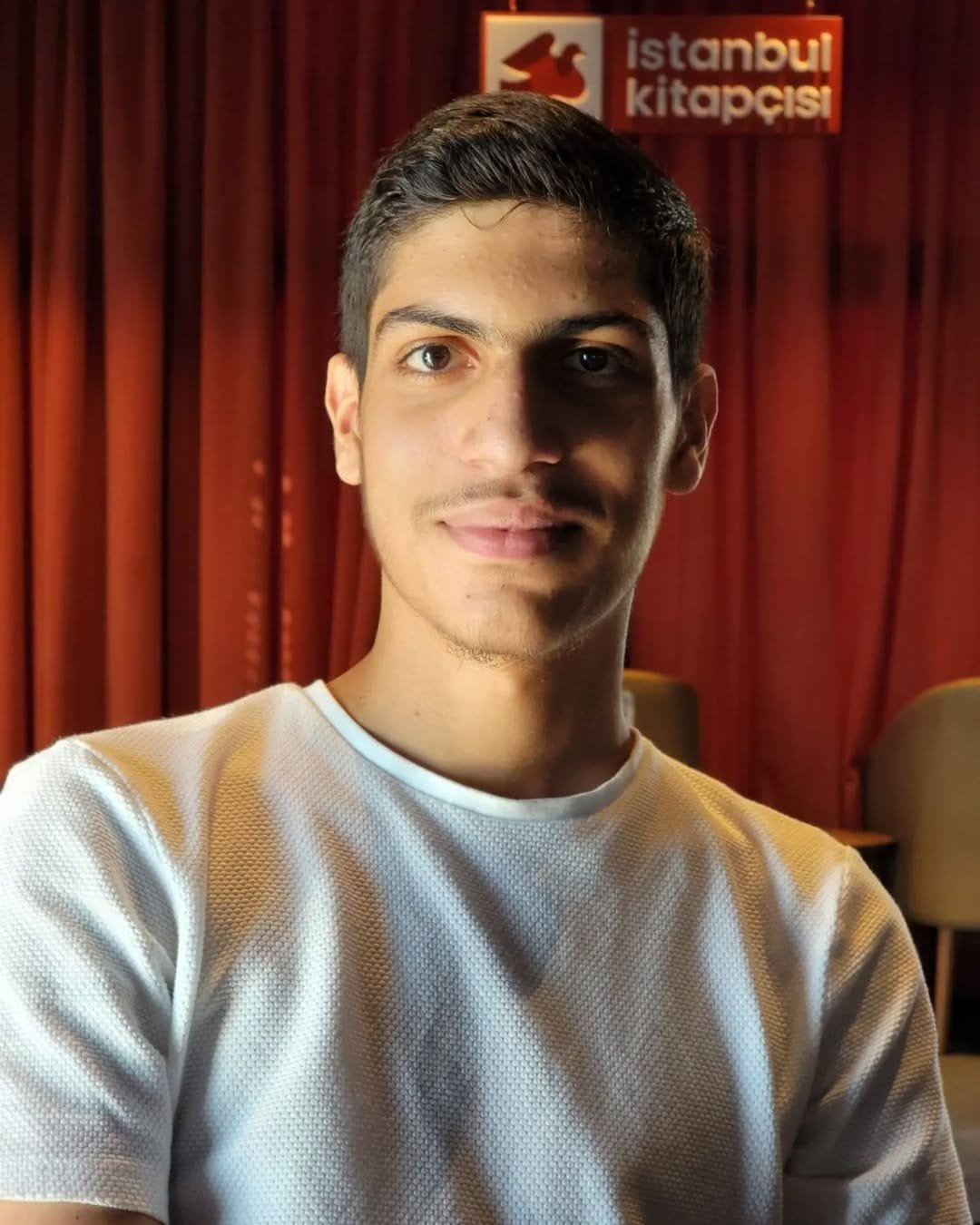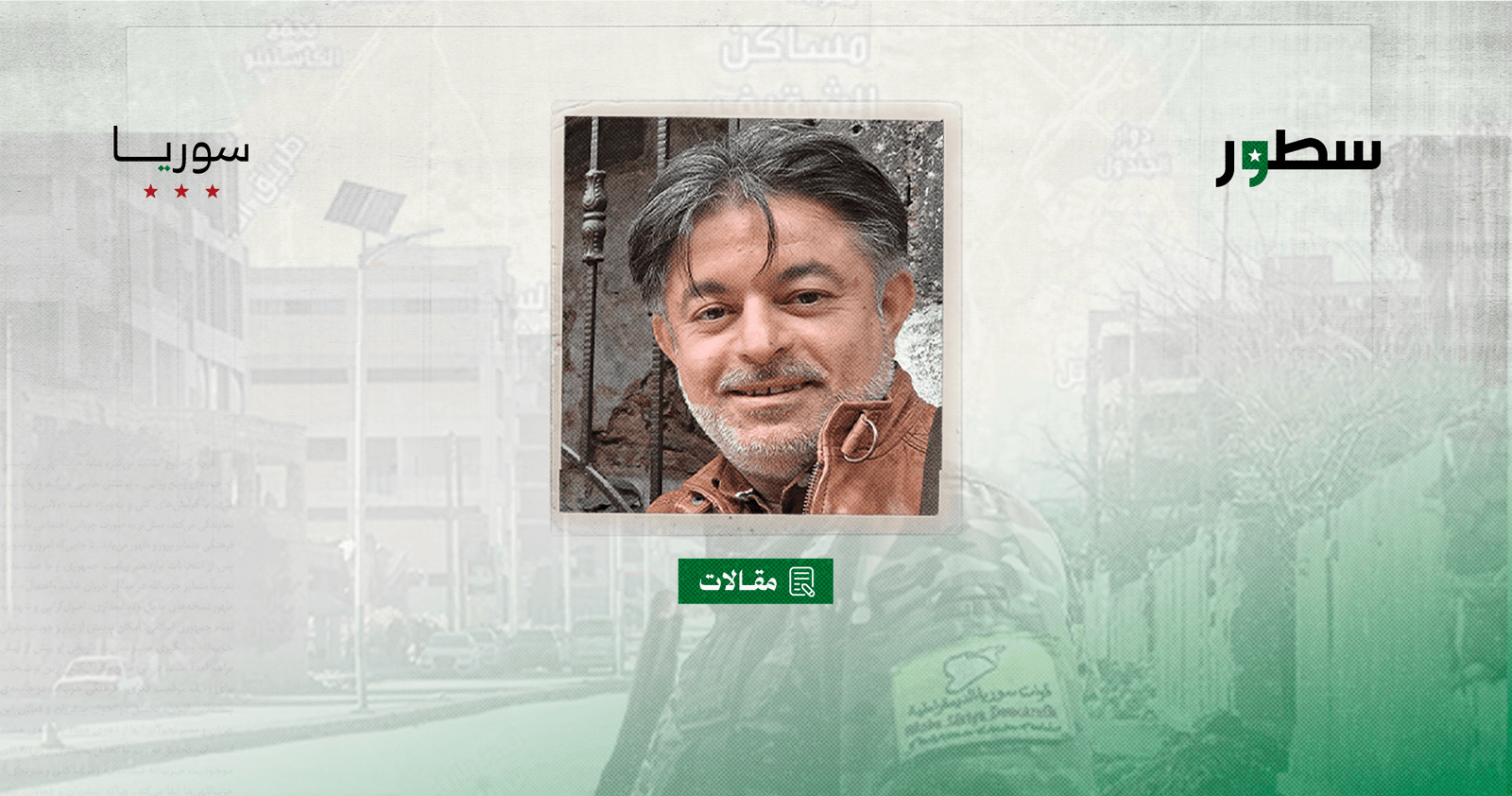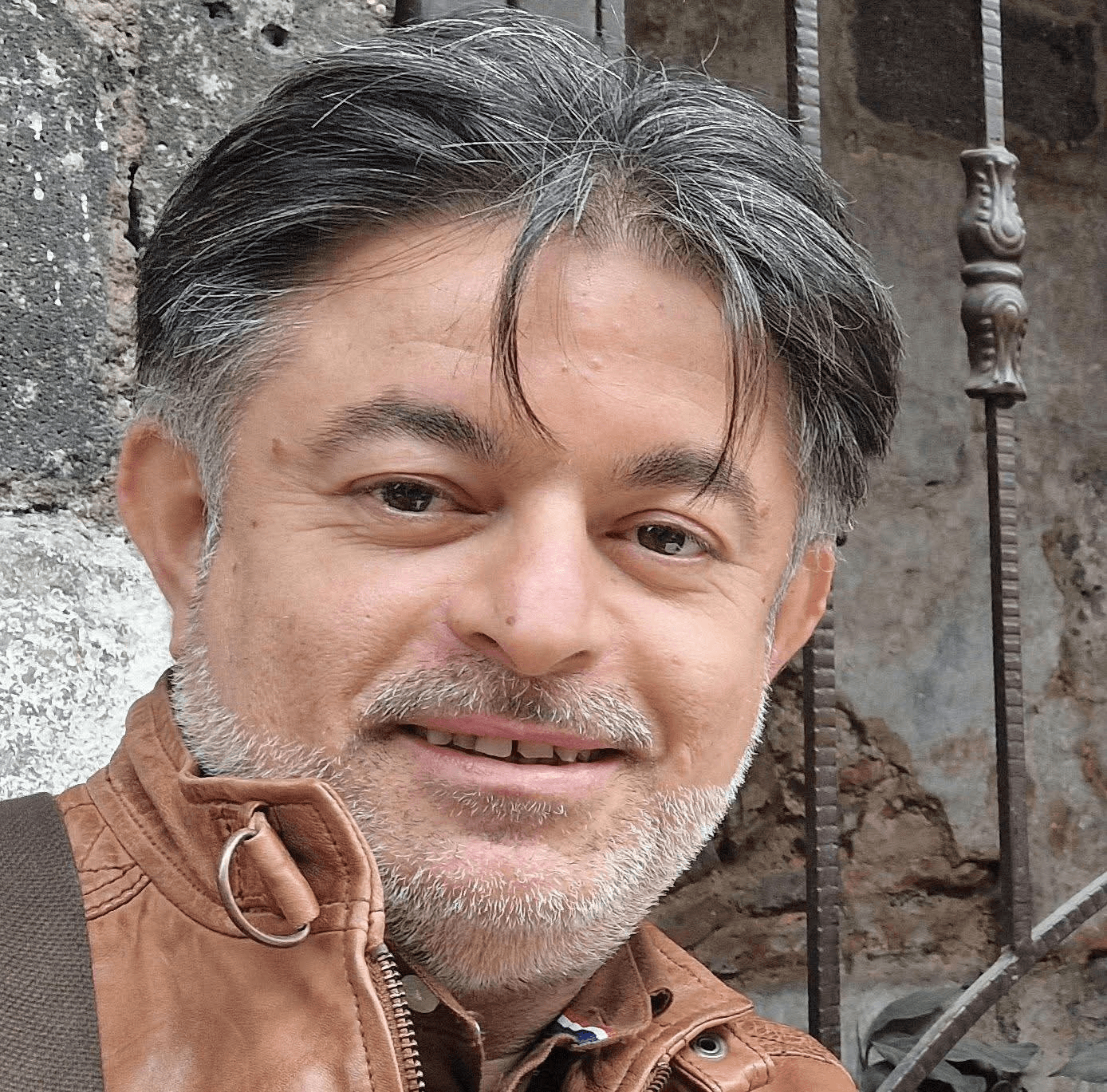مجتمع
الشعب يريد: من النداء التاريخي إلى التنفيس الجماعي
الشعب يريد: من النداء التاريخي إلى التنفيس الجماعي
في مساءٍ صاخب من أمسيات المدينة، كان الشارع يغلي كقدرٍ مكشوف. آلاف الحناجر تتعانق على إيقاع واحد: “الشعب يريد..”. تتردّد الكلمات كأنها زلزال صغير يضرب الأرصفة والجدران، وتتماهى الأجساد في موجة واحدة لا تفرّق بين فرد وجماعة. لحظة نادرة يشعر فيها كل واحد أنه ليس وحيداً، وأن صوته الفردي قد انصهر في جوقة التاريخ. لكن مع انفضاض الجمع وعودة الناس إلى بيوتهم، يتكشّف السؤال الصعب: ماذا تغيّر حقاً؟ هل كان الهتاف بداية فعلٍ كبير، أم خاتمة شعورية عابرة؟
لم يكن شعار “الشعب يريد” مجرد كلمات خرجت من حناجر متعبة، بل كان نداءً تاريخياً حمل معنى أبعد من اللحظة التي وُلد فيها. كان اختزالاً لحلمٍ جماعي بأن الشارع قادر على أن يصوغ مصير الأمة، وأن الهتاف يمكن أن يوازي الفعل، بل أن يخلقه. غير أن هذا النداء، بقدر ما كان عظيماً، سرعان ما انكشف تناقضه: فالشعوب أرادت كثيراً، لكنها لم تحقّق بالضرورة ما أرادته. ظلّ الهتاف حاضراً، بينما غاب المنجز الذي يُسنِده.
في سياقات عديدة، تحوّلت المظاهرة من فعل سياسي إلى مجرد وسيلة تعبير رمزي، أو حتى إلى آلية تنفيس جماعي. النظام نفسه قد يسمح بالاحتجاج، لا لأنه يعترف بشرعيته، بل لأنه يعرف أنّ الغضب حين يُصرَف في الشارع يعود إلى البيوت أضعف، أخفّ، أقلّ تهديداً. وهنا تبرز المفارقة: ما يُفترض أن يكون إسناداً لعمل سياسي أو ميداني، يتحوّل في غياب المُسنَد إلى طقسٍ يستهلك ذاته.
هذا المقال يحاول أن يعالج هذه الإشكالية من زاويتين متداخلتين: الأولى سياسية اجتماعية تضع المظاهرة في موقعها التاريخي كأداة إسناد، والثانية نفسية تستند إلى مفهوم التنفيس الانفعالي والشعور الرمزي بالإنجاز. والغاية هي مساءلة معنى المظاهرة في سياقنا: هل هي فعل تغيير أم مجرّد علاجٍ جماعي مؤقت؟
الإسناد الشعبي ومعناه
الإسناد الشعبي في جوهره ليس فعلاً قائماً بذاته، بل علاقة بين جمهور وفعل. الجموع لا تهتف في الفراغ، بل تهتف لتُسند حدثاً أو مساراً أو قوةً فاعلة في الميدان. في الثورات الكلاسيكية، كان الشارع يشتعل حين تتقدّم المقاومة خطوة: مظاهرة تخرج في باريس بعد انتصار الباريسيين على قوات الملك في أحياء معيّنة عام 1789، أو مسيرات تأييد لخطاب جمال عبد الناصر بعد تأميم قناة السويس عام 1956. هنا يصبح الحشد فعلاً مُسانداً، يعزّز قوة قائمة على الأرض ويمنحها الشرعية المعنوية، بل يحوّل الإنجاز الجزئي إلى لحظة تأسيسية في الوعي العام.
لكن الخلل يبدأ حين يتحول الإسناد إلى فعل مستقل، بلا مُسند واقعي. في الحالة السورية، على سبيل المثال، شهدت المدن الكبرى موجات احتجاج استمرّت شهوراً طويلة، رغم غياب أي قدرة على تحصيل منجز سياسي أو عسكري يوازي ذلك الإسناد. كانت الجماهير تقدّم طاقتها كاملة، بينما القوى السياسية والعسكرية إما ضعيفة، أو مشتّتة، أو عاجزة عن تحويل هذا الدعم الشعبي إلى مسار فعلي. وهنا يصبح الشارع نفسه “المشهد” و”الحدث”، بدل أن يكون ظهراً يسند فعلاً آخر.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن المظاهرات السورية في بداياتها كانت فعلاً قائماً بذاته، حدثاً تاريخياً مستقلاً أعاد تعريف المجال العام وكسَر احتكار السلطة للشارع. كان مجرد تجمع آلاف السوريين في الساحات إعلاناً عن إرادة شعبية رافضة لبقاء العائلة الحاكمة، وتعبيراً صريحاً عن كرامة مهدورة وحقّ مسلوب. في تلك اللحظة، لم يكن الإسناد بحاجة إلى مُسند، لأن المظاهرة نفسها كانت الفعل المؤسس. غير أن مرور الشهور، وتصاعد العنف، وتحوّل النقاش إلى أروقة المحافل الدولية حول شرعية النظام والمعارضة، جعل المظاهرات وحدها غير كافية. عندها برزت الحاجة إلى فعل سياسي وميداني يوازي التضحيات الشعبية، لكنه كان غائباً، وهو ما جعل الشارع مع الوقت يبدو وكأنه يصرخ في الفراغ.
المفارقة أن هذا الانفصال بين الإسناد والفعل يخلق نوعاً من الاستهلاك الذاتي. الجماهير التي تنزل مراراً إلى الساحات بلا جدوى ملموسة، تفقد تدريجياً إيمانها بأن النزول فعلٌ منتج. يتحول الحشد من مصدر قوة إلى طقس رمزي، ومن دافع للتغيير إلى ممارسة استنزافية. هذا ما لاحظه الباحث الأمريكي تشارلز تيلي في دراساته عن الحركات الاجتماعية، حين اعتبر أن المظاهرة تُفقد قيمتها عندما تتحوّل إلى غاية قائمة بذاتها بدل أن تكون وسيلة ضغط لتحقيق مطالب محددة.
على الضفة الأخرى، بعض الأنظمة أدركت هذه المعادلة مبكراً، فوظّفت الإسناد الشعبي بطريقة معكوسة: سمحت بمسيرات وشعارات لا تهدد جوهر السلطة، لكنها تُبقي الناس في حالة انفعال مفرغ. المثال الأوضح هو الأنظمة العربية التي فتحت المجال لعقود لمظاهرات ضخمة “ضد إسرائيل”، فيما كانت تمنع أي تجمع يطالب بإصلاح داخلي. في الجوهر، الإسناد هنا لم يكن إسناداً لفعل واقعي، بل لسياسة النظام نفسه في تصدير الصراع إلى الخارج واحتواء الداخل.
الاستنتاج الأخطر أن المظاهرات بلا مُسند تتحول مع الزمن إلى “سقف منخفض للسياسة”. الجمهور يتعوّد أن قصارى فعله هو الهتاف والتجمّع، بينما القوى الفاعلة تفلت من مسؤولية إنتاج المنجز. في لحظة ما، يغدو الشارع متعباً، يائساً، بلا طاقة جديدة. عندها تفقد المظاهرة معناها كأداة ضغط، وتصبح مجرد انعكاس لعجز عام، أو إعادة إنتاج لصورة البطولة السابقة دون مضمون جديد.
الزاوية النفسية للمظاهرات
من منظور علم النفس، يمكن قراءة المظاهرة بوصفها تجربة جماعية للتنفيس. الإنسان حين يعبّر عن غضبه بالكلمات أو الصراخ أو المشاركة في فعل جماعي، يمرّ بما يُعرف في الأدبيات بالتنفيس الانفعالي. الفكرة التي صاغها فرويد وطوّرها باحثون لاحقون تقوم على أن التفريغ المباشر للمشاعر يخفّف من حدتها، لكنه قد يقلل أيضاً من الطاقة الدافعة وراءها. أي أن الانفعال إذا أُفرغ بالكلام أو الفعل الرمزي، قد يفقد شيئاً من قوته الضرورية للاستمرار في الصراع.
هذا ما يجعل بعض المظاهرات أقرب إلى جلسة علاج جماعي: لحظة يصرخ فيها الأفراد معاً، فيشعرون بالارتياح، لكنهم يعودون إلى بيوتهم باندفاعة أضعف. وهنا يطلّ مفهوم آخر هو الإحساس الرمزي بالإنجاز. حين يهتف المرء ويشعر أنه شارك، يتكوّن لديه وهم أنه حقق شيئاً، حتى لو لم يتغيّر الواقع. هذا الوهم النفسي قد يتحوّل إلى قيد سياسي، لأنه يخلق اكتفاءً زائفاً: لقد أنجزنا بمجرد أن هتفنا.
أما المفهوم الثالث، وهو إشباع الحافز، فيشير إلى أن المشاركة الرمزية قد تستهلك الرغبة في العمل الفعلي. الجماهير التي تنزل كل أسبوع إلى الشارع بلا نتيجة ملموسة قد تشعر بعد فترة أنها فعلت ما يكفي، أو أنها استوفت حاجتها للتعبير، بينما العمل الحقيقي السياسي أو الميداني يبقى مؤجلاً أو غائباً. من هذه الزاوية، يمكن القول إن المظاهرة لا تُضعف فقط بفعل القمع أو العنف، بل قد تُضعف نفسها ذاتياً من خلال الإشباع المؤقت للحافز الجماعي.
الأنظمة السلطوية تدرك هذه المعادلات النفسية جيداً. لذلك لا يكون سماحها أحياناً بالمظاهرات علامة ضعف، بل تعبيراً عن ذكاء سياسي بارد: “دعوا الناس تصرخ، فيرتاحوا قليلاً، ثم يعودوا إلى حياتهم”. هذا ما شهدته بلدان عدة حيث فُتحت الشوارع لشعارات محسوبة، بينما بقيت السلطة في مأمن. المفارقة أن الأداة التي يُفترض أن تعبّر عن إرادة التغيير، تتحوّل في بعض السياقات إلى وسيلة لامتصاص الغضب وضبطه.
من هنا يمكن القول إن المظاهرات، بقدر ما هي فعل مقاومة، تحمل أيضاً قابلية للتحوّل إلى علاج نفسي جماعي مؤقت. هي لحظة التقاء بين الحاجة العاطفية للتعبير، وبين حسابات السلطة في إدارة الغضب. وهذا التعقيد النفسي لا ينتقص من قيمة الشارع، لكنه يفرض سؤالاً ملحاً: كيف نجعل المظاهرة فعلاً مولّداً للحافز بدل أن تكون مفرّغة له؟
من الشرعية إلى الضبط
لم تولد المظاهرة في التاريخ الحديث بوصفها مجرد حشد غاضب، بل أداة سياسية لإنتاج الشرعية. منذ الثورات الأوروبية في القرن التاسع عشر، ارتبط الشارع بفكرة أن الجماهير ليست فقط موضوعاً للحكم، بل مصدراً له. كان نزول الناس إلى الساحات إعلاناً عن أن السلطة الحقيقية تستمد قوتها من الإرادة الشعبية، لا من الملوك أو النخب. من هنا صارت المظاهرات معياراً للشرعية، ومقياساً للقوة السياسية.
لكن التاريخ سرعان ما كشف عن وجه آخر للمظاهرات: وجه الضبط والسيطرة. أنظمة سلطوية عديدة سمحت أحياناً بحشود ضخمة، لكنها قيّدتها بعناية لتكون وسيلة لإعادة إنتاج السلطة نفسها. في مصر عبد الناصر، على سبيل المثال، كانت المسيرات المليونية تعبيراً عن التفاف جماهيري حقيقي حول مشروع سياسي، لكنها في الوقت ذاته كانت مشهداً يوظّفه النظام لإظهار التفويض الشعبي داخلياً وخارجياً. وفي العقود التالية، تحوّل هذا النموذج إلى مجرد نسخة باهتة عند أنظمة عربية أخرى، حيث صارت المظاهرات مسرحاً رسمياً لا يُسمح فيه إلا بالشعار الموجَّه من أعلى.
الأمر نفسه يمكن تلمّسه في تجارب إيران: حيث يُفتح الشارع أحياناً لمظاهرات ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل، لتكون أداة توحيد داخلي وصرف للغضب، بينما أي احتجاج داخلي على بنية النظام يواجه بالقمع.
في الحالة السورية، اكتسب الشارع في بدايات الثورة معنى الشرعية المباشرة: لم يكن هناك حزب منظم أو مؤسسة معترف بها، بل مظاهرات ضخمة تقول ببساطة إن النظام لم يعد يملك تفويض الحكم. غير أن وحشية القمع، إلى جانب عجز المعارضة عن التحوّل إلى قوة سياسية متماسكة، جعلت المظاهرات نفسها تتحول إلى ساحة استنزاف. النظام لم يحتج حتى إلى “السماح” بها كما في بلدان أخرى؛ كان يكفي أن يترك بعض مساحات الغضب محدودة، ثم يواجهها بالعنف عند الحاجة، ليضمن أن الشارع لا يتجاوز حدود التنفيس.
هكذا نجد أن المظاهرات، عبر التاريخ، تأرجحت بين قطبين: إما أن تكون مصدراً للشرعية وتعبيراً عن قوة جماعية قادرة على تغيير الموازين، أو تتحول إلى أداة من أدوات السلطة لضبط المجتمع وإدارته. هذه المفارقة تجعل من أي تحليل للمظاهرات ناقصاً إن لم يضعها في هذا السياق المزدوج: الشارع كمنبع شرعية، والشارع كأداة ضبط.
ومع كل ما تقدّم، يبقى السؤال الأهم: متى تكون المظاهرة فعلاً مُنتجاً، ومتى تتحوّل إلى مجرّد طقس استهلاكي؟ يمكن القول إن معياراً رباعيّاً يساعدنا على تمييز الحالتين. أوّلاً، أن يكون للمظاهرة مُسنَد واضح، أي أن تأتي إسناداً لفعل سياسي أو ميداني قائم، لا مجرد حدث قائم بذاته. ثانياً، أن تتوافر قناة تحويل، قوة سياسية أو تنظيم قادر على التقاط الطاقة الشعبية وترجمتها إلى مكسب ملموس. ثالثاً، أن تفرض المظاهرة كُلفة على الخصم، سواء بسمعة أو اقتصاد أو تعطيل، بدل أن تظل حبيسة التعبير الرمزي. وأخيراً، أن تنخرط في مسار من الاستمرارية والتصعيد، بحيث لا تكون ذروة لحظة عابرة، بل بداية سلسلة تضغط وتتراكم. عندها فقط يمكن للهتاف أن يتحوّل إلى قوة تغيير، لا أن يبقى صدى يذوب مع انفضاض الجموع.
الخاتمة
في النهاية، المظاهرات ليست شرّاً محضاً ولا خيراً مطلقاً. هي أداة، قيمتها رهنٌ بالسياق الذي توضع فيه: قد تكون فعلاً مؤسِّساً يفتتح مرحلة جديدة من التاريخ، كما حدث في ربيع الشعوب حين انكسرت جدران الخوف، وقد تتحول مع الزمن إلى طقس متكرر يستنزف الطاقة ولا ينتج سوى الوهم. الفارق بين الحالتين ليس في عدد الحناجر ولا في قوّة الشعارات، بل في وجود مُسنَد واضح، وقناة تحويل، وكلفة تُفرض على الخصم، واستمرارية تُراكم الفعل.
وهنا يعود بنا الشعار الكبير إلى نقطة البدء: الشعب يريد. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بعد عقد وأكثر من الهتاف هو: هل أراد الشعب حقاً ما يهتف أنه يريده، أم اكتفى بلذة الإرادة وهي تُقال؟ وأي شارع نريد اليوم: شارعاً يُسنِد الفعل ويضاعف أثره، أم شارعاً يريحنا من عبء الفعل ثم يتركنا كما كنّا؟ الفرق هنا لا تصنعه الحنجرة، بل القناة التي تحوّل الهتاف إلى تغيير.