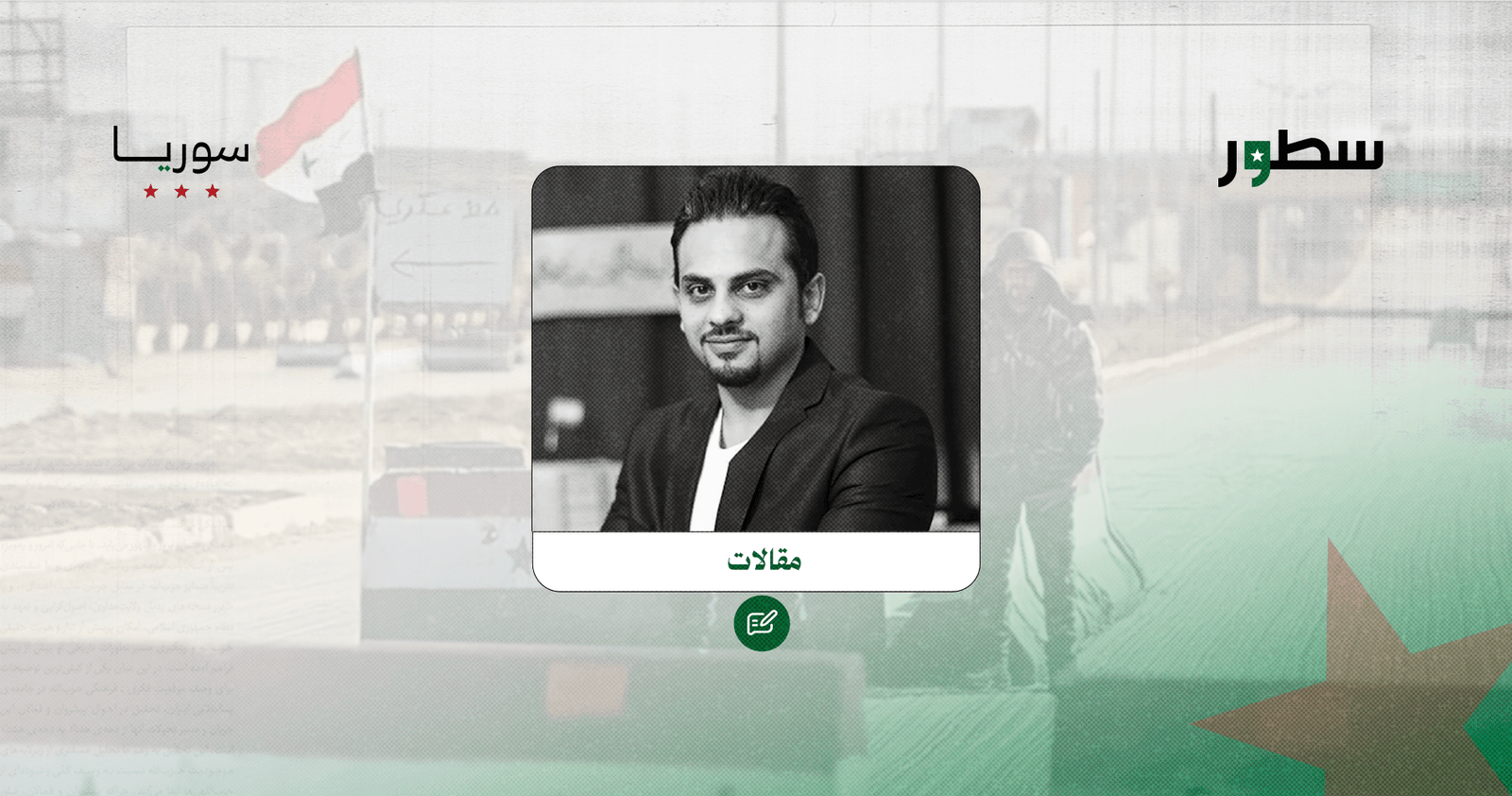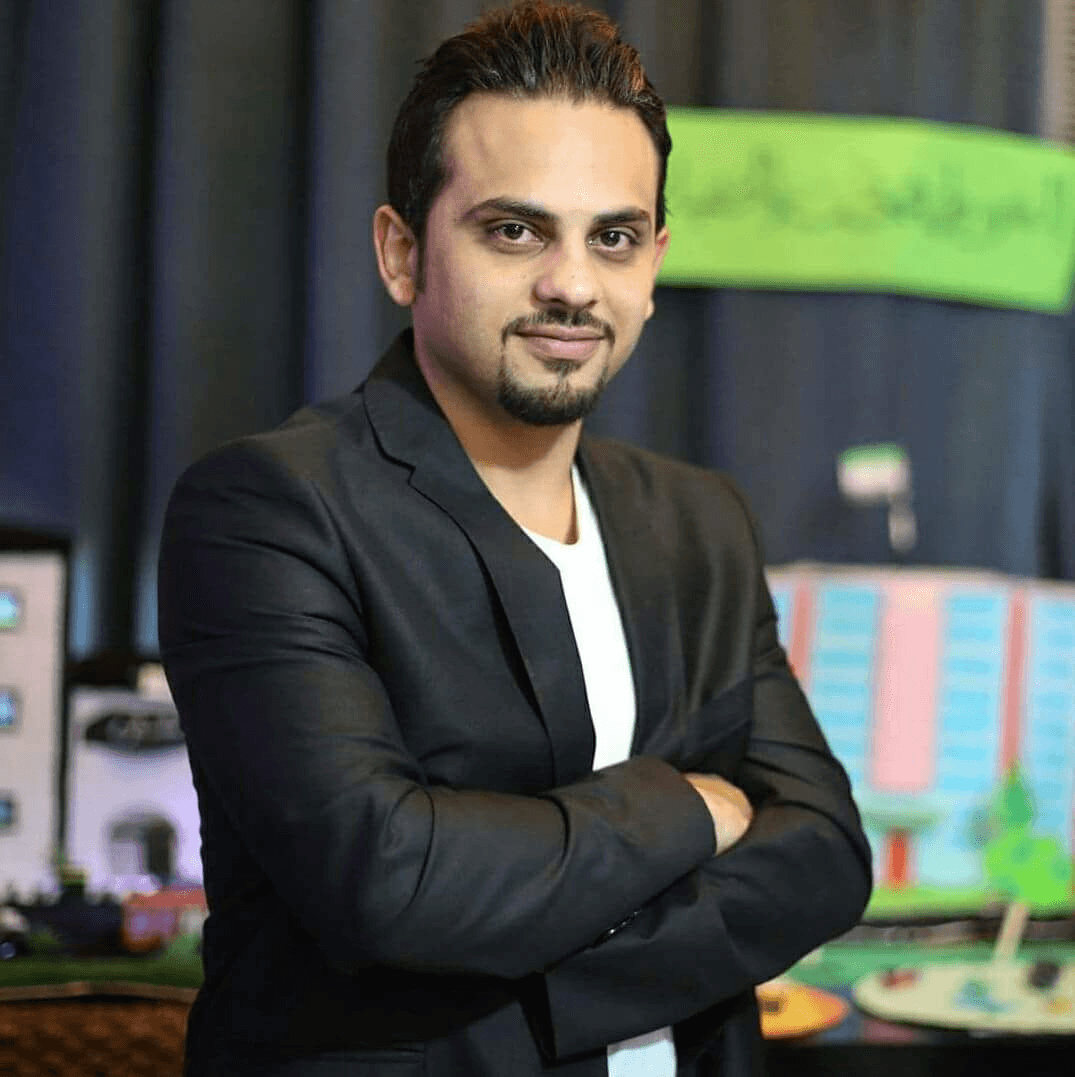مشاركات سوريا
المولية الرقاوية: نشيد الفرات وذاكرة الرقة
المولية الرقاوية: نشيد الفرات وذاكرة الرقة
على عتباتها يجري الفرات كأنه يتلو آيات من الشعر السرمدي، وعلى ضفتها الأخرى تهب الريح على وجه السهل، تذرّي سنابل القمح مبعثرة شذرات الذاكرة. هناك ولدت “المولية الرقاوية”، ليست فناً غنائياً فحسب، بل أسطورة تُروى ومرآة تعكس وجدان مدينة تقف دوماً على تخوم السلام والقتال، الحب والحرب، الوجد والفقد، النخيل والتراب.
النبض الأول: من أين جاءت المولية؟
لا توجد حتى الآن مصادر موثقة رقمياً أو أكاديمياً تشرح تاريخ “المولية الرقاوية” كظاهرة غنائية شعبية، إذ يعتمد معظم ما يُتناقل عنها على التراث الشفهي، التسجيلات الشعبية، والمعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
تعود بدايات المولية الرقاوية إلى مزيج من تأثيرات البادية والريف الفراتي، حيث غنى الناس لتسكين تعبهم ومناجاة الحبيب البعيد من خلال بيت شعر يُردّد مراراً وتكراراً، كأن في التكرار شفاء أو صبراً.
إلا أنه يمكن القول إن المولية الرقاوية نشأت في القرنين الثامن عشر أو التاسع عشر مع استقرار المجتمعات الريفية حول نهر الفرات في محافظة الرقة، ويعتمد هذا التقدير على ارتباطها بالتقاليد الفلكلورية لأهل المنطقة، لا على وثائق مكتوبة تحدد زمن بدايتها بدقة.
فيما يُرجع بعض مؤرخي المنطقة ومغنيها أصل المولية إلى العصر العباسي، وتحديداً معركة الأطراف التي شنها الخليفة هارون الرشيد ضد الإمبراطورية البيزنطية عام 782م. فكلمة “المولية” مشتقة من “مولى” بمعنى المعشوق أو السيد، ويروى أنه بعد المعركة جاءت الجواري لتتفقد حال أسيادهن المشاركين فيها، فرأت إحدى الجواري سيدها مقتولاً فأنشدت:
“يما ويلي الهوا يما يا موليا… ضرب الخناجر ولا حكم العدو بيّة”.
إلا أنّ اللهجة المستخدمة في المولية تتعارض مع اللغة المحكية في ذلك الزمن، حيث لم تكن اللهجة المحكية هي اللغة الفصحى، ومع أن أصوات اللغة في تلك الفترة غير موثقة تماماً، إلا أنها لا تتطابق كلياً مع لحن ولغة المولية الرقاوية، فيما يعتبر شعراء المولية، أنها همزة الوصل بين الفصحى والعامية التقليدية.
كانت المولية في أصولها بيتاً شعرياً واحداً يُقال في المجالس بين نساء وسادات القبيلة. يُعاد ختام الجملة ترديداً حتى يطرأ التلوين الصوتي، وتُضاف اللطائم الإيقاعية على الدفوف والبَزز “الزمارة” والرُّبابة، فتتحول الأغنية من لحنٍ بسيط إلى دالّة عاطفية. مع الزمن تحولت المولية من عزاء إلى احتفال، وغدت جزءاً من الأعراس والمجالس وطقوس البكاء أو الفرح، حتى أنها أصبحت ميزاناً لعذوبة الصوت، وميداناً يتبارى فيه الرجال والنساء على حد سواء.
سمات المولية
تُكتب المولية رباعية الأشطر، محرفة على البحر البسيط ممزوجاً ببحر الهزج، دون أن يكون تفعيلة ضابطة، حيث يُمدّ ويقصر تبعاً للحن ولملئ الزمن الموسيقي، وتنتهي الأشطر الثلاثة الأولى في المولية بقافية واحدة، ويختم الشطر الأخير بياء مشددة وتاء مربوطة “ية”. تعتمد المولية أساساً على ألحان أحادية (مونوفونية) مع تكرار الجملة اللحنية، وتُغنى على مقامات متنوعة، أشهرها مقام الحجاز الذي يتميز بنغمة حزينة وعاطفية تناسب التعبير عن الشوق والوجد، كما تُغنى على مقام الصبا والراست.
ومن أشهر أبيات المولية:
من عرك خدو لأشم واضمير بالجودي
ضليت برجو الدرب لمن ذبل عودي
دنياك يا صاحبي عثرات وسعودي
وكل من ذلولو اعبرت واني عرجت بية
منْ عَرَكْ خَدْدُ / لأَشِمْ وضميرْ بَلْجووْدي = مفاعيلن / مفاعيلن مفاعيلن تقريباً، مع حذف حركة ومد أخرى لاتمام اللحن.
ضَلّيت برجو / الدربْ لمن ذبلْ عوْدي = مفاعيلن / مفاعيلن مفاعيلن، اللهجة أضافت مدود قصيرة مثل “ضليييت” لتكملة الزمن.
دنياكْ يا صا / حبي عثراتْ وسعوودي = مفاعيلن / مفاعيلن مفاعيلن، المَد في “سعوودي” يعوّض أي نقص.
وكُلْ من ذلولو / اعبرتْ واني عرجتْ بِيّهْ = مفاعيلن / مفاعيلن فعولن، هنا يخرج البيت قليلاً عن الوزن، وهذا أمر مألوف في المولية لأن البيت الأخير يُرخى إيقاعه للتسليم اللحني.
أبرز أعلام المولية الرقاوية
كونها شعراً شعبياً لم يُوثّق بدقة، تعاقبت عبر السنين أسماء فناني المولية الشعبيين، إلا أن من تم توثيقهم هم الذين حُفظت تسجيلاتهم بعد اختراع أشرطة الكاسيت، والذين أنقذوا هذا الفن من الاندثار. من أبرزهم الفنان محمد الذخيرة، الذي توفي عام 1975م ويُعتبر من رواد كتابة المولية، إضافة إلى محمد الحسن وشقيقه حسين الحسن. كما يُذكر الشاعر عبد الكريم الخلف الملقب بـ “قيثارة الفرات”، ومن المعاصرين يوسف حسين الحسن وأخوه عبد الله وزيد محمد الحسن.
المولية في الشتات
مع تهجير آلاف من أبناء الرقة، حملوا معهم المولية في الذاكرة واللسان، فأصبحت تترنم في المنافي، ترددها خيام اللجوء، وتنساب على أرصفة الانتظار. لم تَعُد المولية مجرد أغنية، بل تحولت إلى رابط خفيّ يجمع الشتات ويعيدهم إلى جنتهم، ومواسم الحر التي لا تُنسى. في كل نغمة، تنبض روح المدينة المغتربة، وتتجسد قصة الألم والصبر، والحنين الذي لا يفارق قلوبهم، فتُصبح المولية ملاذاً وسلوى، شاهدةً على تاريخ شعبٍ تمزقه النكبات، لكنها تبقى متمسكة بأصالة جذورها وحكاياتها التي لا تموت.
مهددة.. لكنها لا تموت
ورغم محاولات بعض الأصوات في الحفاظ على هذا الإرث الثمين، تظل المولية عرضة للنسيان بسبب غياب التوثيق الرسمي المنظم. لا توجد كتب أو أرشيفات كاملة تحفظ هذا الفن، بل تقتصر المصادر على تسجيلات متناثرة، وفيديوهات لهواة، توثق الأداءات الحيّة والمتوارثة.
ومع ذلك، يبقى سر حيويتها أنها متجذرة في حياة الناس، في بيوتهم، في أفراحهم وأحزانهم، في بكاء عفوي لا يُدرّس في المعاهد، ولا يُنتج بمعامل. المولية حية لأنها تعبير صادق ينبع من وجدان المجتمع نفسه، فتستمر في التنفس مع كل نبضة شعور وألم وفرح.
المولية لغة الحب والحزن والفرح، ليست لحناً عابراً، بل مرآة للهوية وجذور الانتماء. رغم أن اللهجة المستخدمة فيها قد تبدو صعبة على غير الناطقين بها، يكفي أن تستمع إليها مرة واحدة لتقع في عشقها، فتكشف لك عن عمق المشاعر وأصالة التعبير التي تنبع من وجدان أهلها.