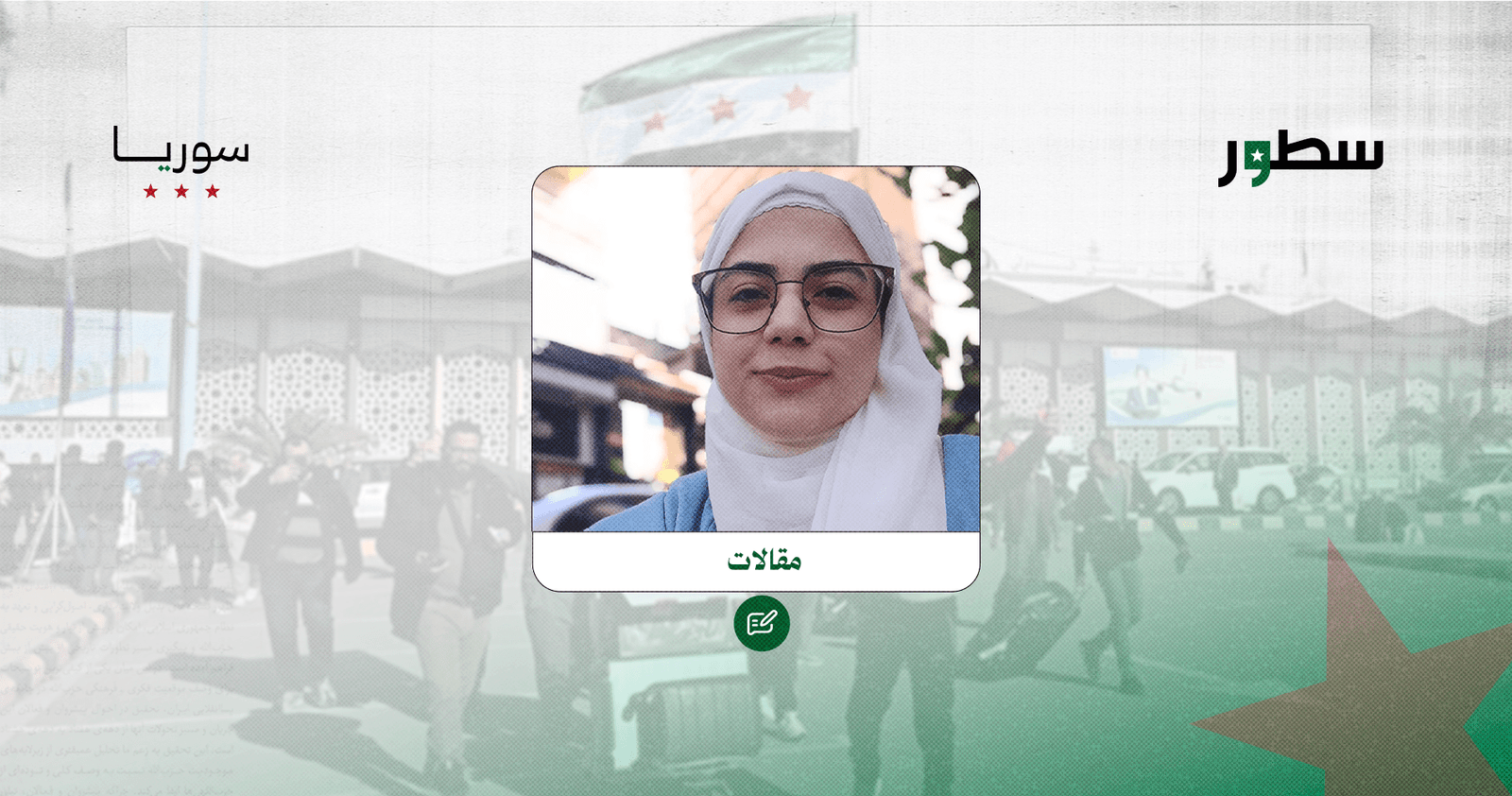أدب
لا دماء في مواجهة اليوم
لا دماء في مواجهة اليوم
أخذتنا مُجازفةُ الثورةِ السوريّةِ إلى مواجهةٍ ضروريّةٍ مع الحياةِ، من حيثُ تموضعْنا فيها ومعَها، وصياغةِ تعاريفَ للمعاني في ظلّها. لِطبيعةِ الوجودِ الجديدِ؛ أَلَمٌ مُحْتومٌ، ففي الأصلِ كلُّ جديدٍ يَكسِرُ القيدَ والتقليدَ مُلطَّخٌ بدمِ خيارِه الموعودِ بالحرّيّةِ والنورِ.
كان على الإنسانِ السوريِّ الذي أدرَكَ سُبُلَ التغييرِ، وأنْ لا طُرُقَ ولا طريقةَ للحياةِ دونَ معرفةِ الموتِ، والمرورِ بدهليزِه، وأُلْفَته كصديقٍ ثالثٍ في الحصارِ، حَفِظَ تراتيبَ صوتِه من الأشدِّ رُعبًا إلى المُحتملِ. والأصعبُ تَقبيلُه على جبينِ الحبيبِ..
كلُّ ذلك، ضمنَ مَقدِرةِ النفسِ على تحمُّلِه، فالإنسانُ في ساحةِ النزالِ المستمرِّ المفتوحِ على جبهاتٍ عدّةٍ: الجوعِ، القتلِ، النزوحِ، والوداعِ، يجدُ نفسَه مُلزَمًا بالطريقِ المشتركِ، والوجعِ المشتركِ، والدمِ الجمعيِّ. وعن الثابتِ في الثورةِ والمُتأصِّلِ في فلسفتِها الحياتيّةِ، لكلِّ الثائرينَ والثائراتِ حقُّ الحُزنِ والثأرِ، وحملُ سرديّةِ مَن لا سرديّةَ لهم، لكلِّ الثوّارِ حقٌّ في الحزنِ على الغائبِ وإنْ لم يعرِفوه، وحقٌّ في الرثاءِ والبكاءِ، فما كانت الكلمةُ والدّمعةُ لأجلِ خسارةِ اليومِ فحسب. حَدا دمعُنا بنا حتى اسودّت بصيرتُنا، وزرعَ حَرفُ ترتيلةِ الوداعِ الأخيرةِ خَنجَرَه في خاصرةِ مُتعةِ العُمرِ المُتبقّي.
على ما مرَّ، لم يكنْ للجُرحِ أنْ يتعفَّنَ، ولا للشخصيّةِ أنْ تضطربَ، وتظهرَ عليها تَقَرُّحاتٌ لغويّةٌ ونفسيّةٌ؛ لولا محاولةُ النِّظامِ النّاجحةُ في اقتلاعِ صاحبِ الجُرحِ وقصّتِه من أرضِه. في المنفى؛ داخلَ البلادِ (الشمالِ السوريِّ) أو خارجَها، مع مواجهةِ واقعٍ وحقيقةِ التَّهجيرِ القسريِّ، جَرَّبَ/ جَرَّبَتِ المُهجَّرونَ قَسرًا طُرُقَ التَّأقلمِ الجديدةَ، على ما وصفوه وجاءَ في مذكِّراتِهم، واقعُ التَّهجيرِ لم يكنْ أريحَ من ماضيهم القريبِ، وحصارٌ في الذّاكرةِ لا يَنفكُّ بالبعدِ عن مسرحِه الأوّلِ. في الأرضِ قبلَ التَّهجيرِ، أنتَ لستَ مُضطرًّا للبحثِ عن هويّتِك، أو أنْ تحمِلَ عبءَ الدَّمِ بعدَ سُقوطِه، ببساطةٍ لأنّك هنا، مع الدمِ، أمامَ المواجهةِ الأولى، مع طَيفِ الراحلِ.
هويّتُك في النَّظراتِ المعروفةِ، والذّكرياتِ التي عَلِمْنا مؤخرًا بصفتِها ذكرى لن تعودَ، حتى مع عودةِ البلادِ. الاقتلاعُ فَرَضَ أقصى “الممكنِ” لبناءِ إنسانٍ سوريٍّ جديدٍ، هويّتُه: مهزومٌ نفسيًّا، مُشوَّهٌ في هوامشِ حياتِه الاجتماعيّةِ والعاطفيّةِ، يجرُّ قصّتَه الثقيلةَ خلفَه في كلِّ مجلسٍ، ليقولَ دونَ حُمولةِ اللُّغةِ المُقتلَعةِ من جذورِها الرَّطبةِ: أنا من هناكَ. يَخونُه عنقُه انحناءً في حضرةِ الأسماءِ وذِكراها، ويشتعلُ بُؤسًا وحِقدًا عندَ حقيقةِ المنافي، حتى المنفى يضعُكَ على مِقصلةِ الفقدِ والمواجهةِ.
لنعودَ قليلًا لفهمِ تركيبةِ الإنسانِ السوريِّ أمامَ أفقٍ سوداءَ واسعةٍ من المواجهاتِ، في الأولى: حالمٌ، ثائرٌ، مجنونٌ، وعاشقٌ. في التعاريفِ التي صاغَها للحياةِ والموتِ، شقَّ العاديَّ المتوارَثَ في الحُبِّ وعنِ الحُبِّ، كتبَ قصيدتَه الغزليّةَ الأولى للشهيدِ، ونظرتَه الخاطفةَ للمحبوبةِ عندَ زخِّ الرصاصِ. نعم للحُبِّ دون “مصاري وأراضي”، فالثورةُ هي أرضُ مَن لم يعرِفِ الانتماءَ يومًا، الثورةُ عزوةٌ وعشيرةٌ، مُفارِقُ الجاهةِ والقيدِ المشؤومِ، والحريّةُ أبلغُ مقاماتِ العِشقِ.
في الصرخةِ الأولى، الطَّلقةِ الأولى، في كلِّ المرّاتِ الأولى من حياةِ الثورةِ السوريّةِ، أدركَ مَن ركبَ سفينتَها المُبحِرةَ في عتمةِ المجهولِ، أَثْمَنَ الانتفاضةِ الكبرى في النفسِ قبلَ المجتمعِ. ثَمَّةَ سحرٌ، مفعولُه سارٍ بين أجيالِ الثورةِ المتصاعدةِ، لا كبيرَ يَعلوهم السحرُ، والعصا هي نفسُها عصا، والأفعى بسمِّها أفعى، تسعى لتَلدغَ كلَّ مُبصرٍ حالمٍ. إلّا مَن مسَّه أذى الحريّةِ، وجنونُ الأوطانِ التي تعرفُ الكرامةَ، لا يخشى موعدَه بأيِّ سبتٍ كان، مسحورٌ، مجنونٌ، أو حتى شاعرٌ، لا يهمُّ في وجهِ انتزاعِ اليقينِ الرديءِ، لا يهمُّ أمامَ صيرورةِ “الأبدِ”، يكفي أنْ تقفَ، حتى يعلَمَ الشاهدُ على الحيادِ ضرورةَ الجنونِ في فتراتِ الاستبدادِ، وجدوى السحرِ في نزعِ غشاوةِ الأعينِ.
أضعْنا سفينتَنا، ولا جوديَّ في الحسبانِ. علَّقْنا مراثيَ الثورةِ على حيطانِ المبكَى لكلٍّ منّا. ولا الغفرانُ يَهتدي ليرحمَ ضعفَ إنسانٍ قال: لا، في وجهِ وحوشِ الأرضِ. ابتلعْنا محيطَ النجاةِ، أصابتِ الغربةُ مَن نجا بأزمةٍ وجوديّةٍ أودتْه قتيلَ حلمِه. وعن هذه المرحلةِ، بتْنا نختبئُ على غيرِ العادةِ من المواجهةِ، نسمعُ ونقرأُ من القريبِ والبعيدِ، مَن يلمزُ ومَن يجهرُ بكلامِه الفظِّ عن “جدوى وضرورةِ” المواجهةِ من أصلِها. يُعزّي مجروحٌ، مجروحًا آخرَ؛ بأنّهم عرفوا الجوابَ على ما فيه من وحشيّةٍ وشراسةٍ، فضَّلوا الإجابةَ الصحيحةَ، لأجلِهم، لأجلِ أولادِهم، لأجلِ دماءٍ طريةٍ فوقَ ذاكرتِهم. لكي لا نموتَ خجلًا من أنفسِنا.
في الثامنِ من كانونَ الأوّل/ ديسمبر 2024، ومع الاصطدامِ الزمنيِّ التاريخيِّ الفارِقِ بحياةِ مَن عبَروا إلى الضفّةِ الأخرى، حيثُ مَبلَغُ الأحلامِ. في لحظةٍ لا تَنفكُّ عن الحدثِ الأبرزِ: بدءُ الثورةِ السوريّةِ، 15 آذاد/ مارس 2011، “كان الفتحُ وانكشفَ الغطاءُ” لينكشفَ لنا مع سقوطِ نظامِ الأسدِ، أنّه من الممكنِ للجُرحِ أنْ يلتئمَ، ومن الواردِ في عالمِنا اللئيمِ، أنْ تنزاحَ طبقاتُ العَفَنِ من فوقِ جرحِنا المفتوحِ/المُشتهى لوحوشِ الأرضِ.
الفاصلُ مع حدثِ السقوطِ، نقطةُ الصفرِ مع النفسِ التي اعتادَتِ التمرُّدَ، مع أنفُسِنا في سنواتِ الحربِ، ما اقتصَّ منّا في سنواتٍ جرداءَ، متروكينَ على عيوبِنا وعلّاتِنا، نحاولُ فنعذُرُ، نسقطُ فنكتبُ، وفي نهايتِنا نرتدُّ معطوبينَ على أُهزوجةِ البداياتِ. جاءَ يومُ السقوطِ بسيلٍ من الأسئلةِ لا غِمدَ لها، وتبِعاتٍ مفاجئةٍ لمَن نذرَ حياتَه للثورةِ ولم يجرؤْ على مغادرةِ جوفِ الحياةِ الثوريّةِ خشيةَ الضياعِ. أسئلةٌ تحملُ تلميحاتِ الجوابِ. للثامنِ من كانونَ الأوّل وما بعدَه؛ نمطُ العاديِّ، الأنماطُ العاديّةُ في الفرحِ، الحزنِ، الارتباطِ، والمعيشةِ.
العاديُّ عدوُّ المتمرّدينَ، اليائسينَ. صباحاتُ المدنِ العاديّةِ، المملوءةِ بالمعاناةِ العاديّةِ أيضًا، والأصواتُ المتعارَفُ عليها دونَ جديدٍ في السماءِ يقتلُ، ومقتول في الأرضِ منزوع الأشلاءِ.
لتقبَلَ واقعَك اليومَ، ليس بالسهلِ، أوّلًا: عليكَ المشي حيثُ ودّعتَ شهيدَك الأوّلَ وليس الأخيرَ، ثانيًا: واجهْ مكانَ صدمتِك الأولى، حين شهقتَ مرحِّبًا بالموتِ لو لم يخطئْ طريقَه، ثالثًا: ازرِفْ دمْعَك على لحدٍ غيرِ متكمّلٍ، على وداعاتٍ لم تُسجَّلْ في الصحفِ، على قبورٍ دونَ شواهدَ، ومقابرَ شابَ آسُهَا دونَ اسمٍ وساقي. رابعًا، وخامسًا، وعاشرًا: لا دماءَ في مواجهةِ اليومِ، واجهْ صفةَ الواقعِ الجديدةَ، واعترفْ بأنّك مررتَ بشيءٍ مشابهٍ، هو أنتَ قبلَ أن تختارَ معركتَك. واحفَظْ ذاكرتَك تحفظْك من نسيانٍ يُساوي الوجوهَ بعضَها ببعضٍ، فلا دهرَ بعدَ التحريرِ يُقاسُ بأيّامٍ معدوداتٍ قضيتَها في وللثورةِ السوريّةِ.