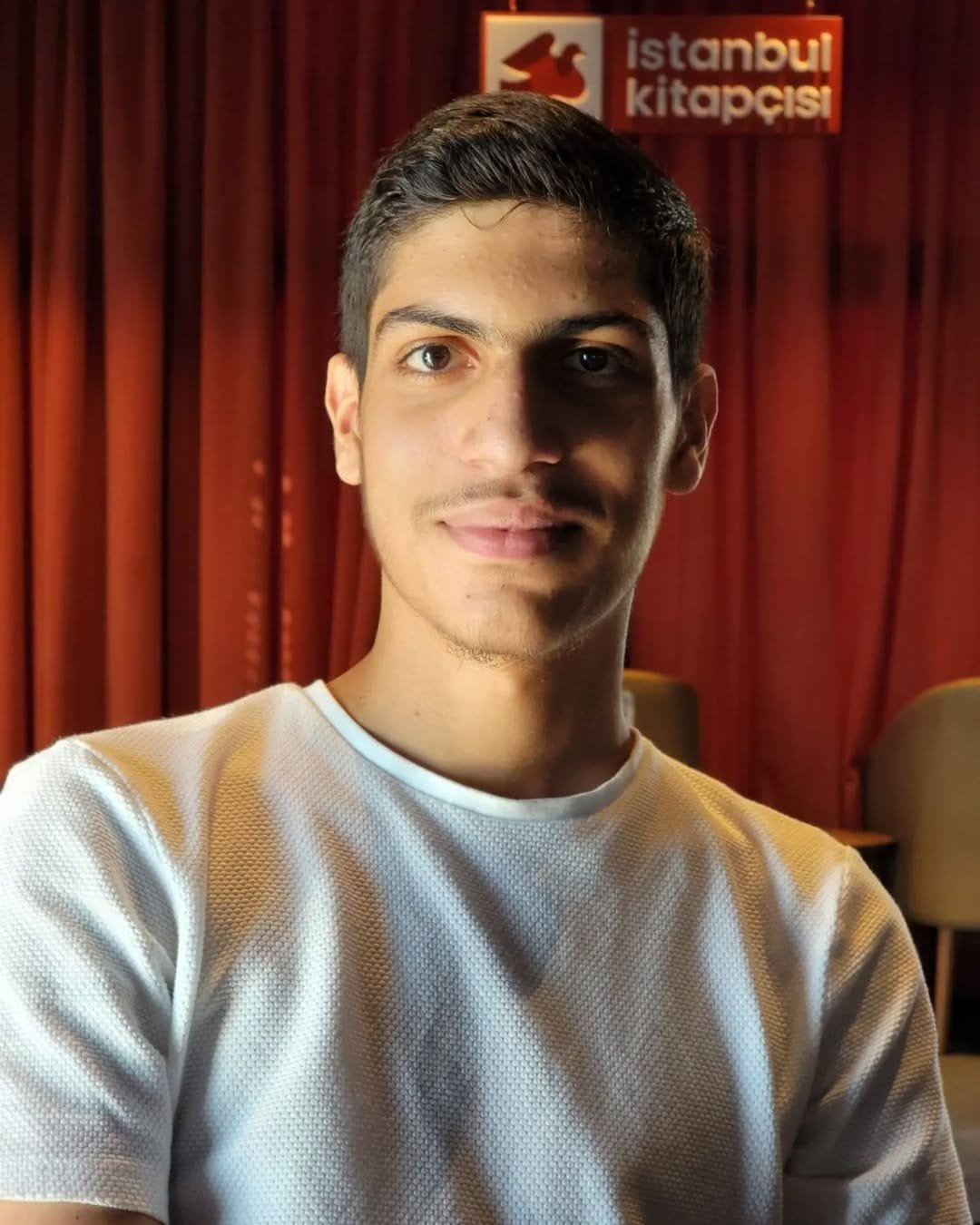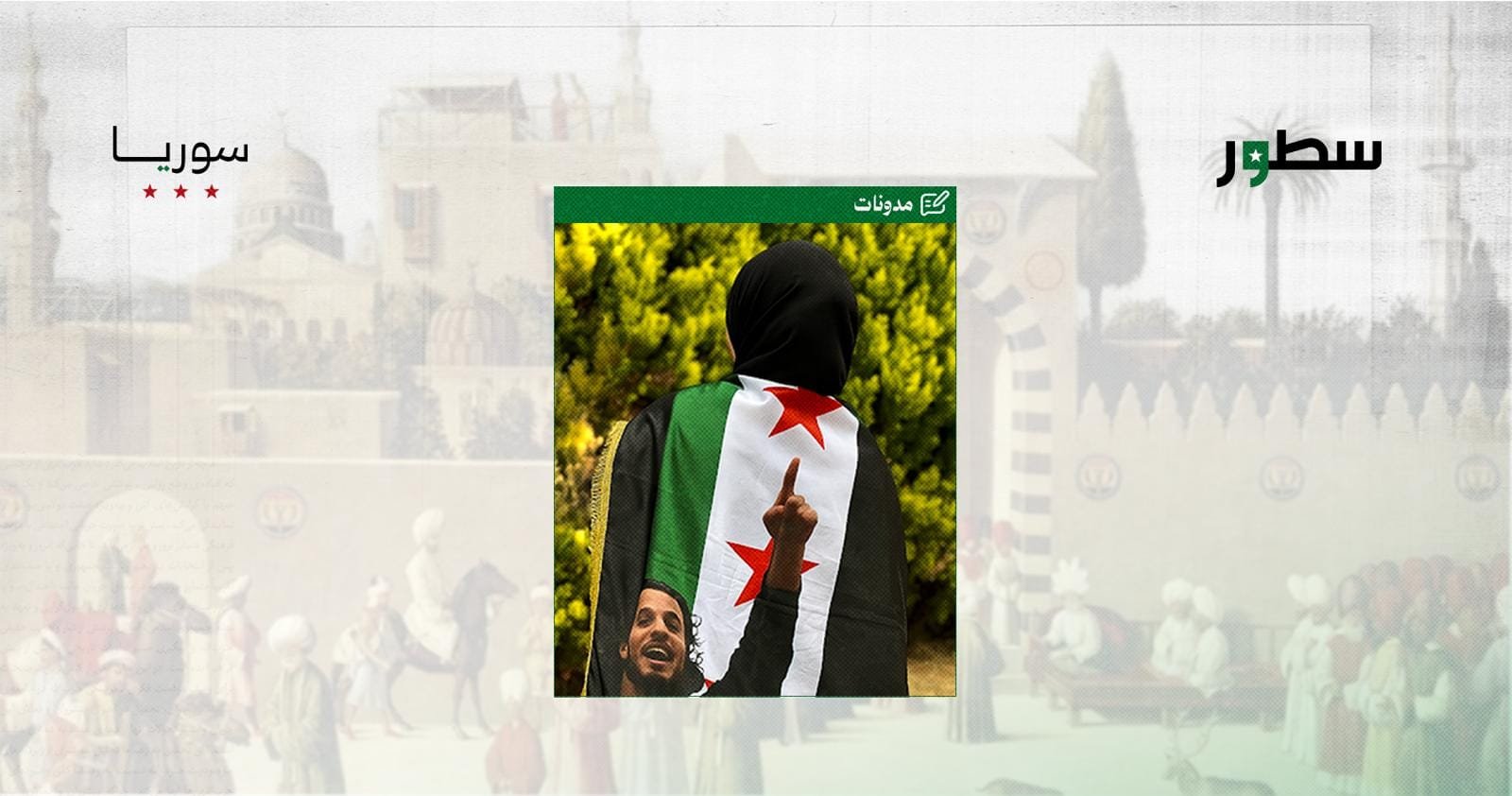مجتمع
حراس الأبواب المغلقة: المثقف السوري في زمن العجز
حراس الأبواب المغلقة: المثقف السوري في زمن العجز
في أمسية ثقافية أقيمت مؤخراً في مدينة أوروبية، كان الحديث يدور حول “الذاكرة الجماعية” في الحروب. حضر مثقفون سوريون بارزون، وتبادلوا الآراء حول أهمية التوثيق والحفاظ على التراث، لكن أحداً لم يأتِ على ذكر الثورة أو الجريمة السياسية التي فجّرت هذا الخراب. كان الصمت أثقل من الكلمات، وكأن الجميع اتفق ضمنياً على إبقاء الباب مغلقاً. من الخارج، بدا المشهد أنيقاً ومهنياً؛ من الداخل، كان يختزن تناقضاً صارخاً بين ما ينتظره الجمهور من المثقف، وما يقدمه بالفعل.
منذ اندلاع الثورة السورية، وُضع المثقف أمام اختبار غير مسبوق: أن يكون صوته امتداداً لصرخة الناس، أو أن يتوارى وراء الحياد والعموميات. في البدايات، انخرط كثيرون في الكتابة والتحريض والنقاش، حاملين الأسئلة الكبرى عن الحرية والعدالة والمستقبل. لكن مع الزمن، ومع تراكم القمع والانقسام، بدأ حضور المثقف يتراجع من موقع الفاعل إلى موقع الشاهد الصامت، ثم إلى دور أخطر: حارس الأبواب المغلقة، الذي لا يفتح أسئلة ولا يسمح لغيره بفتحها.
هذا التحوّل لم يكن محض خيار فردي، بل انعكاساً لبنية كاملة من الضغوط والخسارات والانهيارات. القمع المباشر، وغياب الأطر التي تحمي المثقفين، والانقسامات الحادّة، إضافةً إلى الإغراءات التي تمنحها المؤسسات المانحة أو السلطات المضيفة، كلها عوامل ساهمت في إحالة المثقف من حامل للمسؤولية الفكرية إلى موظف في إدارة الصمت. في هذا المقال، نحاول تفكيك هذا المسار، وفهم كيف تحوّل المثقف السوري من “مفتاح للأبواب” إلى “حارس يمنع فتحها”، وما يعنيه ذلك لمستقبل الوعي في بلد جُرّد من أدواته النقدية.
الصمت يبتلع الفرصة
كانت لحظات التحوّل الكبرى في حياة الشعوب هي اللحظات التي يُختبر فيها المثقف على نحو حاسم. منذ أن كتب أنطونيو غرامشي عن “المثقف العضوي” بوصفه جزءاً من البنية الاجتماعية، لا مجرد مراقب، وحتى تعريف إدوارد سعيد للمثقف بأنه “الهاوي الذي يقف في وجه السلطة باسم القيم الكونية”، ظلّت الفكرة المركزية أن المثقف في أوقات الأزمات لا يملك ترف الصمت. بل هو معني بتأطير اللحظة، وتحويل الغضب الشعبي إلى وعي منظّم، وربط المطالب الآنية برؤية بعيدة المدى.
مع اندلاع الثورة السورية، بدا أن هذه اللحظة قد وصلت أخيراً. فجأة، أصبح الشارع السوري الذي طالما عُزل عن السياسة منفتحاً على الأفكار الجديدة، باحثاً عن خطاب يفسّر له معنى الحرية ويقترح طريقاً للوصول إليها. ظهرت في تلك الفترة مبادرات ومراكز أبحاث مستقلة، ومجلات ومواقع إلكترونية، ودوائر نقاش علنية كانت حتى الأمس القريب من المحرّمات.
لكن هذه المبادرات، رغم أهميتها، عانت منذ البداية من ثلاثة أمراض قاتلة: الهشاشة المؤسسية، وضيق القاعدة الاجتماعية، وتشتت الأجندات. فغياب الحماية القانونية والتنظيمية جعلها عرضة للإغلاق أو الاستهداف، وضعف الموارد حصر نشاطها في نطاق محدود، بينما التباينات السياسية بين أعضائها سرعان ما قادت إلى انقسامات وشلل. ومع تصاعد القمع، لجأ كثير من المثقفين إلى المنفى، وهناك، بدلاً من أن تتحول الجغرافيا الجديدة إلى مساحة آمنة للابتكار الفكري، تكرّر المشهد نفسه: مبادرات صغيرة، صوتها عالٍ في البداية، ثم تخفت تدريجياً حتى تختفي.
الجمهور الذي كان يتطلع إلى المثقف كقائد للرأي وجد نفسه أمام لوحة مشوشة: أصوات متحمسة ثم متراجعة، مواقف أخلاقية قوية سرعان ما تبخرت أمام ضغط الواقع، وأحياناً، صمت مطبق يبرر بحجج “الواقعية” أو “الحفاظ على ما تبقى”. ومع ضياع هذه اللحظة التاريخية، تُركت الساحة لخطابات أكثر تبسيطاً أو أكثر تطرفاً، فيما انسحب المثقف عن وعي أو عن عجز إلى الهامش، مفسحاً المجال لآخرين يعيدون تعريف الحاضر والمستقبل بمعزل عنه.
من الصوت إلى الصمت
لم يكن انحسار صوت المثقف السوري مجرّد استجابة مباشرة للقمع، بل كان نتيجة مسار طويل ومعقّد. في السنوات الأولى من الثورة، بدا كأن المثقف يعيش ذروة تاريخه: يكتب علناً ضد الاستبداد، يشارك في المؤتمرات والبيانات، ويخاطب جمهوراً متعطشاً للفكرة قبل الشعار. كانت الكتابة في تلك المرحلة تحمل حرارة اللحظة وجرأتها، وتتحمل تبعاتها كاملة.
لكن مع توالي الخسارات الميدانية والسياسية، تغيّر المشهد. الانكسارات الكبرى تركت أثراً نفسياً عميقاً، حتى لدى من عاشوا خارج البلاد. تحوّل الحماس إلى حذر، والحذر إلى تردّد، ثم إلى صمت مبرَّر بعبارات تبدو عقلانية: “ليس الوقت مناسباً”، “الأولويات تغيّرت”، “يجب أن نحافظ على ما تبقى”. بالنسبة للبعض، كان الصمت خياراً ذاتياً للحفاظ على الذات بعد إنهاك طويل؛ وبالنسبة لآخرين، كان استجابة لضغوط مباشرة من الممولين أو المؤسسات أو حتى من جمهور بات أكثر تقبّلاً للخطاب المهادن.
هذا الانكفاء ترافق مع تغيّر لغوي لافت. المصطلحات التي حملت وضوح الثورة (“إسقاط النظام”، “المحاسبة”، “العدالة”) تراجعت لصالح مفردات أكثر ضبابية (“الإصلاح”، “الاستقرار”، “العيش المشترك”). لم يعد المثقف يتحدث عن الجرائم بوصفها وقائع سياسية واجبة المحاسبة، بل عن “الأحداث” و”التجارب” و”الدروس المستفادة”. هذا التلطيف لم يكن بريئاً، بل كان في كثير من الأحيان محاولة لتجنّب كسر خطوط حمراء رسمتها سلطات الأمر الواقع أو مؤسسات الدعم.
وفي المنفى، حيث كان يُفترض أن يتحرر المثقف من الرقابة، واجه رقابة من نوع آخر: شروط تمويل، اعتبارات دبلوماسية، وحسابات البقاء الشخصي. حتى الفضاءات التي جمعت المثقفين في البداية، من مؤتمرات ومنصات إعلامية، تفككت بفعل الانقسامات الأيديولوجية أو صراعات النفوذ داخل المعارضة. ومع غياب المساحات المشتركة، انسحب المثقف من المجال العام، مفضّلاً الاكتفاء بأنشطة ثقافية معزولة لا تمسّ جوهر الصراع.
هكذا، وجد نفسه قد فقد أهم ما يميّزه: حرية طرح الأسئلة الصعبة. لم يعد صانعاً للأسئلة، بل متلقياً لما يُسمح بطرحه، يردده بقدر ما يضمن له البقاء في المشهد، حتى لو كان المشهد وهمياً.
حراسة الأبواب المغلقة
حين يختار المثقف الصمت، فذلك شأن شخصي يمكن تفهّمه في ظل القمع أو الخوف أو الإنهاك. لكن الأخطر هو أن يتحوّل هذا الصمت إلى موقف معلن، وإلى وظيفة غير مكتوبة: حراسة الأبواب المغلقة. هنا لا يكتفي المثقف بالامتناع عن طرح الأسئلة، بل يمنع غيره من طرحها، ويمارس دوراً رقابياً باسم الواقعية أو الحفاظ على وحدة الصف أو “عدم استفزاز” الجهات المهيمنة.
يمكن رؤية هذا النمط في الكثير من الندوات والفعاليات الثقافية السورية في الداخل والخارج، حيث يحرص بعض المثقفين على ضبط النقاش ضمن حدود آمنة: لا كلام مباشر عن المسؤولية السياسية، ولا ذكر للأسماء التي قد تثير حساسية، ولا ربط بين الثقافة والحدث السياسي الجاري. يتحول الحوار إلى منطقة منزوعة السياسة، رغم أن موضوعه قد يكون عن الحرب أو الذاكرة أو العدالة. وفي أحيان كثيرة، يُقاطع المتحدثون أو يُصحَّح كلامهم إذا اقترب من “الخط الأحمر”، وكأن مهمة المنصّة لم تعد فتح الأبواب بل التأكد من بقائها مغلقة.
هذا الدور، وإن كان في ظاهره حرصاً على السلامة أو على استمرار النشاط الثقافي، فإنه في جوهره إعادة إنتاج لشروط الصمت التي فرضها الاستبداد لعقود. الفرق أن الحارس هنا ليس رجل أمن بلباس رسمي، بل مثقف بلباس مدني، يحظى باحترام جمهوره ويُنظر إليه كصاحب خبرة وحكمة. وهو ما يجعل مهمته أكثر خطورة: لأنه يُضفي شرعية ثقافية على إغلاق الأبواب، ويقنع الجمهور بأن هذه الأبواب لا تستحق الفتح أصلاً.
بهذا المعنى، يتحول المثقف الحارس إلى جزء من منظومة إدارة الأزمة لا من منظومة حلّها. لا يقدّم رؤية بديلة، ولا يطرح مشروعاً، بل يدير الفراغ بمهارة، ويضمن ألا يتسرّب منه ما قد يهدد التوازن الهش القائم. وإذا كان المثقف، في تعريفه الأصيل، هو من يزعج السلطات ويفتح المسارات المسدودة، فإن الحارس الثقافي هو نقيضه تماماً: يطمئن السلطات، ويحرس المسدود.
الأثر على الوعي العام
حين يتحول المثقف من صانع للأسئلة إلى حارس للصمت، ينعكس ذلك سريعاً على الوعي العام. فالجمهور، الذي كان ينتظر من المثقف أن يفتح أمامه مساحات جديدة للتفكير، يجد نفسه أمام خطاب آمن، خالٍ من المخاطرة، يكتفي بإعادة تدوير ما هو متاح سلفاً. بمرور الوقت، يتعوّد الناس على حدود هذا الخطاب، فينشأ جيل كامل لا يعرف أن هناك أبواباً أُغلقت أصلاً، ولا يتوقع من أحد أن يفتحها.
هذا التأثير يتجلى بوضوح في القضايا الكبرى التي تراجعت من النقاش العام أو اختُزلت إلى شعارات فضفاضة. فالحديث عن العدالة مثلاً، تحوّل في كثير من المنابر إلى “أهمية المصالحة” أو “تعزيز السلم الأهلي” من دون التطرّق إلى المحاسبة أو تحديد المسؤوليات. وحتى النقاش حول إعادة الإعمار، الذي يُفترض أن يكون سؤالاً سياسياً وأخلاقياً، بات في بعض الندوات الثقافية مجرّد حديث عن “إعادة الحياة” و”إحياء المدن”، وكأن الخراب الذي حلّ بها كان كارثة طبيعية لا فعلاً متعمداً.
من الأمثلة اللافتة، الفعاليات التي تتناول “الذاكرة السورية” أو “توثيق الحرب”، لكنها تتجنب الإشارة إلى الجهة التي أشعلت هذه الحرب أو ارتكبت المجازر. في هذه الحالات، يصبح المثقف شريكاً في إنتاج ذاكرة ناقصة، تُفرغ الحدث من سياقه السياسي وتحوله إلى مجرد مادة تراثية أو فلكلورية. والنتيجة أن الأجيال القادمة سترث سرديات مشوهة، تركز على الجانب الإنساني العام، لكنها تتجاهل البنية السياسية التي صنعت المأساة.
بهذه الطريقة، يساهم المثقف الحارس في إعادة إنتاج البنية الثقافية نفسها التي مهّدت لزمن الاستبداد: ثقافة تتعايش مع غياب الحقيقة، وتتعامل مع السلطة كحدّ لا يمكن تجاوزه، حتى لو تغيّرت الأسماء والشعارات. إن أخطر ما في هذا الدور أنه يطبع الناس على القبول بالواقع، لا على الرغبة في تغييره، ويجعلهم يرون في الصمت فضيلة وفي الكلام تهديداً.
استعادة دور المثقف
لا يمكن لمجتمع خرج من حرب مدمّرة، وتعرض لتفكيك سياسي واجتماعي بهذا العمق، أن ينهض من دون مثقفيه. لكن هذا النهوض لن يتحقق إذا ظلّ المثقف حارساً على الأبواب المغلقة، يكتفي بإدارة الصمت وتدوير الخطاب الآمن. فالمثقفون، بحكم موقعهم، لا يُقاس دورهم بما يحافظ على الاستقرار الهش، بل بما يزعجه من أجل إعادة بنائه على أسس أكثر عدلاً وحرية.
استعادة هذا الدور تعني العودة إلى الموقف، حتى لو كان مكلفاً، وإلى طرح الأسئلة التي تحاول السلطة، أيّاً كانت، دفنها تحت مبررات “الواقعية” أو “المصلحة العامة”. تعني إدراك أن الثقافة ليست نشاطاً تجميلياً أو وسيلة لتزجية الوقت، بل أداة مقاومة فكرية وأخلاقية. فالمثقف الذي لا يزعج السلطة، ولا يفتح النقاش، ولا يكسر التابوهات، يفرّط في دوره التاريخي، مهما كانت مبرراته مقنعة على المستوى الشخصي.
لقد أثبتت التجربة أن الأبواب التي لا تُفتح اليوم، ستُغلق غداً بإحكام أكبر، وأن الصمت الذي يبدو آمناً في الحاضر، قد يصبح اعترافاً ضمنياً في المستقبل. لهذا، فإن الخيار الحقيقي أمام المثقف السوري ليس بين الكلام والصمت، بل بين أن يكون شاهداً على إعادة إنتاج الخراب، أو أن يكون طرفاً في إعادة كتابة الحاضر. والفرق بين الاثنين هو الفرق بين الحارس والمفتاح.