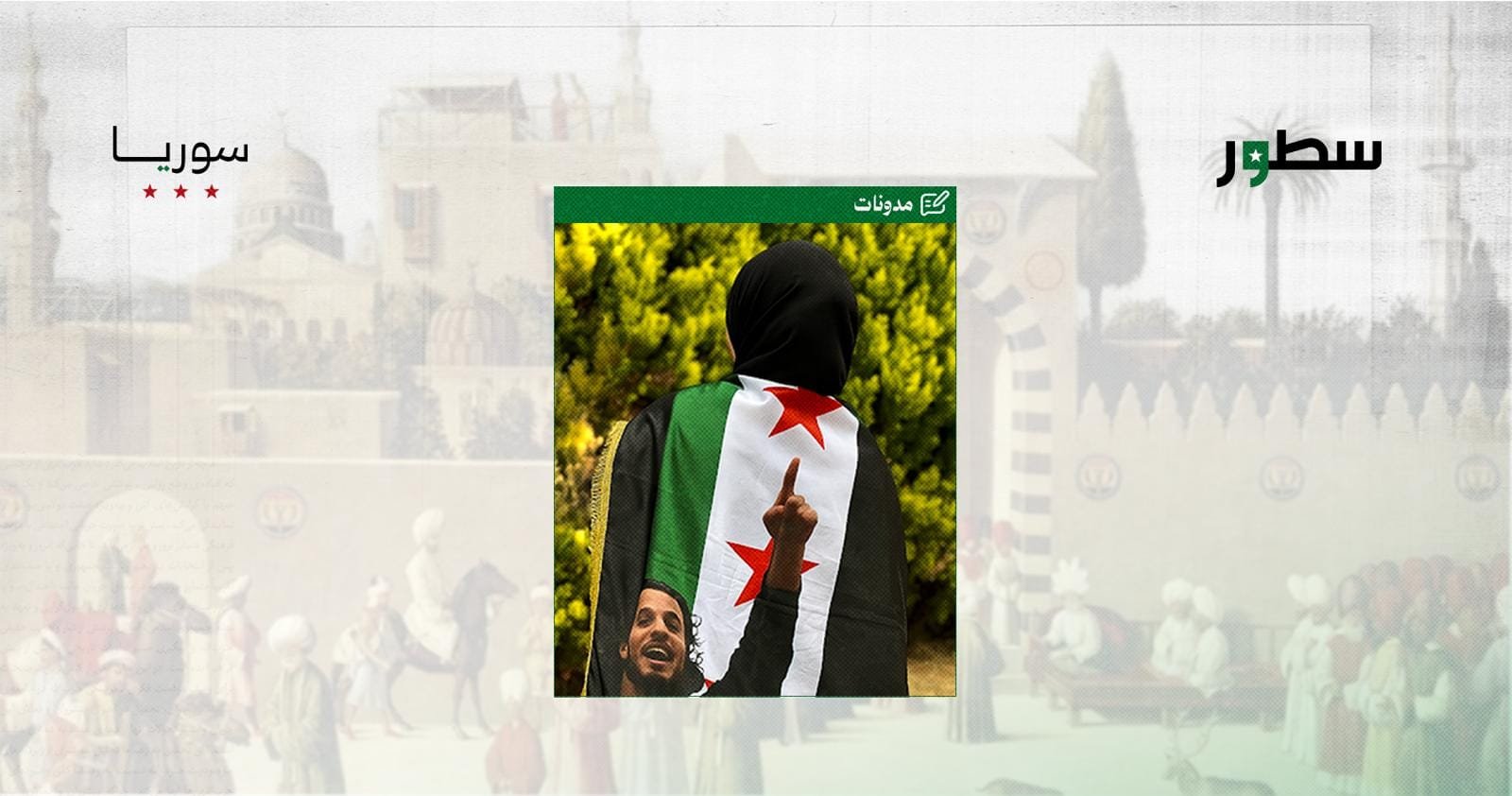سياسة
الخطاب العلماني في سياق الطائفية السورية: بين المشروع الوطني وتكتيك حماية المصالح الفئوية
الخطاب العلماني في سياق الطائفية السورية: بين المشروع الوطني وتكتيك حماية المصالح الفئوية
في إحدى أكثر الفترات تعقيداً وانقساماً في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، انعقد مؤتمر “وحدة الموقف” في مدينة الحسكة، جامعاً ممثلين بارزين من “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق البلاد، إلى جانب قيادة دينية من طوائف متعددة، منها شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى غزال غزال، بالإضافة إلى الشيخ الكردي مرشد الخزنوي، أحد أعلام التيار الإسلامي الصوفي “الطريقة النقشبندية الخزنوية” في شمال شرق سوريا.
ما ميز هذا الحدث وجعله محط اهتمام واسع، هو تبني المشاركين، ومن بينهم رجال دين ينتمون إلى طوائف متعددة، لفكرة تبدو متناقضة مع خلفياتهم التقليدية، تمثلت في الدعوة إلى بناء “دولة سورية علمانية”، إلى جانب الترويج لمشاريع الحكم والإدارات اللامركزية في مناطق مثل شرق سوريا والسويداء والساحل السوري.
رغم التأكيدات المتكررة على الطابع الوطني الجامع للمؤتمر، تسيطر الجهات المشاركة عملياً على مساحات واسعة بالقوة المسلحة، وتعمل خارج نطاق الدولة المركزية، مما يضيف أبعاداً جديدة من التعقيد والتناقض إلى الخطاب العلماني. في مفارقة بارزة، يتبنى ممثلون لهويات طائفية متجذرة خطاباً علمانياً ضمن تكتلات مسلحة مدعومة خارجياً. هذا الواقع الميداني لا يشكل مجرد خلفية سياسية، بل يشكل إطاراً مؤثراً في طبيعة الخطاب السياسي ذاته، إذ تتحول السيطرة العسكرية إلى أداة ضغط تُغذي الخطاب العلماني التكتيكي الذي تسوّقه هذه الجهات.
في ظل هذه التناقضات، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن اعتبار الخطاب العلماني الصادر عن المؤتمر تعبيراً حقيقياً وصادقاً عن مشروع وطني جامع يسعى إلى بناء دولة مدنية حقيقية تتجاوز الانقسامات الطائفية؟ أم أنه، في جوهره، أداة تكتيكية تُستخدم لحماية مصالح فئوية وطائفية داخل مشهد سياسي هش وبنية سورية ما تزال في طور التشكل؟
العلمانية والطائفية: تحديات المجتمعات المنقسمة
تُعتبر العلمانية في جوهرها مبدأً يقوم على حيادية الدولة تجاه الأديان، بحيث لا تخضع التشريعات والمؤسسات العامة لأي انتماء ديني أو مذهبي. وقد نشأت هذه الفكرة في السياق الأوروبي ضمن مشروع بناء الدولة الحديثة، إلا أن تطبيقها وفهمها اختلفا بشكل ملحوظ عبر السياقات العالمية، خصوصاً في المجتمعات التي تتسم بتنوع ديني وطائفي معقد.
لا يقتصر الخطاب العلماني على مجرد فصل الدين عن الدولة، بل يتجاوز ذلك ليشمل تعزيز الحقوق المدنية والحريات الفردية التي تُشكّل الركيزة الأساسية للدولة الحديثة والحكم الديمقراطي. وفي حالات ما بعد النزاع مثل رواندا ولبنان، تم إعادة تقديم العلمانية كأداة استراتيجية لإعادة بناء التماسك الوطني والحدّ من الانقسامات المجتمعية، بحيث لم تعد مجرد فصل تقني بين الدين والدولة، بل وظيفة سياسية واجتماعية حيوية.
في هذه المجتمعات متعددة الطوائف، تتحول العلمانية من حيادية شكلية إلى آلية تضمن المساواة والعدالة بين المكونات الدينية والعرقية، شرط توافر دولة قوية ومؤسسات مستقرة تطبق القوانين بفعالية. وهذا الشرط الحاسم هو ما تفتقر إليه سوريا في الوقت الراهن، حيث يعاني المشهد من غياب الدولة المركزية وضعف المؤسسات.
على النقيض، تستغل الطائفية السياسية الهويات الدينية والمذهبية لتحقيق مكاسب فئوية في توزيع السلطة والثروة. وغالباً ما تنخرط الجماعات الطائفية في عمليات “إعادة تأطير” خطابها ليتماشى مع المتطلبات الدولية والسياقات الخارجية، متبنية مفردات علمانية وحقوقية تُوظف كأدوات تفاوضية وتكتيكات سياسية للحفاظ على نفوذها ومصالحها، دون أن تتخلى عن بنيتها الطائفية الأصلية.
تشكل هذه التداخلات بين العلمانية كمشروع سياسي والطائفية كممارسة تكتيكية أحد أبرز التحديات التي تواجه بناء دولة مدنية جامعة في سوريا، حيث تختلط المصالح الفئوية مع الخطابات الوطنية في بيئة هشّة تتأرجح بين التعددية والتجزئة.
مؤتمر وحدة الموقف: علمانية أم مصالح طائفية؟
في مؤتمر “وحدة الموقف”، رفع رجال الدين المشاركون شعارات فصل الدين عن الدولة، وضمان حيادية المؤسسات العامة، وتأسيس نظام مدني ديمقراطي، وهو خطاب يتناغم ظاهرياً مع مفاهيم الدولة الحديثة والعلمانية. إلا أن التدقيق في المضمون يكشف مفارقة جوهرية، إذ إن هؤلاء القادة الدينيين، الذين يمثلون طوائف متعددة، لا يتخلون عن مواقعهم التمثيلية ضمن هياكل طوائفهم، ما يعكس استمرار ارتباطهم العميق بالانتماءات الطائفية.
يمكن تفسير هذا الواقع بأنه لا يشكل بالضرورة قطيعة مع الطائفية، بل يعبر عن استراتيجية لإعادة التموضع داخل النظام السياسي الجديد. فالخطاب العلماني والمدني يتحول في هذا السياق إلى أداة تكتيكية تخدم مصالح ضيقة، بعيداً عن التزام حقيقي بمبادئ العلمانية والدولة المدنية.
تتمثل أبرز أهداف هذا الخطاب في تأمين الاعتراف الدولي وتحسين المواقع التفاوضية أمام الحكومة المركزية، حيث تحظى الخطابات العلمانية والحقوقية بقبول واسع لدى الجهات الدولية الفاعلة، وتُستخدم وسيلة لجذب الدعم السياسي والمالي، دون التخلي عن السيطرة الفعلية على بنية السلطة أو التوزيع الطائفي للنفوذ.
في ظل المساعي الدولية والإقليمية لتسهيل مسارات تفاوضية بين دمشق والأطراف المحلية في شمال شرق سوريا والجنوب، تسعى هذه الأطراف إلى ضمان موقع تفاوضي قوي. ومن هنا، يُعتبر تبني خطاب “الدولة المدنية العلمانية” خطوة تكتيكية تمكّنها من المشاركة في المفاوضات وكسب شرعية داخلية، لا سيما أمام جمهور منهك من الخطابات الطائفية والمذهبية. فإظهار خطاب طائفي صريح قد يعرضها لفقدان الدعم الشعبي ويفتح الباب أمام انتقادات دولية تفقدها شرعيتها.
بهذا يتحول الخطاب العلماني إلى ما يُعرف بـ “العلمانية الدفاعية”، خطاب تنتجه النخب الدينية لحماية مصالح جماعاتها من الاستبعاد السياسي. فعلى سبيل المثال، يستخدم قادة دينيون في المؤتمر هذا الخطاب درعاً رمزياً يحمي نفوذهم السياسي ويُبقي على هيمنتهم الطائفية، دون المساس بمواقعهم أو هياكلهم داخل الطائفة.
تتعارض هذه العلمانية الدفاعية بشكل جوهري مع المبادئ الأساسية للعلمانية، التي تقوم على فصل الدين عن السياسة والتمثيل والحقوق المدنية. رغم الشعارات المرفوعة، فإن استمرار التمثيل الطائفي والتمسك بقيم دينية صارمة، إضافة إلى فتاوى تكفيرية تطال المعارضين السياسيين وحتى الأفراد الراغبين في الخروج عن المظلة الطائفية “عباءة الشيخ” حتى في قضايا شخصية مثل الزواج، يؤكد على عمق هيمنة الطائفية في الممارسة. ويُستخدم الخطاب العلماني هنا وسيلة لإخفاء الطابع الطائفي الصريح للتحركات السياسية والعسكرية، مما يحوله إلى خطاب شكلي يخفي تحالفات ومصالح ضيقة.
ينطوي هذا الاستخدام المشوه للعلمانية على أخطار عدة، منها تعميق الانقسامات المجتمعية بدل حلّها، وترسيخ انفصال شكلي بين الدولة والمجتمع دون بناء مؤسسات علمانية فعلية، واستمرار دوائر العنف المتجددة، إضافة إلى فقدان العلمانية معناها التحرري، لتتحول إلى أداة سياسية مرنة تُوظف حسب المصلحة والظرف.
تجارب دولية في مواجهة الطائفية وترسيخ الدولة المدنية
لفهم أبعاد الخطاب العلماني في سوريا، لا بد من النظر بتمعن إلى تجارب دول أخرى واجهت تحديات مماثلة. ففي لبنان، يقوم النظام السياسي على المحاصصة الطائفية التي تُشكّل حجر الزاوية في توزيع السلطة، مما جعل الخطاب العلماني موضوع نقاش مستمر لكنه ظل بعيداً عن التطبيق الفعلي، إذ تُعيق التوازنات الطائفية الراسخة في بنية الدولة والمجتمع إحداث أي تغيير جذري.
أما في العراق، فقد حاولت القوى السياسية بعد سقوط النظام السابق تنويع السلطة وبناء مؤسسات الدولة المدنية، إلا أن الخطاب العلماني واجه مقاومة شرسة من جماعات دينية تسعى للحفاظ على نفوذها، مما أعاق جهود تحقيق الوحدة الوطنية وساهم في تعقيد المشهد السياسي وزيادة الانقسامات الطائفية.
على النقيض، تقدم تجربة البوسنة نموذجاً فريداً، حيث اعتُمدت العلمانية أداة مركزية لإعادة بناء المجتمع بعد الحرب الطائفية التي دمرته. تحقق هذا النجاح بفضل توافق واسع وجهود مؤسساتية مكثفة، بالإضافة إلى إرادة سياسية قوية وحوار مجتمعي عميق، ساهمت جميعها في ترسيخ الاستقرار وبناء دولة مدنية قائمة على المساواة والحقوق.
تؤكد هذه التجارب أن العلمانية ليست وصفة سحرية تُطبق بسرعة، بل هي مشروع سياسي واجتماعي معقد يتطلب بناء مؤسسات قوية، وحواراً مجتمعياً شاملاً، وتوافقاً سياسياً حقيقياً بين مختلف مكونات المجتمع. لذا، يتعين على سوريا دراسة هذه النماذج بعناية، مع مراعاة خصوصياتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، من أجل تكييف مفاهيم العلمانية بما يتناسب مع واقعها، وتفادي الوقوع في أخطاء الإقصاء أو تعزيز التوترات الطائفية التي قد تعرقل مسار بناء الدولة المدنية.
الخطاب العلماني: أداة المواجهة ودور البناء
يظل الخطاب العلماني في السياق السوري حالة معقدة ومتناقضة، تعكس التوترات العميقة بين الرغبة في بناء مشروع وطني حديث يرتكز على المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وبين الاستخدام بهدف حماية مصالح فئوية وطائفية في بيئة سياسية وأمنية هشة ومتغيرة. وبينما يحمل الخطاب العلماني إمكانية تجاوز الانقسامات المذهبية وتعزيز قيم الدولة المدنية، إلا أنه قد يتحول إلى أداة تكتيكية تخدم أجندات ضيقة، خاصة في ظل غياب مؤسسات دولة قوية تُفعّل مبادئه على أرض الواقع.
ويرتبط مستقبل هذا الخطاب بمدى قدرة الفاعلين السياسيين والمجتمعيين على بناء جسور من الثقة تتخطى جدران الطائفية والإقصاء، من خلال تأسيس مؤسسات مدنية مستقلة قادرة على حماية الحقوق والحريات، وتطبيق القانون بإنصاف وشفافية. ولن تُبنى هذه الجسور إلا على أرض التوافق السياسي الشامل، الذي يشد أزر مكونات المجتمع السوري المتنوعة، ويشجع على المشاركة السياسية الفاعلة لكافة الأطراف، بعيداً عن أعراف الانتماءات الدينية والطائفية.
كما أن بناء دولة علمانية حقيقية يستدعي إشراك المجتمع المدني ليكون شعلة تنير دروب نشر قيم المواطنة والحقوق المدنية، إلى جانب إصلاح النظام القضائي والقانوني لضمان حماية قانونية عادلة ومتساوية لجميع المواطنين. فلا بد أن يترافق ذلك مع صون حرية التعبير واحترام التنوع الثقافي والديني، كي لا تتحول العلمانية إلى سيف قمع أو جذر استئصال، بل إلى مظلة تحفظ الجميع.
وفي الختام، يجب أن ندرك أن الخطاب العلماني في سوريا، ليصبح مشروعاً حقيقياً نابضاً بالحياة، لا يكتفي بالكلمات الرنانة أو الشعارات المتكررة في المؤتمرات والبيانات السياسية، بل يحتاج إلى رؤية واضحة، واستراتيجيات متكاملة، وجهود دؤوبة ومستدامة على المستويات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية، رؤية يقودها أشخاص وطنية لا قيادات دينية وزعماء طائفية.