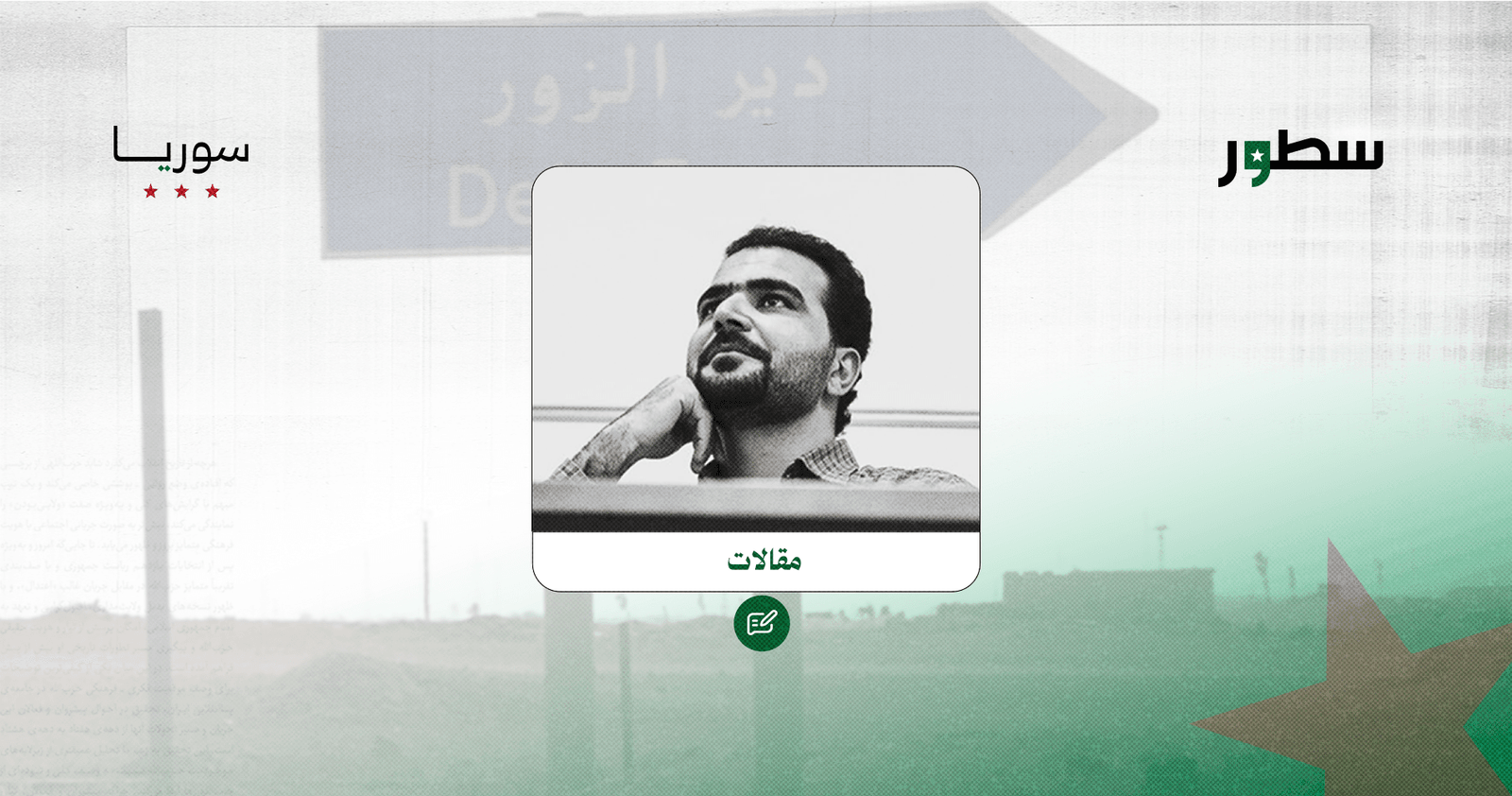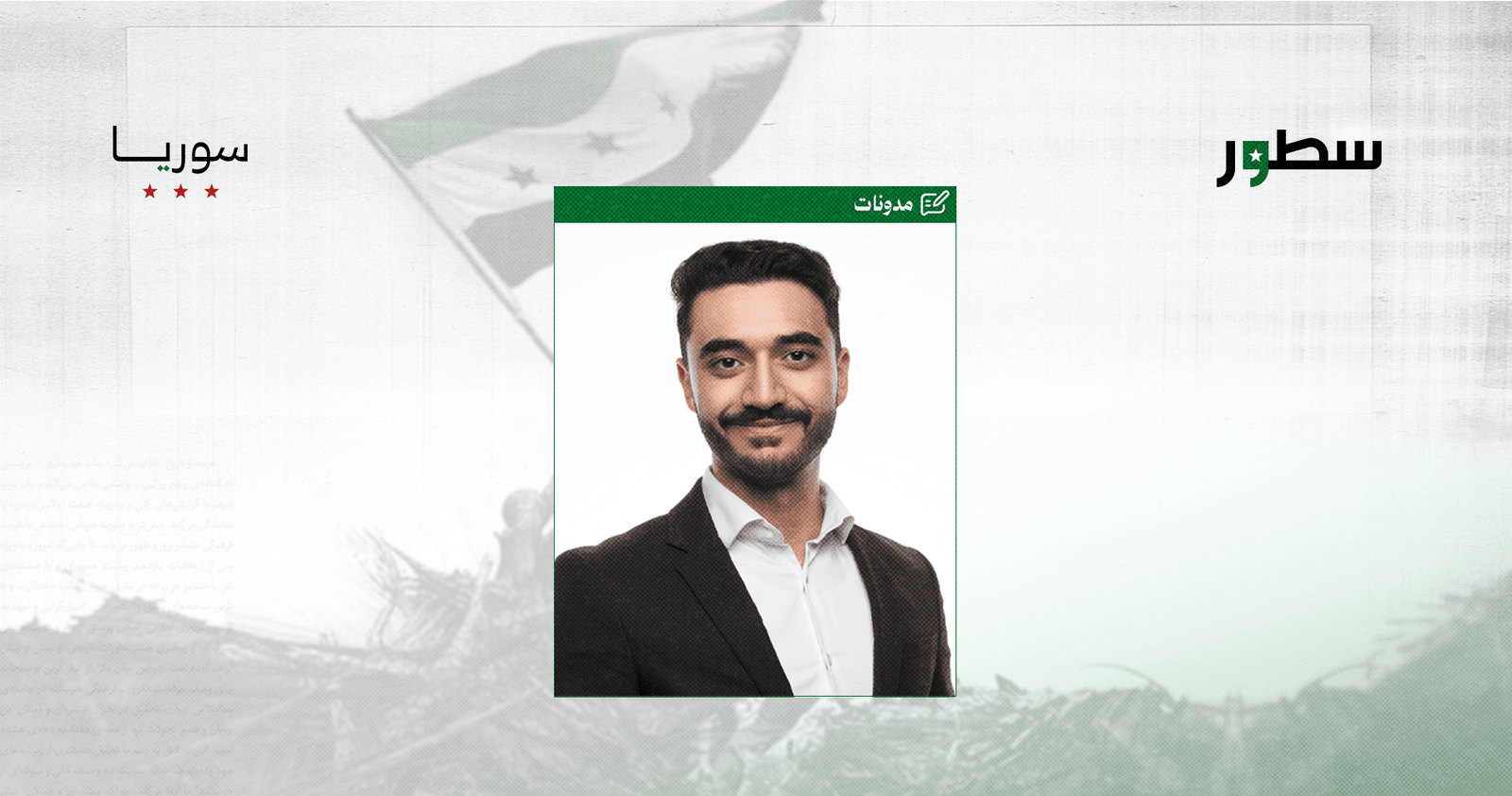مشاركات سوريا
دير الزور: بين مرارة واقع مظلم وآمال لغد مؤجل
دير الزور: بين مرارة واقع مظلم وآمال لغد مؤجل
دير الزور ليست مجرد مدينة على ضفّة الفرات العذب، بل على الضفّة الأخرى من هذا الوطن. أو بالأحرى، من هذا العالم الموازي. مدينة تقف منذ عقود خلف جدار التغافل الرسمي، تتكئ على جراحها المفتوحة بصمت، وتعيش بين ركام الحرب وظلمة التجاهل، بأجسادها المنهكة، وأفواهها المكتومة.
منذ إعلان الحكومة السورية الجديدة توليها السلطة عقب الإطاحة بنظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ازدحمت قاعات الشرف في قصر الشعب بالملفات والمقترحات، وتسابقت الوزارات لتقديم خُططها وبرامجها ومشاريعها التنموية والاستثمارية الطموحة، وعلت نبرة الوعود بإعادة البناء والتنمية. بدا وكأن البلاد تُعاد صياغتها من جديد.
لكن كعادتها، كانت دير الزور خارج هذه الأوراق. غابت عن دفاتر الأولويات، واستُبعدت حتى من هوامشها، وأُعيد تصنيفها كـ “منطقة ما بعد المعركة”، أو “أرض مؤجلة حتى إشعار آخر”.
الناس هناك لا يعيشون في الزمن نفسه الذي تعيشه الحكومة الجديدة. الزمن في دير الزور عالق بين نهاية حرب لم تنتهِ بعد، وبداية نسيان بدأ فعلاً.
حياة مُعلقة، ملامحها الإهمال، وتفاصيلها الانتظار. الشوارع ما تزال موحشة، المدارس بالكاد تنهض من تحت الركام، المستشفيات تئن دون أجهزة أو أطباء، والماء والكهرباء لا تأتيان إلا كهبّات موسمية متقطعة، لا مواعيد معروفة لها.
ولا تحتاج أن تكون محللاً نفسياً أو حتى محللاً استراتيجياً لتقرأ الوجوه في دير الزور. القهر والخوف من المجهول هناك لا يُخفى، له رائحة وله وجوه وله وقع في الأصوات الخافتة. لا حاجة لتحليل البيانات أو بناء تصورات استراتيجية لفهم المأساة. ما يحدث واضح كالشمس: مدينة بأكملها تُترك لتتعفن على قارعة الزمن، بلا أي تصور جاد لاستعادتها كجزء من الوطن.
ما يؤلم أكثر هو أن الحكومة الجديدة، رغم وجوهها ووعودها المتجددة، لم تنظر بعد إلى دير الزور بعين مختلفة. لم تسأل عن واقع حياة المدينة اليوم، ولا عن معنى أن يكون المرء مواطناً على ضفة النسيان والتهميش. لم يُطرح سؤال كيف تُبنى الثقة بين الدولة والمواطنين في مدينة كانت ذات يوم خط تماس، وما تزال، ثم تحولت إلى منطقة معزولة ومهمشة.
لكن الإهمال لا يعود فقط إلى الحكومة بوصفها الجهاز التنفيذي، بل يعكس إهمالاً تنظيماً داخل الدولة بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة، التي لم تُعر دير الزور أي أهمية لإدراجها ضمن أولويات لوائح الاستثمار في الإعمار والتنمية.
فمن الذي قرر أن هذه المدينة لا تحتاج أن تدرج ضمن لائحة الأولويات في المشاريع التنموية؟ ومن الذي أشار للدولة أن تبدأ رحلتها في إعادة البناء من مدن لم تمسسها ويلات الحرب، كدمشق المدينة؟ بينما تبقى ديرالزور عالقة في المربع صفر، محكومة بذاكرة الدمار ومنفية عن الحاضر والمستقبل.
في هذا السياق، يصبح الحديث عن “إعادة الإعمار” في دير الزور ضرباً من العبث. كأنك تتحدث عن الربيع في مدينة ما تزال تغرق في وحول الشتاء الطويل. نطالب أهلها بالصبر، بينما لا نرسل إليهم سوى البيانات ورسائل التطمين، لا مشاريع تبدل الأحوال ولا حلول في الأفق القريب. نحمّلهم مسؤولية الأمن، بينما لا نوفر لهم حتى الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة.
وهنا، تأتي المفارقة الصادمة: ففي الوقت الذي تفتقر فيه غالبية أحياء ديرالزور المتضررة إلى الحد الأدنى من البنية التحتية للعيش الكريم، حيث يقدر عدد الإحياء غير الصالحة للسكن الآدمي 11 حياً من أصل 14 حياً سكنياً، أي بنحو من 80% من المدينة، بينما تبقى أحياء الجورة والقصور و هرابش فقط، الصالحة للعيش، لكن بمقومات حياتية تكاد أن تكون معدومة، أعلنت الحكومة السورية، ضمن مراسم توقيع مذكرات استثمارية في سوريا، في 6 آب/ أغسطس، عن توقيع عقد لبناء فندق سياحي فاخر يحمل اسم “داما سراي” في قلب دير الزور، فيما وصف بأنه مشروع لتعزيز السياحة وتنشيط الاستثمار في المناطق المتضررة! المشروع، الذي يتجاوز حجم استثماره بتكلفة 400 مليون دولار أمريكي.
السؤال البديهي، الذي لا يبحث عن إجابة تحليلية: من سيقيم في فندق خمس نجوم وسط مدينة مدمرة؟ كيف تُستثمر الملايين في فندق بينما عشرات المدارس ما تزال مغلقة والمرافق الخدمية معطلة، ومئات العائلات بلا مأوى؟ هل باتت “الواجهة” أهم من الحياة اليومية وهموم الناس التي ألفوها؟ وهل يمكن اعتبار هذا المشروع سوى جائزة ترضية لمدينة ما تزال تنزف؟
يبدو أن على أهالي دير الزور أن يعتادوا هذا الإرث الثقيل من الإهمال الحكومي المتراكم، منذ عهد الأسديين حتى اليوم، وكأن المدينة وُلدت لتكون على الدوام خارج دائرة القرار والاهتمام. وهذا التهميش لا يقتصر على دير الزور فحسب، بل يشمل كامل الشرق السوري، من الرقة إلى الحسكة وصولاً الى دير الزور، فهذه المناطق تُدرج منذ سنوات ضمن قائمة العقاب الجماعي، تحت تصنيف “المدن النائية”، ضمن منطق الإقصاء لنظام الأسدين الطائفي المستبد، كأنها خارجة عن الإجماع الوطني، أو أنها لم تقدم ما يكفي لتستحق التنمية والاهتمام.
وفي لحظة موازية من لحظات الألم الجماعي للمدينة، لا يمكن الحديث عن دير الزور اليوم دون التوقف عند جريمة اغتيال الناشط المعروف “كندي العداي”، التي شكّلت منعطفاً حاداً، وصدمة قاسية في الوجدان السوري.
كندي، الذي عاد إلى دير الزور بعد سنوات من اللجوء في ألمانيا، عُرف بأنه من الأصوات النادرة التي بقيت تصرخ وسط الركام، تطالب بالحقيقة، وترفض الصمت. وجد “كندي” مقتولاً في شقته في مطلع شهر آب/ أغسطس، مكبل اليدين، وآثار التعذيب أخفت ملامح جسده، في مشهد مؤلم وحزين لم يترك مجالاً للشك في الرسالة: الصمت أو الموت.
لم يكن اغتيال “كندي” ضحية جريمة جنائية عابرة، بل إعداماً رمزياً لحلم بناء سوريا الجديدة، الذي عاد به من منفاه، واغتيالاً سياسياً لما تبقّى من الأمل، حادثة اغتياله كانت بمثابة محاولة لإغلاق ملف المدينة، لا فقط كمكان، بل كفكرة.
تُحمّل مؤشرات المسؤولية لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وسط اتهامات غير معلنة أيضاً لعناصر مرتبطة ببقايا النظام المخلوع، في مشهد يعكس تشاركاً غير معلن في خنق الأصوات الحرة.
لقد تحولت دير الزور إلى مرآة تعكس بوضوح معاناة مواطنيها، وأن هناك مدناً ما تزال خارج الحسابات، خارج الذاكرة، وخارج الخريطة الفعلية للدولة. مدناً تنظر لها الحكومة من بعيد، دون أن تقترب، ودون أن تسمع صوتها.
لكن دير الزور رغم كل ما فُعل بها، ما زالت هناك. تنبض، تنزف، تصرخ. لكنها لم تمت، ولم تستسلم، ولم تتحول إلى أثر بعد عين، كما أُريد لها.
هي ليست على الهامش كما يُراد لها أن تكون، بل هي بمثابة الشريان الرئوي في قلب هذا الوطن، الذي يسعى إلى النهوض بعد مخاض عسير، حتى إن أُجبرت على النبض في الظل.
هذه ليست دعوة للبكاء على الأطلال، ولا جلسة مرافعة علنية لاستجداء عطف الحكومة الجديدة للقيام بمهامها ودورها السيادي والخدمي والأمني. بل نداء للانتباه، ومناشدة لإعادة النظر، وكسر الصورة النمطية العالقة في ذهنية الدولة تلك الذهنية التي رسّخها نظام الأسديين لعقود طويلة، والتي تعاملت مع دير الزور ومجمل الشرق السوري على أنها مناطق أقل شأناً، وكأنها خارج الخريطة السياسية والاقتصادية للبلاد، المتروكة خلف خطوط التنمية.
فالعدالة ليست مكرمة أو منّة، والخدمات ليست هبات وعطايا، والأمن ليس مكافأة تُمنح، بل هي واجبات سيادية لا تقبل التأجيل ولا التسويف. والقيام بمهام الدولة في دير الزور ليس ترفاً أو خياراً سياسياً، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية لازمة، تسبق أي شعار وأي مشروع، مهما بدا لامعاً من الخارج. تغيير هذه الصورة الذهنية المنحازة لم يعد ترفاً أو مجاملة، بل أضحى ضرورة وحاجة ملحة، واستحقاقاً وطنياً وأخلاقياً لا يحتمل التأجيل.
لأن استمرار تغييب دير الزور والرقة والحسكة عن الفعل والقرار، لا يعني إلا خسارة مستمرة لجزء من قلب سوريا، ذلك القلب الذي تنضح دماؤه كلما واصل النبض، وجراحه مفتوحة تنزف دون أن تُضمّد، مما أصابه من خذلان.