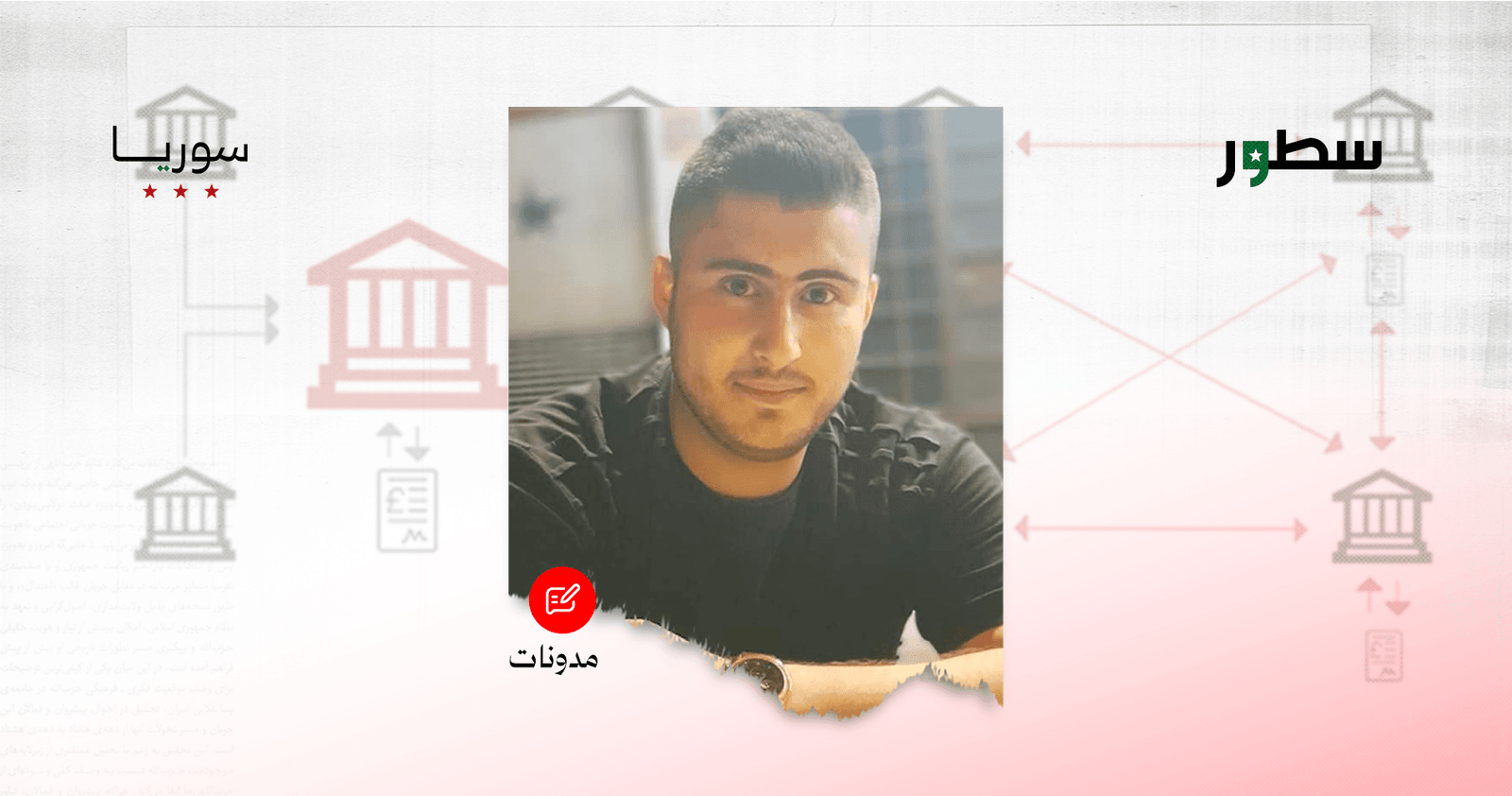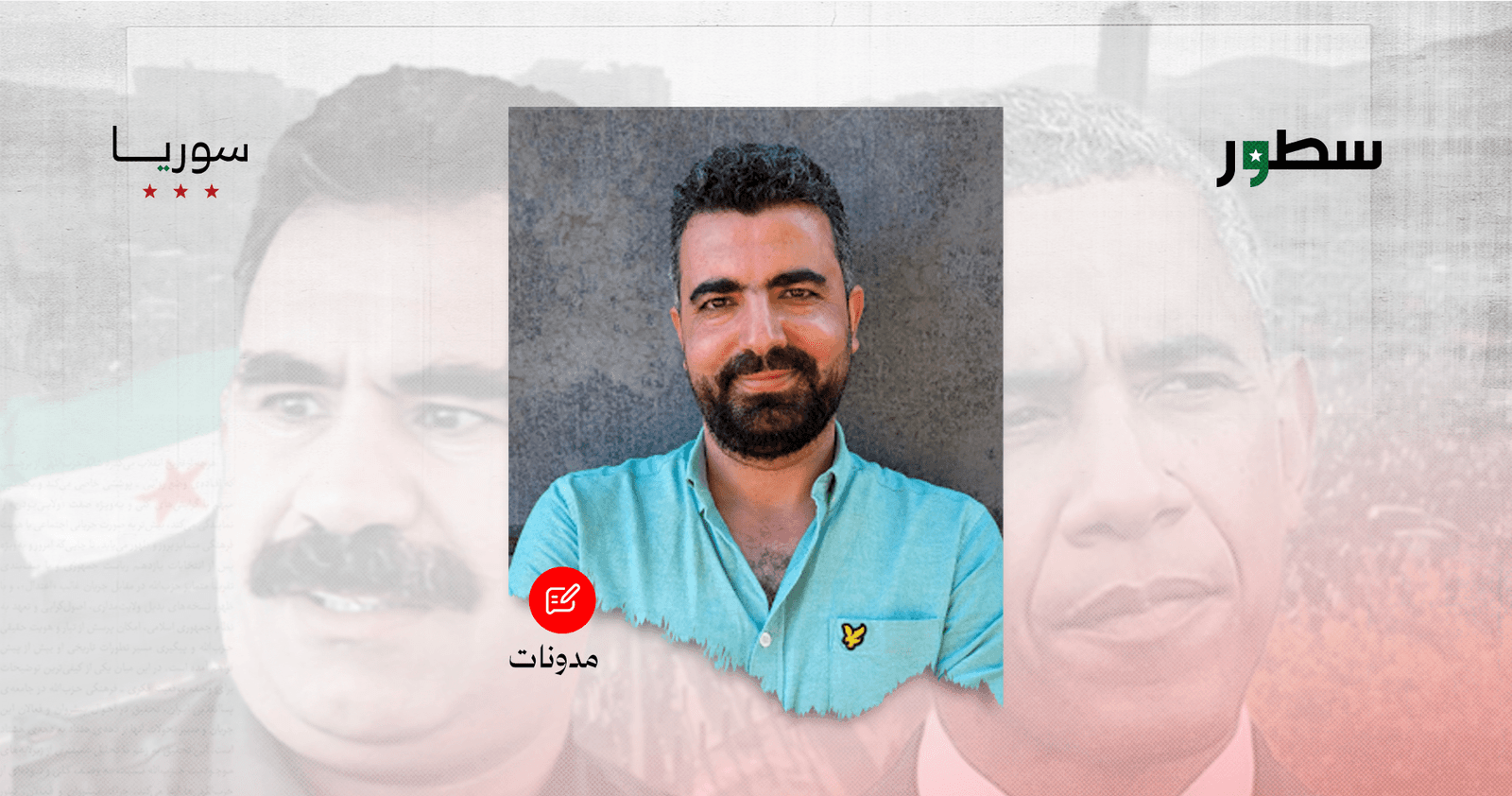مشاركات سوريا
الصحة في سوريا.. من انهيار البنية إلى أزمة طويلة الأمد
الصحة في سوريا.. من انهيار البنية إلى أزمة طويلة الأمد
شهدت سوريا منذ عام 2011 واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم الحديث، تركت آثارها العميقة في بنية الدولة والمجتمع، وكان قطاع الصحة من أوائل الضحايا. فلم تقتصر الأضرار على تدمير المستشفيات ونزوح الكوادر الطبية، نتيجة حملات الاعتقال الممنهجة وقصف المدن والمرافق الصحية من قبل نظام الأسد، بل امتدت لتطال المؤشرات الصحية الأساسية، كوفيات الأطفال، وانتشار الأمراض المعدية، وسوء التغذية، وتراجع مستويات الرعاية الصحية الأولية.
لمحة تاريخية عن النظام الصحي في سوريا
شهد النظام الصحي السوري تحولات جذرية عبر عقود، متأثراً بالتحولات السياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
في ظل الانتداب الفرنسي 1920-1946، كانت الرعاية الصحية محدودة ومتمركزة، حيث لم يتجاوز عدد المستشفيات 35 مستشفى بسعة إجمالية بلغت 1700 سرير، معظمها في دمشق وحلب. توزعت إدارتها بين الدولة والبعثات التبشيرية الأوروبية، بينما لم تنل مناطق مثل الشمال الشرقي سوى مستشفيين فقط.
بين عامي 1946-1970، وهي فترة الانقلابات المتتالية والاضطراب السياسي في سوريا، شهد النظام الصحي ركوداً واضحاً، فلم تُبنَ مستشفيات جديدة، بل اقتصر التوسع على افتتاح مستوصفات تقدم الرعاية الأولية في الريف، دون بنية تحتية صحية متماسكة.
ومع صعود نظام البعث واستقرار الحكم بيد حافظ الأسد، اتسمت مرحلة ما بعد 1970، ولا سيما بحلول عام 1948، بتركيز الدولة على تعزيز البنية التحتية الصحية، فارتفع عدد المستشفيات الحكومية إلى 41 مستشفى، كل منها بسعة تقارب 200 سرير، إضافة إلى 139 مستشفى خاصاً، معظمها صغيرة بسعة 20 سريراً. إلا أن التوزيع بقي غير عادل، إذ تركزت 56% من هذه المنشآت في دمشق وحلب، رغم أنهما لم تحتضنا سوى ربع السكان. اتبع النظام الصحي آنذاك نموذج “سيماتشكو” السوفيتي، القائم على التمويل المركزي والخدمات المجانية للجميع.

قبل عام 2011، كانت وزارة الصحة تتولى مسؤولية الرعاية الأولية، التي تم تنظيمها على 3 مستويات وفقاً للتقسيم الإداري: القرية، المنطقة، والمحافظة. فبينما تُقدّم القرى خدمات أساسية للأم والطفل، توفر مراكز المحافظات خدمات وقائية وعلاجية أكثر شمولاً، وتشمل المستشفيات والمراكز المتخصصة في المدن الكبرى.
تميزت الخدمات الصحية العامة بالمجانية، عدا المستشفيات المستقلة التي فرضت رسوماً رمزية، فيما قدمت وزارات كالدفاع والتعليم العالي خدمات طبية خاصة بكوادرها، ضمن مؤسساتها الصحية المنفصلة.
حيث شكلت وزارة الصحة في تلك الفترة قبل 2011، العمود الفقري للنظام الصحي السوري، إذ كانت تدير 90 مستشفى تضم نحو 13907 أسرة، ما يعادل نصف عدد الأسرة المتاحة للجمهور في عموم البلاد. في المقابل، احتكرت وزارة التعليم العالي أكثر المستشفيات تطوراً من حيث الموارد والتجهيزات، حيث شغّلت 14 مستشفى تعليمياً تركز في المدن الكبرى فقط: دمشق، حلب، اللاذقية.
أما وزارة الدفاع، فشغلت 18 مستشفى مخصصة حصرياً لأفراد الجيش وعائلاتهم. بينما خصصت وزارة الداخلية مستشفيين في دمشق وحلب لأفراد قوى الأمن الداخلي فقط.
من جانبه، أدى القطاع الخاص دوراً متنامياً، إذ شغّل 376 مستشفى، ساهمت مجتمعةً بتوفير 8962 سريراً، أي ما نسبته 32% من إجمالي الأسرة في البلاد. هذا التوزيع عكس بنيةً صحية متعددة الأقطاب، لكنها اتسمت بتركّز الموارد في يد الدولة، مقابل نمو غير متوازن في القطاع الخاص، وغياب واضح لتكافؤ التوزيع الجغرافي أو العدالة الصحية.
لكن منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، انهار الهيكل الصحي تدريجياً، نتيجة الاستهداف المباشر للمراكز الصحية والعاملين فيها، مما حوّل المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية إلى المزود الرئيسي للرعاية الصحية، خاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد. لقد تبدد مفهوم “الصحة حق لكل مواطن” أمام مشهد من الانقسام والتفاوت والعجز المزمن.

أولاً: تراجع المنظومة الصحية والبنية التحتية
وفيما وُصف النظام الصحي السوري قبل عام 2011 بأنه كان نظاماً متماسكاً نسبياً، حيث غطت المراكز الصحية الحكومية، والتي عُرفت بالمشافي الوطنية والمستوصفات الصحية الحكومية، معظم المدن والبلدات السورية. لكن الحرب قلبت المشهد رأساً على عقب، فبحلول عام 2013، دُمر ما يقارب 60% من المشافي والمراكز الصحية في البلاد، وبحلول كانون الثاني / يناير من عام 2022 تم توثيق 602 هجوم على أكثر من 348 مرفقاً صحياً مختلفاً، معظمها مشافٍ، ساهم هذا الدمار الهائل في التراجع الحاد في قدرة الناس على الحصول على الرعاية الصحية، وخاصة الرعاية الثانوية والثالثية -بحسب محرك بحث Pubmed- وهو محرك بحث مفتوح المصدر من أجل الوصول إلى قاعدة بيانات الملخصات والمقالات المتعلقة بالبحوث الطبية والصحية.
كما شهد القطاع الطبي في سوريا نزيفاً حاداً في الكوادر خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير تقديرات شبه رسمية إلى أن أكثر من 70% من الأطباء والممرضين غادروا البلاد، ما أدى إلى فراغ كارثي في التغطية الصحية، خصوصاً في المناطق الريفية والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.
في عام 2010، قدّر عدد الأطباء في سوريا بنحو 30 ألف طبيب، بمعدل 22 طبيباً لكل 10 آلاف نسمة. إلا أن هذا الرقم انخفض بشكل مقلق إلى نحو 15 ألف طبيب بحلول عام 2020. إذ توجهت النسبة الأكبر من هؤلاء الأطباء إلى ألمانيا، حيث يُقدَّر عدد الأطباء السوريين المقيمين هناك حالياً بما بين 9000 – 10.000 طبيب، ما يعكس هجرة جماعية للكفاءات، ويمثل أحد أعظم التحديات البنيوية التي تواجه مستقبل القطاع الصحي في البلاد.
ثانياً: وفيات الأطفال دون سن الخامسة
تُعد وفيات الأطفال مؤشراً حساساً لفعالية النظام الصحي في أي بلد. في عام 2009، بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في سوريا 19 وفاة لكل 1000 ولادة حية. ومع اندلاع الحرب، ارتفعت الأرقام تدريجياً لتصل إلى 22 وفاة لكل 1000 ولادة حية في عام 2021، ثم انخفضت قليلاً إلى 21 في عام 2022، وفقاً لبيانات The Global Economy.
رغم هذا الانخفاض الطفيف، ما تزال الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الحرب، وأدنى من المعدل العالمي الذي بلغ في 2022 نحو 25 وفاة لكل 1000 ولادة حية. هذا يشير إلى أن القطاع الصحي، رغم تعرضه لانهيار واسع، ما يزال يحتفظ ببعض القدرة على الحد من الكارثة، لا سيما في المناطق الحضرية.

يوضح المخطط البياني معدل الوفيات بين الولادات الحية، حيث بلغ أعلى نسبة في عام 1960 لتتراجع تدريجياً، ثم لتعود بالارتفاع بين عامي 2011 – 2022 نتيجة لعوامل عدة منها: تدمير البنية التحتية الصحية، ونقص الكوادر الطبية، وتراجع برامج التطعيم الوطنية، وسوء التغذية الحاد والمزمن، حيث ارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال بشكل كبير، وعانى 16% من الأطفال من التقزم في عام 2023، وهو عامل رئيسي في ضعف المناعة وزيادة الوفاة عند الإصابة بالأمراض الشائعة.
ثالثاً: وفيات الأمهات وتراجع الرعاية الإنجابية
كانت سوريا قبل الحرب تحقق تغطية جيدة في مجال الولادات بإشراف طبي، بنسبة وصلت إلى 96% في عام 2009. أما بعد الحرب، تراجعت هذه النسبة بسبب تدمير المرافق وغياب الكوادر. وارتفع معدل وفيات الأمهات من 26 حالة لكل 100 ألف ولادة إلى نحو 30 حالة عام 2020.
يُعزى هذا التدهور إلى عوامل مركبة، تشمل انقطاع الخدمات، ونقص الأدوية، وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية، لا سيما في مناطق النزاع والمخيمات الحدودية.

رابعاً: عودة الأمراض المعدية وتفشي الأوبئة
الحرب أزالت الكثير من الحواجز التي كانت تمنع عودة أمراض منسية. ففي عام 2013، عاد شلل الأطفال للظهور في سوريا بعد سنوات من اختفائه، وتسبب حينها في إصابة المئات وترك 17 طفلاً مصاباً بالشلل الدائم.
كما شهدت البلاد في عام 2022 تفشياً واسعاً لوباء الكوليرا، حيث سُجل أكثر من 189 ألف حالة مشتبه بها، 105 حالات وفاة بين آب/ أغسطس 2022 وأيلول/ سبتمبر 2023، وفقًا لتقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وقد كانت مصادر مياه نهر الفرات من الأسباب المباشرة لانتشار المرض.
إلى جانب ذلك، ظهرت موجات من الحصبة، وداء الليشمانيات، والتهاب الكبد الفيروسي، وكلها انتشرت في بيئة فقدت برامج اللقاح المنتظمة وخدمات الصرف الصحي.
| السنة | عدد الحالات أو النسب | ملاحظات | |
| شلل الأطفال | تشرين الأول/ أكتوبر 2013 | 17 حالة شلل مؤكد | أول ظهور منذ عام 1999 |
| آذار/ مارس 2014 | 37 حالة إصابة مؤكدة | ||
| التلقيح ضد شلل الأطفال | 2010 – 2012 | انخفاض من 91% إلى 68% | انخفاض شديد قبل تفشي الجائحة |
| حملات التلقيح | 2013 – 2014 | استهداف 1.6 مليون طفل – 37 جولة تطعيمية | تغطية ضخمة لتحجيم التفشي |
| الكوليرا | أيلول/ سبتمبر 2022 | 20 حالة وفاة مؤكدة | بدايات التفشي |
| آب/ أغسطس 2022- آذار/ مارس 2023 | 936 حالة شبه مؤكدة | تفشٍ محدود لكنه حقيقي |
خامساً: سوء التغذية ومحنة الطفولة
أحد أبرز انعكاسات الأزمة هو تدهور الوضع الغذائي للأطفال. وجد مسح SMART 2023 لمنظمة الصحة العالمية أن نسبة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون 5 سنوات ارتفعت من 1.7% عام 2019 إلى 4.8% في 2023.
أما نسبة التقزم Stunting وهي مؤشر على نقص التغذية المزمن ارتفعت من 12.6% إلى 16.9% (حوالي 610 آلاف طفل)، خلال نفس الفترة.
بحسب تقارير المنظمات الإنسانية، فإن أكثر من ثلث الأطفال السوريين يعانون من شكل من أشكال سوء التغذية، في ظل تراجع القدرة الشرائية للأسر، وارتفاع الأسعار، وانهيار برامج الدعم.
فيما ارتفعت نسبة سوء التغذية لدى النساء الحوامل والمرضعات إلى 19% في بعض المناطق وبلغ متوسطه 7% على مستوى البلاد.
هذا وتشهد نصف مناطق سوريا انقطاعاً في تقديم العلاج للحالات الشديدة، فبحسب تقرير لـ Save The Children، فإن أكثر من 416 ألف طفل معرض لسوء التغذية كل عام بسبب قطع تمويل المساعدات، وقد توقف حوالي 20 من أصل 50 برنامجاً غذائياً حيوياً في الفترة بين عامي 2020 – 2025.
سادساً: تصاعد الأمراض المزمنة في بيئة منهكة
لم تعد الأمراض المزمنة في سوريا حِكراً على كبار السن، بل امتدت لتطال فئات عمرية أوسع في ظل بيئة صحية واجتماعية متدهورة. ففي دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR بين عامي 2011 و2021 على اللاجئين السوريين في دول الجوار، تبيّن أن 24% منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم المزمن، و12% مصابون بالسكري من النمط الثاني، بينما يعاني 5% من أمراض قلبية وعائية، و11% من التهاب المفاصل المزمن، و4% فقط من أمراض تنفسية مزمنة. وبمجموع تراكمي، فإن أكثر من نصف اللاجئين يعانون من شكلٍ من أشكال الأمراض المزمنة.
أما داخل سوريا، فتكشف بيانات منظمة الصحة العالمية WHO عن نفس الفترة أن حوالي 25% من السكان يعانون من أمراض قلبية وعائية، في حين بلغت نسبة الإصابة بالسرطانات 9%، والأمراض التنفسية المزمنة نحو 20%، فيما شكّلت الإصابات المرتبطة بالنزاع المسلح حوالي 50% من مجمل الإصابات.
في ظل هذا الواقع، أصبحت الرعاية الصحية للأمراض المزمنة تمثل تحدياً يومياً في بيئة تفتقر إلى الموارد، وتنهكها الحرب والهجرة والدمار، ما ينذر بكارثة صحية طويلة الأمد تطال المجتمع بكامل شرائحه.
كما أشارت أبحاث عدة عن انخفاض متوسط العمر المتوقع للسوري بمقدار 6 سنوات للرجال و5 سنوات للنساء عن المتوقع.
سابعاً: النفسية ساحة حرب محتدمة
تشير الدراسات إلى أن الصحة النفسية للسوريين تدهورت بشكل حاد خلال سنوات الحرب والنزوح، حيث يعاني أكثر من 80% من السكان داخل سوريا من اضطرابات نفسية، من بينها 37% يعانون من أعراض كاملة لاضطراب ما بعد الصدمة PTSD، و27% يعانون من اضطرابات نفسية شديدة مترافقة مع PTSD، بحسب دراسة وطنية شملت 1951 مشاركاً. كما كشفت دراسة أخرى على 3326 شخصاً أن 83% يعانون من درجات مختلفة من الاكتئاب و69% من القلق، وهي نسب تفوق المتوسطات العالمية بعدة أضعاف. الوضع ليس أفضل لدى اللاجئين: في تركيا، تصل احتمالات الإصابة بـPTSD إلى 83% في بعض المخيمات، بينما تتراوح نسب الاكتئاب والقلق بين 34-50%. هذه الأرقام تعكس حجم الأزمة النفسية وتستدعي تدخلاً عاجلاً على المستوى المجتمعي والدولي.
أزمة مستقرة ومستقبل مقلق
ومن خلال الإحصائيات والدراسات المذكورة، يبدو جلياً أن المنظومة الصحية السورية منهارة ولم تعد محصورة بنقص الأدوية أو انقطاع التيار الكهربائي عن غرف العمليات، بل تعدّت ذلك إلى غياب التخطيط الصحي طويل الأمد، وتفشي الأمراض المنسية وسوء التغذية، وهجرة الكوادر الطبية، وانهيار ثقة السوريين بالمؤسسات الصحية.
ولا بد من رؤية استراتيجية تتجاوز الحلول الإسعافية، وتقوم على إعادة هيكلة النظام الصحي وفق نموذج يعيد توزيع الخدمات الصحية بعدالة بين المناطق، وتحفيز الكفاءات الطبية عبر ضمان الأمن الوظيفي والدعم المهني والتعليمي المستمر، وتخصيص دعم دولي مباشر بالاشتراك مع المنظمات والجهات الدولية المانحة لبرامج الأمومة والتغذية ولقاحات الأطفال، إضافة إلى توسيع شبكة الرعاية الأولية بالاعتماد على مراكز صحية فعالة في المناطق النائية وليس فقط شكلياً، كما ينبغي بالضرورة تفعيل أنظمة الإنذار الوبائي المبكر وتوطينها لرصد الأمراض ومنع تحول الجوائح إلى أوبئة.