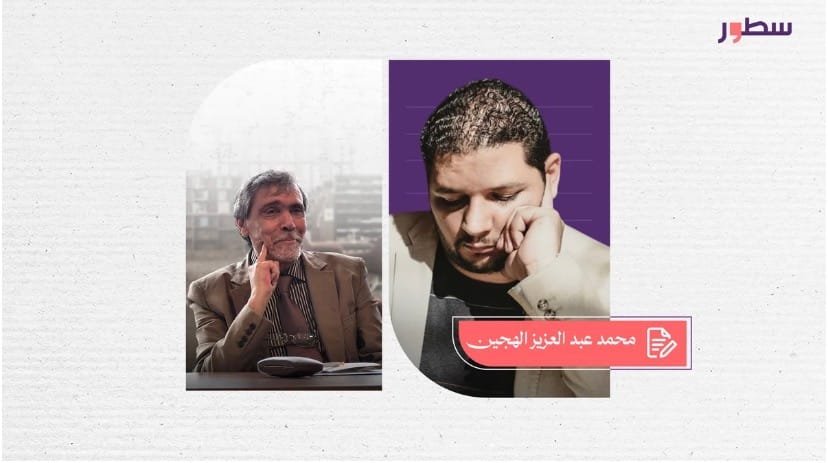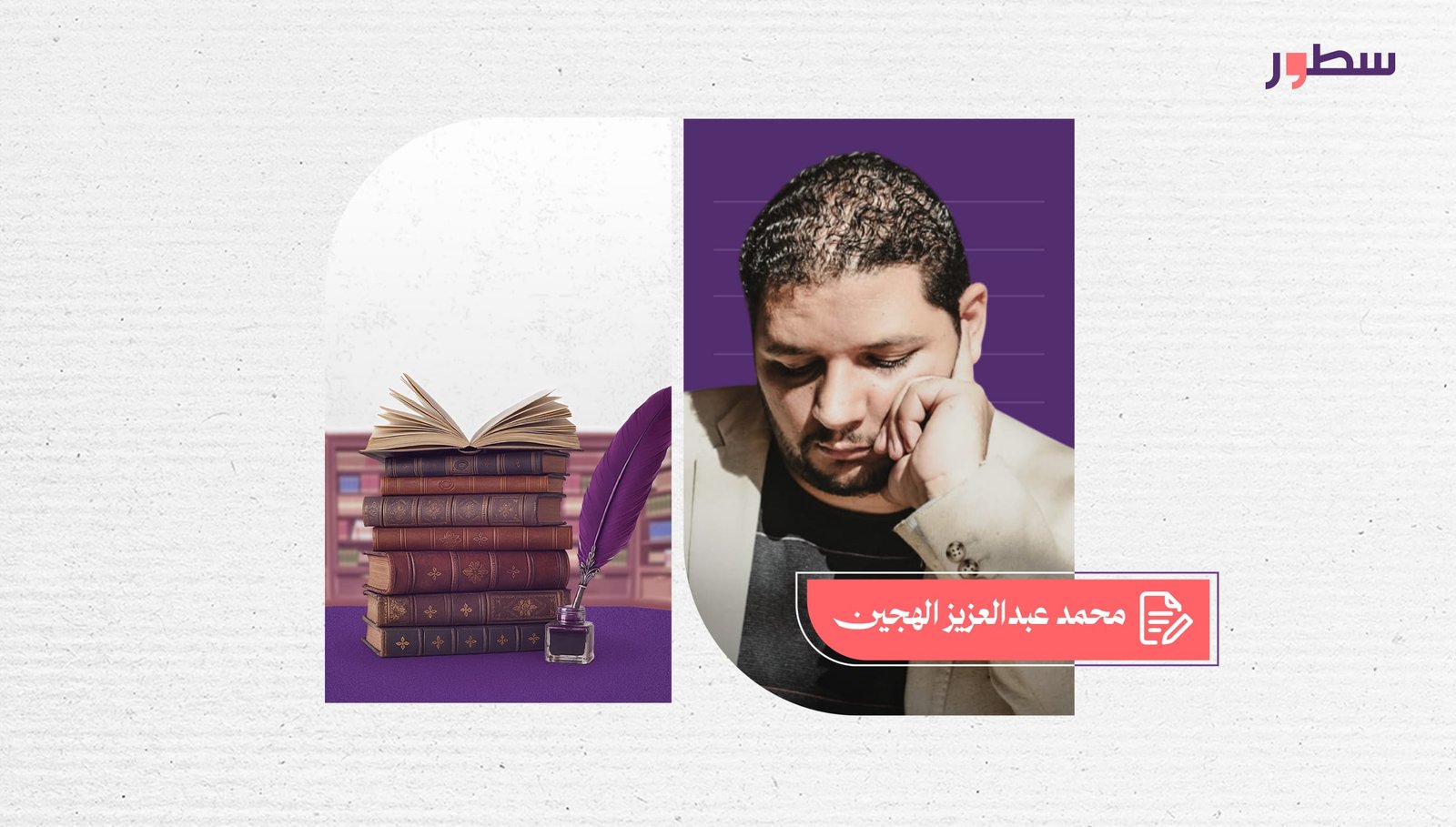أدب
رسالة في مداواة النفوس!
رسالة في مداواة النفوس!
قضيتُ الأسبوع الماضي في قراءة حوارات المحقِّق والعالِم إحسان عباس، جمع يوسف بيكار. وصل إليَّ الكتاب من عمان عن طريق صديقي الذي زار إحدى المكتبات وأخذ يبحث لي عن عناوين كتب ومذكرات قديمة. وعند قراءة حوارات إحسان عباس تذكَّرتُ تعرُّفي إليه عن طريق قراءة رسائل الإمام ابن حزم التي حقّقها ونشرها، وتوقُّفي أمام رسالة “مداوة النّفوس“.
قصَّتي مع الإمام ابن حزم بدأت مع الدراسة على الدكتور سمير قدوري في محاضرات ماجستير مقارنة الأديان، وهو مِن المهتمين بتراث الإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم القرطبي. وقد أخرج قدوري تحقيقًا جديدًا لكتابه “الفَصْل في المِلَل والآراء والنِّحَل” عن الدار المالكية في خمسة مجلدات، وله كتاب “تاريخ نص الفَصْل في المِلَل والنِّحَل” عن مكتبة الشيخ عبد العزيز بن خالد آل ثاني، وقد درَّسني الدكتور سمير في الماجستير، ولم أكُن من طلابه النجباء لكنّي تعلَّمتُ منه واستفدت.
د. سمير قدوري شغوف بمعرفة التاريخ، وتواريخ الكتب المقدَّسة يتحدَّث عنها كأنَّه يقرأ من كتاب مفتوح، فيستعرض التواريخ والكتب والطبعات والتراجم بذاكرة سيَّالة، وشغفه بالحصول على الكتب لم يَقِلّ، بل يتمسَّك بالحصول على كتاب أو طبعة بعيدة ويُلِحُّ في طلبها، ثمَّ تراه يطرب لشعر الغزل ويرقُّ له، ولما سمع بيت عمرو بن معد يكرب في الحماسة: “ذَهَبَ الَّذِينَ أُحِبُّهُمْ… وَبَقِيتُ مِثْلَ السَّيْفِ فَرْدَا”، رأيته متأثرًا بالبيت. وكان الدكتور سمير يقول عن رسالة “مداواة النفوس”: إنَّ بعض عباراتها ينتمي إلى الفكر الإنسانيِّ الخالد.
قد لفت نظري في قلم ابن حزم حديثه عن نفسه، إذ يقول: “ما نسيت لي وُدًّا قَطُّ، وإنَّ حنيني إلى كلِّ عهد تقدَّم لي ليغصّني بالماء، ويشرقني بالطعام، وقد استراح مَن لم تكُن هذه صفته، وما مللت شيئًا قَطُّ بعد معرفتي به، ولا أسرعت إلى الأُنس بشيءٍ قَطُّ أول لقائي له، ولا رغبت الاستبدال إلى سبب من أسبابي”.
هذا الأمر ممَّا أُحِبُّه في كتابة الإمام ابن حزم هو طابع التجربة الشخصيَّة الذاتيَّة في كتابته، التي تتجلَّى في هذه الرسالة، فهو يستعمل كلمة “رأيت”، وهذه الرسالة إنَّما نتجت عن طول تأمُّله وتدبُّره الشخصيّ ومحض اجتهاده، فهو يُقرِّر بأنَّ لذَّة العاقل بعقله والعالِم بعلمه والمجتهد باجتهاده والحكيم بحكمته أعظم من اللذَّات الماديَّة في الطعام والشراب والنكاح وسائر المتع الحسِّيَّة. وسبب ذلك في رأيه أنَّ بعض الناس قد جرَّب هذه المتع الحسيَّة ثمَّ انتقل إلى الرياضات الذهنيَّة بعد تجربتها، لذلك كان انتقاله دليلَ فضلها، ثم يُلَمِّح أبو محمد إلى أنَّه مَن يحكُم في هذه الأمور مَن جرَّبها، كأنَّه يقصد نفسه.
ويقول ابن حزم: “تأمَّلت كلّ ما دون السماء، وطالت فيه فكرتي، فوجدت كلَّ شيء فيه من حيّ وغير حيّ، من طبعه إن قوي أن يخلع على غيره من الأنواع هيئته ويلبسه صفاته، فترى الفاضل يودّ لو كان كلُّ النَّاس فضلاء، وترى الناقص يودّ لو كان كلُّ النَّاس نقصاء، وكلُّ ذي مذهب يودّ لو كان الناس موافقين له”، فهو ينطلق من تأمّلاته الذاتيَّة والشخصيَّة، فقد جمع معاني رسالته بمرور الأيام وتعاقب الأحوال، حيث وهبه الله الاهتمام بتصاريف الزمان والإشراف على أحواله، حتَّى أنفق في ذلك أكثر عمره.
هذا النص يؤكّد قِدَم مفهوم الكتابة الذاتيَّة في التراث العربيّ والإسلاميّ، وأنَّها ليست فنًّا معاصرًا ابتكره الأوروبيّون مع كتاب “اعترافات جان جاك روسو”. والفارق في ظنّي بين السيَر الذاتيَّة المعاصرة توجُّهها إلى الاعترافات وتعرية النفس على نمط الاعترافات الكنسيَّة. وكتابة المسلمين في التراث عن أحوال أنفسهم إنَّما ترتبط بالتوجُّه إلى الله، ولا يدوِّن الكاتب وهو يركِّز على نفسه، بل يغلب عليه التفكير في علاقته مع الله عز وجل، ولا يقع في مركزيَّة الإنسان في الكون.
يوضِّح المحقّق إحسان عباس أنَّ رسالة “مداواة النفوس” تبدو نوعًا من المذكرات والخواطر، التي دُوِّنَت على مَرِّ الزمن، وكانت حصيلة التجربة المتدرِّجة، ولعلَّ أكثرها إنَّما دُوِّن في سِنٍّ كبيرة، لأنَّها تشير إلى الهدوء والنضج في محاكمة النَّاس والأشياء، وتمثِّل مفارقة وتكملة لـ”طوق الحمامة”، ففي هذه الرسالة يقدّم ابن حزم نظرته في الحياة على نحو فلسفيّ أو فكريّ.
للإمام ابن حزم كلمات جميلة في رسالة “مداواة النفوس”، مثل قوله: “كلُّ أمل ظفرت به فعُقباه حزن، إمَّا بذهابه عنك، وإمَّا بذهابك عنه، إلَّا العمل لله عزَّ وجلَّ، فعُقباه على كلِّ حالٍ سرور، في عاجل وآجل”. وله بعد ذلك ملاحظة مهمة عمّا اجتمعت عليه أهواء الناس في طلبه، فكان في رأيه أنَّ هذا الأمر هو “طرد الهمّ“، فيقول: “تطلَّبْتُ غرضًا يستوي الناس كلّهم في استحسانه وفي طلبه، فلم أجده إلَّا واحدًا، وهو طرد الهمّ، فلما تدبّرته علمْتُ أنَّ الناس كلّهم لم يستووا في استحسانه فقط، ولا في طلبه فقط، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتبايُن هممهم وإراداتهم، لا يتحرَّكون حركة أصلًا إلَّا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم، فمن مُخطئ وجْهَ سبيله، ومن مُقارِبٍ للخطأ، ومن مصيبٍ -وهو الأقلُّ من الناس-… فَطَرْدُ الهَمِّ مَذْهَبٌ اتفقت الأمم كلها مذ خلق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء، ويعاقبه عالم الحساب، على ألَّا يعتمدوا بسعيهم شيئًا سواه”.
وهذا القول يشبه قول أبي حيَّان التوحيدي: “قلَّما يخلو إنسان من صبوة أو حسرة على فائت، أو فكر في تمنٍّ أو خوف من قطيعة، أو رجاء لمنتظر، أو حزن على حال، وهذه أحوال معروفة، والناس منها على جديد معهودة”.
وذكر ابن حزم اختلاف الناس في المطالب، فمنهم من يؤْثر المال، ومنهم من يؤْثر العلم، ومنهم من يطلب الصيت والشهرة. ثم يقول: “ومنهم من يؤثر الجهل على العلم كأكثر من نرى من العامة”. أعجبتني كلمته، فهي تفسِّر كراهية النَّاس للعلم والعمق أو لبذل الجهد للوصول إلى صورة أعمق للأشياء، وهو يجد الحلّ في العمل للآخرة لطرد هذه الهموم، لأن الناس قد التمسوا طرقًا عديدة لطرد الهمّ، سواء في العمل، أو في الغناء والطرب، أو في اللذَّة، أو في سماع الأخبار لطرد الوحدة، كلها تجتمع لطرد الهمّ، والحل كما ذكر هو طرد الهموم عن طريق البذل للآخرة، فهي خير وأبقى، ثمَّ يؤكِّد بابًا عظيمًا من أبواب العقل والراحة، وهو طرح المبالاة بكلام الناس، ويقول كلمة جميلة: “العاقل لا يرى لنفسه ثمنًا إلَّا الجنَّة”، وينفي المروءة عمّن لا دين له.
يمدح الإمام ابن حزم الاشتغال بالعلم بقوله: “لو لم يكُن من فائدة العلم والاشتغال به إلَّا أنَّه يقطع المشتغل به عن الوساويس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهمّ وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس، لكان ذلك أعظم داعٍ إليه”. وقد توقفت أمام حكمته البديعة: “اللقاء يذهب بالسخائم، فكان نظر العين إلى العين يصلح القلوب”.
يُشبِّه ابن حزم طالب الأجر في الآخرة بالملائكة، وطالب الشر بالشياطين، وطالب الشهرة بالسباع، وطالب اللذَّات بالبهائم، وطالب المال لعين المال لا ليُنفقه في وجوه الخير بمرتبة أقلّ من الحيوان والحمق، وهو ينبِّه إلى أنَّ العاقل لا يغتبط بصفة يفوقه فيها حيوان أو جماد، وإنَّما يغتبط بفضيلة “التمييز” الذي يشارك فيها الملائكة، فمَن سُرَّ بشجاعته فالنمر أشجع منه، ومَن سُرَّ بقوَّته فالبغل والحمار أقوى منه. وتذكَّرت عند هذه الفقرة موجة الاهتمام الشبابي بالجمال الجسدي في صالات الرياضة، الجيم هو معبد العصر الحديث، فالرياضة هي هَوَس عصرنا، وهي تُعبِّر عن حضور الجسد في الحياة المعاصرة ومعايير الجمال، وتعبِّر كذلك عن نمط الحياة غير الصحيّ الذي يدفع الناس إلى الراحة ثمّ السمنة، لذلك تحوّلت الرياضة إلى تعبير عن ذوات الناس وكفاحهم مع أجسامهم.
يذكر ابن حزم قصة عن أهل الجهل وأهل العلم، يقول: “غاظني أهل الجهل مرتين من عمري: إحداهما بكلامهم في ما لا يُحسِنونه أيام جهلي، والثانية بسكوتهم عن الكلام بحضرتي أيام علمي، فَهُم أبدًا ساكتون عمَّا ينفعهم، ناطقون في ما يضرُّهم. وسرَّني أهل العلم مرتين من عمري: إحداهما بتعليمي أيام جهلي، والثانية بمذكراتي أيام علمي”.
ومن ملاحظاته الشخصيَّة يقول ابن حزم: “كم رأينا من فاخر بما عنده من المتاع، كان ذلك سببًا لهلاكه، فإيّاك وهذا الباب الذي هو ضُرٌّ محضٌ لا منفعة فيه أصلًا”. هذه ملاحظة نفيسة في زمن التفاخر الاجتماعيّ ووسائل التواصل الاجتماعيّ. وله كلمة جميلة: “استبقاك من عاتبك، وزهد فيك من استهان بشأنك”.
يقول ابن حزم: “وجدتُ المشاركين بأرواحهم أكثر من المشاركين بأموالهم، هذا شيء طال اختباري إيّاه“. وله خواطر ذاتيَّة بارعة مثل حديثه عن عيوب نفسه ومعالجته لها، إذ يقول: “كانت فيَّ عيوب، فلم أزَل بالرياضة، واطّلاعي على ما قالت الأنبياء والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدّمين في الأخلاق وفي آداب النفس، أُعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومَنِّه”.
ويلخص المحقِّق إحسان عباس فلسفة ابن حزم فيقول: “نحن نحسّ كأنَّ ابن حزم يتحدَّث عن مشكلاتنا الحاضرة وهو يقول: أشدُّ الأشياء على الناس الخوف، والهمّ، والمرض، والفقر”.
وفي المقال القادم نقف على سيرة المحقِّق إحسان عباس من خلال حواراته.