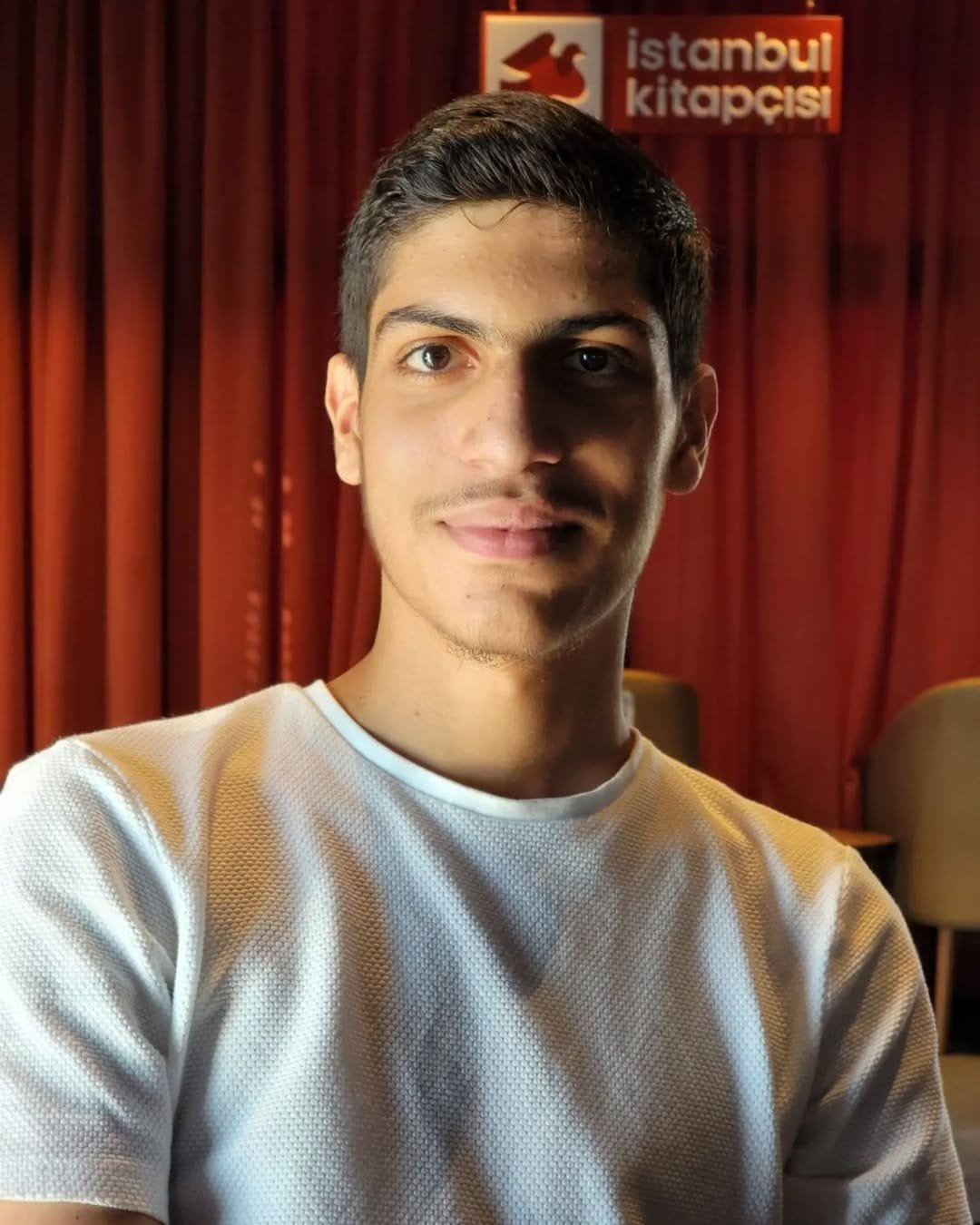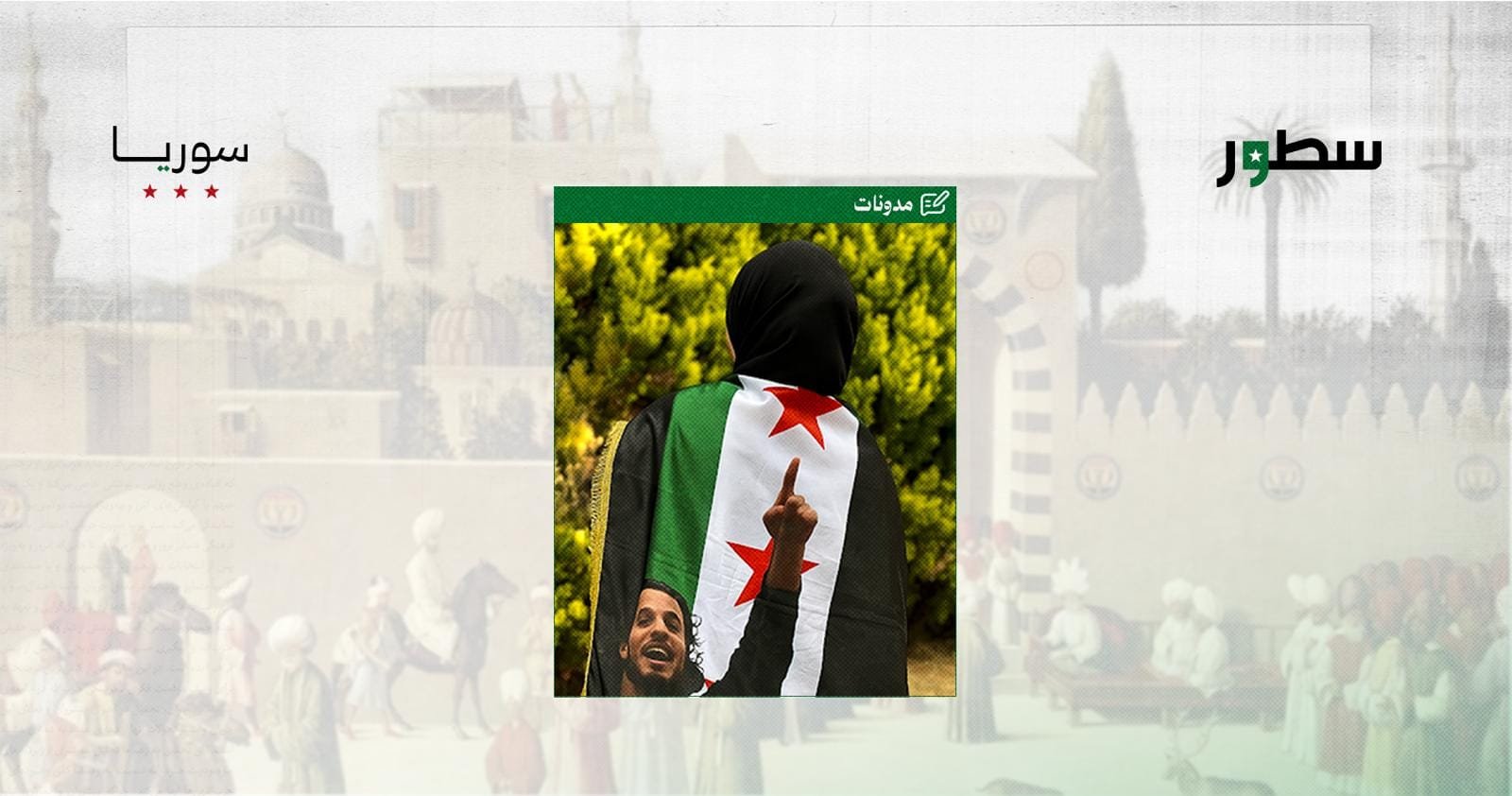مجتمع
ما بعد النجاة: حين يصبح البقاء قيداً لا إنجازاً قراءة في عقل السوري الناجي
ما بعد النجاة: حين يصبح البقاء قيداً لا إنجازاً قراءة في عقل السوري الناجي
في أحد اللقاءات التي أجريتها، قال رجل في العقد السادس من عمره، مهجّر إلى الشمال السوري منذ سنوات، جملة ظلّت عالقة في أذهاننا: “أنا مو من هون.. عيني مو هون. عيني على بلدي. إذا ما قدرت أرجع أعيش فيها، بدي أرجع اندفن فيها”. لم يكن يقصد إثارة الشجن، ولم يكن حديثه عن العودة مدفوعاً بالحنين وحده، بل برفض ضمني لفكرة أن النجاة وحدها كافية لنعلن أننا بخير. كان يرى نجاته من الحرب والتهجير أمراً واقعاً، لكنه لا يمنحه شعوراً بالانتصار، ولا حتى بالانتماء.
في السنوات الأخيرة، بدا أن وعينا السوري الجمعي قد أعاد تعريف البطولة بطريقة جديدة: لم تعد تُقاس بالفعل أو التغيير أو القدرة على بناء بديل، بل النجاة وحدها. صارت قصص البقاء على قيد الحياة تُروى بوصفها انتصارات، وتحوّل الصبر إلى فضيلة مكتفية بذاتها. نردّد على أنفسنا أن مجرد الاستمرار بعد كل ما حدث هو بحد ذاته إنجاز، وأننا ما دمنا أحياء، فذلك يعني أننا أقوى. وهكذا، أصبحت عبارة “نجونا رغم كل شيء” مرادفة للرضا، وأحياناً للرضوخ.
هذا التحوّل في الوعي لم يأتِ من فراغ. لقد خسرنا الكثير، ولم نحصل في المقابل على مشروع بديل نستند إليه. وبدلاً من مواجهة هذا الفراغ، اخترنا أن نمجّد قدرتنا على تحمّله. تحوّلت الضرورة إلى بطولة، وتحول الصمت إلى حكمة، وتحولت النجاة إلى وسام. في هذا المقال، نحاول أن نتتبّع كيف تحوّلت النجاة في المخيال السوري من ضرورة اضطرارية إلى قيمة يُحتفى بها، وكيف ساهم تمجيد البقاء في ترسيخ وعي جماعي يُجيد الاحتمال، لكنه لا يجرؤ على الحلم.
النجاة أعلى إنجاز: من الضرورة إلى البطولة
لم يكن البقاء على قيد الحياة يوماً هدفاً بحد ذاته، بل كان دائماً شرطاً للانتقال إلى ما هو أبعد: الاستمرار، البناء، الحلم. لكن في السياق السوري، حيث تراكمت الخسارات وتساقطت المشاريع الكبرى، انكمش المعنى حتى صار مجرّد النجاة يبدو إنجازاً. لم يعد السؤال: “ماذا سنفعل بعد أن نجونا؟” بل أصبح: “كيف ما زلنا على قيد الحياة؟” وهكذا، انتقلت النجاة من كونها ردّ فعل اضطرارياً على واقع مفروض، إلى أن أصبحت قيمةً تُروى ويُحتفى بها.
نرى هذا التحوّل في طريقة تداول القصص الفردية، التي كثيراً ما تُقدَّم باعتبارها نموذجاً يُحتذى: شاب نجا من القصف، فاحترف مهنة جديدة. عائلة فقدت منزلها، فأسست مشروعاً صغيراً في المنفى. لا شك أن هذه القصص تلهم وتمنح الأمل، لكنها حين تصبح السردية الوحيدة، فإنها تحجب واقعاً أكثر تعقيداً: أن أغلب السوريين لم ينجحوا، بل نجو فقط. وأن هذا “النجاح” الذي نرويه، لا يمثّل الغالبية، بل يختزل التجربة ويعيد تشكيلها بشكل مريح.
بمرور الوقت، تكرّست النجاة كهوية ثقافية، وصار تمجيدها بمثابة التعويض الرمزي عن غياب الإنجاز الحقيقي. بدل أن نواجه الأسئلة الكبيرة: “أين مشروعنا الوطني؟”، “أين العدالة؟”، “أين المعنى؟”، نجد في تمجيد الصبر والاحتمال مهرباً نفسياً وجماعياً. نُقنع أنفسنا بأن البقاء مقاومة، وأن التحمل بطولة، حتى وإن كنّا لا نملك شيئاً ندافع عنه سوى قدرتنا على الاستمرار وسط الخراب.
لعلّ أنسب ما يُذكّرنا بحدود هذه الفكرة هو موقفٌ محفوظ في التاريخ الإسلامي: حين كان عبد الرحمن الداخل، آخر أمراء بني أمية، يهرب من العباسيين بعد سقوط الدولة، وكان رأسه مطلوباً حيّاً أو ميتاً، سأله أحد خدمه: “ما خطتك؟” فأجابه بجملة شهيرة: “أن نبقى أحياء” لم يكن يقصد النجاة كغاية، بل كمرحلة ضمن مشروع أكبر. لقد أراد النجاة لكي يُكمل ما بدأه، لا لكي يروي حكايته. وشتّان بين أن ننجو لنحكم، وأن ننجو لنتذكّر فقط أننا نجونا.
السردية العامة: تمجيد الفرد لإخفاء العجز الجماعي
في السنوات التي تلت الانفجار السوري، ومع اتّساع رقعة التهجير وتفتّت المجال العام، بدأت تتبلور سردية جديدة تُعيد ترتيب معنى “الصمود” في المخيال الجماعي. لم يعد الصمود مرتبطاً بالفعل الثوري أو الاستمرار في مواجهة منظومة القتل، بل بات يُختزل في القدرة على النجاة الفردية. وهكذا، صار من الطبيعي أن تُروى القصص الشخصية بوصفها بديلاً عن الرواية الوطنية، وأن تتحوّل حكاية اللاجئ الذي أنشأ مطعماً صغيراً، أو الطالب الذي تفوّق في جامعة أوروبية، إلى نموذج يُقدَّم على أنه ملهم، مكتفٍ، وممثل عن “النجاح السوري”.
لا إشكال في أن نحتفي بالنجاحات الفردية، بل من الطبيعي أن نبحث عن النور وسط هذا الظلام الطويل. المشكلة تبدأ حين تتحوّل هذه الحكايات إلى منصة للطمأنة الرمزية، فيُعاد تدويرها بشكل مفرط في الإعلام ومنصات المجتمع المدني ومنشورات السوشيال ميديا، لتصبح أقرب إلى سردية رسمية بديلة: “انتهت مرحلة الثورة، وبدأت مرحلة الحياة” بهذا الشكل، لم تعد القصص الفردية وسيلة لتوسيع الوعي، بل أداة لإعادة إنتاج التقبّل، وربما، في بعض السياقات، للتكيّف مع الخسارة بوصفها قدراً نهائياً.
النتيجة هي أن الخطاب العام لم يعد يهتم بما خسرناه كمجتمع، بل بما استطاع بعضنا النجاة به كأفراد، فتحوّلت المحنة من سؤال سياسي وأخلاقي عن الجريمة والعدالة، إلى استعراض مرئي للمرونة الفردية. لم نعد نتساءل عن مصير البلاد، بل نصفّق لمن خرج منها و”نجح” في تأسيس حياة أخرى. ولم نعد نبحث عن سردية جامعة، بل عن حكايات تبقينا مشغولين عن مواجهة الحقيقة: إننا، في المجمل، ما نزال في قلب العجز، لكننا نحتمي بمن استطاع الخروج منه.
في المحصلة، تحوّلت النجاة الفردية من نتيجة حتمية لواقع قاسٍ، إلى قيمة رمزية يُحتفى بها، ويُطلب تعميمها. لكن هذا التمجيد المتواصل، وإن بدا بريئاً أو مُلهِماً، يخفي انهياراً أعمق في بنيتنا الجمعية، ويُسهم في ترسيخ العزلة والتشظّي بدل مواجهته. لقد وجدنا في قصص الأفراد مهرباً من مشروع لم نعد نملك الشجاعة لطرحه، ومن أسئلة لم نعد نجرؤ على صياغتها.
النجاة كهوية: حين يصبح الألم وطناً
مع مرور الوقت، وتكرار الصدمات، وتراكم الخسائر، بدأت النجاة تتحوّل من فعل مؤقت إلى موقع وجود دائم. لم تعد مجرّد لحظة عبور من خطر إلى أمان، بل أصبحت تعريفاً للذات، ومصدراً للشرعية، وحتى بطاقة انتماء جديدة. لقد استبدل كثير من السوريين شعورهم بالانتماء إلى بلد أو قضية، بانتماء إلى التجربة نفسها: تجربة النجاة. وهكذا، لم نعد نُعرِّف أنفسنا بالهوية أو الرؤية أو الهدف، بل بما خسرناه وتمكّنا من تحمّله.
يتجلّى هذا التحوّل في اللغة اليومية وفي رموزنا الثقافية. إذ باتت السير الذاتية، حتى في الأوساط المهنية، تبدأ من لحظة “الهروب من الحرب” أو “النجاة من الاعتقال”، وكأن تلك اللحظة صارت الأصل، وكل ما بعدها فرع منها. في الخطاب الإعلامي، كثيراً ما تُقدَّم الشخصيات العامة وفقاً لما نجت منه لا لما تحققه، وفي السرديات الروائية والمذكرات، أصبحت بداية النجاة مرادفاً لبداية الحياة. وبذلك، أصبح الألم هو المكوّن الرئيسي للهوية، والنجاة هي العلامة الفارقة التي تمنح التجربة معناها، حتى ولو كان معنى خالياً من الاتجاه.
لكن تحويل النجاة إلى هوية ليس مجرد أثر نفسي لصدمات متكررة، بل هو أيضاً نتاج غياب البدائل. في ظل انعدام الأفق السياسي، وتفتّت النسيج الاجتماعي، وغياب المشروع الوطني، لم يجد كثيرون غير الألم جامعاً مشتركاً، والتجربة الفردية مأوى رمزياً. ومع هذا التحوّل، صار الحديث عن العودة أو التغيير أو بناء مستقبل يبدو خطاباً غريباً أو حتى رومانسياً، في حين يُنظر إلى سردية النجاة على أنها الواقعية الوحيدة المتبقية.
ما يغيب عن هذا المشهد هو أن النجاة، إذا لم ترتبط برؤية، تتحوّل من قوة إلى قيد. فإذا كان الألم قادراً على أن يجمعنا، فهو أيضاً قادر على أن يُبقينا عالقين فيه. وإن كانت النجاة تمنحنا شرعية القول، فإنها لا تمنحنا بالضرورة حق الفعل. والأسوأ من ذلك، أنها قد تُقنعنا بأن البقاء نفسه هو الفعل، وأن الصمت هو الخيار، وأن كل ما يمكن فعله قد فُعل.
خاتمة
لا ننكر أن النجاة، في حد ذاتها، كانت فعلاً بطولياً في لحظات معينة. لقد عبرنا سنوات من القصف والاعتقال والحصار والمنافي، وشهدنا انهيارات كان من الممكن أن تفني الذاكرة، لولا أن بعضنا تمسّك بها. لكننا لا نستطيع أن نحول فعل النجاة إلى مشروع بديل، ولا أن نعلّق عليه معنى الحياة، لأن النجاة من دون غاية، من دون بناء، من دون تجاوز، هي مجرّد وقوف طويل في مكان السقوط.
لقد منحتنا الحرب هوية مشتركة من الألم، لكننا لا نحتاج إلى مزيد من الألم لنعرف من نحن. ما نحتاجه اليوم هو أن نتحرّر من هوس الاحتمال، ونفكر من جديد بما نريده فعلاً، لا بما يمكننا تحمّله. أن نعيد طرح الأسئلة التي أخفيناها خلف قصص البقاء: من نحن؟ ماذا خسرنا؟ وماذا يمكن أن نبني الآن، لا لأننا نجونا، بل لأننا نرفض أن نظلّ في دور الناجين فقط.
أن ننجو، نعم، لكن ألا نكتفي بذلك.