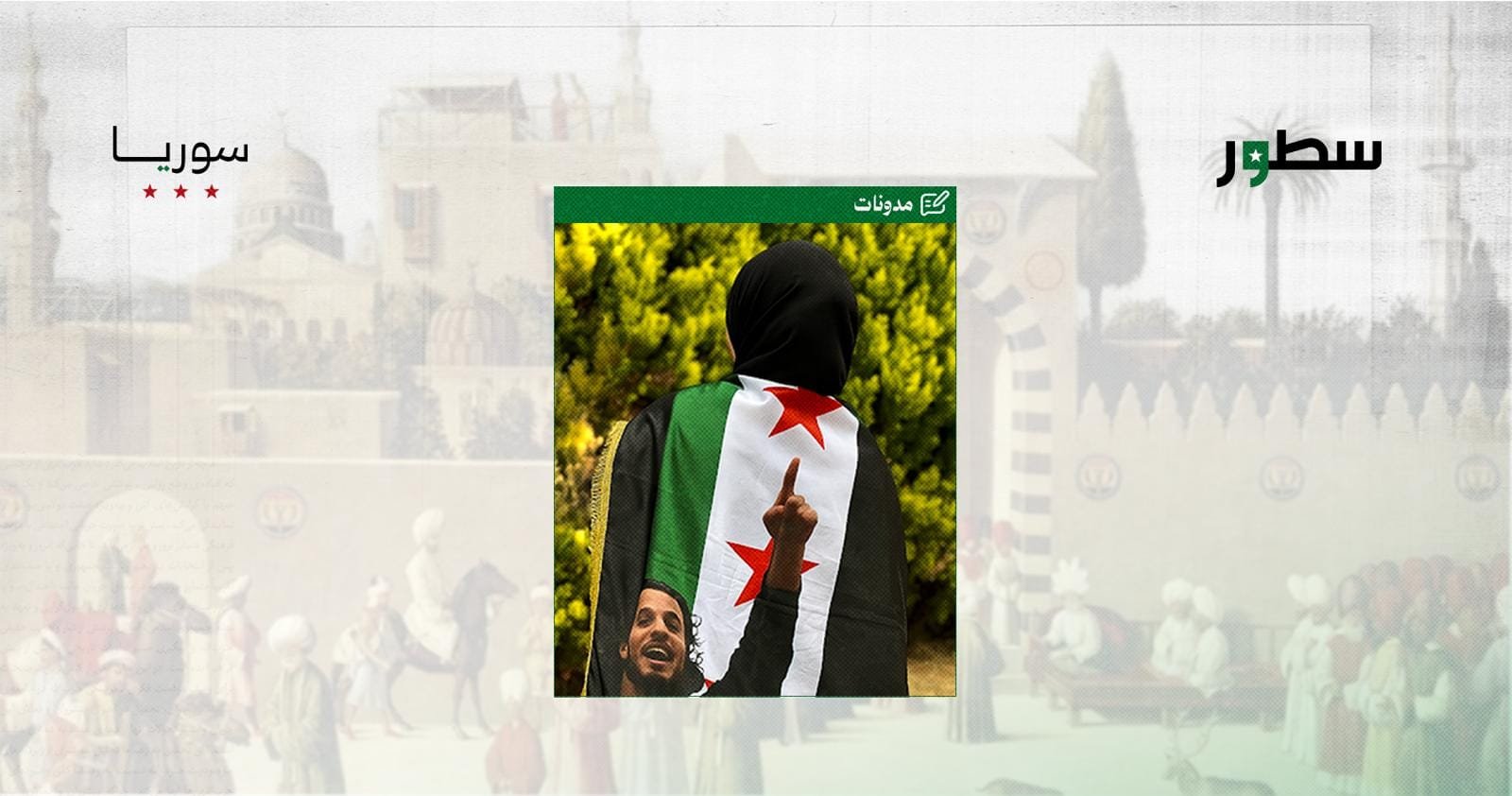سياسة
من رماد الحرب: بناء الدولة أم بناء الأمة؟ جدلية البقاء والنهضة
من رماد الحرب: بناء الدولة أم بناء الأمة؟ جدلية البقاء والنهضة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻤﺖ اﻟﻤﺪاﻓﻊ وﺗﺘﻮﻗﻒ أﺻﻮات اﻟﺮﺻﺎص، ﻻ ﻳﺤﻞ اﻟﺴﻼم ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً، بل ﺻﻤﺖ ﺛﻘﻴﻞ، ﻣﺸﺒﻊ ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺒﺎرود واﻟﺨﺮاب، ﻳﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪن ﻣﺪﻣﺮة وﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎرة، مع دمار أﻋﻤﻖ ﻻ ﺗﺮاه العيون، دمار دفين ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻤﺰق، واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮاﺣﺪ، واﻟﺠﺮوح اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻐﺎﺋﺮة اﻟﺘﻲ زرعتها الحرب ﻓﻲ ذاﻛﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
لم تمضِ سوى أشهر قليلة على سقوط نظام الأسد البائد، حتى اصطدمت عملية إعادة بناء الدولة بمعضلات بنيوية معقدة، إذ لم تنجح الدولة الناشئة في بسط سلطتها على كامل الجغرافيا السورية، وظلّت خرائط السيطرة العسكرية التي ترسمها جماعات ما دون الدولة قائمة في الأطراف، تُنازع المركز سلطته. هذه الخرائط، لا تعبّر عن موازين قوى سياسية فقط، بل تعكس أيضاً أبعاداً اجتماعية وهوياتية عميقة، حيث يتراجع حضور الهوية الوطنية لصالح هويات فرعية غير مرتبطة بفكرة الدولة.
جاءت محاولة فلول نظام الأسد برسم واقع انفصالي جديد في الساحل، وتنصل “قسد” المتكرر من اتفاقية الاندماج الكامل مع الدولة الوطنية، ثم مواجهات السويداء وما رافقها من اشتباكات وانتهاكات متبادلة وتهجير فئة أصيلة من مجتمع المحافظة المحلي، لتؤكد جميعها على هشاشة الهوية السورية الجامعة، أمام تصاعد الهويات غير الوطنية بشقيها الطائفي والقومي. فالانقسام بات يتجذر في الأطراف التي تنسج تضامنات داخلية مستقلة، منفصلة عن المركز وعن الكتلة المجتمعية الأوسع. في المقابل، أكدت الانتهاكات المرتكبة في هذه المناطق حالة عدم الانتماء الجمعي وكشفت الزاوية غير الوطنية التي تنظر منها الفئات المجتمعية تجاه بعضها البعض، كما عززت خطاب الكراهية المتبادل، وسط غياب هوية وطنية جامعة كان يمكن أن تُمثّل مظلة حماية رمزية وأخلاقية للجميع.
في هذه اللحظة الفارقة، تبرز أمام السوريين إشكالية وجودية: من أين يبدأ البناء؟ وما الطريق الذي يجب أن يُسلك للانتقال من ركام الحرب إلى مستقبل آمن ومزدهر؟، كما تطرح هذه المرحلة سؤالاً حاسماً: هل ينبغي أن تكون الأولوية لإعادة بناء الدولة، بما تتطلبه من مؤسسات وهياكل قانونية ونظم إدارية؟ أم أن الجهد يجب أن يُوجَّه أولاً نحو بناء الأمة، من خلال استعادة الهوية الجامعة، وتعزيز اللحمة الاجتماعية، وبناء روح جماعية جديدة تتجاوز الانقسام؟
هذا السؤال ليس مجرد نقاش فكري، بل هو جوهر التحدي الذي سيحدد مستقبل سوريا لعقود مقبلة. فالدولة التي فشلت مؤسساتها في أداء وظائفها، وانهارت قواعد شرعيتها خلال سنوات الحرب السابقة، لا يمكن إعادة بنائها دون مشروع وطني جامع، كما أن بناء الأمة في ظل غياب الدولة يفتقر إلى الأمان المؤسساتي الذي يحمي هذه الهوية ويمنحها الاستمرارية.
بناء الدولة وبناء الأمة: التباس شائع وضرورة التمييز
قبل الخوض في تعقيدات العلاقة بين المسارين، من الضروري وضع أساس مفاهيمي واضح. فالخلط بين مصطلحي “بناء الدولة” و”بناء الأمة” شائع في الخطاب السياسي والإعلامي، وهو خلط لا يمر بلا ثمن، إذ يقود إلى رؤى مرتبكة وسياسات مشوهة. في العلوم السياسية، يحمل المصطلحان دلالات متقاربة من حيث الارتباط بإعادة الإعمار، لكنهما يختلفان في الجوهر والوظيفة. وإدراك هذا الاختلاف هو نقطة الانطلاق لأي عملية بناء جادة؛ فبناء الجدران لا يغني عن ترميم الهوية، كما أن إحياء المؤسسات دون مشروع وطني جامع هو ضربٌ من العبث السياسي.
يشير بناء الدولة إلى العملية المؤسسية والمادية التي تركز على تأسيس وتعزيز الهياكل الأساسية “Hardware” التي تمارس السلطة وتؤدي الوظائف الحيوية للحكم، بحيث تصبح الدولة قادرة على الاستمرار بفعالية وكفاءة. ووﻓﻘﺎً لتعريف ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ، ﻓﺈن ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء.
بهذا المعنى لا يقتصر بناء الدولة على مجرد إنشاء أجهزة حكومية، بل يشمل إقامة نظام أمني متماسك يضمن السيطرة على العنف المشروع عبر جيش وطني ومؤسسات أمنية مستقلة، إلى جانب ترسيخ سيادة القانون من خلال قضاء نزيه وفعال. كما يتطلب هذا البناء إقامة إدارة عامة بيروقراطية متطورة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، كالقطاع الصحي والتعليم والبنية التحتية، فضلاً عن صياغة سياسات اقتصادية تضمن الاستقرار المالي، وتعزز بيئة الاستثمار، وتوفر فرص العمل. ومن هنا، يصبح بناء الدولة عملاً متكاملاً يسعى إلى تحقيق توازن بين القوة الأمنية، وكفاءة الإدارة، والاستقرار الاقتصادي، مما يؤسس لقاعدة صلبة للحكم الفعّال وبقاء الدولة في مواجهة التحديات.
بالمقابل، يركز بناء الأمة على الروابط الاجتماعية “Software” التي تربط أفراد المجتمع ببعضهم البعض، فهي عملية تأسيس هوية وطنية جامعة وشعور بالانتماء ومصير مشترك يتجاوز الولاءات الضيقة كالقبلية والطائفية والعرقية، بهدف توسيع دائرة الاهتمام الأخلاقي لتشمل جميع المواطنين، كما يصف ذلك الفيلسوف بيتر سينغر. ويتضمن بناء الأمة تعزيز المصالح المشتركة والتسامح عبر تعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة ومعالجة آثار الماضي من خلال آليات العدالة الانتقالية، إلى جانب خلق هوية وطنية جامعة تحتفي بالتنوع وتجمع قواسم مشتركة بين مكونات المجتمع المختلفة.
ويشمل إعادة بناء الثقة الاجتماعية، ليس فقط بين المواطنين والدولة، بل بين المواطنين أنفسهم، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة التي تقوم على الحقوق والواجبات المتساوية لجميع الأفراد. وغالباً ما يختلط مصطلح بناء الأمة بمصطلح بناء الدولة، خاصة في سياقات التدخل الدولي حيث يُستخدم لوصف جهود إعادة بناء المؤسسات في دول أخرى، لكن التجارب أثبتت أن بناء الدولة يمكن فرضه من الخارج بالقوة، بينما بناء الأمة هو عملية عضوية داخلية أولى لا يمكن أن يقوم بها الخارج. ومن هنا، فإن التمييز بين الهيكل المادي (الدولة) والروح الجماعية (الأمة) يمثل الخطوة الأولى نحو وضع استراتيجية متكاملة للتعافي والتعايش.
جدلية الدولة والأمة: تفاعلات البناء وتأثيراته
تتسم العلاقة بين بناء الدولة وبناء الأمة بالتعقيد والديناميكية، فهي ليست علاقة خطية أو ذات اتجاه واحد، بل تمثل تفاعلاً متبادلاً قد يكون في بعض الأحيان ضمن دائرة مثلى من الدعم المتبادل، وأحياناً في دائرة مفرغة من الفشل والتباعد. فالدولة القوية والعادلة توفر الإطار الذي يمكن للأمة من خلاله التعايش والتوحد، بينما تضمن الأمة المتماسكة للدولة الشرعية والقوة اللازمة للعمل بفعالية. عندما تؤسس الدولة مؤسسات قضائية مستقلة يشعر المواطنون بإمكانية تحقيق العدالة، مما يسهل عمليات المصالحة، كما أن التوزيع العادل للخدمات والثروة يقلل من مظاهر الانقسامات الاجتماعية، ويخلق الأمن اللازم للحوار المجتمعي عبر جيش وطني موحد.
بالمقابل، فإن شعور المواطنين بالانتماء لهوية وطنية جامعة يعزز من شرعية الدولة، ويشجع على الالتزام بالقانون، ويخفض من تكاليف المناكفات والمماحكات الاجتماعية ويكافح الفساد، ما يزيد من كفاءة المؤسسات. ومن الأمثلة النموذجية على هذا التكامل تجربة رواندا التي لم تركز بعد الإبادة الجماعية المروعة، فقط على إعادة بناء مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية، بل أطلقت حملة وطنية شاملة لبناء هوية وطنية موحدة تجاوزت الانقسامات العرقية عبر المحاكم الأهلية وبرامج التوعية والتأكيد على المواطنة المشتركة، ما مكنها من تحقيق نجاح حظي بإعجاب دولي واسع جعله نموذجاً أمثل يسعى كثير من الدول التي تعاني من تبعات الحروب إلى اقتباسه في مساعي التنمية بعد النزاع.
عندما يتركز الاهتمام على مسار واحد مع إهمال الآخر، غالباً ما تنتهي العملية بالفشل في بناء كليهما، الدولة والأمة، وهو السيناريو الذي يفسر ظهور ما يُعرف بـ “الدولة الفاشلة” أو “الدولة الهشة”. هذا الفشل ينبع من فجوة عميقة بين بناء الهيكل المادي للدولة وتجاهل البنية الاجتماعية والثقافية للأمة، كما حدث في العديد من الدول العربية التي استنسخت نموذج الدولة القومية الغربية دون مواءمة مع البنية الاجتماعية الموروثة، فكانت النتيجة مؤسسات شكلية منقطعة الصلة بالمجتمع، تفتقر للشرعية، وتحولت إلى أدوات قمع بيد فئة أو طائفة، مما عمّق الانقسامات وزاد من تعقيد الصراع بدلاً من حله. بالمقابل، تبقى محاولات بناء الأمة التي تركز على المصالحة وبناء الهوية المشتركة حبراً على ورق إذا غابت مؤسسات دولة مركزية قوية تفرض القانون وتحمي المواطنين، إذ إن غياب سلطة مركزية يؤدي إلى فراغ يملؤه أمراء الحرب والمليشيات، فتتحول الهويات الفرعية إلى مشاريع سياسية متصارعة، ما يجعل بناء الأمة مستحيلاً في ظل تشرذم اجتماعي وسياسي وأمني دائم.
تحديات البناء الوطني: واقع داخلي مُتشظٍ وضغوط خارجية
تظل عملية البناء المزدوجة للدولة والأمة محفوفة بمخاطر جسيمة وعقبات هائلة، تعرقل الجهود المبذولة حتى في حال توفر النيات الحسنة والاستراتيجيات السليمة. تتميز هذه التحديات بطبيعتها المركبة والمتشابكة، إذ يمكن تصنيفها إلى عقبات داخلية تتعلق بواقع الدولة والمجتمع، وأخرى خارجية تنبع من التدخلات والضغوط الدولية والإقليمية. إن الفهم الدقيق لهذه العقبات، وإدراك تداخلها وتأثيرها المتبادل، يشكلان مدخلاً ضرورياً لوضع سياسات فعالة تساهم في تجاوزها وتحقيق بناء مستدام لكل من الدولة والهوية الوطنية الجامعة.
تُعدّ مواجهة إرث الصراع من أصعب التحديات الداخلية التي تعترض مسار بناء الدولة والأمة، حيث تتجلّى هذه العقبة في التعامل مع تبعات الحرب المباشرة، والتي تشمل انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، مع صعوبة نزع سلاح المليشيات ودمج مقاتليها ضمن المجتمع المدني، الأمر الذي يفاقم حالة انعدام الاستقرار ويعزز من وجود “رواد الأعمال المجرمين” الذين يسعون إلى استمرار حالة الفوضى المقترنة مع نمو اقتصاد الحرب، وشبكات الفساد حفاظاً على مصالحهم الضيقة. وعلى الصعيد المجتمعي، أدت الحرب إلى تفكيك النسيج الاجتماعي، مخلّفة انقسامات عميقة وجروحاً تاريخية لا تُشفى بسهولة. كما تزداد تعقيدات إعادة بناء الدولة مع ارتفاع مستويات التنوع الديني والعرقي والانقسام المناطقي والثقافي، حيث يصبح بناء الثقة والاتفاق على رؤية وطنية مشتركة شبه مستحيل، مما يعوق تحقيق وحدة وطنية حقيقية.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني الفضاء السياسي الداخلي السوري من ضعف في النخب السياسية المؤثرة، ويفتقر المجتمع السوري اليوم إلى قيادات تمتلك رؤية وطنية جامعة. وبدلاً من ذلك، تهيمن نخبة سياسية فئوية وجماعاتية تسعى لخدمة مصالح فئاتها الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا، وهو ما أثبتته محاولة فرض السيطرة على محافظة السويداء، إذ انقسمت النخب السياسية والثقافية طائفياً و”ارتدت” عن وطنيتها وعلمانيتها، ما فاقم حالة الانقسام وعطل جهود المصالحة والتوافق.
على الصعيد الخارجي يُشكّل التنافس الجيوسياسي أحد أبرز التحديات الخارجية التي تواجه عمليات بناء الدولة والأمة السورية، ففي ظل عالم متشابك ومترابط، لم تكن الحرب السورية شأناً داخلياً بحتاً. إذ كثيراً ما انخرطت القوى الإقليمية والدولية بدعم أطراف محلياتية مختلفة؛ ما قد يحول جهود إعادة الإعمار إلى استمرار للصراع بأساليب جديدة، من خلال دعم أحد الأطراف ودفعه للمطالبة بالحكم المحلي فالانفصال، أو عبر استخدام المساعدات والاستثمارات لخدمة أجندات سياسية خارجية بعيدة عن مصلحة الوطن. إضافة إلى ذلك، تفرض جهات المانحين الدوليين، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شروطاً اقتصادية وسياسية قد تكون غير متوافقة مع الواقع المحلي الهش، حيث غالباً ما تركز هذه الحلول بشكل مفرط على الاستقرار الاقتصادي الكلي دون إعطاء الأبعاد الاجتماعية الحيوية، مثل العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية، ما يؤدي إلى تقويض فرص بناء أمة متماسكة ومستقرة. إلا أن المتغيرات الخارجية ليست مهيمنة بالمطلق في إعادة بناء الدولة والأمة، كونها استحقاق داخلي لا يمكن فرضه من الخارج، بل يتطلب قيادة وطنية جامعة تتمتع بالقدرة على خلق رموز وممارسات وقيم مشتركة ينبثق عنها مشروع مجتمعي مستدام.
نحو عقد اجتماعي جديد: بناء الدولة والأمة في إطار رؤية مشتركة
في نهاية المطاف، يتضح أن السؤال القائل: “الأمة أولاً أم الدولة أولاً؟” هو سؤال مضلل من الناحية العملية، إذ لا يمثل خيارين متعارضين، بل وجهاً مختلفاً لعملية واحدة متكاملة. لا يمكن لأي منهما أن ينجح بمعزل عن الآخر، فالتحدي الحقيقي الذي تواجهه الدولة السورية لا يقتصر على إعادة بناء ما كان قائماً قبل الثورة، بل يتطلب تأسيس صيغة جديدة لعقد اجتماعي يتجاوز أوجه التوازن الهشّة التي كانت سائدة سابقاً، ويؤسس لعلاقة صحيّة بين الحاكم والمحكوم.
على ألا يقوم العقد الاجتماعي الجديد فقط على البُنى السياسية والاقتصادية، بل على المعاني والرموز المشتركة وقيم الفضيلة التي يجب أن تسود المجتمع، مثل الصدق، والعدالة، والتسامح، والمسؤولية، كأرضية أخلاقية تربط بين لبِنات الدولة وروح الأمة. والسلام الحقيقي لا يتحقق بإصلاح جانب دون الآخر، فبناء الدولة من دون أمة هو مجرد هيكل بلا روح، وبناء أمة من دون دولة هو روح بلا جسد يحميها. التحدي إذن ليس في اختيار أحد المسارين، بل في السعي لدمجهما ضمن رؤية متكاملة تنطلق من فهم العلاقة التكافلية بين الدولة والأمة، وتسير في مسارين متوازيين ومتضافرين.
إن هذا الإطار الأخلاقي يُعيد تشكيل المجتمع في طريق طويل وشاق، لكنه ليس مستحيلاً. يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ومشاركة مجتمعية واسعة، ورؤية مشتركة قادرة على تحويل رُكام الحرب إلى أساس متين لمجتمع موحد، مرن، وقادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.