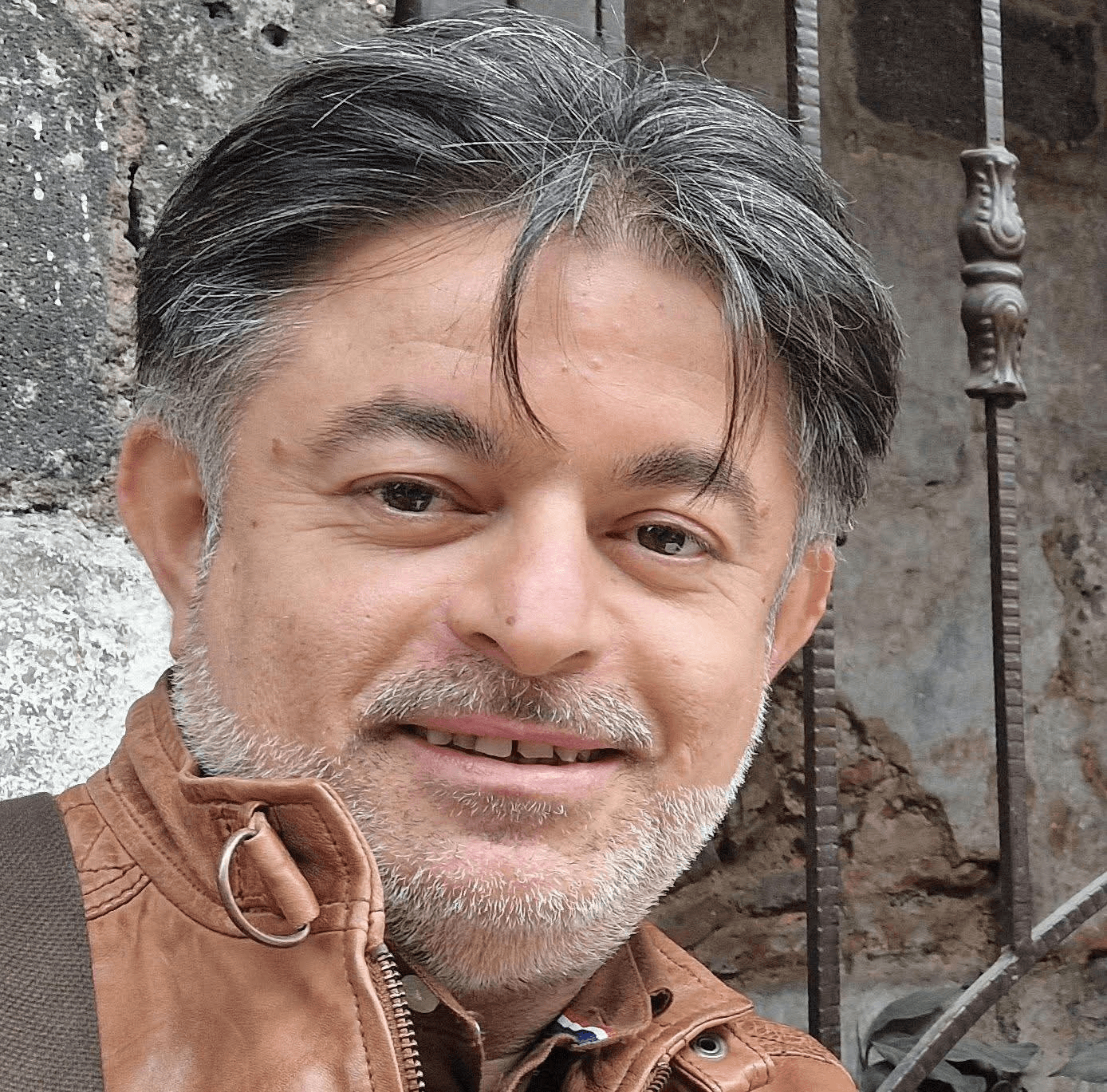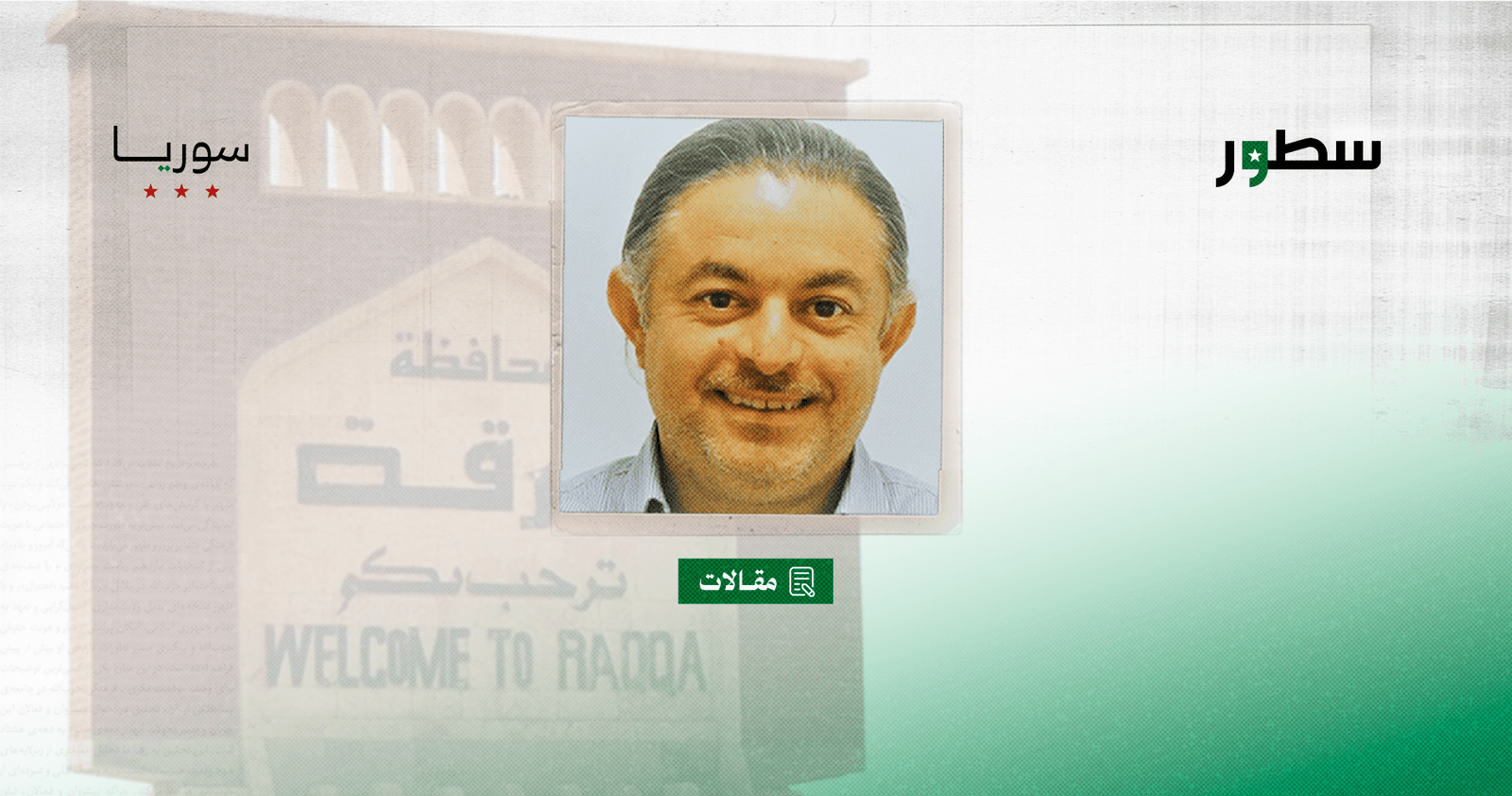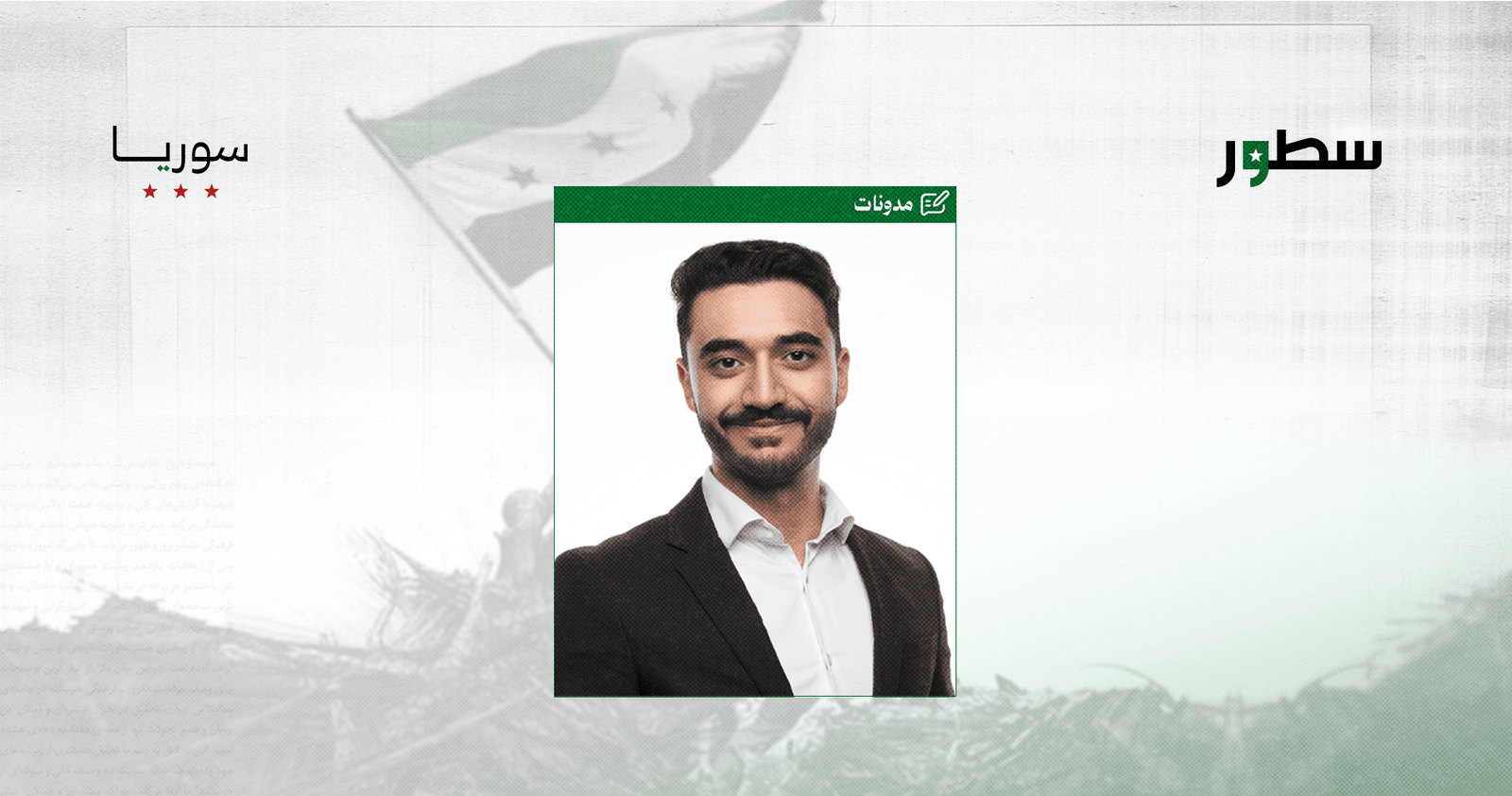مجتمع
“لستُ بعثياً”.. عن الولاء الإجباري والهوية المسروقة
“لستُ بعثياً”.. عن الولاء الإجباري والهوية المسروقة
أتذكر تلك اللحظة جيداً، كما لو أنها حدثت البارحة، لا لأن فيها حدثاً استثنائياً، بل لأنها شكلت لدي بداية تكوين الوعي. لا بناءً على من تكون، بل بناءً على من تنتمي إليهم. إذ كنت في الصف السابع الإعدادي عام 1994-1995، أدرس في مدرسة “زكي الأرسوزي”، في حي المشلب، الحي الذي أعيش فيه، أحد أحياء مدينة الرقة. يومها، شعرت بسعادة لا توصف عندما أُخرجت من الحصة الدراسية، لحظة انتصار ساحقة لمراهق يهرب من درس رتيب، وهو محاط بأبناء وبنات عمومته، كلنا نحمل ذات اللقب العائلي، لم نكن نعلم أن ما نعيشه ليس سوى بداية لمشهد يلازمنا طيلة حياتنا.
ظننا بداية أن من دخل علينا هم موظفون من “التفتيش التربوي”، وسعدنا لفكرة أن بقاءنا في ساحة المدرسة لبعض الوقت سيكون ممتعاً ومسلياً، لكن سرعان ما تبين أن هؤلاء ما كانوا سوى مندوبين من فرع “حزب البعث العربي الاشتراكي”، الحزب القائد للدولة والمجتمع. جلسوا أمام زملائنا وبدؤوا الحديث عما أسموه “منطلقات الحزب”،”الوحدة، والحرية، والاشتراكية، والقومية العربية”، وعن دوره في “التحرير والعدالة الاجتماعية”، ثم بدؤوا بالترغيب تارة والوعيد بأن لا سبيل للحياة إلا من خلال الانتساب إلى الحزب، بدءاً من صفة “نصير” ثم “عضو عامل”.
في أعينهم، بدا الأمر شرفاً رفيعاً، الجلوس في حلقة حزبية، ومخاطبتك بلقب “يا رفيق”، كان يفترض أن يشعرك بأنك امتلكت شيئاً لا يمتلكه غيرك، وأنك أصبحت فجأة عنصراً فاعلاً في “قيادة الدولة والمجتمع”. هكذا علمونا أن نفكر.
لكن شيئاً في داخلي كان مشوشاً، تساءلت: لماذا نحن بالذات؟ لماذا أنا وأبناء عمومتي دوناً عن باقي الطلاب؟ ما الرابط الذي جمعنا نحن فقط؟ ولماذا اختير من بين عشرات الطلاب من يحملون نفس اللقب العائلي؟
الإجابة لم تتأخر، لكنها كان وقعها صادماً أكثر مما ظننت. عرفنا لاحقاً أننا أخرجنا من حصصنا الدراسية لا تكريماً، بل عقاباً. لأننا، بحسب رواية الحزب، ننحدر من “سلالة الإقطاع”. نعم، هكذا وصفنا. لا مراهقين نعيش في مدينة تعاني من التهميش والفقر، بل كأبناء طبقة يجب أن تُعاد تربيتها على سلم “قيم الحزب”.
البعث هوية: آلة تصنيع الإنسان
هنا بدأت أفهم أن “البعث” لم يكن حزباً عادياً، بل مؤسسة شمولية متكاملة تعيد تشكيل الوعي والهوية، لا بهدف البناء، بل بهدف السيطرة والاستحواذ. كان يريد أن يغرس في أذهاننا منذ الطفولة أننا مذنبون فقط لأننا نحمل أسماء لم تعجبه. وأن الخلاص لا يكون إلا عبر الولاء له والخضوع لبيت الطاعة، عبر التنصل من اسمك، ومن تاريخك، ومن طبقتك الاجتماعية، وحتى من عقيدتك، التي لم تنج من التشويه.
لقد رأيت كيف يتحول التنظيم السياسي إلى أداة لإعادة تصنيع الإنسان، وفق مقاييس ومعايير محددة. من يقبل، ينجو ويكافأ. ومن يرفض، يراقب ويقصى.
خطاب التخوين.. من القائد عبد الناصر إلى دولة البعث
منذ انقلابه على الحكم عام 1963، بنى حزب البعث خطابه على معادلة تبسيطية خطرة: “نحن” نمثل الخير المطلق، و”الآخر” هو الشر المطلق. ولم يكن هذا “الآخر” عدواً خارجياً دائماً، بل كثيراً ما كان الجار أو المزارع أو رجل الأعمال أو حتى ابن البلد.
فئة كاملة من السوريين، من ملاك الأراضي، والمستثمرين الزراعيين، والعائلات التي أسست مشاريع إنتاجية ناجحة، جرى شيطنتها ووصفها بـ “الرجعية” و”الاستغلالية”، بحجة أنهم “أعداء الفلاحين”، لم تكن تلك مجرد دعاية شعبوية، بل سياسة ممنهجة ومتكاملة الأركان، وتحت شعار “الإصلاح الزراعي”، صودرت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، لا لتوزيعها بعدل أو إنصاف، بل لتُقدَّم كهبات لأفراد منتقين بعناية، ضمن شبكات الولاء البعثي.
أنا، وكثير من أبناء منطقتي، نعرف جيداً كيف ومتى انطلقت هذه المسيرة؛ فقد بدأت عام 1958 مع صدور قانون “الإصلاح الزراعي” في عهد الوحدة بين سوريا ومصر، بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر. كان ذلك القانون بمثابة منعطفاً حاداً في البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إذ فرض سقفاً للملكية الزراعية، ومصادرة ما يزيد عليه لصالح الدولة، في مسعى لتفكيك القوة الاقتصادية التقليدية في الريف السوري، والتي شكلت عماد الطبقة الوسطى والمنتجة آنذاك.
رافقت هذه السياسات موجة تأميم شملت مشاريع زراعية وصناعية كبيرة، مثل مشاريع “أصفر ونجّار” في منطقة رأس العين شمال شرق سوريا، ومشاريع عائلات البرسان، والبوحبال، وآل الفواز من آل البياطرة في الرقة، وغيرهم كثير.
أثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية والسياسية، بين من رآها خطوة نحو العدالة الاجتماعية، ومن اعتبرها حرباً ممنهجة على الإنتاج والكفاءة والملكية الخاصة.
لكن الضربة القاضية جاءت لاحقاً، حين عزّز حزب البعث، بعد استيلائه على السلطة، هذه التوجهات بسياسات أكثر تطرفاً. ففي عام 1969، تم توسيع قانون الإصلاح الزراعي، ليشمل استصلاح أراضٍ جديدة وتقييد الملكية الزراعية بشكل أشد، مما أدى فعلياً إلى إنهاء نفوذ كبار ملاك الأراضي وتفكيك الطبقة الزراعية المنتجة في البلاد.
ومع ذلك، لم يكن المستفيد من هذا التفكيك هم الفلاحون الحقيقيون كما ادّعت السلطة، بل انتقلت ملكيات شاسعة إلى ضباط بعثيين ومسؤولين حزبيين، وتكوّنت طبقة جديدة من “الإقطاع الحزبي” طبقة لا علاقة لها بالإنتاج أو الاستثمار، بل فقط بالسلطة، ومن والاها.
قتل الطبقة الوسطى.. وبناء الولاء
ما فعله الحزب لم يكن مجرد استيلاء على أراضٍ زراعية، بل اغتيال لمفهوم الطبقة الوسطى المنتجة. فئة كاملة كانت تؤمن بالعمل، وتوظف الناس، وتطور الزراعة، وتساهم في الاقتصاد الوطني، جرى القضاء عليها بذريعة العدالة الاجتماعية، وبدل أن يخلق مجتمعاً متعدد الطبقات يدفع عجلة النمو، تم تعويم طبقة جديدة من المنتفعين والمتسلقين، الذين لا يملكون من أدوات الصعود إلا الولاء المطلق للحاكم من خلال بوابة الحزب الواحد، ولا من صفات القيادة إلا الانتماء الشكلي.
هكذا غاب صوت الفلاح الحقيقي، واختفى المستثمر المحلي، وصعد “الرفيق”، يحمل بيده قرار الحزب، وبقلبه طموح السلطة، لا أكثر.
تشويه الذاكرة وسرقة التاريخ
أكثر ما آلمني ليس فقط ما حدث لنا كمراهقين، بل ما جرى لذاكرة المجتمع كله. أصبح من المعيب أن تقول إنك تنتمي لعائلة زراعية ناجحة، أو أن جدك كان يملك أرضاً. أصبح من المقبول أن تُسلب، ومن المشرِّف أن تكون “رفيقاً بعثياً”، يحمل في وجدانه حب الوطن وقائده.
تمت شيطنة عائلات بأكملها، ونُسف ماضيها، وغُييب دورها في بناء سوريا. كل ذلك لصالح رواية واحدة، يقول فيها الحزب: “نحن من أعطى، ونحن من أخذ، ونحن من قرر من هو المواطن الصالح، ومن هو العدو الطبقي.
البعث: الهوية إلى بطاقة حزبية
لم يُقدم حزب البعث يوماً في سوريا كحزب سياسي بين أحزاب، بل حقيقة وجودية لا تحتمل الشك، كأن الوطن لا يُعرف إلا من خلال أدبياته، ولا يُعترف بالانتماء إليه إلا عبر بوابته. أوهم النظام الناس أن البعث ليس مجرد حزب يمارس السلطة، بل هوية كاملة، تسبق الانتماء الديني أو الطبقي أو الثقافي، بل تعلو عليها جميعاً.
في المدارس، في الجامعات، في مؤسسات الدولة وحتى في الجيش، لم تكن عضوية الحزب خياراً أيديولوجياً، بل ضرورة وجودية. بطاقة الحزب لم تكن إثبات رأي، بل إثبات وجود. من لا يحملها، يشكك بولائه، ويمنع من التوظيف، ويقصى من التمثيل، ويراقب كمشبوه أو خائن لوطنه.
هكذا تحول الحزب إلى مرآة جدارية، نُجبر جميعاً على النظر إليها. من لم ير نفسه فيها، لا يُؤمن جانبه، بل هو مهدِّد. لم يعد البعث يمارس السياسة كفعل، بل فرض على الناس أن يلبسوه كهوية، وأن يعرفوا أنفسهم من خلاله، كما لو أن السوري لا يولد مواطناً، بل مشروعاً بعثياً مؤهلاً للولاء.
لهذا لست بعثياً
لهذا كله، ولأني عشت التجربة لا كمتفرج، بل كمراهق تم اصطفاؤه لا للتكريم، بل للتأديب.
لم أكره البعث لأنني لم أنتسب إليه، بل لأنني رأيت كيف يحوّل الإنسان إلى مجرد رقم في سجل الولاء، ويجرد المراهق من مراهقته، ويضعه في خانة الشبهة فقط لأنه ينتمي لعائلة لم تعجبها الرواية الرسمية.
كبرت ونجوت، وعرفت أن الانتماء الحقيقي ليس لحزب، بل لقيم. وأن الكرامة لا تأتي من لقب “رفيق”، بل من أن تقول “لا” حين يجب أن تُقال.