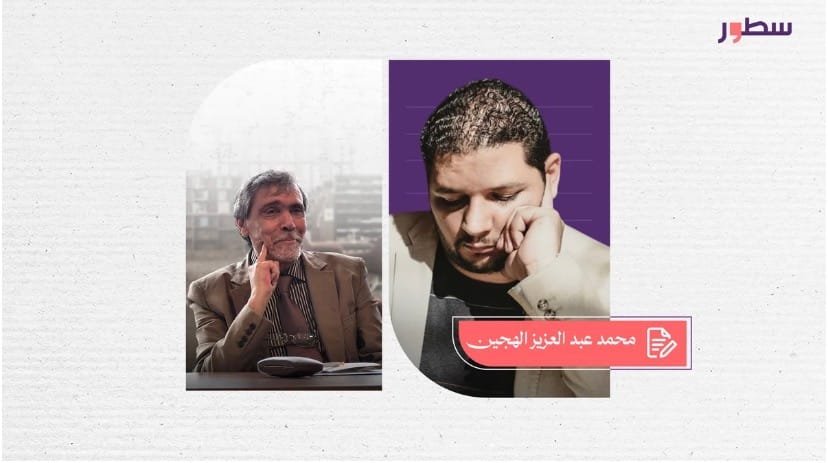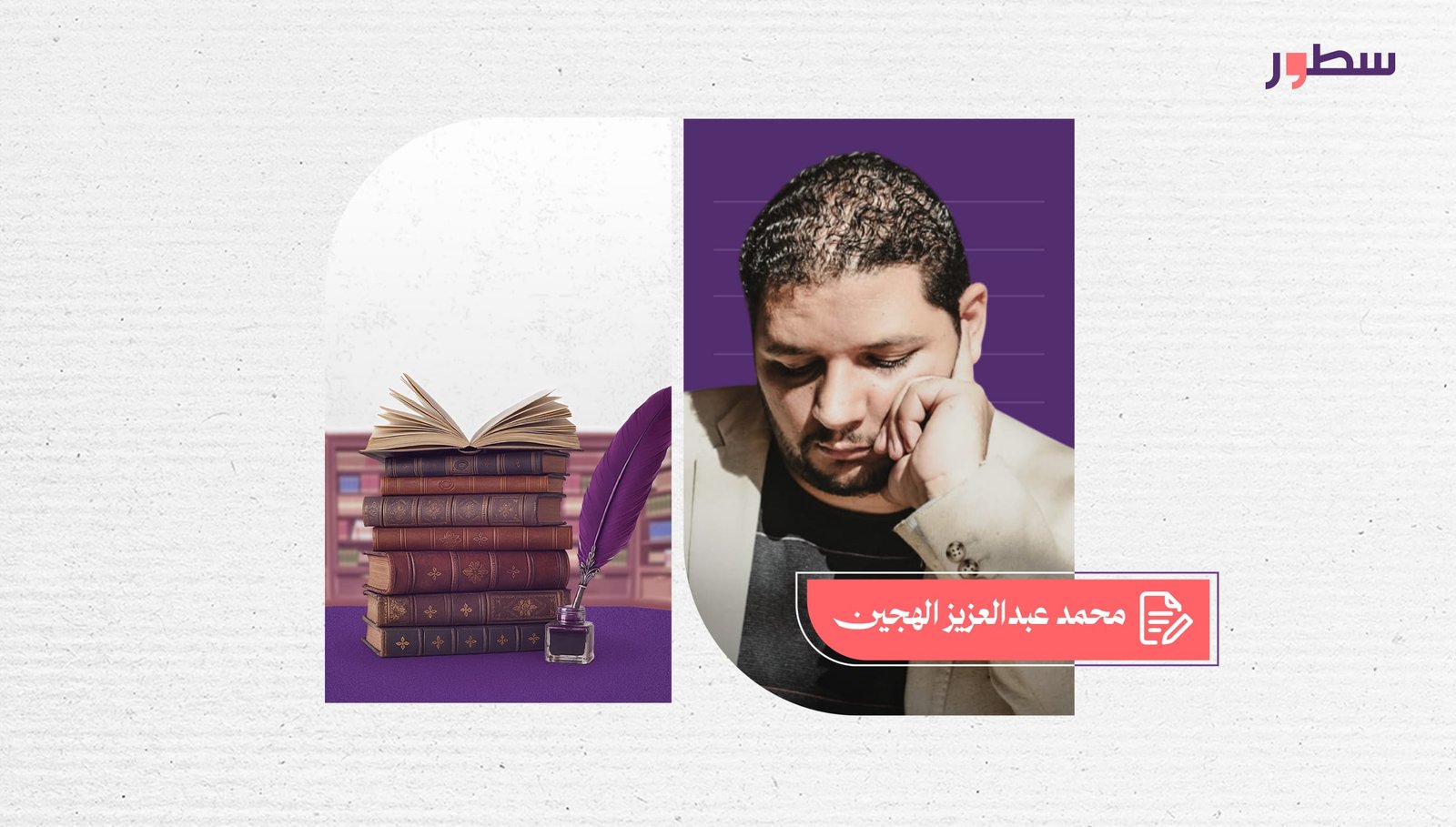أدب
المازني.. رمز التواضع بين الأدباء!
المازني.. رمز التواضع بين الأدباء!
حديثي اليوم عن إبراهيم عبد القادر المازني، فقد خطر في بالي، وتذكّرت حينما كنت أرشح كتبه من رف دار الشروق في المكتبة عندما كنت أعمل في بيع الكتب، لمن يلتمس كتابة أدبية راقية وخفيفة.
وقد جال ذهني في عالم الأدب والأدباء، ورأيتُني أُقسِّم أدبهم إلى نصفين، النصف الأول نصوص مكتوبة فيها أحوال النفس ونتاج الإبداع الأدبي من قصة ومقالة وشِعر، وقد تميَّز هذا الجيل -أعني جيل العقاد والمازني وطه حسين- بإشراق الأسلوب والذاتية المميزة في حديثهم عن أنفسهم، لذلك يتمتع بهم القراء إلى الآن، وهذا سِرّ العودة إلى أدبهم وجمع مقدماتهم وتتبُّع سِيَرهم وآثارهم.
والنصف الثاني هو حياة الأديب، أي قصة الأديب في أحواله العامة من نقاشات فكرية وعمل في الصحافة، أو صراعات مع السياسة، أو حكايات الضعف البشري التي نعرفها من نصوص الآخرين عنه.
نرى صفحة من الأدب المعيش، حياة عالِم أو تهتُّك أديب أو مسار مفكِّر، نلمس ذلك في كُتّاب التراجم عنه من شخصيات عاصرته ونقلت عباراته وسمعت مزاحه، وجالسته على المقهى أو زارته في مجلس البيت، مثل العقاد الشامخ الذي يطلب من مريديه في مجلسه أن يسمع آخر نكتة وهو يناديهم: “يا مولانا”!
الأديب في مباذله، وعلى ذكر المباذل أحكي لك قصة كلمتين.
بين المباذل والارتسامات
كما أُعجب الكاتب حسين محمد بافقيه بلفظ “ارتسامات” في عنوان كتاب لأمير البيان شكيب أرسلان، الذي ذكر فيه رحلته إلى الحجاز، والكتاب بعنوان “الارتساماتُ اللِّطاف في خاطِرِ الْحَاجِّ إلى أَقْدَسِ مَطَاف”، واعتبرها بافقيه أجمل من كلمة “انطباعات”.
توقفت وأنا أقرأ يحيى حقي عند كلمة “مباذل”، فقد كتب يحيى حقي فصلًا من فصول سيرته بعنوان “أشجان عضو منتسب”، وهو نص عزيز ونفيس وقصير لكنه يقول الكثير، يذكر فيه حقي: “صورتي في هذه الأحاديث مأخوذة خطفًا، أحيانًا وأنا في مباذلي، فهي أصدق. وهكذا أبرأت ذمتي منك وزيادة”.
هذا يذكّرني بكتاب ترجمه شكيب أرسلان بعنوان “أناتول فرانس في مباذله”، وهي ذكرياتٌ مِن أقوال فرانس في مباذله، أي في حياته اليومية وحواراته، ترى فيها فرانس يسير ويأكل ويناقش ويجادل.
ومِن تواضُع الأديب الكبير يحيى حقي ما حكاه في مقالة له عن كتاب يحكي تاريخ نضال العمال، ويصف الكتاب بأنه “كتاب دسم وسهل الهضم معًا، فيه تثقيف وترويح للنفس معًا، قرأته بمتعة كبيرة وعلمت منه أشياء كنت أجهلها وعشت كالبهيم، طور الله في برسيمه. أفلا تنقضي الحسرات إلا بانقضاء العمر؟”.
عطر الأحباب
يقول إبراهيم عبد القادر المازني -رحمه الله- في أواخر أيامه على سبيل التواضع والمزاح والتهوين من موهبته: “ما أشبهني بأرباب الحرف من أصحاب الدكاكين! إنني أصبح فأجلس في منزلي أمام آلة الكتابة، صابرًا على رزقي، فمن جاء يسألني مقالًا أو قصة توكلت على الله ودققت له ما يطلب بلا تأجيل. ويظل هذا شأني إلى أن تحين ساعة التشطيب!”.
ويعلّق يحيى حقي عنه في كتابه “عطر الأحباب” فيقول: “كان المازني لا يسوِّد ولا يمحو ولا ينقِّح، لا يحار ولا يتلجلج، لا يبحث ولا ينقِّب، بل يجلس أمام آلة الكتابة -كما يفعلون في أمريكا!- فيدقُّ مِن فوره ما يريده مؤلفًا أو مترجمًا وينساب منه القول في أحسن أسلوب وأرق ذوق وأخف دم، ولا أعرف مِن كُتّابنا أحدًا يُدانيه في هذه المقدرة الفائقة”.
قصة عن المعارك الأدبية
نحتاج أحيانًا إلى جرعة نقدية جريئة تماثل قوة هجوم العقاد والمازني على كبار الأدباء عندما كتبوا “الديوان”. كنت أطالع الأعمال غير المنشورة للمازني، جمع د. عبد السلام حيدر، ووقفت على مقالة يهاجم فيها المازني كتابات طه حسين في مقالة له عام 1925، يقول له: “لقد لفتني من الدكتور طه حسين في كتابيه {حديث الأربعاء} -وهو مما وضع- وقصص تمثيلية -وهي ملخصة- أنَّ له ولعًا بتعقُّب الزُّناة والفُسَّاق والفجَرة والزنادقة. وقد يُنكِر القارئ أن أُدخِل القصص التمثيلية في هذا الحساب ويقول إنها ليست له، وإنَّ كل ما له فيها أنه ساقه خلاصة وجيزة لها، وهو اعتراض مدفوع لأن الاختيار يدل على عقل المرء ويشي بهواه كالابتكار سواء بسواء، وإنما يختار المرء ما يوافقه ويرضاه ويحمله عليه اتجاه فكره حتى لا يسعه أن يتخطاه… وها هو ذا حديث الأربعاء، ماذا فيه؟ فيه كلام طويل عن العصر العباسي، وللعصر العباسي وجوه شتى، وفي وسعك أن تكتب عنه من عدة جهات… ولكن الدكتور طه يدَع كل جوانب سوى الهزل والمجون ويروح يزعم لك أنه عصر مجون ودعارة وإباحة متغلغلة إلى فرع من فروع الحياة. فلماذا؟ لأية علّة يغضّ عن الجوانب الأخرى لذلك العهد؟ بل قُل: لماذا لا يرى في غير الماجنين والخليعين صورة منه؟
ولم يكفِ الدكتور طه أن يعمد إلى طائفة معيَّنة من شعراء العباسيين، وأن يرسم من سيرتهم صورة يزعمها صورةَ العصر، بل هو يُنكِر أنَّ غير هؤلاء من العلماء أو الشعراء يمثل العهد العباسي!
لقد ترك طه حسين أبا تمام والبحتري والشريف ومهيار والمتنبي والمعري من فحول شعراء العرب وفضلائهم، ووقع على أهل المجون والخلاعة والاستهتاك، كذلك لم ينتقِ مِن كنوز الأدب العربي إلا هذه القصص الحافلة بضروب الآثام والمنكرات…”.
قرأتها في كتاب “تطبيقات نقدية”، المجلد الثالث من أعمال المازني غير المنشورة، جمع وتحرير عبد السلام حيدر.
معركة بالأدب الرفيع
أتتبع معارك هذا الجيل الأدبي وعلاقاته الفكرية والإنسانية، ولا تخلو من قصص فيها نُبل ومروءة. ومثال ذلك القصة التي حكاها ثروت أباظة في مذكراته عندما كتب مقالة يردّ فيها على يحيى حقي، وأرسلها إلى رئيس التحرير أحمد أمين في مجلة الثقافة لينشرها. اتصل به رئيس التحرير أحمد أمين وحدَث التالي برواية أباظة في مذكراته: “جريت إلى التليفون، وجاءني صوته الطيب البسيط الهادئ: {أنا أكلمك كأحمد أمين الوالد، لا أحمد أمين رئيس تحرير الثقافة. مقالتك في الرد على يحيى حقي في المطبعة فعلًا، ولكنني أرجوك أن تخففها، فإنّ الرجل فقدَ زوجته منذ قريب، ولا أُحِبّ أن تُسيء إليه وهو في حالته هذه. إن رأيت أن تستجيب لرجائي أكُن شاكرًا، وإن رأيت أن تُبقيَ المقالة كما هي فهي فعلًا في المطبعة}. وقلت في إذعانٍ سريع ودون ريث تفكير: {أمرك يا سعادة البِك}”.
المازني في الحجاز
دخل المازني حياة الأدب بفرقعة حين أصدر مع عبد الرحمن شكري وعباس العقاد كتاب “الديوان”، فبصر هذا الجيل بأصول النقد ومعنى الفن وأسرار البلاغة. يعلّق حقي: “لم ننتبه في دهشنا إلى ما شاب أسلوب المازني من تلذذ بالإيلام، وشَيِّهِ للمنفلوطي على الجنبين بلا رحمة أو شفقة، لذة شهية تنفس عن نزعة القسوة والاستعلاء في قلوبنا نحن الشباب. وقد ندم المازني في ما بعدُ على ما سلف من سخريته اللاذعة، وعاش في صلح مع الحياة والناس”.
وفي تلك الآونة كان النشاط الدبلوماسي قليلًا، فراح يحيى حقي يقضي وقت فراغه في مكتبة القنصلية، حتى قرأ المكتبة عن آخرها. وفيها اكتشف حقي تاريخ الجبرتي لأول مرة، وفُتن به أشد الافتتان، واعتبره مِن أهم مَن يمثل رُوح الشعب المصري مثله، ومنذ ذلك الحين وهو شديد الاتصال الروحي بالجبرتي، حتى لقد وقّع عددًا من مقالاته الأولى باسمه “عبد الرحمن بن حسن”. ومِن أهمها ست مقالات عن “الدعابة في المجتمع المصري” صدرت في كتاب لاحقًا.
لقاء بين جيل المازني ويحيى حقي
نظر يحيى حقي وهو يعمل أمينًا للمحفوظات في قنصلية مصر بجدة إلى المازني، وهاله منه منظر كاد ينفطر له قلبه، وشعر نحوه بحنوّ شديد، وتملّكه إحساس عجيب، كأنه يشهد سلحفاة خرجت من حصنها، فإذا أمامه مخلوق رقيق مضيع يفتك به أضعف عدوّ.
رأى حقي المازني -رحمه الله- يمشي مشية منخلعة، يكاد شقه كله يهوي عن يمين إلى الأرض فوق ساق أقصر من أختها بكثير، كأنما أصيب في جنبه بضربة عنيفة من هراوة ثقيلة قصمت وسطه.
نظر حقي إلى المازني وهو يقوم فيضع في قدمه فردة حذاء كعب مرتفع يعالج الفرق بينها وبين أختها، ليس في نظراته إلّا أقل دلالة على الحرج، كأنها تقول له ببساطة وبراءة: ها أنت ذا قد رأيت، الآن أصبحت صديقي!
يقول حقي: “ولو كنت مكانه لقلت لهذا الذي اقتحم عليَّ خلوتي وسري: ها أنت ذا قد رأيت، فَغُرْ مِن وجهي!”.
وهنا يصل حقي إلى مفتاح شخصية المازني، ويقول: “أكان حُبُّه للمعابثة تنفيسًا لكبت قديم حين أقعدته عِلّته عن المشاركة في عبث قرنائه بالجري واللعب؟”.
وهذا المعنى يؤكده الكاتب محمود السعدني في كتاب “الظرفاء”، فهو يرجع سِرّ سخرية المازني إلى صورته وهيئته، فقد كان قصيرًا نحيفًا، أعرج من أثر حادث قديم.
ويختار السعدني مقدمة رواية المازني الطويلة “إبراهيم الكاتب” ويعتبرها أصدق وصف للمازني مما كتبه هو، فقال: “إنني سمحٌ متواضع، قانع، سلِس عطوف، مغتبط بالحياة، راضٍ عنها قانع بها، أتلقى الحياة بغير احتفال، وأفتر للدنيا عن أعذب ابتساماتي، وأحس السرور يقطر من أطراف أصابعي كالعرق”.