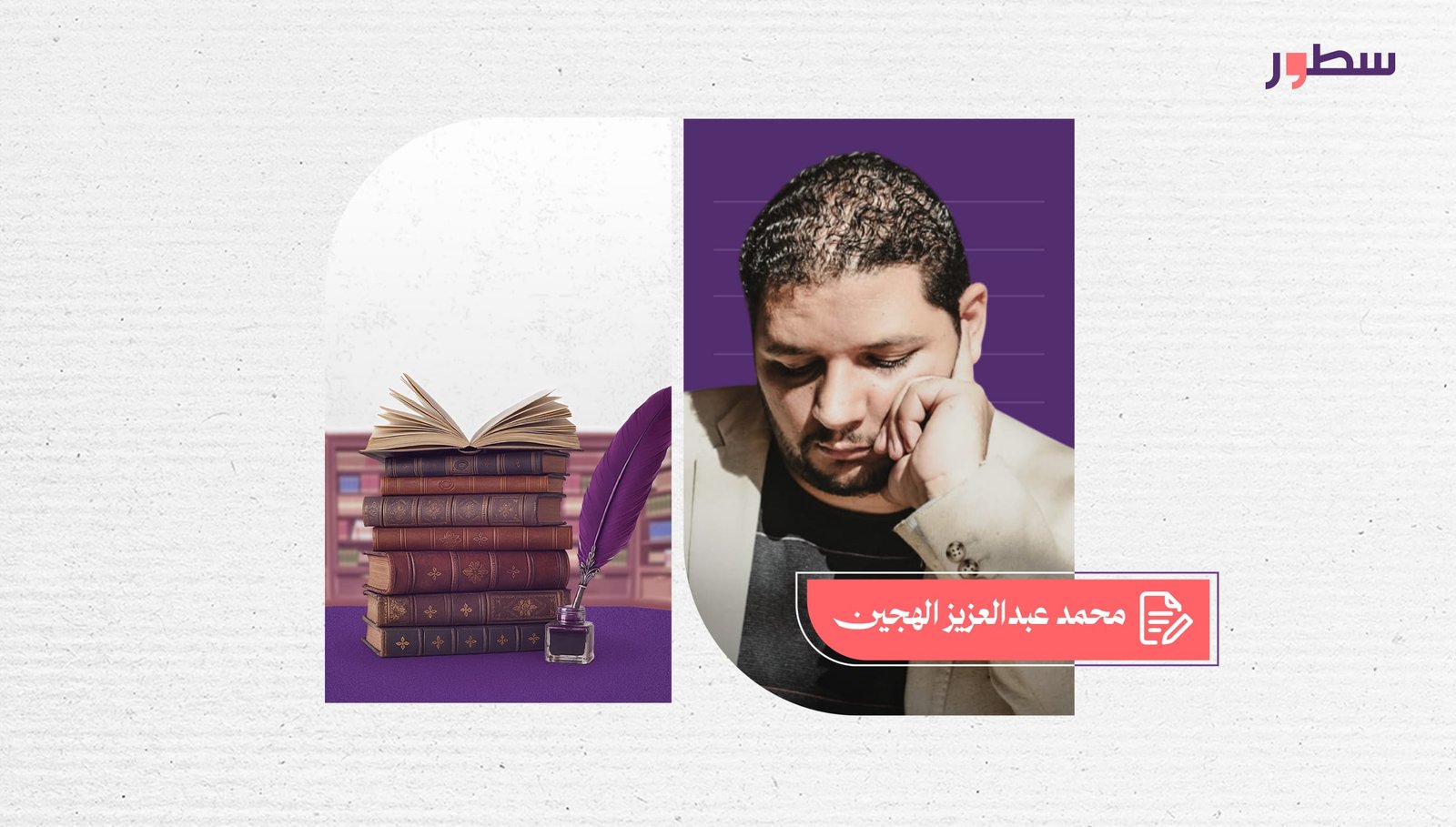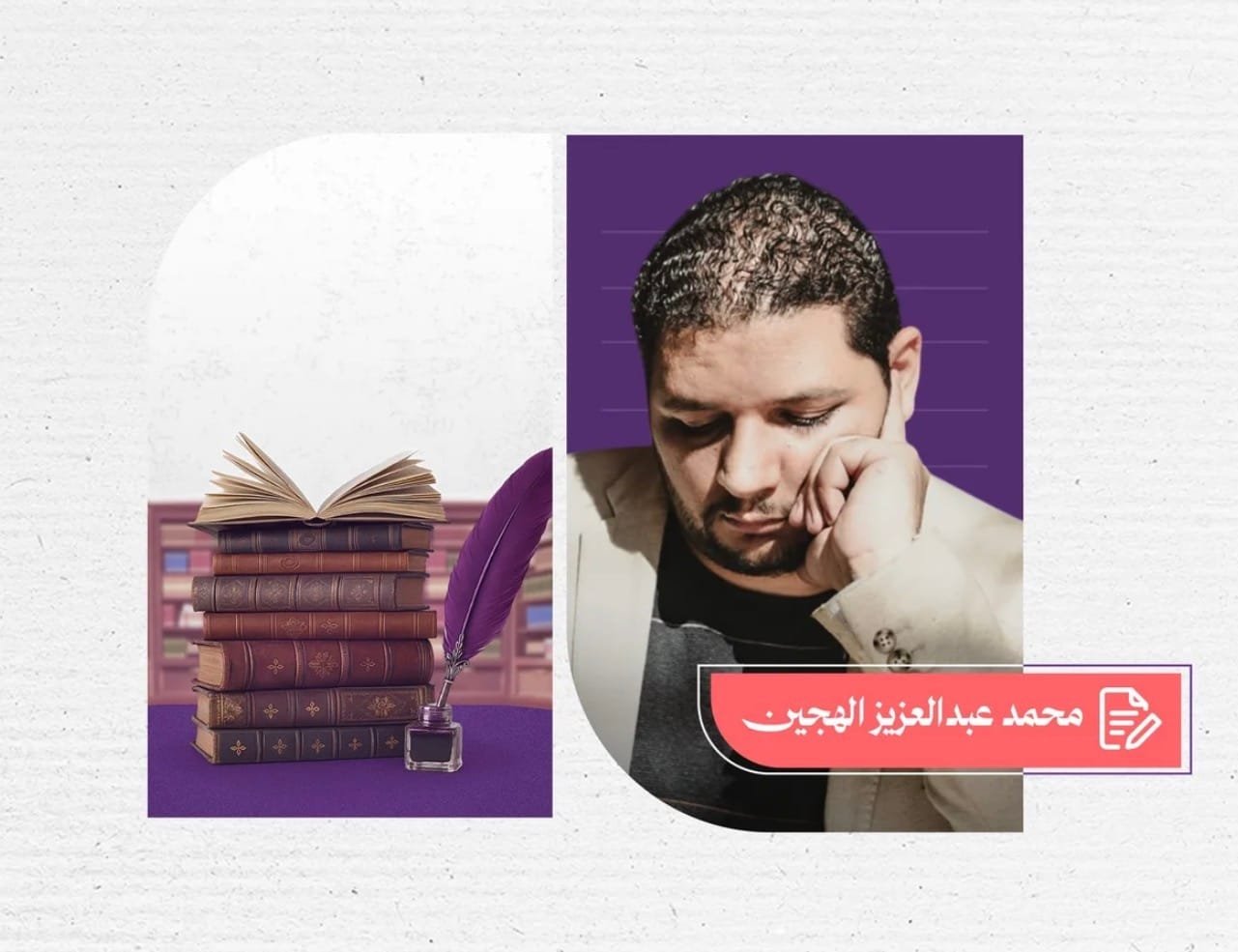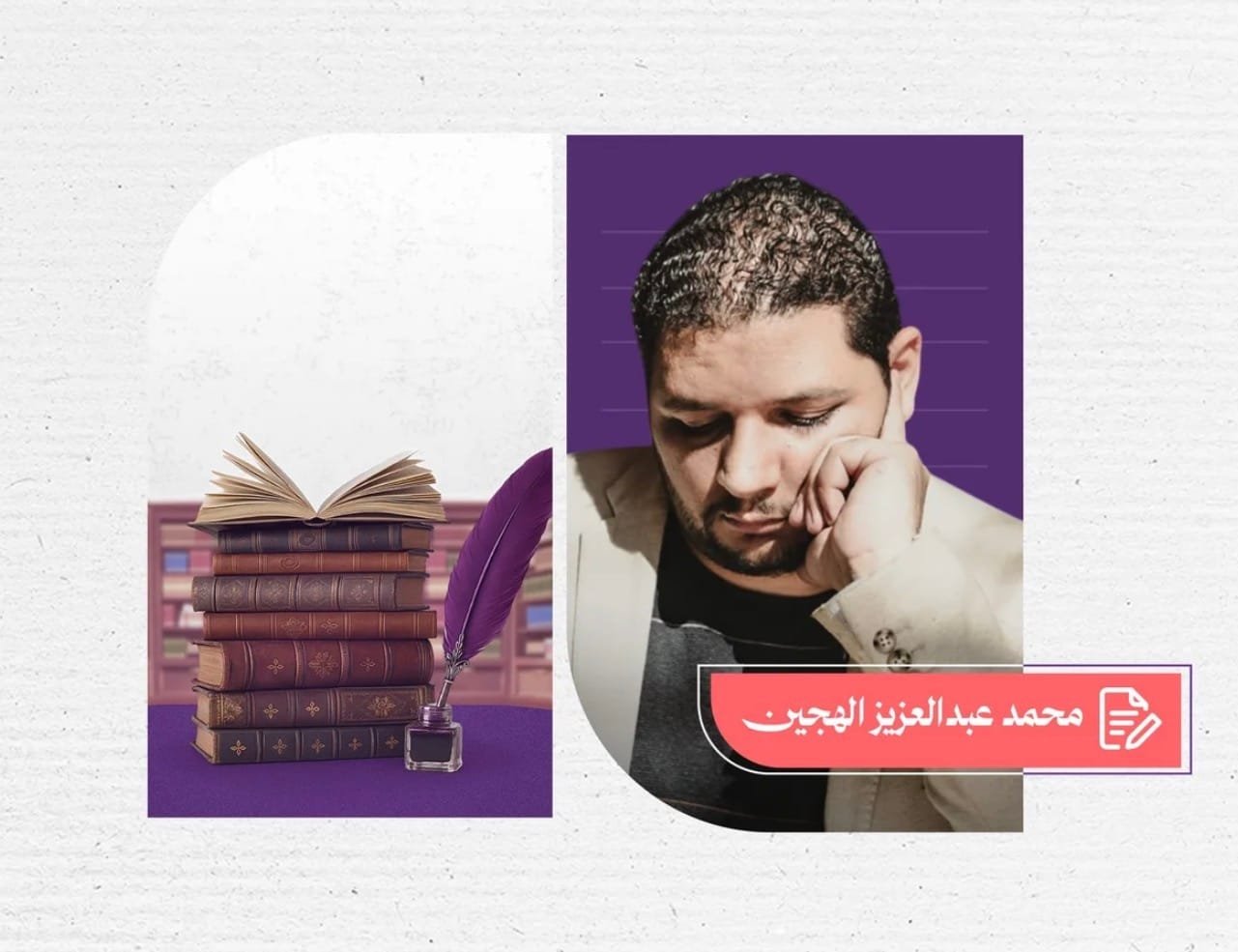أدب
يحيى حقي.. حكايات القراءة على صاحب القنديل!
يحيى حقي.. حكايات القراءة على صاحب القنديل!
يحلو لي الحديث عن تاريخ الأدباء وسِيَر حياتهم ومعاركهم الفكرية والحياتية؛ أرى في طبيعة الأدب أفضلَ مُتنفَّسٍ للروح المتعَبة ومهربٍ من تعاسة الحاضر، خصوصًا لمن يعيشون في منطقتنا المنكوبة بالكوارث والألم والصراعات، ويعيشون حالة العجز من أهوال ما يتعرض له أهلنا في غزة. لاحظت أنني أجمع قصاصات من تجارب وشهادات كنت أدوِّنها عن الأديب المصري يحيى حقي، هي خواطر مبعثرة في عالم هذا الأديب الجميل.
بيت يحب الكتب
كانت والدة يحيى حقي شديدة التديُّن، مغرمة بقراءة القرآن الكريم وكتب الحديث والسيرة النبوية، وكانت تختار أسماء أبنائها من صفحات القرآن، فإذا اقترب موعد الوضع فتحت المصحف على أي صفحة واختارت أول اسم يقابلها.
كانت كثيرًا ما كانت تقرأ عليهم صفحات من البخاري والغزالي. ومن الكتب التي يقرؤونها في بيتهم: البخلاء للجاحظ، ومقامات الحريري. وكان والده مفتونًا بالمتنبي، يحفظ كثيرًا من شِعره ويُلقيه عليهم في جلساتهم المسائية، وكان مغرمًا بالقراءة إلى أبعد حدٍّ، حتى إنه كان يقرأ وهو يسير في الطريق. ويذكر يحيى حقي كيف عاد والده ذات يوم وجبهته مبطوحة قد نبتت فيها حبة زرقاء، فقد صدم عمود الترام وهو سائر يقرأ في صحيفة! وهكذا نشأ يحيى حقي في بيئة تحب الكتاب وتقدِّره.
سأله فؤاد دوارة في حوار معه: ماذا عن كتاب “ألف ليلة وليلة”؟
فقال يحيى حقي: “كانت عندنا نسخة منه، ولكنه لم يكُن من الكتب التي نقرؤها قراءة مشتركة. وأعترف أنني حين قرأته لأول مرة انزعجت انزعاجًا شديدًا من الألفاظ الجنسية المكشوفة”.
كان الجوّ الغالب على بيته يتلخص في ثلاثة مظاهر:
الأول: “الشغف برشاقة اللفظ، والابتهاج بالتوفيق في العثور على الكلمة المناسبة للمعنى، لذلك كانت الخطابات التي نتبادلها تُكتب بأسلوب أدبي متأنق”.
الثاني: “نوع من الحياء يتنبه إلى زلة اللسان مهما كانت طفيفة”.
والمظهر الثالث يتمثل في “قدر من الانطوائية لأننا كنا أسرة موظفين من أصل تركي وليست لنا أملاك تُذكر، بعد أن أساء الأبناء إدارة الأراضي التي ورثوها عن جدهم، حتى أصبح وجودها كعدمه، ثم ما لبثت أن تبددت”.
يذكر أديبنا أنه حينما كانت تظهر قصيدة لأحمد شوقي في الصفحة الأولى من «الأهرام» كان البيت كله يقف على رجل.. كانوا يقرؤونها بصوتٍ عالٍ ويحفظونها ويرددونها في مختلف المناسبات. مِن هذه القصائد قصيدته في البكاء على خلع السلطان عبد الحميد التي يحفظ حقي مطلعها:
“سل «يلدزًا» ذاتَ القصورِ
هل جاءها نبأُ البدور؟
لو تستطيع إجابةً
لبكتكَ بالدمع الغزير”.
كان عمُّه محمود طاهر على صلة وثيقة بأحمد شوقي، وعن طريقه أُتيح لحقي الجلوس إلى شوقي عدة مرات، سواء في محل «صولت» الحلواني أو في بيته، وفي إحدى تلك المرات أعطاه شوقي قصته «أميرة الأندلس» وهي مخطوطة، لِيُبديَ فيها رأيه، وكان وقتها لا يزال شابًّا في السادسة عشرة.
نصف ابتسامة!
يحكي صلاح معاطي عن يحيى حقي في كتاب “صحوة عبق من عطر الأحباب” ويقول: “كانت الابتسامة هي أقرب شيء إلى يحيى حقي.. كانت ابتسامته تسبقه إلى مُريديه.. مُرحِّبةً بهم. ويا لها من ابتسامة تُشعِرك بأنَّ الدنيا كلها تبتسم مِن حولك.. وليس هذا فقط، بل إنك تجد حديثه لا يخلو من الدعابة والنكتة”.
وعلى ذكر الابتسامة، يحكي معاطي الموقف التالي: “كنت أقرأ عليه إحدى قِصَصي القصيرة، وكنت أصِفُ ابتسامة شخصية من شخصيات القصة فأقول إنّ الرجل ابتسم نِصف ابتسامة، ففوجئت به يستوقفني وهو يتراجع بظهره إلى الوراء ويقول: يا أخي، يعنى أنت كنت قِسْتَها بمازورة؟ (أداة للقياس).. وطلب منى أن أكون أكثر تحديدًا، فأقول مثلًا: ابتسامة باهتة، أو ابتسامة عريضة، أو ابتسامة ماكرة، وهكذا”.
سليمان فياض بين الحقل والغيط
بعد نشر سليمان فياض مجموعته القصصية الأولى “عطشان يا صبايا”، أعطى فياض قصته “العيون” للأستاذ، وكان يعرف ذوقه المصري الرفيع، وحُب حقي لرصد نفوس الشخوص، والتجارب المحلية المعيشة.
طلب منه الأستاذ يحيى حقي أن يقرأ عليه قصته حتى يسمعه وهو يقرأ، تعمَّد فياض القراءة بأداء، وأن يلوِّن صوته مع هذا الأداء.
وعندما قرأ فياض كلمة “الحقل”، قال حقي: “انتظر، هذه الكلمة التي نتوقف عندها”.
أدرك فياض أن حقي قرأ القصة من قبل، وأنه يريد أن يُعطيه درسًا، صبَر لأجله مدة القراءة كلها، وقال حقي له: “ألا ترى معي أن كلمة {الغيط} أوقع وأحسن؟ نحسّها أفضل وتوحي لنا بالكثير”.
انتهى اللقاء بقول حقي: “قصة بديعة، وغيِّر الآن كلمة {الحقل} إذا شئت، فأنت مسؤول عن عملك”.
وافق سليمان فياض على تغيير الكلمة راضيًا في قصته ونشرها حقي، لكن هذا الموقف يدلُّ على حُبه قراءة الآخرين عليه، وحساسيته اللغوية.
يحيى حقي في عين ماهر شفيق فريد
يقول الناقد الكبير ماهر شفيق فريد إنه على الرغم من رحيل حقي وأنه أصبح في رحاب الله، ولا يملك لأحد نفعًا ولا ضرًّا، ولا يزدحم أحد على أبواب مجلته طلبًا للنشر، فإنّ سامي فريد قد خصص له أكثر من كتاب بعد رحيله، لا يرجو من ذلك جزاءً ولا شكورًا”. ثم يتذكر اهتمام فؤاد دوارة بإصدار أعماله الكاملة، وحرص أحمد تيمور على إحياء ذكراه كل عام، ويرجع ذلك إلى “الوفاء الكريم والمحبة الصادقة، البذرة المباركة التي ألقاها حقي ذاته بخلقه وموهبته في تربة المحيطين به، فأنبتت نباتًا حسنًا ربا واستوى على سوقه. إنه عطر الأحباب ما زال يفغم أنوف كل من عرفوه، فكان إنسانًا عظيمًا وفنانًا نادرَ المثال ومحررَ مجلة كانت وجهًا مشرفًا للفكر في مصر. تنقضي سنون ولا ينقضي دَيْنُنا له، وتظلُّ قصصه ومقالاته وترجماته تلمع -كالماسة الغالية- على مفرق أدبنا. درسٌ إبداعيٌّ وخلقيٌّ في آن، هي كالنبيذ المعتَّق في دنانة لا يزيده مَرّ السنين إلا جودة وقيمة”.
وفي كتاب “وجوه يحيى حقي” يوثق الناقد ماهر شفيق قصة علاقته مع الأديب. يذكر ماهر أنه عندما كان يزور حقي في بيته بمصر الجديدة -حيث يستقبله كلبه فيدل، وقد كاد مرة ينشب أسنانه في طية بنطلون ماهر دون ذنب جناه- كان حقي يطلب من الشاب ماهر أن يقرأ له من ملحق التايمز الأدبي، وهو يستمع ويسأله أحيانًا عن معاني بعض الكلمات كأنه لا يعرف.
لا شك أنه كان يريد بهذه القراءة إراحة عينيه من ناحية، ولكنه كان يريد في المحل الأول -هذا العزيز الماكر كما يصفه ماهر شفيق- أن يمتحن قدراته في الترجمة من الإنجليزية، وقد كان ماهر وقتها شابًّا يافعًا، ليرى حقي هل يمكنه الثقة بما يكتبه الشاب لمجلته ويترجمه أم لا. وكم من أمور صغيرة تعلَّمَها ماهر منه وهو يقرأ عليه المقالات، وقد كتب ماهر ذات مرة: “أجريت له عملية جراحية”، فقال حقي: “بل قُل: أجريت له جراحة”.
كان ماهر يكتب: “على الرغم من… إلا أنه”، فعلَّمه حقي أن يحذف “إلا”، ويقول بدلًا منها: “على الرغم من… فإنَّه”، أو “… فَقَدْ”.
كتب ماهر شفيق فريد ذات مرة أنّ “أمبريا مقاطعة تقع في وسط شبه الجزيرة الإيطالية، بين توسكانيا والمستنقعات شمالًا وشرقًا، ولاتيوم والأبروزي جنوبًا وغربًا، شاملة مقاطعتَي پیروجيا وتيرني”، فنهره يحيى حقي بقوله: “هو درس جغرافيا؟! كفاية تقول مقاطعة في وسط شبه الجزيرة الإيطالية”، فحذفها ماهر وقد تضرَّجَت وجنتاه خجلًا وتعلَّم الدرس.
قارورة من عطر الأحباب
قصص تلاوة الأدباء قصصهم على الأستاذ يحيى حقي ذكّرتني بحكاية الكاتب سعيد الكفراوي التي رواها في كتابه “حكايات عن ناس طيبين”، حينما أتى الكفراوي من قريته قادمًا إلى القاهرة، يحلم بنشر قصته في مجلة “المجلة” التي يرأس تحريرها حقي.
في تلك الأيام التي كانت فيها الأحلام لا تزال حية في القلب، وكانت فيها الدنيا غير الدنيا، أتى الكفراوي وبيده حزمة الورق، وبقلبه الخوف القديم، يرتدي جلبابًا بلديًّا، وعلى رأسه طاقية من الصوف، وملامحه القروية تعكس قلة الخبرة، والخوف من المدينة.
سحب حقي الكفراوي من يده إلى الشرفة، وقال له: “اقرأ يا كفراوي”.
بدأ سعيد القراءة متلعثمًا، يضرب قلبُه بقوة، يكاد يقفز من بين ضلوعه.
أشعل حقي أكثر من سيجارة، ولمح كفراوي قطرة من العرق على جبهته، تنهّد الأديب بعد أن انتهى كفراوي من القراءة، ونظر إليه نظرة طويلة، لمح فيها كفراوي مصابيح الفرح، وذكاء الفطرة، وتجربة الدنيا. وقال: “كويس يا كفراوي، حِسّك جديد بالريف، اقرأ مرة أخرى”.
وبعد أن فرغ نهض، وعند الباب شدَّ على يده، وأخذ منه القصة، وودَّعه بابتسامة وكلمات طيبة قائلًا: “سلِّم لي على أعمامك في البلد، وخلينا نشوفك”.
وفي العدد الجديد من مجلة “المجلة”، كانت القصة منشورة، ومِن هُنا كانت بداية الكفراوي مع متاهة الكتابة.
بعد ستة عشر عامًا رأى الكفراوي يحيى حقي في حفل موسيقي، وتذكّره حقي وقال له: “فاكر يا كفراوي لما كنت بتيجي مجلة {المجلة} لابس الجلابية البلدي؟”، وضحك بفرح.
هوى الكفراوي على رأس حقي تقبيلًا، وانحنى على يده يُقَبِّلها من غير وعي، اليد التي رسمت “البوسطجي” و”دماء وطين” و”خليها على الله”، اليد التي أنارت الطريق بالقنديل للقصاصين من بعده.
يبدو لنا أن هَوَس يحيى حقي بقراءة الآخرين عليه قد بدأ مبكرًا، فقد بدأ بِتَتَلْمُذِه منذ عام 1939 على يد الأستاذ محمود محمد شاكر، فقد قرأ عليه قدرًا كبيرًا من الأدب العربي القديم، من الشعر الجاهلي إلى بقية أمهات الكتب العربية، ومنذ ذلك الحين وهو شديد الاهتمام باللغة العربية وأسرارها.