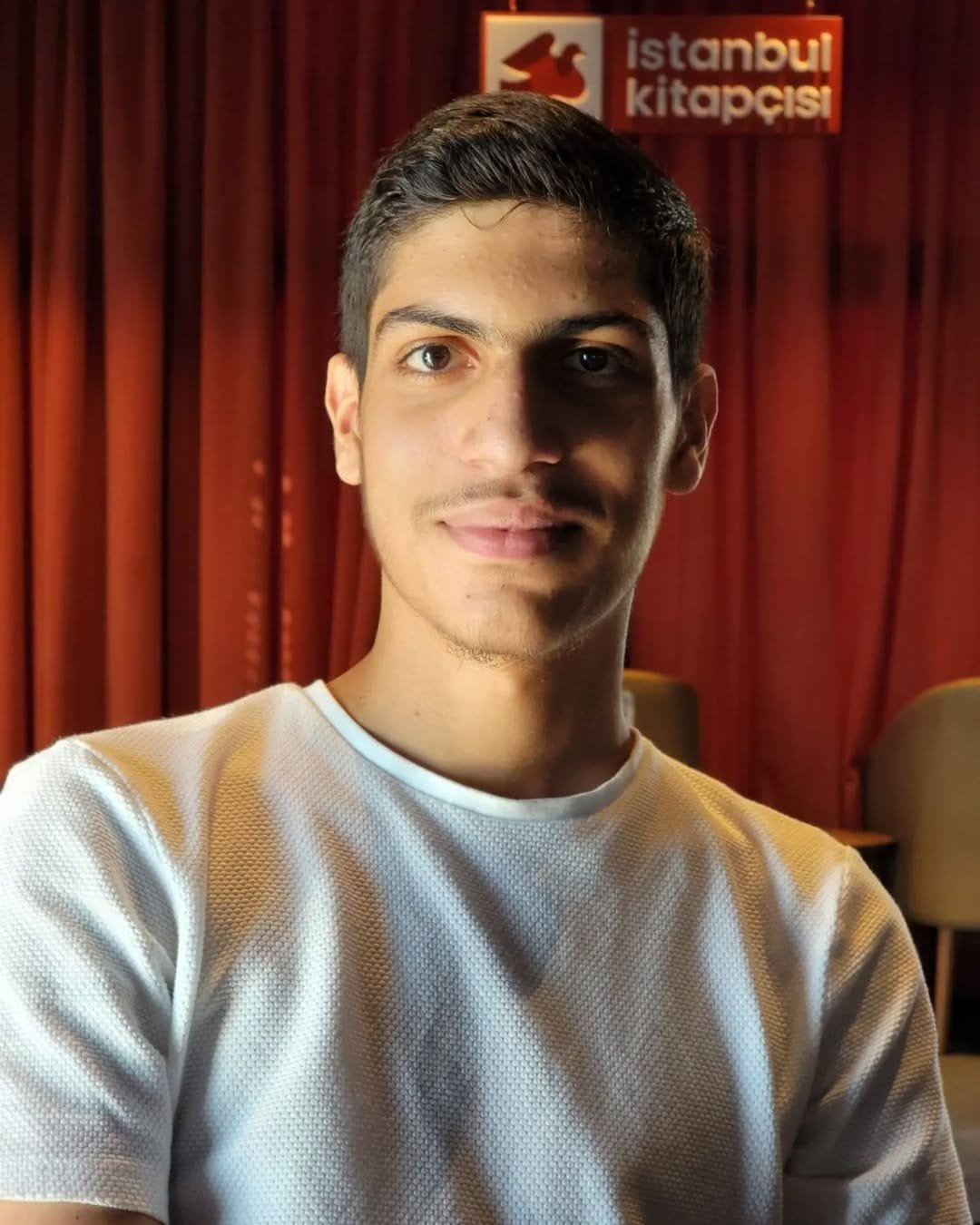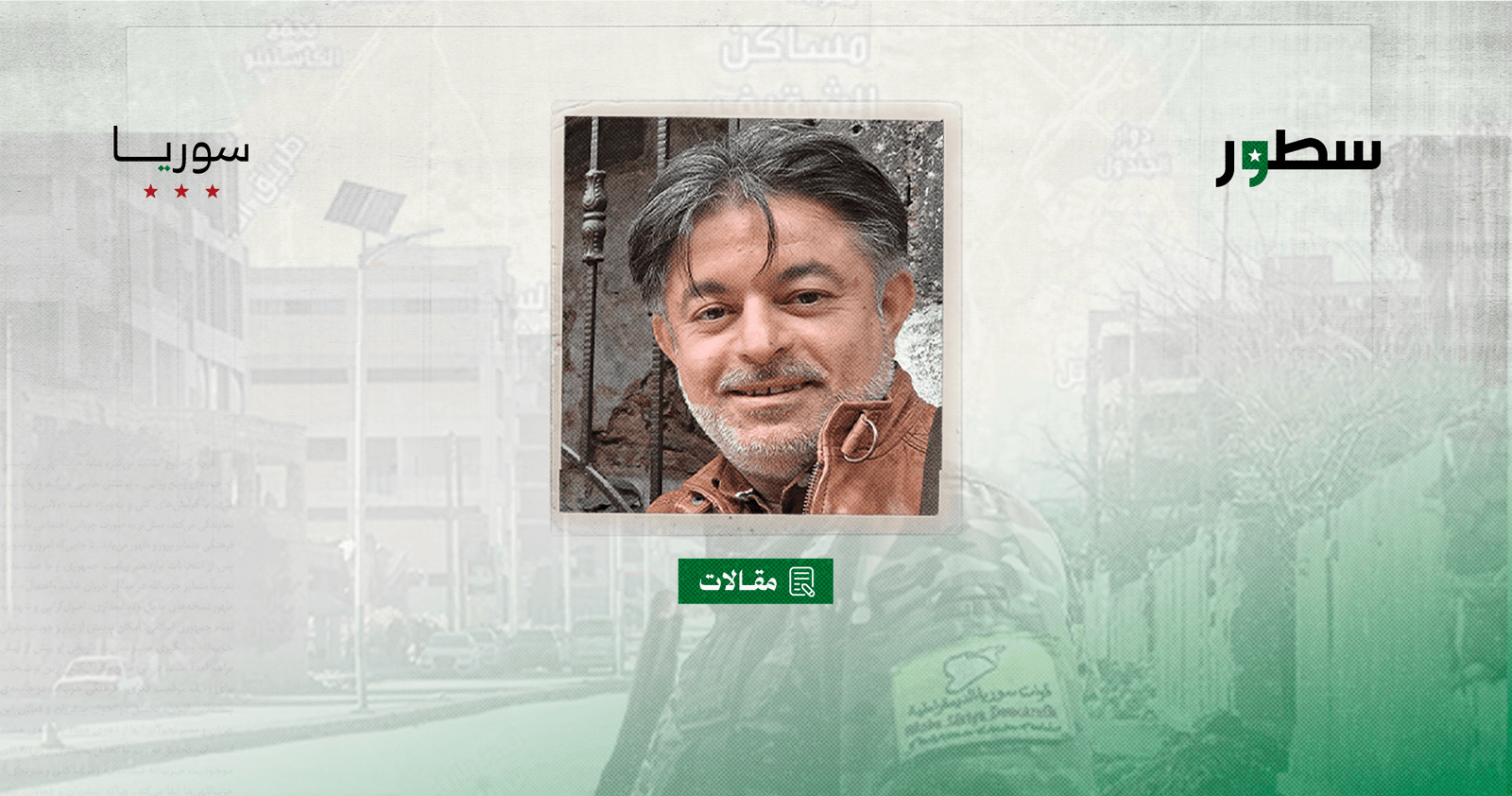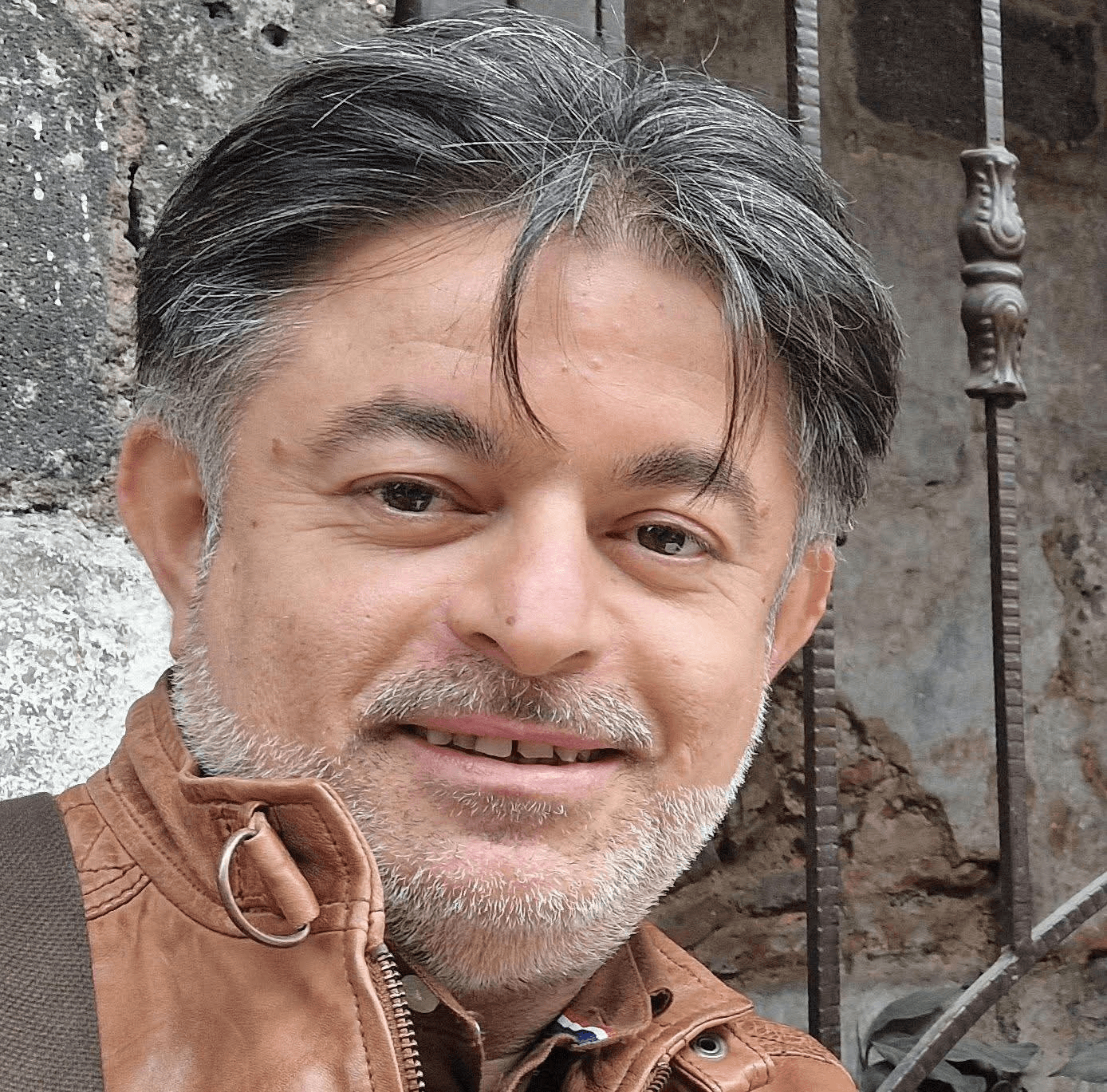مجتمع
السيادة من الأسفل: الفزعة العشائرية بين الفراغ والدولة
السيادة من الأسفل: الفزعة العشائرية بين الفراغ والدولة
في ليالي السويداء الأخيرة، لم يكن صوت الرصاص مجرد صدى لمعركة، بل كان كأنه صرخة قديمة تخرج من صدر الصحراء: صرخة الفزعة. رجال يتركون بيوتهم على عجل، يضعون الكوفية على وجوههم، ويمسكون ما توفر من سلاح، كأنهم ورثة لأولئك الذين حرسوا القرى بالخيول، ولكنهم الآن يحرسون فكرة أكبر: أن الأرض لا تُترك فارغة، حتى لو غابت الدولة.
هنا، تبدأ القصة من حيث لا يتوقعها أحد. ليس من قاعات السياسة ولا من مؤتمرات العواصم، بل من خيمة عشائرية اجتمع حولها رجال ونساء، ليقولوا ببساطة: “إذا سقطت الأرض، سقطنا جميعاً”. هذه ليست لحظة بدائية كما يظن البعض، بل لحظة فريدة تكشف عن مجتمع يستطيع أن يتحول إلى دولة مصغّرة حين تختفي الدولة أو تتأخر.
لكن الفزعة ليست معركة سلاح فقط؛ إنها معركة معنى. هل هي قوة موروثة من زمن العصبية والدم؟ أم أنها شكل جديد من المقاومة الشعبية التي يمكن أن تصنع توازناً مع الدولة بدل أن تعارضها؟
هنا، على خطوط النار، تتضح المفارقة: الفزعة التي كانت تُحسب على الماضي، تثبت اليوم أنها جزء من المستقبل، وأنها قادرة على ملء الفراغ الذي تركه القصف الإسرائيلي، لا قوة ضد الدولة، بل قوة تذكّر الدولة أن المجتمع ما يزال حياً.
ما حدث في السويداء لا يشبه خبراً في شريط الأخبار، بل يشبه مرآة تُرينا ما نريد أن نكونه: مجتمع لا ينتظر الأوامر كي يدافع عن نفسه، ودولة تعرف أن قوتها الحقيقية ليست في بيروقراطيتها، بل في شعوبها.
هذا المقال ليس روايةً للأحداث، بل محاولة لفهمها: كيف تتحول الفزعة إلى فلسفة مقاومة؟ كيف يمكن للدولة أن تحتضن قوة مجتمعها بدل أن تخاف منها؟ وما الذي تخبرنا به السويداء عن معنى السيادة حين تأتي من الأسفل، من الناس أنفسهم، لا من أعلى؟
من العرف إلى السياسة:
الفزعة، في أصلها، ليست مجرد صرخة بدوية تستدعي السلاح، بل هي منظومة قيمية واجتماعية راسخة، نشأت من حاجة الإنسان الأولى إلى حماية نفسه وجماعته. في المجتمعات القبلية، لم تكن الدولة موجودة بوصفها كياناً ضامناً للأمن، فكان نداء الفزعة يقوم مقام الجيش والقانون. حين يتعرض بيت واحد للهجوم، يهبّ الجميع وكأن الخطر مسّهم جميعاً، فيتحول الخوف الفردي إلى شجاعة جماعية، ويصير الدفاع عن البيت دفاعاً عن هوية الأرض وكرامة العشيرة.
ومع أن الدولة الحديثة حاولت عبر القانون والمؤسسات أن تحل محل هذه النظم التقليدية، لم تختفِ الفزعة من الوعي العربي، على العكس، كلما واجهت المجتمعات لحظات فراغ أمني أو خطر خارجي، عادت الفزعة قوة حية تستيقظ من تحت الرماد. يكفي أن نستعيد ثورة سلطان باشا الأطرش عام 1925 لنرى كيف تحولت فزعة جبل العرب وحوران إلى شرارة أطلقت أكبر حركة مقاومة ضد الفرنسيين، وكيف صارت القبائل والعشائر هي العمود الفقري لثورة وطنية شملت كل سوريا.
وفي فلسطين، لم تكن الانتفاضات الشعبية لتأخذ زخمها لولا هذه الروح، حين كانت العائلات تحوّل بيوتها إلى خطوط دفاع أولى، فكانت الفزعة هناك لا حماية فردية، بل بناءً لمناعة جماعية ضد الاحتلال. حتى العراق بعد 2003 عرف هذه اللحظة، حيث تصدّت العشائر للاحتلال الأمريكي والفوضى الأمنية بنداءات الفزعة التي سبقت أي تشكيل عسكري أو قرار حكومي.
ما حدث في السويداء اليوم ليس بعيداً عن هذه السلسلة التاريخية، لكنه يحمل دلالات جديدة. الفزعة لم تعد مجرد عرف اجتماعي أو رد فعل بدائي، بل صارت فعلاً سياسياً واعياً يملأ فراغ الدولة حين تتأخر أو تُعطَّل. إنها تقول، بوضوح شديد: المجتمع ليس مجرد تابع للدولة، بل شريك حقيقي في حماية السيادة.
لكن الفزعة، في الوقت نفسه، تواجه تحدياً عميقاً: هل تستطيع أن تحافظ على عفويتها ووطنيتها، أم تتحول إلى قوة منفلتة قد تستغلها أطراف خارجية؟ هذه هي المفارقة التي تجعل لحظة السويداء لحظة فارقة، لأنها كشفت أن الفزعة -إذا بقيت في إطار الدفاع عن الحق والأرض- يمكن أن تكون امتداداً للسيادة، لا تهديداً لها.
بين الثورة والاختزال
لم تكن العشائر يوماً خارج التاريخ السوري، بل هي أحد أعمدته الأعمق جذوراً. في ثورة 1925 ضد الاستعمار الفرنسي، لم تكن مقاومة سلطان باشا الأطرش حدثاً فردياً بقدر ما كانت تجلّياً لوحدة المجتمع الأهلي حين التقى بدافع وطني واضح. لم تكن السويداء وحدها، بل نهضت حوران والغوطة والبادية، وتحولت الفزعة العشائرية إلى حركة تحرير شاملة، جمعت بين الفارس والشيخ والفلاح، بين الخيمة والمدينة. هذه اللحظة التاريخية تثبت أن العشائر ليست مجرد مكوّن اجتماعي، بل كانت يوماً القوة التي تحركت من الهامش إلى قلب مشروع التحرر الوطني.
لكن الأنظمة السياسية التي تلت الاستقلال تعاملت مع العشائر بطرق متباينة، وغالباً متوجسة. فمنذ خمسينيات القرن الماضي، ومع توسع الدولة المركزية، سعت الحكومات إلى تحييد قوة القبائل عبر توزيع المناصب والامتيازات أو عبر احتوائها أمنياً، ثم جاء حزب البعث ليؤكد على فكرة “الدولة الواحدة” التي لا تقبل بوجود أي قوة أهلية مستقلة. وفي عهد حافظ الأسد، جرى توظيف العشائر أدوات دعم للنظام، سواء عبر ربط بعض شيوخها بالأجهزة الأمنية أو استخدامها ورقة قوة في مواجهة خصومه. وفي المقابل، جرى تهميش أدوارها التقليدية، وتجريدها من صورتها كفاعل وطني له استقلالية معنوية.
الحرب السورية (2011 وما بعدها) عرّت هذا الواقع تماماً. حين ضعفت الدولة في مناطق واسعة، وجدت القبائل والعشائر نفسها بين خيارين: أن تتحول إلى قوى فوضى متنازعة كما حدث في الشرق السوري، أو أن تعيد اكتشاف دورها حاضنة دفاع وطني. للأسف، الصورة الإعلامية التي سادت في السنوات الأخيرة اختزلت العشائر إما مقاتلين مأجورين أو كيانات متأخرة حضارياً، بينما التجارب التاريخية تقول العكس.
ما جرى في السويداء مؤخراً يفتح الباب لإعادة النظر في هذه الصورة النمطية. هل ما رأيناه استمرار لذاك الإرث المقاوم الذي أطلق ثورة 1925 أم أننا أمام استثناء فرضته لحظة فراغ أمني؟
الجواب ربما يكمن في التفاصيل: مشهد مشايخ العشائر وهم يقسمون على “تحريم القهوة” حتى تعود كل المحافظات السورية إلى سلطة الدولة، ليس مشهداً عشائرياً تقليدياً بقدر ما هو إعلان موقف وطني واضح، يذكّر الدولة بأن هذه القبائل، رغم كل محاولات التهميش، ما تزال ترى نفسها سهماً في كنانة الوطن، لا خصماً ولا بديلاً عنه.
الفراغ الأمني: حين تتأخر الدولة
في لحظات الأزمات الكبرى، لا تختبر الدول بقوة جيوشها فقط، بل بقدرتها على أن تكون حاضرة في الزمن المناسب. ما حدث في السويداء خلال الأيام الماضية كشف أن أخطر ما يمكن أن يحدث في معادلة السيادة هو أن يُترك فراغ أمني، حتى لو كان مؤقتاً. انسحاب الجيش السوري بعد القصف الإسرائيلي لم يكن انسحاباً نهائياً، بل إعادة تموضع مفروضة بفعل الضغوط الدولية والخطر الجوي. لكن هذا الانسحاب ولو لساعات فتح الباب أمام المليشيات المدعومة من إسرائيل لتملأ الفراغ، فكان رد العشائر سريعاً، كأنهم يقولون: “إذا تأخر الحارس الرسمي، لن نسمح بأن تُسرق البوابة.”
هنا تتضح المفارقة المعقدة: الدولة التي تُهاجم من الخارج قد تجد نفسها مجبرة على الانسحاب التكتيكي، بينما المجتمع المحلي يندفع إلى خط المواجهة المباشر. في هذه اللحظات، لا يكون التحدي الأكبر هو القتال، بل هو الحفاظ على الثقة بين الدولة ومجتمعها. فالقبائل التي دافعت عن أرضها لم تكن تتحرك ضد الدولة، بل لأجلها، دفاعاً عن الأرض السورية أمام مليشيات عميلة لإسرائيل.
لكن ماذا لو تأخرت الدولة أكثر من اللازم؟ هنا يطلّ سؤال حساس: هل سيبقى المجتمع الأهلي في موقع “المؤقت المساند”، أم أنه سيبدأ بالتفكير بنفسه كقوة مستقلة؟
الجواب يتوقف على كيفية تعامل الدولة مع هذه اللحظة. فالتاريخ يعلمنا أن الفراغات الأمنية التي تتركها السلطة ولو بحجة إعادة التموضع تتحول بسرعة إلى مساحات تتنافس فيها القوى الأهلية، وبعضها قد يقع فريسة للاستغلال الخارجي. إسرائيل تدرك هذا جيداً، ولهذا ركّزت ضرباتها على تعزيزات الجيش السوري لتخلق فجوة بين الدولة ومجتمعها، وتدفع القبائل إلى موقع الدفاع الفردي بدل أن تكون جزءاً من استراتيجية وطنية موحّدة.
إن ما حدث في السويداء يذكرنا بأن الدولة ليست كياناً فوق المجتمع، بل هي شبكته العميقة. كلما كانت الدولة أكثر حضوراً في وجدان الناس، قلّت الحاجة إلى الفزعات المفاجئة. لكن حين تُترك الأرض فارغة، تتقدّم هذه الفزعات لتصبح خط الدفاع الأول. وهذه ليست مشكلة في ذاتها، بل قد تكون فرصة: فرصة لتذكير الدولة أن المجتمع يمتلك مناعة ذاتية، وأن الشراكة معه ليست ضعفاً، بل قوة إضافية.
هذه اللحظة في السويداء يمكن أن تكون درساً مهماً للسياسة السورية. بدل أن يُنظر إلى العشائر على أنها بديل محتمل للدولة، يجب أن تُعامل كحليف تاريخي، وقوة مساندة يمكن دمجها ضمن مشروع وطني شامل. فالدولة التي تنجح في احتضان حيوية مجتمعها، بدل أن تخاف منها أو تهمّشها، تضمن أن أي فراغ لن يُملأ إلا بروح وطنية، لا بروح متفلتة أو مُستغلة.
بين إسرائيل والدولة والمجتمع: الصراع على الجنوب
منذ عقود، تتعامل إسرائيل مع الجنوب السوري بوصفه خط تماسّ استراتيجي، ليس فقط عسكرياً، بل اجتماعياً أيضاً. فإسرائيل تدرك أن السيطرة على الحدود لا تتحقق بالقوة العسكرية وحدها، بل عبر تفكيك العلاقة بين الدولة والمجتمع المحلي. ومن هنا جاء تركيزها المستمر على الطائفة الدرزية في السويداء، ومحاولة تصوير نفسها حامية للأقليات، مستغلة خطاب “الخوف من العشائر” أو “خطر الأكثرية”.
القصف الإسرائيلي الأخير على تعزيزات الجيش السوري في محيط مطار الثعلة والريف الغربي لم يكن حركة تكتيكية عابرة؛ بل جاء وفق استراتيجية أوسع: إبقاء الدولة خارج الميدان، وفتح فراغ يُجبر المجتمع الأهلي على الاحتماء بذاته، لتظهر إسرائيل كأنها الضامن الوحيد للأمن. تقارير مراكز بحث إسرائيلية مثل معهد دراسات الأمن القومي (INSS) تؤكد أن تل أبيب تراقب الجنوب السوري باعتباره مساحة مرنة لإعادة رسم النفوذ بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأن أي تصاعد لدور الجيش السوري يُعد تهديداً لخططها.
لكن المشهد الأخير في السويداء قلب بعض الحسابات. الفزعة العشائرية التي تصدت لمليشيات حكمت الهجري، المدعومة ضمنياً من إسرائيل، أثبتت أن المجتمع يمكن أن يشكل خط دفاع مستقلاً لا يخضع لإملاءات الخارج. هذه الفزعة رغم عفويتها وضعت إسرائيل أمام مشهد محرج: المجتمع الأهلي الذي حاولت استغلاله أثبت ولاءه للأرض والدولة، ورفض الانجرار إلى معادلة حماية زائفة.
تاريخياً، لم تكن علاقة إسرائيل بالجنوب السوري معزولة عن محاولات قديمة لاختراق النسيج المحلي. يكفي أن نتذكر محاولات استمالة بعض الدروز في الجولان المحتل بعد 1967 عبر سياسات التجنيس والخدمات، لكن أغلبية المجتمع الدرزي تمسكت بهويتها السورية ورفضت الانصياع. واليوم، تكرر إسرائيل تكتيكات مشابهة في السويداء، غير أن الفزعة الأخيرة أثبتت أن الانتماء الوطني أعمق من أي مغريات أو مخاوف.
المعادلة الثلاثية -الدولة، المجتمع، إسرائيل- هي جوهر الصراع على الجنوب. فإذا نجحت الدولة في ترسيخ ثقة المجتمع بها، لن تجد إسرائيل ثغرة لتدخل منها. أما إذا شعرت القبائل والعشائر أن الدولة بعيدة أو غير قادرة على حمايتها، ستبقى إسرائيل تراهن على تغذية الانقسامات. هذه اللحظة الحرجة تفرض على دمشق أن تعيد التفكير في علاقتها مع الجنوب: ليس فقط كجغرافيا عسكرية، بل كمجتمع يحتاج إلى احتضان، وتمكين، وإشراك حقيقي في مشروع الدولة.
إن السويداء اليوم ليست مجرد ساحة صراع، بل بوصلة تكشف خطوط النفوذ. إسرائيل قد تراهن على الفوضى، لكن المجتمع حين يتوحد كما حدث في الفزعة الأخيرة يُربك كل هذه الحسابات. وهنا، تبرز مسؤولية الدولة في تحويل هذا التوحد من رد فعل إلى قوة دائمة، تُحبط أي محاولة خارجية لتفكيك النسيج السوري.
قوة المجتمع: الدرس الأهم
السويداء، بكل ما حملته من مشاهد الفزعة ونخوة العشائر، قدّمت درساً بليغاً يتجاوز حدود المعركة ذاتها: المجتمع ليس مجرد متفرج على التاريخ، بل هو أحد صانعيه الأوائل. عندما تتراجع الدولة خطوةً بفعل الضغوط الخارجية أو القيود العسكرية، يملأ المجتمع الفراغ، لا بوصفه خصماً، بل بوصفه الامتداد الطبيعي لوظيفة الدولة الأولى: حماية الأرض والكرامة.
في التجارب الحديثة، نرى أن كل دولة قوية تستمد قوتها من مجتمعاتها الحيّة، وليس من مؤسساتها البيروقراطية فقط. لبنان، على سبيل المثال، عرف كيف تتحول المقاومة الشعبية إلى جزء من منظومة الدفاع، وإن كان ذلك خارج الأطر الرسمية أحياناً. وفي فلسطين، لم تكن الانتفاضات لتبقى حيّة لولا روح المجتمع التي تسبق أي اتفاق سياسي. هذه الأمثلة ليست بعيدة عن المشهد السوري؛ فما فعلته العشائر في السويداء يُذكّرنا بأن قوة المجتمع ليست بديلاً عن الدولة، بل هي الوقود الذي يمنحها شرعية وحياة.
غير أن هذا الدرس يحمل جانباً آخر لا يقل أهمية: الدولة التي تهمّش مجتمعاتها، أو تنظر إليها كتهديد، تضعف نفسها دون أن تدري. ما حدث في السنوات الماضية من تراجع الثقة بين الدولة وبعض القوى الأهلية أتاح لإسرائيل أن تراهن على الانقسام، وعلى غياب التنسيق بين الطرفين. لكن الفزعة الأخيرة أثبتت أن المجتمع، حين يُستنهض، قادر على قلب المعادلة خلال ساعات.
هذه الحقيقة ينبغي أن تكون مفتاحاً لسياسة جديدة: سياسة تُبنى على الثقة لا على الشك، وعلى المشاركة لا على الهيمنة.
إن ما يميز الفزعة التي رأيناها في السويداء أنها لم تكن مجرد انفعال قبلي، بل تنظيم ميداني مدروس، قائم على حماية المدنيين والدفاع عن الأرض، في وقت كان يمكن فيه أن تتحول الأمور إلى فوضى أو اقتتال داخلي. هذه القدرة على الانضباط أثبتت أن المجتمع يمكن أن يكون قوة أمان، لا عنصر اضطراب، شرط أن تُحسن الدولة استيعابه وتوجيهه. فالمعادلة واضحة: لا دولة قوية من دون مجتمع قوي، ولا مجتمع قادر على الصمود من دون دولة تحترم قيمه وتحتضن طاقاته.
السيادة من الأسفل
ما جرى في السويداء لم يكن معركة محلية عابرة، بل مرآة عكست ملامح سوريا العميقة: دولة تبحث عن استعادة سيادتها، ومجتمع يرفض أن يبقى متفرجاً، وعدو خارجي يراهن على الانقسام ليزرع نفوذه. الفزعة العشائرية هنا لم تكن ضد الدولة، بل ضد الفراغ، ضد الفوضى التي حاولت إسرائيل وأذرعها أن تتركها في قلب الجنوب.
قد يظن البعض أن هذه الفزعة مجرد لحظة انفعالية ستخبو، لكن الحقيقة أنها لحظة وعي سياسي تعيد تعريف العلاقة بين السلطة والشعب. فهي تقول إن السيادة ليست قراراً فوقياً فقط، بل هي فعل يتولد من الأرض إلى الأعلى، من الناس الذين يرفضون التخلي عن أرضهم حتى لو تأخرت الدولة. هذا لا يعني أن المجتمع قادر على الاستغناء عن الدولة، بل العكس تماماً: الدولة القوية هي تلك التي تسمح لمجتمعها بأن يكون شريكاً، لا تابعاً ولا خصماً.
إن انتصار العشائر في السويداء ولو كان مؤقتاً وجّه ضربة رمزية للمشروع الصهيوني في الجنوب، وأكد أن الأرض التي تحرسها إرادة جماعية لا يمكن أن تُؤخذ بسهولة. الدرس الأهم هنا ليس عسكرياً فحسب، بل اجتماعياً وسياسياً: إذا وجدت الدولة الجرأة على احتضان هذه القوة الشعبية بدل تحييدها، فإنها ستملك حصانة داخلية تعجز عن اختراقها كل مشاريع التفتيت.
هذا المقال لم يُكتب ليصف حدثاً، بل ليفتح سؤالاً أكبر: كيف يمكن لسوريا بكل تنوعها وقواها الأهلية أن تعيد تعريف سيادتها في مواجهة الخارج؟
الجواب ربما يكمن في السويداء: هناك، حيث رفع الرجال بنادقهم دفاعاً عن الأرض، تذكّرنا أن السيادة ليست ما يُمنح من أعلى، بل ما يصنعه الناس حين يقفون جميعاً خلف اسم واحد اسمه الوطن.