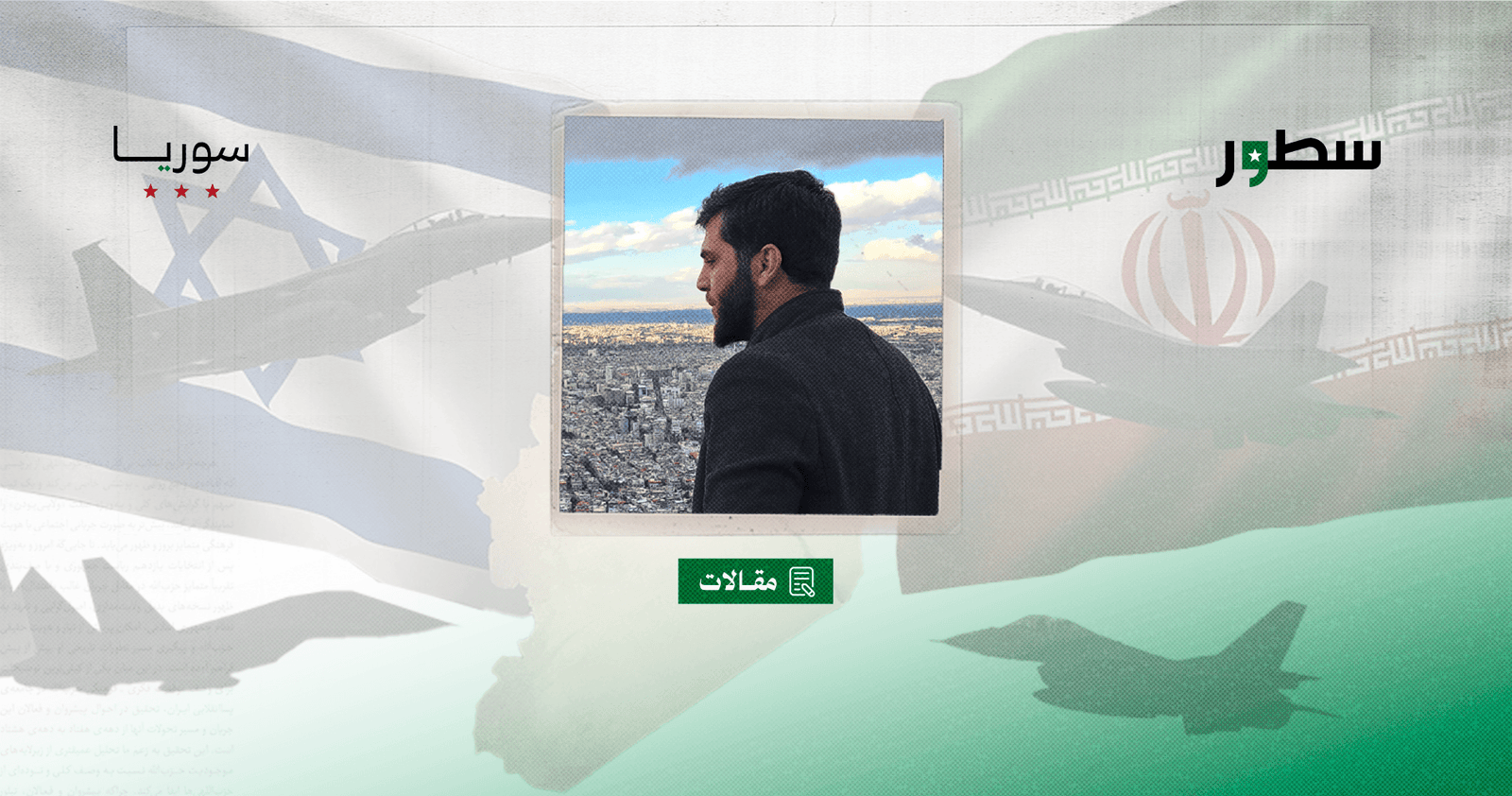سياسة
أَزْمَةٌ داخل السُّلْطَةِ السّنْغَالِيَّةِ: صَدَى تَصْرِيحَاتِ سُونكُو عَلَى مُستَقبَلِ حُكُومَةِ جُومَاي–فاي!
أَزْمَةٌ داخل السُّلْطَةِ السّنْغَالِيَّةِ: صَدَى تَصْرِيحَاتِ سُونكُو عَلَى مُستَقبَلِ حُكُومَةِ جُومَاي–فاي!
في بداية حكمهما، بدا عثمان سونكو مُتَحَدِّثًا إلى الجماهير بعد تعيينه رسميًا رئيسًا للوزراء في إبريل 2024، في وقتٍ كان فيه التَّحالُف بينه وبين الرئيس بشيرو جوماي فاي في أوج قوّته وتماسكه. وقد تُوِّجَ هذا التَّحَالُفُ بشعارٍ لافتٍ في حملتهما المشتركة: «جوماي هو سونكو» (Diomaye moy Sonko)، وهو الشِّعَارُ الذي أسهم بقوة في حشد التأييد الشعبي، ومهّد الطريق لفوز جوماي-فاي بنسبة 54% من الأصوات.
وفي أعقاب الانتصار، خاطب سونكو السنغاليين، قائلًا: “لن أدخر جهدًا في تحقيق الأهداف التي وعدنا بها الأمة “قطيعة حقيقية مع الماضي، وانطلاقة نحو التقدّم، وتغيير لا رجعة فيه”. كلماتٌ مشحونة بالوعد والثورة، بعثت في النّفوسِ أملًا جديدًا، ورسّخت صورة الثنائي “فاي–سونكو” كمحرِّكٍ لتغييرٍ جذريٍّ في البلاد، مع وعودٍ بإصلاحاتٍ من أعلى السلطة.
وقد انعكس هذا الزخم الإصلاحي في الانطلاقة الأولى لحكومة “فاي–سونكو”، أنّ حزب “باستيف” حقّق فوزًا مريحًا في الانتخابات التشريعية لعام 2024، وهو ما منح التحالف الحاكم اليد العليا في السلطتين التنفيذيَّة والتشريعيَّة، ما يُمكنّه من المُضِيِّ قُدمًا في تنفيذ أجندته التغييريَّة دون عوائق كبرى.
وقد وصف الإعلام تلك اللحظة بأنَّها “مرحلة سماح” حقيقية، أُتيح فيها للقيادة الجديدة أن تُبرهن على صدق وعودها، بسياسات ترمي إلى محاربة الفساد، ومراجعة شاملة للعقود الاقتصاديَّة -النفطيَّة والغازيَّة– لضمان تحقيق المنفعة العامة، كنقطة الانطلاق نحو ما بدا أنَّه عهدٌ مختلف في تاريخِ السنغال السياسيِّ.
نشوءُ التوتراتِ وصراعُ الصلاحيات
لكن مع مرور الوقت، بدأت تشققات التحالف تظهر رويدًا رويدًا، وطفا التوتر على سطح المشهد السياسيِّ السنغاليِّ، حتى صار جليًّا للعيان. فمن حيثُ الهيكل الدستوريّ، يظلّ الرئيس في السنغال هو صاحب الكلمة العليا في السلطة التنفيذية، غير أنَّ الشعبيَّة الجارفة التي يتمتع بها عثمان سونكو، وجاذبيته الثوريَّة في الشارع، دفعته -ربما- إلى التطلع بدور موازٍ في قيادة قاطرة الإصلاح، كأنَّما يطلب مقعدًا موازٍ للرئاسة لا دونها.
وقد لاحظ المراقبون أنَّ تفكير سونكو ينزع إلى تذويب الفوارق بين الحزب الحاكم والدولة، إذْ راجت في الدوائر السياسيّة مقولة مفادها أنَّ “سونكو يريد أن يكون الحزب هو الدولة، والدولة هي الحزب”، بينما بدا الرئيس جوماي فاي مُتمسكًا بمنهج أكثر تحفظًا، يريد للدولة أن تظلَّ فوق الاشتباك الحزبي، وأن يحتفظ بموقعه رئيسًا لكل السنغاليين، لا لفئة دون أخرى.
هذا التباين في الرؤية –بين زعيم حزبيّ متحفز لإدماج التنظيم في قلب الحكم، ورئيس يحرص على ارتداء عباءة الحياد الوطنيِّ– لم يلبث أن تحوّل إلى تباعدٍ سياسيٍّ سرى في مفاصل السلطة. ولم تقتصر الخلافات على الفلسفة العامة في الحكم، بل امتدت إلى صراعاتٍ ملموسةٍ حول ترتيب الأولويات، وملفات التعيينات الكبرى في الوزارات والمواقع الحساسة، فضلاً عن تضارب في وجهات النظر بشأن علاقات البلاد بالقوى الخارجية.
فشعر سونكو، شيئًا فشيئًا، أن يديه قد بدأتا تُقيدان من الداخل، وأنَّ القصر لم يعد يقف إلى جانبه كما كان. وفي هذه الأجواء، بدأت آلة إعلاميَّة للمعارضة، يُقال إنَّها من أنصار النظام السابق، تطلق سهامها نحو سونكو، وتحيي ملفات قضائيّة سابقة طُويت، كما أكدّ القضاء تُهمًا من شأنها أن تُبعد سونكو عن أي استحقاق رئاسيّ في عام 2029. وقد قرأ بعض المحللين صمت الرئيس فاي تجاه هذه الحملة بأنَّه إشارة إلى امتناعٍ ضمنيٍّ عن الدفاع، أو حتى رضا مستتر بما يجري؛ خشية أن يتغوّل سونكو شعبيًّا ويستحيل إلى منافس يُهدد عرش الرئاسة ذاتها.
في خِضْمِ هذا الاحتقان، خرج سونكو في العاشر من يوليو 2025، أثناء اجتماع المجلس الوطنيّ لحزبه “باستيف”، وألقى خطابًا لاذعًا، قال: “هنالك أزمة سلطة في البلاد… بل غياب تام للسلطة”، وأضاف بأنَّه بذل ما بوسعه لحل المشكلة داخليًا، وذهب بنفسه للرئيس عارضًا عليه الوضع، لكن دون جدوى. “توجهت إليه شخصيًّا، وهو يعلم أنَّه قادر على إيقاف هذا العبث متى شاء، فلماذا لم يفعل؟” ثم ختم خطابه بالقول: “أدعو الرئيس جوماي إلى أن يتحمّل مسؤوليته، وإن لم يفعل، فليفسح لي الطريق لأقوم بذلك”. وخاطب كوادر حزبه قائلًا: “لو كنتُ في مكانه، لما سمحت بتكرار هذه الانتهاكات”، وأضاف بنبرةٍ حازمةٍ: “مشكلة السنغال اليوم ليست الاقتصاد، ولا الأمن، بل هي مشكلة سلطة”. نزل هذا التصريح على الأوساط السياسيَّة كالصاعقة، إذ وصفته الصحافة بأنَّه “كسر للصمت”، حمل في طيَّاته تلميحًا إلى إمكانية الانفصال عن الرئيس فاي، أو على الأقل إعلان الطلاق السياسيٍّ الرمزيِّ.
كما استغلت المعارضة هذه اللحظة فورًا، معتبرةً أنَّ ما يُسمى “التشارك في السلطة” لم يكن إلا وهمًا مؤسّسيًّا سرعان ما انهار أمام أول امتحان جدِّي. وعلى مواقع التواصل الاجتماعيِّ، انقسم الرأي العام كعادته؛ بين من رأى في خطاب سونكو تجسيدًا للشجاعة السياسيَّة، ونقدًا صادقًا لضعف الدولة، وبين من اعتبرها مغامرة قد تطيح بتماسك الحكومة، في وقتٍ لا تحتمل فيه البلاد أَيَّ اهتزازٍ جديدٍ.
رَدُّ الرَّئِيسِ فَاي وَاحْتِوَاءُ الأَزْمَةِ
في خِضْمِ هذا السجال العاصف، ظلّ الرئيس جوماي ملتزمًا جانب الحذر، حتى الخامس عشر من يوليو، وخلال مراسم استلامه تقرير «الحوار الوطني حول النظام السياسي»، ليكسر الصمت، قائلًا: «رئيس الحكومة عبّر عن رأيه، وهو صديقي… لا وجود لأيّ خلاف بيننا… معركتنا الحقيقية هي التصدي للمصاعب التي يرزح تحتها شعبنا». بهذه العبارات، سعى الرئيس فاي إلى بث رسائل تهدئة في الأوساط السياسيَّة والشعبيَّة، مفادها أنَّ العَلاقةَ الشَّخْصِيَّةَ لم تُمسّ بسوء، وأن ما يجمع الرجلين من مشروعٍ وطنيٍّ يفوق ما قد يفرّقهما من تباين في الرؤى. وقدّم نفسه أمام الجمهور، لا كخصمِ لسونكو، بل كشريكٍ في مواجهة أعباء الحكم، واضعًا مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
غير أنَّ امتناعه عن الخوض في تفاصيل الخلاف، ترك الباب مفتوحًا أمام التأويلات. فمن جهة، رأى فيه البعض حكمةً بالغةً واستراتيجية تأمل في امتصاص الغضب وتفادي التصعيد، بانتظار أن تهدأ العاصفة، ليُصار إلى معالجة الأمور خلف الأبواب الموصدة. ومن جهة أخرى، لم يخلُ المشهد من قراءاتٍ مختلفةٍ، اعتبرت أنَّ الصمت المتواصل يُنبئ بضعفٍ أو ارتباك، أو أنَّه نوعٌ من الإنهاك السياسيِّ، يخشى فيه الرئيس أن تؤدي المواجهة المباشرة إلى تَصَدُّعِ التَّحَالُفِ.
السُّلْطَةُ لَا تَقْبَلُ القِسْمَةَ: دَرْسُ التَّارِيخِ الَّذِي يَتَنَاسَاهُ الأَفَارِقَةُ.
ما لا يُدركه كثير من المراقبين الأفارقة – خاصّة أولئك الذين يأسرهم الحماس العاطفيّ– هو أنّنا سرعان ما ننسى طبيعة السلطة، وحقيقتها الجارحة: السلطة لا تقبل المشاركة، ولا تعرف الشراكة. ومهما حاول البعض تزيين العلاقة الفريدة التي جمعت سونكو بالرئيس جوماي فاي، فإنَّ دروسَ التاريخ تُذكّرنا بأنّ التَّحالُفات في دوائر الحكم لا تدوم، لأنّ طبيعة السلطة ترفض التعدد في مركز القرار. نعم، من الصحيح أنّ الرئيس جوماي فاز بفضل دعم سونكو، وأنّه ما كان له أن يعتلي سدَّةَ الحكم لولا هذا التحالف السياسيّ والشعبيّ، لكن الزمن تغيّر، والمواقع تبدّلت، والرئاسة الآن بيد جوماي فاي، وسونكو – شاء أم أبى – صار تحت سلطته، موظفًا في هرم السلطة التنفيذية.
فالدرس الأقدم في سجلات التاريخ السياسيِّ، هو أنّ السلطة لا تقبل القسمة على اثنين. وما أكثر الشواهد. فقد قُتل الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر على يد زوجته ليفيا، طمعًا منها في توريث الحكم لابنها تيبيريوس. لكن تيبيريوس نفسه، لم يَسلَم، فقد خُنق وهو نائم على يد حفيده بالتبنّي، كاليغولا. ولم يكدْ كاليغولا يُتمّ فصول طغيانه حتى انقلب عليه حرسه وقتلوه، ليبايعوا الفيلسوف كلاوديوس، الذي لم يكن حظّه بأفضل، إذ دسّت له زوجته السمّ كي تُمكّن ولدها نيرون من العرش، وهو ذاته الذي أحرق روما.
وفي سجلات التاريخ الإسلامي، يروي لنا المؤرخون كيف أقدمت الخيزرانُ أُمُّ هارونَ الرشيدِ، على قتل ابنها الخليفة الهادي، حين حاول منعها من التَّدخُّلِ في شؤون الدولة. وسليمان القانوني، أحد أعظم السلاطين العثمانيين، لم يتردد في إعدام ابنه مصطفى – الذي أجمع المؤرخون أنَّه أحقّ بالخلافة – ثم قتل أخاه بيازيد، وأبناءه الخمسة، درءًا لشبح الانقسام على عرش السلطنة.
ولم يكن تاريخ السنغال السياسيّ بعيدًا عن هذه المعادلة لكن أقل قسوةً. فقد عرفت البلاد صراعاتٍ متكررة بين الرؤساء ورؤساء الوزراء؛ من أولى فصولها بين ليوبولد سنغور ورئيس وزرائه مومودو، إلى عبد الله واد ومصطفى نياسي، ومن ثم إدريسا سيك، وصولًا إلى الأزمة بين واد نفسه وماكي سال، الذي خلفه لاحقًا في الرئاسة، قبل أن يسلّم المشعل إلى الرئيس الحالي جوماي فاي. فالتَّصدُّعات داخل الثنائيَّة التنفيذيَّة لم تكن استثناءً، بل جزءًا من تقاليد السياسة السنغاليَّة.
لكن الجديد هذه المرّة، هو الصورة الوردية التي بيعَت للشعب: أنَّ البلاد تُحكَم بشراكةٍ متكافئة بين “ثُنَائِيٍّ استِثنَائِيٍّ”. إلا أنّ الواقع، كما هو دائمًا، لا يلبث أن ينسف الأحلام. فالسلطة، كما قال ميكيافيللي، لا تُمنح، بل تُنتزع، وهي بطبعها تُبدّل النفوس، وتصنع من الأصدقاء خصومًا.
وإنْ كان على الرئيس فاي أن يُضحّي بصديقه ورفيق دربه عثمان سونكو ليؤكد أنَّه صاحب الكلمة العليا، فسيُقدِمُ على ذلك دون تردّد. فالسلطة لا تعرف الصداقة، ولا تقبل القسمة.
ختامًا، يواجه التحالف بين جوماي-فاي وسونكو اختبارًا حاسمًا، بين خيار الاستمرار عبر تسوية تُراعي مصلحة الدولة، أو الانفصال الذي يهدد بإشعال أزمة سياسيَّة وشعبيَّة. وهنا تقف التجربة السنغاليَّة أمام مفترق طرق: إمَّا النضج والتنازل من أجل الوطن، أو السقوط في فخ الصراع الشخصيِّ وتبدّد حلم التغيير. وفي الحالتين، سيحكم التاريخ على الرجلين بما جنته أيديهما. لكن على المستوى الشخصيِّ لَدَيَّ قناعة أنَّ هذه الأزمة لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، وثمَّة فصول قادمة تُنبئ بالكثير.