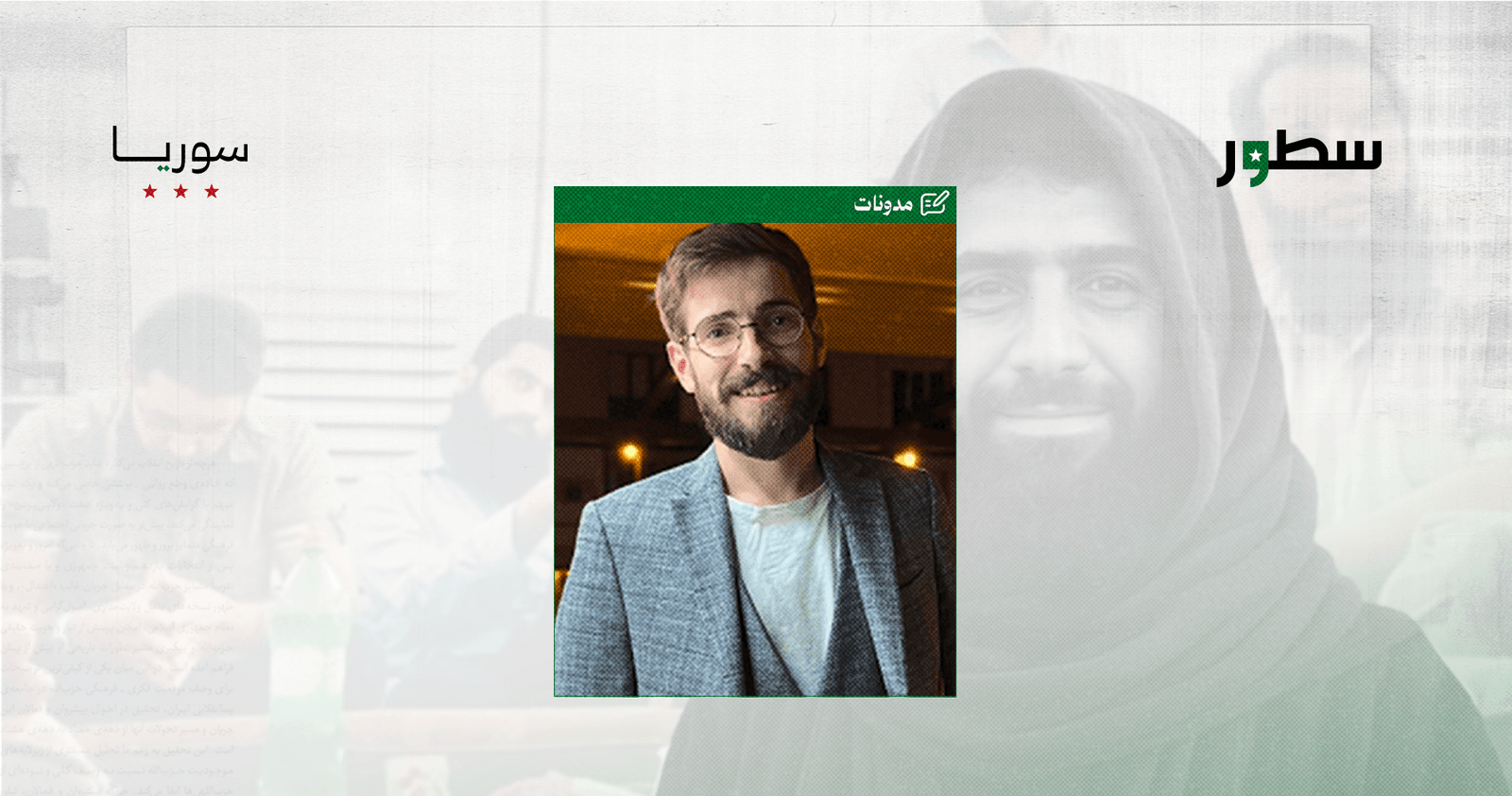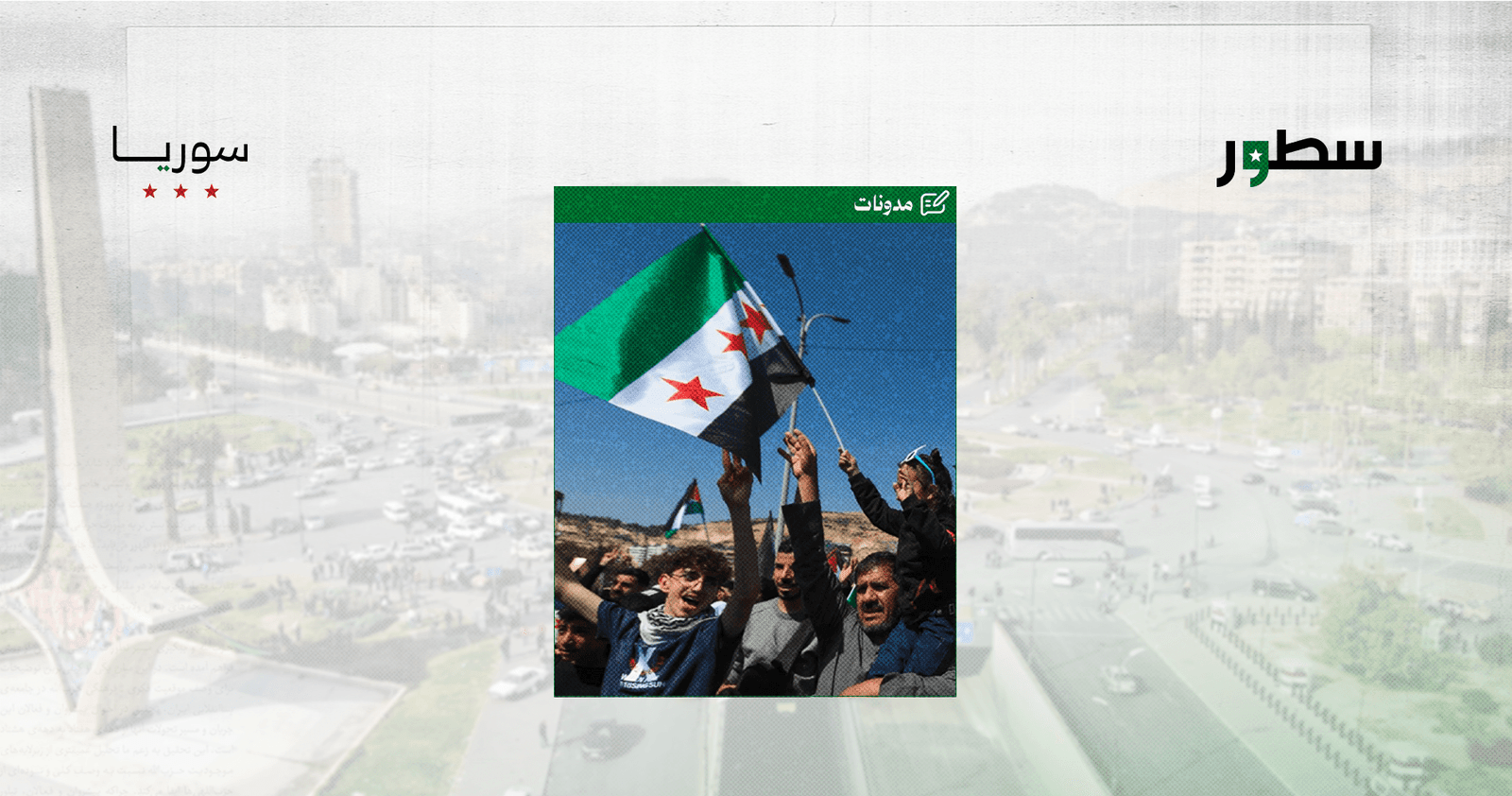مشاركات سوريا
الهجرة إلى أوروبا: بين تصاعد الطلب ومحاولات التقنين
الهجرة إلى أوروبا: بين تصاعد الطلب ومحاولات التقنين
– عبد الكريم أنيس
تعيش أوروبا مؤخراً على وقع تجاذب محتدم حول الهجرة والمهاجرين ومواقف سابقة لها في هذا المضمار، ألزمت بها نفسها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، في ظل واقع دولي يزداد اضطراباً. فمع استمرار التدهور الاقتصادي في أجزاء واسعة من العالم الثالث والتي كانت غالباً مستعمرات سابقة لأوروبا، وامتداد رقعة النزاعات المسلحة، وتفاقم آثار التغير المناخي من تصحر وجفاف وتوابعه، تتزايد أعداد الساعين لعبور المتوسط نحو حياة أكثر استقراراً وأمناً.
بالمقابل، تتجه الحكومات الأوروبية، الواحدة تلو الأخرى، لتشديد إجراءاتها وسَنِّ قوانين جديدة تهدف لضبط الحدود وتقييد تدفق المهاجرين بوسائل مختلفة، منها التعاقد مع سلطات الأمر الواقعة في الضفة المقابلة من المتوسط، وتمويلها بمبالغ طائلة لمنع هذا التدفق، وسط صعود لافت للتيارات اليمينية في صناديق الاقتراع، غالب هذه التيارات لا تملك مشاريع نهضوية سوى التحدث عن المهاجرين وأثرهم السلبي في مجتمعاتهم الجديدة.
هذا يسبب اضطراباً بيناً بين الحاجة المتزايدة لليد العاملة الأجنبية من جهة، والرغبة الشعبوية الصاعدة بتقنين الهجرة من جهة أخرى، لا ينعكس فقط في السجال التشريعي داخل البرلمانات، بل يتجلى أيضاً في تغطيات إعلامية متناقضة، تتأرجح بين خطابات تحذير من اللاجئين مفعمة بشحنات كراهية، والدعوة لفتح الأبواب فقط أمام الكفاءات والخبرات.
هنا، تؤدي بعض الجهات الإعلامية دوراً خطيراً في تضليل الرأي العام، بالجهتين، سواء من خلال اجتزاء التصريحات من سياقاتها، أو تقديم الأرقام بلا تحليل معمق، أو الانزلاق خلف الإثارة، كما هي عادة الصحافة الصفراء بحثاً عن نسب قراءة أعلى.
المصداقية في نقل هذا النوع من الأخبار لا تنبع من الحياد المتوجب اتباعه في عالم الإعلام المحترف فقط، بل من إدراك عمق الظاهرة وتعقيدها وتشابك أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فالهجرة ليست مجرد تنقّل أفراد، بل ظاهرة بنيوية تمس حاضر الدول ومستقبلها، وتشكل اختباراً لسياسات الاندماج، وامتحاناً لضمير المؤسسات الإعلامية. ولا يعدو التلاعب بهذا النوع من الاخبار فقط من جانب اليمين المتطرف في الغرب، بل يتعداه للتلاعب بأرقام كبيرة للحاجة لليد العاملة والتعمية على تفاصيلها في الطرف المقابل في دول العالم الثالث.
ففي خضم هذا المشهد المركّب، وبينما تتجه دول أوروبية لفرض مزيد من القيود على الهجرة، عاد إلى التداول تقرير صدر عن البنك المركزي الإسباني في 30 نيسان/ أبريل 2024، ليشعل تطلعات الباحثين عن فرص للهجرة من جديد. التقرير، الذي لم يُسلَّط عليه الضوء سابقاً بما يكفي، عاد ليتصدّر العناوين اليوم بمبالغات غير موضحة، بعد أن تلقفته مواقع ومجموعات تُعنى بقضايا اللجوء والهجرة.
فبحسب تقديرات “بانكو دي إسبانيا”، فإن إسبانيا التي نمى اقتصادها بشكل ملفت، ستكون بحاجة إلى نحو 25 مليون مهاجر في سن العمل بحلول عام 2053، لتغطية العجز المتوقع في سوق العمل، ومواكبة النمو الاقتصادي، وضمان ديمومة النظام التقاعدي. التقرير أشار إلى أن الاقتصاد الإسباني يشهد وتيرة نمو تفوق دولاً كبرى مثل فرنسا، ما يعني أن العمالة المحلية لن تكون كافية وحدها للحفاظ على هذا الطلب المتصاعد لفرص العمل.
في وقت بدأت فيه أوروبا تتبنى خطاباً يمينياً متشدداً تجاه الهجرة، تأتي هذه التوقعات لتكشف عن مفارقة جوهرية لا يمكن تجاهلها أن القارة العجوز تحتاج لمهاجرين أكثر مما تود الاعتراف به. ففي سوق العمل، لا يمكن للاقتصادات المتقدمة أن تستغني عن الأيدي العاملة الوافدة، خصوصاً مع تراجع نسب المواليد وشيخوخة السكان، والأرقام هنا لا تجامل ولا تتصنع ولا تنصت لخطاب الكراهية من تيارات اليمين.
أما بالنسبة للعدد الهائل من طالبي فرص العمل واللاجئين الاقتصاديين، فيمثل هذا التقرير الإسباني نافذة أمل غير مباشرة، ورسالة تقول إن القارة التي بدأت تُغلق أبوابها سياسياً أمام اللاجئين السياسيين، خصيصاً التي تتجاهل حقوق الإنسان في الضفة المقابلة للدول الأصلية للمهاجرين، ستفتحها اقتصادياً بمقتضيات الإكراه العملي لسوق العمل. لكن هذه الرسالة المتناقضة تضع هؤلاء أمام معضلة جوهرية حول أي خطاب يجب أن يصدّقوا؟ خطاب الحاجة، أم خطاب الرفض؟
التقارير الاقتصادية التي لا تعرف المجاملة ولا ترتيبات عالم السياسة، وعلى رأسها تقرير البنك المركزي الإسباني، تسلط الضوء على تناقض استراتيجي في بنية القرار الأوروبي.
فمن جهة، تتغذى التيارات اليمينية الشعبوية على خطاب التخويف من المهاجرين ومن خلفياتهم الدينية والفكرية، ومن جهة أخرى، تعترف المؤسسات الاقتصادية بعدم إمكانية الاستغناء عنهم. هذه الازدواجية تعكس أزمة تخطيط لا يمكن التقليل من شأنها، حيث يطغى الاعتبار الانتخابي قصير المدى على الرؤية البعيدة التي تتطلبها إدارة ملف معقد كهذا. ويقابل التخبط السياسي الأوروبي تلاعب بالألفاظ يستخدمه الإعلاميون في مقلب دول العالم الثالث حين يُستخدم مثل هذه التقارير لتشكيل ذهنية مبالغ بأرقامها حين يتم التعمية على أن هذه الأرقام كالتي صدرت عن البنك الإسباني المركزي، تأتي على دفعات، مرتبطة بجدول صاعد للنمو الاقتصادي المفترض ديمومته وثباته لإسبانيا.
في هذا السياق، برز توجه متزايد نحو ما يمكن تسميته بـ “استنخاب اللاجئين”، أي اختيار من يسمح لهم بالدخول بناء على مؤهلاتهم التعليمية أو المهنية العالية وذات الصنعة الفريدة. هذا النهج، وإن بدا عقلانياً للوهلة الأولى، يطرح إشكالات أخلاقية كبرى، لأنه يحوّل الأنظار عن الحق في اللجوء السياسي إلى امتياز مشروط للمهاجر الاقتصادي، ويكرّس رؤية نفعية للإنسان، لا ترى فيه سوى مورد اقتصادي بحسب ما يمكن أن يضيفه للمجتمع المضيف.
إن اعتماد سياسات انتقائية تجاه اللاجئين والخلط بينهم وبين اللاجئين الاقتصاديين الباحثين عن فرص عمل، يعمّق الاختلال القائم بين شمال غني يستقطب العقول، وجنوب منهك يفقد خيرة أبنائه من المهنيين وأصحاب القمصان البيضاء المؤهلين، لصالح من يمكن لأسواق عمله أن تستقطبهم وتستفيد من مؤهلاتهم التي ساهمت بلادهم بتفعيل هذه الملكات فيهم عبر دائرة طويلة من التنمية والإنفاق.
الاختلال هنا لا يمكن عزله عن أدوار الغرب السياسية والاقتصادية في تفاقم الأزمات التي تدفع الناس إلى الفرار للشمال الثري المطعم بالمؤسسات والحقوق القانونية، بل يفتح الباب لهروب العمالة المؤهلة للطرف الذي يعده بالكثير من الحقوق والعوائد الاقتصادية والمنفعة.
من هنا، يتحول ملف الهجرة من مجرد قضية إدارية أو ديموغرافية، إلى مرآة تعكس موقع الغرب من معادلة العدالة الدولية. والسؤال يبقى هل تتجه أوروبا نحو إدارة أخلاقية وإنسانية للهجرة، وتمايزها عن قضية اللجوء المستحق؟ أم تواصل تعزيز جدرانها، وتدعم الدكتاتوريات ليكونوا شرطة بحرية على الشواطئ في الطرف المقابل، وتنتقي من يستحق العبور فقط وفق شروط السوق؟
بتاريخ أيار/ يوليو 2024، أقر الاتحاد الأوروبي ميثاقاً للهجرة واللجوء بهدف توحيد السياسات وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية.
وتضمّن الميثاق إجراءات مشددة على الحدود، ونظام تضامن إلزامي، وتسريعاً لعمليات الترحيل، إضافة لمقترحات مثيرة للجدل مثل إنشاء مراكز احتجاز خارجية. وبينما يُعدّ الميثاق محاولة لتوازن بين ضبط الحدود وضمان الحماية، فإنه أثار مخاوف حقوقية بشأن مدى توافقه مع القيم الإنسانية، ما يوحي بأن الأمور لا تبشر بمستقبل تكون فيه الشروط القيمية الإنسانية ذات أولوية كبرى في عالم يُقال إنه بلا حدود.