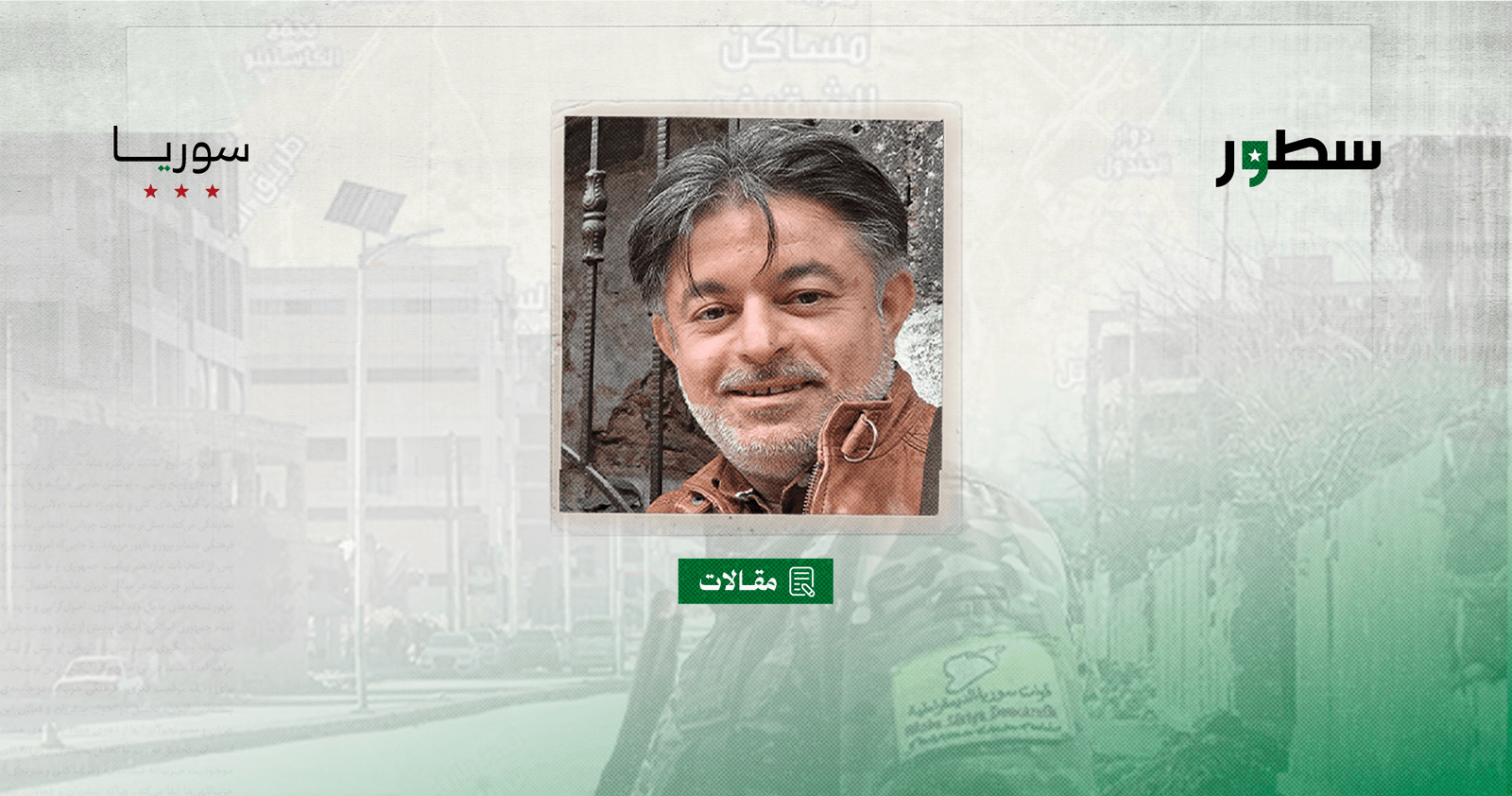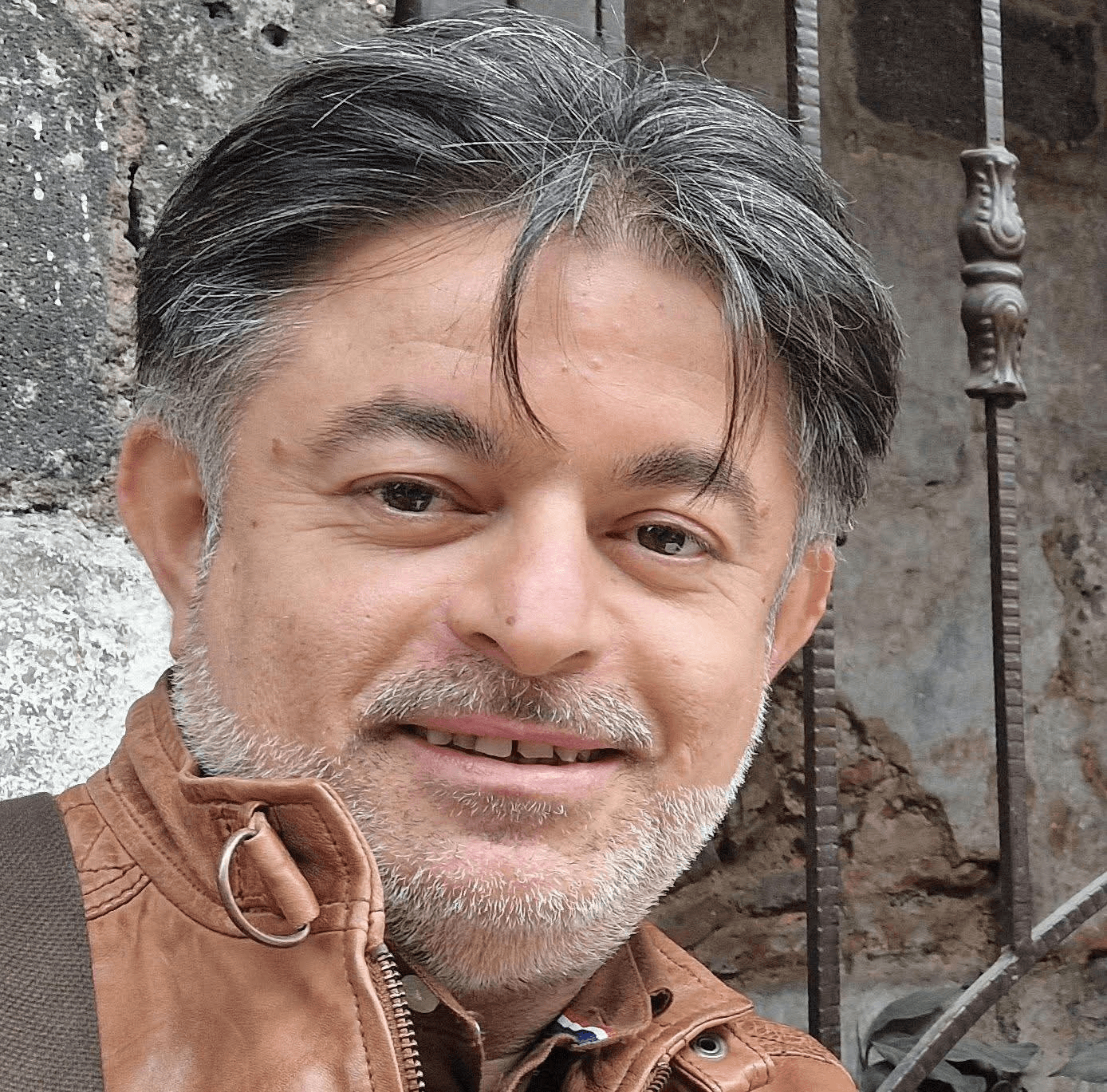مجتمع
الهويات القاتلة في سوريا: حين تتحوّل الانتماءات إلى أسلحة
الهويات القاتلة في سوريا: حين تتحوّل الانتماءات إلى أسلحة
المقدمة: الهوية.. ذلك الوهم الخطير
“ما أُدافع عنه هو حقي في أن أكون معقداً”، بهذه العبارة، يفتتح أمين معلوف كتابه الهويات القاتلة، معلناً رفضه الحاسم لاختزال الكائن البشري إلى مجرد بُعد واحد من أبعاده المتعددة. فالفرد، كما يرى معلوف، ليس كائناً أحادي البعد، بل نسيجاً مركباً من تجارب، وذكريات، وانتماءات متداخلة: الدين، اللغة، العائلة، الطائفة، الوطن والمكان، لكن هذا التركيب الطبيعي لا يتحوّل إلى خطر إلا حين يُفرض على الإنسان أن يختار، كما لو أن هويته لا تكتمل إلا إذا قمع أحد أجزائها، في تلك اللحظة يصبح الانتماء أداة قتل. فالهوية التي يُفترض أن تكون جسراً للتواصل، تتحوّل، في ظل التهديد والخوف، إلى متراس للعزل والمواجهة.
ضمن هذا السياق الفلسفي، تبدو الهوية كأنها بناء هشّ وقابل للانفجار، إذا ما وُضعت في السياق السياسي الخاطئ، وهنا يكمن جوهر الطرح المعلوفي: الهوية لا تقتل إلا حين تُختزل، وحين يُطلب من الإنسان أن يُعلن ولاءه المطلق لانتماءٍ واحد، ويُشكّك في بقية انتماءاته، بل وفي شرعيته كإنسان إن لم يلتزم التصنيف، هذه الفكرة التي تبدو فلسفية في ظاهرها، تملك تطبيقاً كارثياً على الواقع السوري، حيث كانت الهوية منذ عقود إحدى أخطر الأدوات التي استُخدمت لتفتيت البلاد، وقتل شعبها، وشرعنة حرب الجميع ضد الجميع.
من التعدد إلى الانفجار: خلفية تاريخية سريعة
سوريا في جوهرها التاريخي، لم تكن يوماً دولة موحّدة إثنياً أو دينياً، فمنذ ما قبل الاستقلال كانت رقعتها الجغرافية مأهولة بمجموعات بشرية متعددة، حافظت على تمايزاتها الدينية واللغوية والثقافية، دون أن تفقد في لحظات معينة قدرتها على العيش المشترك: عرب، كرد، سريان، أرمن، شركس، بدو، حورانيون، مدنيّون، علويون، سنة، شيعة، دروز، إسماعيليون، مسيحيون من مذاهب مختلفة… هذه هي الخريطة البشرية الحقيقية لسوريا. لكن التعدد لم يُترجم في بناء الدولة على شكل اعتراف قانوني صريح، بل ظل محصوراً في التوازنات الهشّة، وفي آليات التعايش القسري أو التهميش المتعمّد
في مرحلة ما بعد الاستقلال، فشلت النخب السياسية في إنتاج تصور متكامل للدولة الوطنية الجامعة. وسرعان ما انزلقت الجمهورية الفتية نحو نزاعات سلطوية داخلية حادة، كانت الهوية الدينية والعرقية أحد مفاتيحها. ومع صعود حزب البعث، ومن ثم استلام حافظ الأسد السلطة، تمّ الانتقال من خطاب العروبة الشامل إلى بناء سلطة ترتكز فعلياً على شبكات طائفية، ولو غلّفت نفسها بخطاب علماني. هذا التناقض بين الشكل والمضمون، بين خطاب الدولة وممارستها، هو ما أدى تدريجياً إلى تحويل الانتماءات الجزئية إلى أدوات سلطة ومفاتيح ولاء. فالهوية لم تعد تعبيراً عن الذات، بل جواز مرور في جهاز الدولة، ووسيلة لتحديد مكانة الفرد، لا حسب كفاءته بل حسب موقعه من خارطة الولاءات
ومع مرور الزمن، وتحديداً مع انتقال السلطة من الأب إلى الابن، ترسّخت هذه المنظومة حتى صارت الهوية جزءاً من البنية الأمنية. كل شيء أصبح يمرّ عبر فلتر الانتماء: التوظيف، الترقية، التعليم، المشاركة السياسية، بل حتى الحق في الحياة والنجاة من القمع. وهكذا، حين اندلعت الثورة في 2011، لم يكن مستغرباً أن تنفجر الهويات الدفينة دفعة واحدة، لأن أحداً لم يسبق له أن عالجها بوصفها عنصر غنى، بل كانت على الدوام مخزوناً للقهر أو للامتياز، حسب الموقع
كيف تصبح الهوية قاتلة؟ نظرة من معلوف إلى سوريا
يرى أمين معلوف أن الهوية تصبح قاتلة حين يتحول أحد عناصرها إلى موقع تهديد أو تضييق أو ضغط خارجي، فيندفع الإنسان إلى التشبث بهذا العنصر تحديداً، ويجعله معياراً وحيداً للانتماء والدفاع عن الذات. في لحظة الخطر، تصبح الطائفة درعاً، واللغة خندقاً، والدين سلاحاً. هذا التحول من التعدد إلى الاختزال هو ما يفتح الباب أمام الكارثة.
في الحالة السورية، كان من الممكن للثورة أن تكون لحظة استعادة للمواطنة، وللجامعة الوطنية التي تتجاوز الطوائف والأعراق. لكنها وُوجهت منذ أيامها الأولى بخطاب سلطوي يعيد تصنيف المجتمع طائفياً. فالنظام، في مسعاه لحماية نفسه، حوّل الحراك السلمي إلى تهديد طائفي، وحرّض المكوّنات الأقليّة على الشعور بالذعر من أكثرية سنية قادمة للانتقام. وفي المقابل، انجرفت بعض قوى المعارضة في خطاب مذهبي مماثل، سقط في الفخ الذي نصبه النظام. والنتيجة: توزّع السوريون قسراً على خنادق هوياتهم، لا لأنهم اختاروها بحرية، بل لأن كل طرف شعر أنه بات مستهدفاً في جوهر وجوده
في تلك اللحظة، أصبحت الهويات أدوات تعبئة وقتال. وصار من الطبيعي أن يُطلب من العلوي أن يبرّر عدم تأييده للنظام، ومن السني أن يُثبت عدم صلته بالإرهاب، ومن الكردي أن يُبرّئ نفسه من تهمة الانفصال، ومن المسيحي أن يشرح موقفه من العلمانية أو “التحالف مع السلطة”. كل فئة وجدت نفسها أمام مرآة الهوية القاتلة، تُلزمها بالتفسير والتبرير، بل بالتنصل من ذاتها، والهوية لم تعد خياراً، بل قدراً مفروضاً، وميداناً للصراع الدموي.
الهويات أقنعة سياسية: كيف تُستخدم للسيطرة؟
الأنظمة السلطوية لا تخشى التنوع، بل تخشى وعي الناس بتنوعهم. لذلك، فإنها غالباً ما تُعيد إنتاج الانقسامات، لا لتدمير المجتمع فحسب، بل لضمان بقائها. في سوريا، تحوّلت الهوية إلى أداة متقدمة في يد النظام الأمني. لم يكن الهدف تمثيل المكونات، بل إخضاعها وتفتيتها، ومن ثم تقديم السلطة بوصفها “الضامن الوحيد” لبقائها.
هذا النمط من الإدارة يقوم على تفعيل الخوف، وإعادة هندسة الولاءات وفق ميزان دقيق من التهديدات والتحالفات. فالنظام استخدم البنية الطائفية لإحكام السيطرة على المؤسسة العسكرية والأمنية، وأطلق يد “رجال الأعمال الجدد” من أبناء الأقليات والموالين لخلق طبقة اقتصادية تعتمد عليه، ثم روّج، طوال عقود، لنفسه حامياً للأقليات من المدّ الإسلامي أو القومي. في الوقت ذاته، كانت بعض أطراف المعارضة تمارس الانزلاق ذاته، عبر تبنّي سرديات قومية أو دينية إقصائية، تُقصي الآخر أو تهمّشه. فتمّت إعادة تدوير نفس الهويات، لكن بألوان وخطابات مختلفة.
ومع دخول الفاعلين الإقليميين والدوليين، تمّ تقنين هذا الانقسام وتوسيعه. فكل قوة دعمت طرفاً، لا بناءً على مشروع وطني جامع، بل حسب الهوية التي تخدم مصالحها: إيران دعمت النظام عبر البعد الطائفي، وتركيا دعمت فصائل عربية ضد الكرد، وروسيا دعمت النظام لأنه “علماني”، والغرب دعم معارضة “سنية معتدلة” حسب التصنيف، بينما وُصم الآخرون بالإرهاب. لقد أصبحت الهويات أقنعة استراتيجية على رقعة شطرنج دولية، يُحرَّك فيها السوريون كبيادق، لا كأصحاب وطن
مأزق الهوية في زمن الشتات
اليوم، بعد أكثر من عقد على اندلاع الثورة، وأكثر من نصف الشعب السوري يعيش نازحاً أو لاجئاً في الداخل والخارج، يبدو أن سؤال الهوية لم يهدأ، بل زادت حدّته. في المنافي، لم تنتهِ انقسامات الداخل، بل حملها السوريون معهم. في المخيمات، يُقسَّم اللاجئون حسب الجغرافيا أو الطائفة أو الجهة التي فرّوا منها. في أوروبا، يجد اللاجئ السوري نفسه أمام تصنيفات جديدة، حيث يُطلب منه أن يعرّف ذاته من جديد أمام مؤسسات لا تعترف إلا بالمصطلحات القانونية الباردة: “لاجئ”، “مواطن دولة ذات نزاع”، أو ببساطة: “غير أوروبي”.
لكن في العمق، ما تزال الهويات القاتلة تعمل بصمت. في الجاليات، في الحوارات، في شبكات التواصل، يعاد تدوير الشك المتبادل، وتُستحضر اللغة الطائفية أو القومية من جديد، لا لتفهم التجربة، بل لتُعيد تثبيت السردية القديمة ذاتها: “نحن الضحية، والآخر هو الجلاد”.
هذا الشتات، الذي كان يمكن أن يكون فرصة لبناء هوية وطنية جديدة، بات ساحة لاستنساخ الانقسام. والهوية، بدل أن تتحول إلى نقطة لقاء بين الداخل والخارج، أصبحت عبئاً مشتركاً، يُعيد السوري تعريف ذاته من خلالها كمتهم، أو كناجٍ من تهمة لم يخترها
كيف نخرج من قبضة الهوية القاتلة؟ نحو مشروع وطني إنساني
الخروج من مأزق الهوية القاتلة لا يكون عبر إنكارها أو تجاوزها كلياً، بل عبر إعادة تعريفها في سياق إنساني جديد. علينا أولاً أن نتوقف عن التعامل مع الهوية بوصفها جوهراً مطلقاً، وأن نعيد الاعتبار لفكرة التعددية داخل الفرد، قبل المجتمع. أن يُسمح للإنسان السوري أن يكون كردياً وسورياً، مسلماً ومواطنياً، عربياً وحداثياً، دون أن يُطلب منه التضحية بجزء من ذاته. هذا لا يعني طمس الانتماءات، بل وضعها في سياقها الطبيعي جزءاً من التجربة الإنسانية لا كأداة للصراع أو معيار للولاء.
ومن هنا، لا بد من صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على المساواة الفعلية بين المواطنين، لا على ضمان “حقوق المكونات” بوصفها كيانات مستقلة، بل على ضمان الحريات الفردية والجماعية في آن معاً. دستور جديد يعترف بالتنوع الثقافي واللغوي، لكنه يُؤسس لمواطنة لا تحتاج إلى تبرير. هذا المشروع لا يمكن أن يُبنى دون إعادة صياغة التعليم والإعلام، ليصبحا أدوات لزرع الاعتراف والتفاهم، لا التلقين والانغلاق. فالمجتمع يبدأ من المدرسة، والتعايش لا يُلقَّن، بل يُعاش.
كذلك لا يمكن تجاوز هذه الأزمة دون عدالة انتقالية شجاعة، تسمّي الضحايا بأسمائهم، وتحمّل المجرمين مسؤولية أفعالهم، لا مسؤولية طوائفهم. المحاسبة ليست انتقاماً، بل بداية التطهير. ولا مصالحة حقيقية دون كشف الحقيقة، ودون سردية جمعية تعترف بالوجع المتبادل، وتكفّ عن تحويل الذاكرة إلى سلاح.
وربما الأهم من كل ذلك، هو أن نعيد إنتاج ذاكرتنا الجماعية خارج ثنائيات العدو والصديق، والمجني عليه والجلاد. أن نكتب تاريخاً سورياً لا يُقصي أحداً، ولا يُنكر مأساة أحد. تاريخاً يُعترف فيه أن الثورة كانت حلُماً، وأن الحرب شوّهته، وأن الاستبداد كان جريمة، ولكن الردّ عليه لم يكن دوماً بريئاً.
خاتمة: نحو هوية سورية تتّسع للجميع
في النهاية، لن تُحل الأزمة السورية بتغيير نظام سياسي فقط، بل بتغيير جذري في تصوّرنا عن أنفسنا. الهوية التي نحتاجها ليست تلك التي تُفصل حسب المقاس الطائفي أو القومي، بل هوية تتّسع لتعقيدنا الإنساني، وتمنحنا الحق في أن نكون ما نحن عليه: مركبون، متداخلون، متغيرون، وأحرار.
السوري، بعد كل هذه السنوات، يستحق أن يكون أكثر من ابن طائفة، أو حامل لغة، أو تابع منطقة. يستحق أن يكون إنساناً كاملاً، يعرّف ذاته بالحرية أولاً، لا بالخوف. ولهذا، فإن الطريق إلى سوريا جديدة لا يبدأ من الاتفاق على شكل الحكم، بل من الاتفاق على أن دم الإنسان لا يجب أن يُراق باسم هوية… أبداً