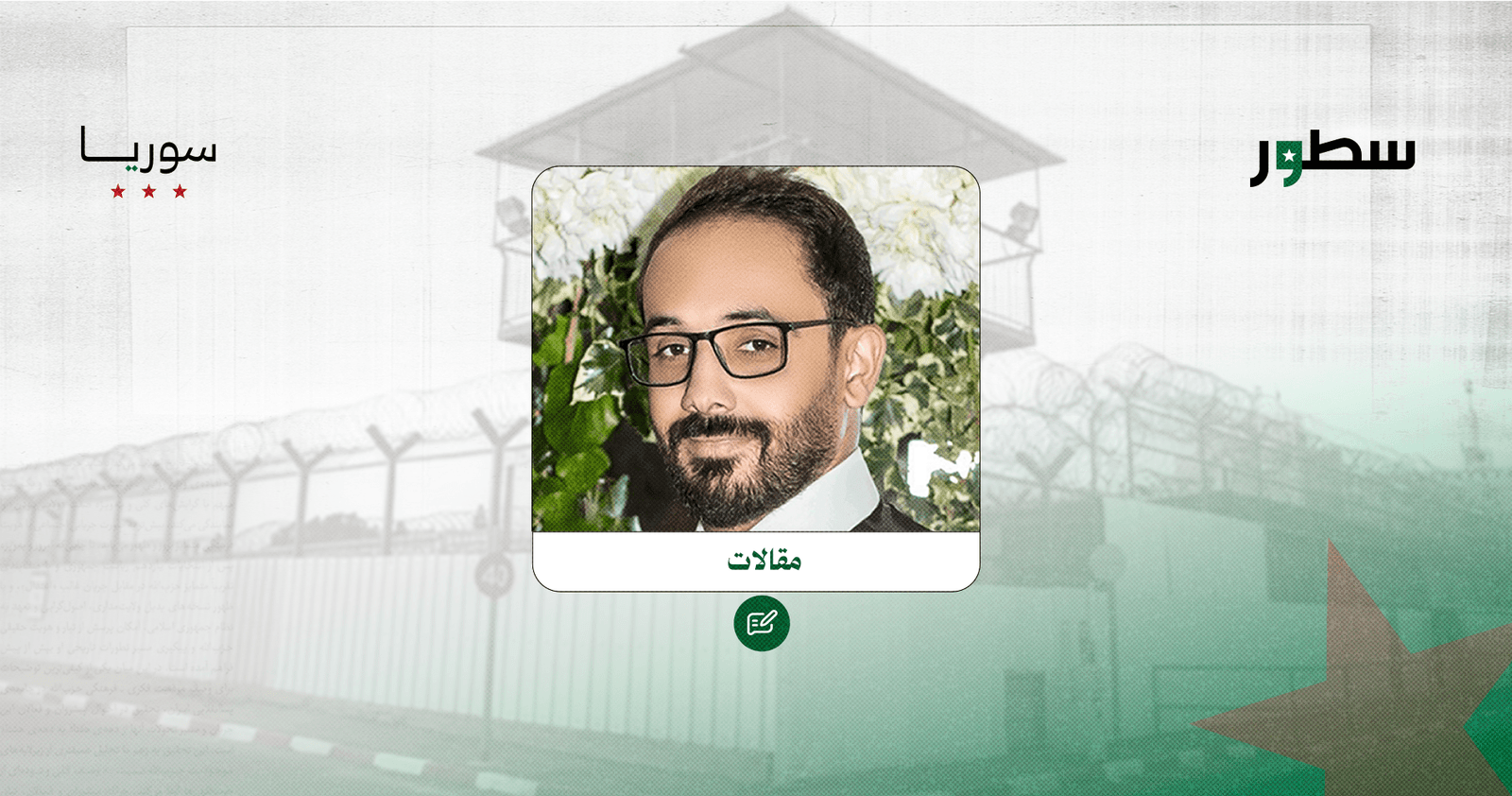أدب
حوار عن ملحمة جزيرتنا مع أجاثا كريستي: من ضفاف الخابور إلى تلال فردان
حوار عن ملحمة جزيرتنا مع أجاثا كريستي: من ضفاف الخابور إلى تلال فردان

في عام 1942، وبينما كانت قنابل سلاح الجو الألماني تهز لندن، كانت أجاثا كريستي، سيدة رواية الجريمة التي فتنت العالم، تجلس في ملجأ تحت الأرض. لكن عقلها لم يكن حبيس جدران الملجأ، بل كان يحلق آلاف الأميال شرقاً، نحو أرض زارتها في ثلاثينيات القرن الماضي مع زوجها عالم الآثار ماكس مالوان: أرض الجزيرة السورية.
في خاتمة مذكراتها الساحرة “تعالَ، قل لي كيف تعيش”، كتبت جملة تكثّف مفارقة عالمين:
“من ملجأ لندن.. وفي هذه اللحظة بالذات، يمرّ ظل القطيفة الصغير ذاك ويسير رجال مسنون ونساؤهم البيضاوات خلف حصرهم، دون أن يدروا بوجود ربما حرب عشتها منذ 4 سنوات حتى الآن في لندن”.
لم تكن كريستي تدرك حينها أن هذه الكلمات ستتحول من تأمل عابر إلى نبوءة معكوسة. فالشرق الذي تخيلته بمنأى عن ضجيج العالم ورائحة البارود، سيصبح هو نفسه مسرحاً لحرب أكثر عبثية وتركيب، وسيعيش أهله فصولاً من المأساة لم تكن لتخطر حتى في أكثر رواياتها البوليسية سوداوية.
80 عاماً تفصل بين زمنها وزمني. هي كتبت من خوف فوق الأرض، من ملاجئ لندن، عن ضفاف الخابور ونهر الجغجغ، وأنا اليوم بالقرب من مقابر فردان التي دفنت الحياة ذات حرب عالمية، أكتب عن نفس تلك البلاد التي أنهكتها الحروب، ينهض هذا المقال كحوار متأخر بيني وبينها، بين نظرة غريبة مدهوشة وذاكرة جريحة تحاول أن تتكلم.

نظرة الروائية: جمال البراءة المفقودة
حين وصفت أجاثا كريستي رحلتها إلى الشرق السوري، لم تكن تكتب كسياسية أو مؤرخة، بل كروائية مفتونة بالتفاصيل الإنسانية. رسمت للجزيرة صورة أرض بكر، مترامية الأطراف، يسكنها أناس فطريون، متناغمون مع طبيعتهم، ويمتلكون كرامة هادئة. لم تكن مهتمة بالحدود السياسية أو النزاعات العرقية التي ربما كانت كامنة تحت السطح، بل كانت عيناها تبحث عن الوجوه، عن لغة الجسد، وعن تلك العفوية التي افتقدتها في مجتمع الغرب الصناعي المنظم.
“هناك في تل براك، تحت خيمة بدوية، جلست مع نساء لم يقرأن رواياتي قط، لكنني شعرت أنني أعرفهن أكثر مما أعرف صديقاتي في لندن…”، كذلك ذلك الشيخ البدوي من قبيلة شمر الذي شبّهت موكبه بموكب أحد أمراء العائلة الملكية في لندن، ونساء عامودا الكرديات البسيطات، والسائق الأرمني المساعد.
في كتاباتها، لا نجد الشرق “الغريب” (Exotic) خلفية لرواياتها، بل عالماً حقيقياً، ربما أكثر واقعية من عالمها. وجدت في بساطة يد بدوية امتدت لها بقطعة خبز ساخن دون أن تسأل عن هويتها، “إنسانية العالم الأولى التي نسيناها”. كان ذلك اعترافاً بأن ما وجدته في قرى الجزيرة لم يكن مجرد مغامرة، بل كان العثور على راحة القلب، وألفة الإنسان مع أرضه وإنسانيته.
المرآة المحطمة: من لم يسمع بالحرب غرق فيها
بعد 80 عاماً، تحطمت تلك المرآة الشاعرية. الجزيرة السورية، التي كانت رمزاً للسكينة في ذاكرة كريستي، أصبحت مرادفاً لحرب لا تنتهي. قُصفت مدنها، ومُزّقت روابطها الاجتماعية، وتقاطعت على أرضها مصالح القوى الدولية والإقليمية. لم تُروَ قصتها على لسان روائية عالمية، بل بالكاد تسربت أصوات أهلها عبر تقارير المنظمات الحقوقية وضجيج الأخبار العاجلة.
جاءت جيوش لندن نفسها وواشنطن وباريس وموسكو وأنقرة وطهران، كلها لتتصارع في “فراديس الأرض” كما وصفتها أجاثا. لم تعد الأرض بكراً، ولم يعد الناس بسطاء متعايشين، بل ظهرت داعش وأجرمت، وكذلك عصابات نظام الأسد، ثم قسد، وبعض فصائل المعارضة، كلهم تصارعوا على الأرض وشرّدوا واعتقلوا أهل الجزيرة.
الجيل الذي وُلد في القامشلي والحسكة وتل تمر وتل براك لم يعد يعرف السهول المفتوحة، بل الحواجز العسكرية، وبطاقات الأمن، والتجنيد الإجباري الذي طال حتى القاصرين. وسقطت المنطقة تحت سيطرة “الإدارة الذاتية” التي رغم رفعها شعارات التحرر والديمقراطية، فرضت بمرور الوقت سلطة أيديولوجية صارمة، تجلّت في تغيير المناهج التعليمية، وقمع الأصوات المعارضة، واعتقال الصحفيين والمدنيين خارج أي إطار قانوني، بحسب ما وثقت منظمات دولية حقوقية من مكاتبها في لندن وباريس وجنيف ولاهاي.
أولئك الناس الذين فتنت بساطتهم أجاثا كريستي، أحفادهم اليوم يعيشون في نظام معقد من الولاءات والتصاريح الأمنية، عالقين في خوف دائم من التصنيف والمحاسبة.
سؤال يتردد في الفراغ: من الذي يتذكر من؟
مثلما تذكرت كريستي أهل الجزيرة في محنتها، يحق لنا أن نسأل اليوم: هل يتذكر أحد في لندن أو باريس أو نيويورك تلك الأرض التي وصفتها كاتبتهم يوماً بأنها جنة هادئة؟ هل يدرك العالم أن أحفاد أولئك الذين لم يسمعوا بالحرب العالمية الثانية، عاشوا وما زالوا منذ أكثر من عقد في أتون حروب متداخلة لا يعرفون كيف بدأت، ولا متى ستنتهي؟
تحدثت أجاثا عن كرم الضيافة وابتسامة عفوية. أما نحن اليوم، فنكتب عن قرى محى الحزن ملامحها، وأخرى جُرفت، وعن أطفال لم يعرفوا مقاعد الدراسة، وعن أمهات ينتظرن أبناءهن في سجون بلا أسماء ولا محاكم. كل هذا ليس لأنهم مذنبون، بل لأنهم وُجدوا في بقعة جغرافية يتقاطع فيها النفط مع القواعد العسكرية، وتُباع فيها مصائر الشعوب في أسواق السياسة.
شهادة من قلب العاصفة
كصحفي سوري، أقرأ مذكرات أجاثا كريستي وكأنني أكتب لها رداً تأخر 80 عاماً. هي كتبت عنّا من ملاجئ لندن تحت قصف الطائرات النازية، وأنا أكتب عنها من منفاي في سهول إقليم اللورين الفرنسي، حيث تطوّقني أسماء لا تُحصى من مقابر الجنود الذين قضوا في معارك فردان. كلما عبرتُ إحدى تلك اللوحات الرمادية التي تخبرنا بأن ألفي جندي قضوا هنا في ساعات، شعرت بثقل التاريخ على صدري.
أنا وأجاثا: كاتبان، مكانان، زمانان. هي في لندن زمن الحرب العالمية، وأنا عند مقابر فردان بعد نهاية الحرب السورية. لكن ما جمعنا، رغم كل الفروق، هو الشوق لتلك الضفاف في الجزيرة السورية، لصور أولئك الناس، والحنين لسلام بسيط وجمال فطري لا يُشترى.
هي كانت تكتب من مدينة تختبئ فيها الحياة، أما أنا فأكتب من أرض دُفنت فيها الحياة، لكن كلا المكانين يجتمعان في رمزية واحدة: الحرب لا تُغادرنا، فقط تتبدّل جغرافيتها.
أجاثا رأت في أرض الجزيرة مساحة للسكينة، وأنا أراها اليوم مساحة للخذلان؛ خذلان الحلفاء، وخذلان العالم، وخذلان كل القيم التي رُفعت باسمها الرايات وأُرسلت الجيوش.
ما تركته أجاثا ليس مجرد وصف حالم للماضي، بل شهادة غير مقصودة على ما يمكن أن يكون عليه السلام حين يُمنح فرصة للنمو. كانت ترى الناس البسطاء يزرعون أرضهم، ويصنعون قهوتهم، ويستقبلون الغريب بكلمة وابتسامة. أما نحن، فنراهم اليوم يقفون في طوابير للحصول على حصتهم من الوقود والخبز، أو أمام أبواب مراكز أمنية للحصول على خبر عن معتقل.
نحن نقطتان على خريطة الزمن، فرّقتنا الحروب وجمعتنا الذاكرة. وبين ملجأ لندن ومقبرة فردان، ثمة صدى بعيد لصوت واحد: الإنسان يستحق الحياة إن تُرك لها أن تُزهر.
وقد أصبح واجبنا، نحن أبناء هذه الأرض، أن نكتب الفصل التالي من الحكاية. لا لنندب حظنا، بل لنشهد للتاريخ، ولنقول إن أجاثا كريستي رأتنا يوماً في أفضل حالنا، ولعل العالم يرى ما نحن فيه اليوم: ذاكرة لا تموت.
ربما أجاثا كريستي لم تفكر أن كتابها سيكون مادة لمقال سياسي في زمن لاحق. لكنها أعطتنا، دون أن تدري، مرآة. مرآة نرى فيها أنفسنا كما كنا قبل أن يمر هذا الخراب.
كتبت عنّا يوم كنا أجمل، ونحن نكتب عنها اليوم، لنقول إننا لا زلنا أحياء، لا زلنا نحلم أن يُسمع صوت الجزيرة، لا كجبهة صراع، بل كأرض للحياة.
وإن كنا نحن اليوم من يعيش القهر، فربما يأتي زمن نكتب فيه من جديد: “بينما تهتز جدران العالم بالصراعات، تذكّرت تلك الأرض.. حيث يعيش الناس رغم كل شيء”.
لعل أحداً ما يسمعنا. كما سمعتنا أجاثا ذات يوم.