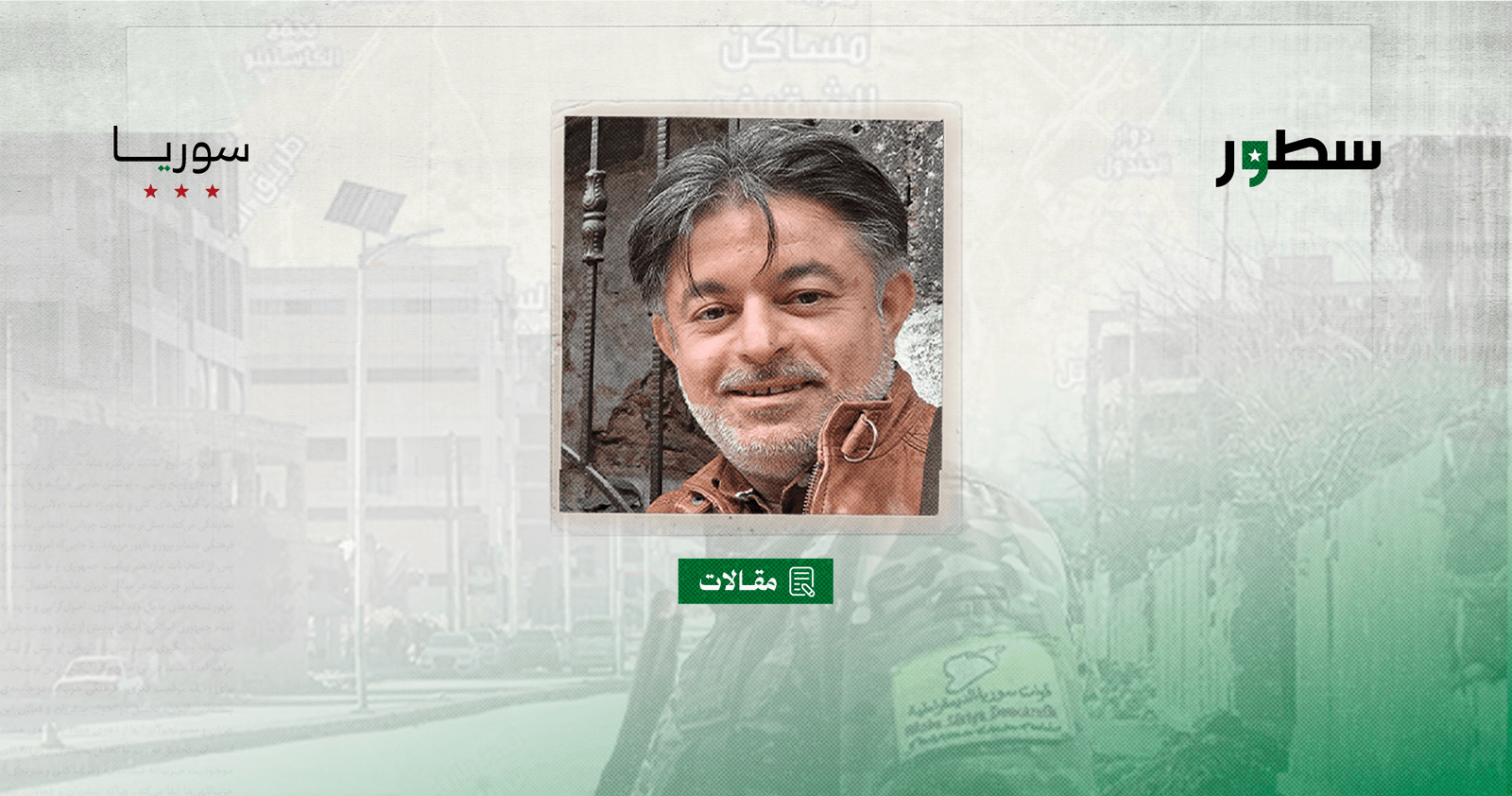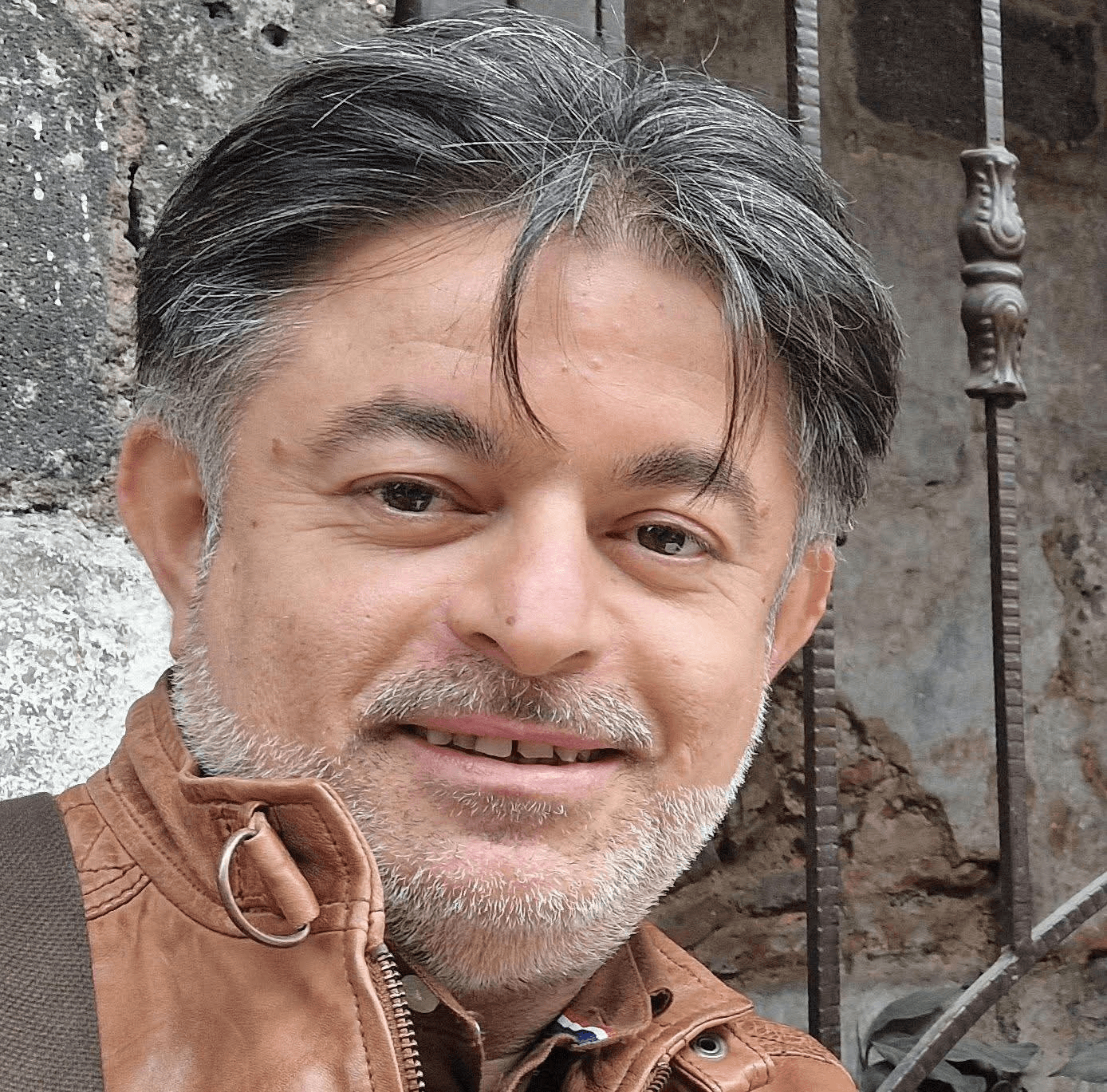مجتمع
ميزان الإكراه والحرية: تأملات فلسفية سياسية في مبدأ التناسب والدستور السوري
ميزان الإكراه والحرية: تأملات فلسفية سياسية في مبدأ التناسب والدستور السوري
تتنفس التاريخ والقلق في المآذن التي تحولت إلى صدى للأنين، وفي الأزقة التي تحفظ أسماء الشهداء كما تحفظ أسماء الفاتحين، ينهض في كل صباحٍ شاميّ يسأل سؤالاً قديماً جديداً: أين يتوقّف سلطان الدولة وتبدأ سيادة الفرد؟
مبدأ التناسب هو الميزان الذي صاغه الفلاسفة والقانونيون كي لا يتحول الأمن إلى قفص ولا تنقلب الحرية إلى فوضى. غير أنّ هذا الميزان، في السياق السوري، تاه بين انقلاب يرفع شعار “ضرورات المرحلة” وقانون طوارئ ظلّ جاثماً على الصدور لأكثر من نصف قرن، حتى صار صوت التوازن همساً يتسرّب من بين بنود الدساتير وعناوين الصحف الرسمية. تأتي هذه الورقة لتحيي ذلك الهمس، فتضعه في قلب نقاشٍ يستحضر التاريخ والفلسفة والسياسة، ويقارن بالتجارب الأجنبية، ثم يخطّ خارطة طريقٍ نحو دستورٍ يعرف كيف يزن الإكراه بالحرية. لأن السؤال الدستوري في سوريا ليس لغزاً قانونياً فحسب، بل هو مرآةٌ لوجدانٍ جمعيّ يريد أن يرى وجهه بلا قيود ولا مساحيق.
أولاً التناسب بين الأخلاق والفلسفة: من كانط إلى دوركين
يبدأ التناسب من قاعدةٍ أخلاقية وضعها إيمانويل كانط حين جعل كرامة الإنسان حداً لا يجوز للدولة أن تتجاوزه، فكتب أنّ الفرد “غاية لا وسيلة”. بعده بقرنٍ تقريباً، سيجيء بينجامين كونستان ليقول إن الحرية هي الأصل وإن القيود استثناءٌ ينتظر برهان الضرورة والملاءمة، ولذلك لا تُعطى الدولة شيكاً على بياض طالما وُجد بديلٌ أقل قسوة. وفي القرن العشرين بلور الفقيه الألماني روبرت أليكسي هذا الموقف في “اختبار المراحل الثلاث”: ملاءمة الإجراء، وضرورة تنفيذه، ثم موازنة مكاسبه وأضراره.
في المقابل يحذّر ميشال فوكو من قدرة السلطة على حياكة سرديات الخوف لتبرير القمع بشكلٍ يبدو عقلانياً ظاهرياً، مُذكّراً بأن اختبار التناسب يظل بلا قيمة ما لم يقترن بشفافية وإعلامٍ حر. أخيراً يأتي رونالد دوركين ليصوغ فكرة “الأفضلية الأخلاقية للحقوق” مؤكداً أن عبء الإثبات يقع دوماً على كاهل من يريد تقييد الحرية لا على من يتمتع بها.
ثانياً خرائط دستورية ضائعة: قصيدة سورية بين الانقلاب والنص
من دستور 1950 الذي صاغته جمعية تأسيسية تشرّبت الروح البرلمانية، إلى دستور 1962 الذي وأده انقلاب الثامن من آذار/ مارس، ثم إلى دستور 1973 الذي كرّس لرئاسةٍ تكاد تبتلع السلطات كلها، وصولاً إلى دستور 2012 الذي وُلد تحت ضغط الانتفاضة الشعبية، تبدو الدساتير السورية مثل قصائد جميلة يُغتال وزنها مع أول امتحانٍ واقعي. تنص تلك الدساتير على حرية التعبير والحق في التظاهر، لكنها تضع مفاتيح تطبيقها في يد سلطةٍ تنفيذية شبه مطلقة وغيابُ القضاء؛ إذ “الحق الذي لا يجد قاضياً يدافع عنه حلمٌ بلا أثر”، كما يقول ديتَر غريم.
وحتى حين أُنشئت محكمة دستورية عليا عام 1973، لم تُمنح صلاحية الرقابة على القوانين إلا في حدودٍ ضيقة، وظلت المراسيم التشريعية الرئاسية في منأى عن الطعن. هكذا انشقّ الطريق بين خطابٍ دستوريٍ معسولٍ وحياةٍ سياسية تحكمها حالة الطوارئ ويقظة الأجهزة
ثالثاً في مختبر الضرورة: كيف صادرت القوانين الاستثنائية حق التوازن
على مدى 48 عاماً ارتدى قانون الطوارئ (1963-2011) عباءة المصلحة العليا ليُعلّق الضمانات، فيُحلّ حزب، ويُغلق منبر، وتُحاكم كلمةٌ كأنها رصاصة، فمثلا يعدُّ المرسوم 6 لعام 1965 الاتصال بجهة أجنبية جريمةً قد تصل عقوبتها الإعدام من دون تعريف للجهة ولا لنية الاتصال، متجاوزاً أي معيار ملاءمة أو ضرورة. وفي 2012 جاء قانون مكافحة الإرهاب بتعريفٍ فضفاضٍ يعدّ زعزعة الوحدة الوطنية عملاً إرهابياً، فحاكم ناشطين سلميين أمام محكمةٍ استثنائية لا تعترف بحق الاستئناف، فمن فهذا القصور تُمنح الأجهزة الأمنية بموجب هذه النصوص، سلطات توقيفٍ وحجزٍ إداري خارج رقابة القضاء، لتتحول قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته إلى جملةٍ معلقة في هوامش مهملة. يتحققُ الضررُ بالإجراء أكثر مما يحققه من أمنٍ مستدام، في افتقادٍ علني لمراحل الملاءمة والضرورة والتوازن.
رابعاً – متاهة المؤسسات: حين يبتلع التنفيذ التشريع والقضاء
لا يمكن للتناسب أن يحلّق في فضاءٍ سياسي تواجه فيه المؤسسات اختناقاً بنيوياً. فالمحكمة الدستورية تُعيَّن بمرسومٍ صادرٍ عن رأس السلطة ذاته، ولا تملك صلاحية رقابةٍ لاحقة على القوانين ولا حق التصدي للمراسيم، ما يجعلها حارساً بلا مفاتيح.
مجلس الشعب يُنتَخب بقانونٍ يفصّل الدوائر بحيث تضمن الأكثرية المطلقة للحزب الحاكم، فتحوَّلت جلساته إلى مسرحٍ للتصفيق بدلاً من كونه منبراً للنقاش. والقضاة العاديون يخضعون لترقياتٍ وإعاراتٍ تصدر عن وزارة العدل الخاضعة للسلطة التنفيذية، فكيف يُنتظر منهم أن يقفوا بجرأةٍ أمام جهازٍ أمني؟
عندما تنهار معادلة سلطة تقابل سلطة، ويتغوّل التنفيذ على التشريع والقضاء، تفقد الدولة ميزانها، ويتحول اختبار التناسب إلى رفاهيةٍ أكاديمية تتلوها الجامعات ولا تقرؤها المحاكم. ولا يقف الأمر عند البنية القانونية فحسب، بل يتعداه إلى ثقافةٍ إداريةٍ ترى في الطاعة فضيلة، وفي النقد تهديداً، ما يجعل الرقابة الذاتية أداة أخرى من أدوات تغييب مبدأ التناسب.
خامساً بوصلة المقارنة: دروسٌ من برلين وجوهانسبرغ وتونس
التاريخ يبيّن أن للتناسب أنياباً حين يحرسه قضاء مستقل وإعلام حر، ففي ألمانيا الاتحادية، أبطلت المحكمة الدستورية قيوداً مبالغاً فيها على ممارسة الصيدلة، ثم صوّبت قانوناً يحدّ من التجمّع السلمي في بروكدورف 1985 مؤكدة أن المنع هو الملاذ الأخير لا الخيار الأول، وفي جنوب أفريقيا أُحرقت صفحة الفصل العنصري، وأُدرج اختبار التناسب نصاً في دستور 1996، فقضت محكمتها بإسقاط قانونٍ جنائي يجرّم انتقاد الرئيس لعدم توازنه مع حرية التعبير.
أما تونس بعد 2011، فقد نصّ دستورها على أنّ القيود لا تُفرض إلا لحماية حقوق الغير أو متطلبات الأمن القومي على أن تكون متناسبة مع الداعي إليها، ونجحت المحكمة الإدارية في إبطال قرارات داخلية استندت إلى حجج أمنية فضفاضة. تكشف هذه التجارب أن التناسب ليس حلاً سحرياً، لكنه يصبح مفتاحاً فعالاً كلما وُضع في قفلٍ صحيح: قضاء مستقل، وشفافية، ومجتمع مدني يقظ.
سادساً سوريا الممكنة: خارطة طريق لدستورٍ يتنفس التناسب أولى الخطوات الاعتراف بالفجوة
يتطلب ذلك إنشاء محكمة دستورية ذات ولايةٍ شاملة تستقبل دعاوى الأفراد، ويُنتخَب قضاتها بتوافق البرلمان ونقابة المحامين وممثلي المجتمع المدني، ويتعذر عزلهم إلا بقرارٍ قضائي. يلي ذلك تعديل المادة 112 بحيث يُقيَّد إعلان الطوارئ بـ 30 يوماً، ويستلزم أي تمديد تقريراً حكومياً مفصلاً يبيّن الداعي ويستعرض بدائل أقل تقييداً، على أن يخضع التصويت البرلماني لعتبة ثلثي الأعضاء.
يجب سنُّ قانون يلزم بنشر كل إجراءٍ مقيّد للحرية في الجريدة الرسمية خلال 48 ساعة، ويفتح باب الطعن المباشر أمام القضاء الإداري بعدم التناسب. وعلى الجامعات إدراج مساقٍ إلزامي في فقه التناسب يدرّس فلسفته وتقنياته، فيما يتكفل الإعلام حين يُسمح له بتحويل موازين الملاءمة والضرورة إلى موضوعٍ حواريٍ شعبي. ولا بد من صندوق تعويض لضحايا القيود التي يُبطِلها القضاء، حتى تتحول المسؤولية المالية إلى محفّزٍ يردع الاستسهال في تقييد الحقوق. إن صدقت هذه الإصلاحات، فلن يبقى التناسب بنداً في الدستور، بل سيصير عادة مؤسسية تضبط الإكراه وتوائم الحرية
وأخيراً أختم المقال بجملة كتبها كانط “العدالة تنحني ولكنها لا تنكسر”، في سوريا انكسرت العدالة كثيراً، مراراً وتكراراً.. ولكنها لم تتلاشَ من ذاكرة شعبها.