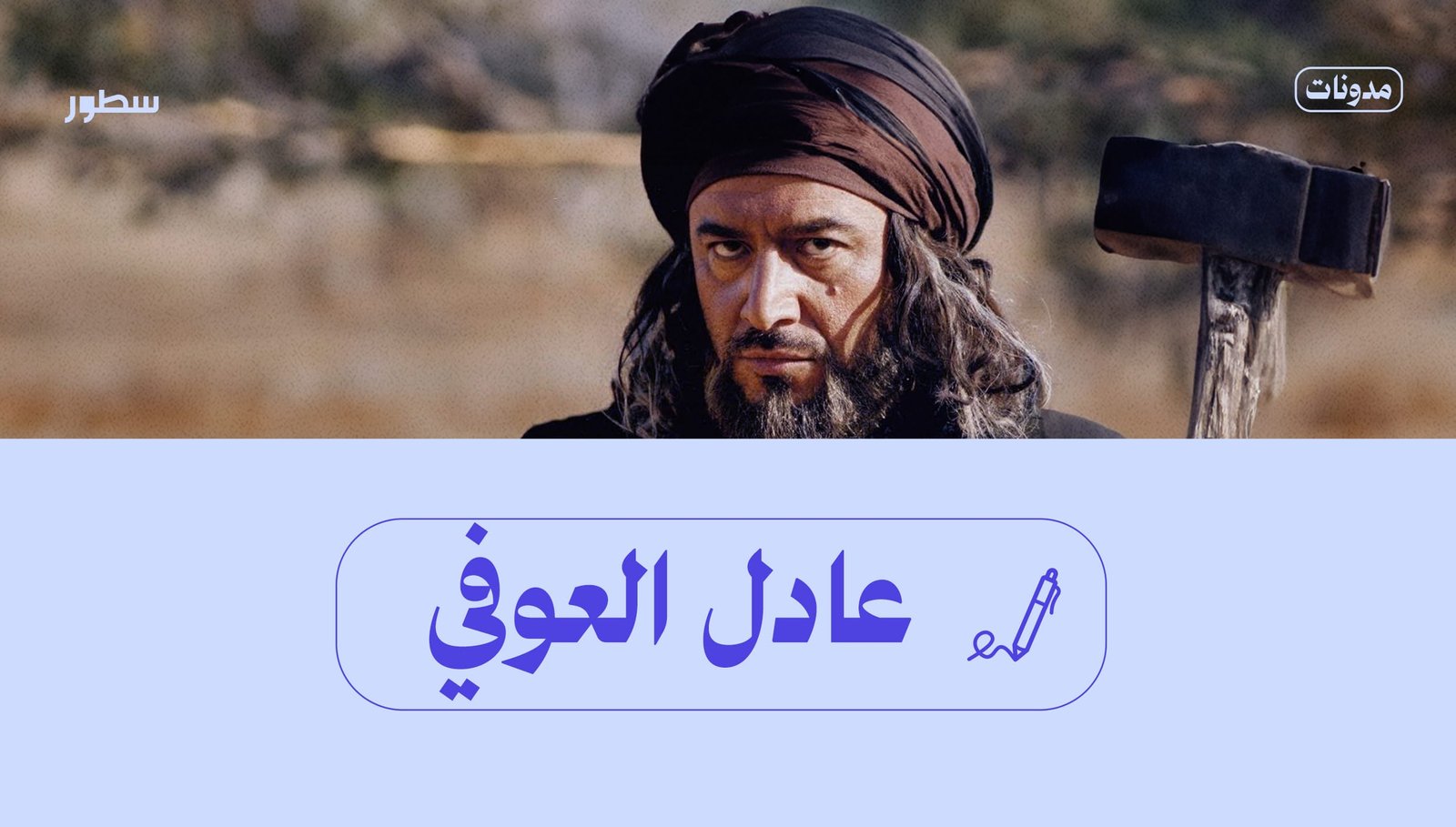مدونات
النكبة الدائمة: تحول مصر إلى خرابة في دمار مستمر وخراب مُعَجَّل!
النكبة الدائمة: تحول مصر إلى خرابة في دمار مستمر وخراب مُعَجَّل!
للكاتب: مصطفى نصار
التحويل المشوَّه والتغيير الجذري: نكبة ١٩٦٧ باعتبارها تداعيات ضاربة في التاريخ الحديث.
في صباح ٧ يونيو عام ١٩٦٧، وُجِّهَت الضربات الإسرائيلية من سلاح الجو نحو سيناء، فدمرت الدفاعات الجوية تمامًا والمدفعية المصرية، ما أدى إلى تدمير عسكري غير مسبوق وهائل شمل، بطريقة بانورامية، عدة جوانب حيوية وأساسية في حياة المصريين، بطريقة مخيفة ومفزعة، ممتدة لأيام حاليّة في الاقتصاد والمجتمع والسياسة، وحتى تحوّل عقدي خطير وممكن للعبودية المختارة لجموع الشعب المصري. فالنَّكبة المصرية المُلطّفة من قِبَل هيكل، عميد الصحافة المصرية، سلَّمت مصر كلّها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا للكيان الإسرائيلي اللقيط.
لكن من الضروري التذكير بتكملة ما قاله الأستاذ محمد جلال كشك في كتابه كلمتي للمغفلين، حينما نسف منطق “فجأة النكبة” وعدم التحضير لها، وكذلك ما ذكره وزير العدل أحمد علاونة في كتابه شهادة حق، أن ذلك جاء نتيجة استحواذ قلة قليلة من العسكر على مقاليد الحكم والاقتصاد والقضاء المدني والعسكري، فأدَّى ذلك إلى جعل الدولة المصرية آنذاك مقابر جماعية وإعدامات ميدانية لمن يحاول الإصلاح قيد أنملة، أو حتى الانتقاد من الحلفاء والأولياء مثل سيد قطب، الأديب والمفكر الإسلامي.
وترافق هذا التغيير القسري بعدة موجات تشويهية لعدة أمور مشوِّهة للأنماط الاجتماعية والتفاصيل الدقيقة؛ منها انتشار اليأس، وانعدام الثقة بالعسكر، وكذلك خروج جيل مهزوم نفسيًا لم يجد من وسائل التعبير شيئًا، فقرَّر التعبير عن غضبه وسخطه العام بالمظاهرات المتتالية والمتعاقبة بشدة، أشهرها مظاهرة ١٩٦٨ التي وصفها الدكتور أحمد عبد الله رزة بالهزة العنيفة. فكوَّنت مثل عدة اهتزازات ارتدادية على المجتمع، رسَّخت الهوان وسلب الإحساس بالندية من السلطة الغاشمة والباطشة تجاه الشعب بأكمله، فضاعت جهود عبد الناصر “المظفّر” من أجل بناء مجد شخصي، غير تحقيق الثروات المتراكمة عبر النهب والإلهاء “بالفضائح القذرة”، كما ألمح المؤرخ ج.م. فاتيفكيس في كتابه عبد الناصر وأيامه.
وأما بالنسبة للأمن القومي، فيكفي أن سيناء والضفة والجولان وقعوا تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، غير فصل غزة عن مصر إداريًا، فتحوَّل الأمن القومي إلى مزحة ثقيلة الدم في ظل دولة اعتبرت حكامها ونخبتها الفاسدة والمنحدرة أمنها القومي الوحيد. ولهذا، يُلخّص الدكتور محمد مورو، المفكر الإسلامي، في كتابه عن تاريخ مصر أن النكبة أو “نكسة ١٩٦٧” تعبير صارخ عن الاستباحة الكاملة والفتح الكامل على الراتق، الذي حوَّلها من جمهورية فعلية إلى مملكة عسكرية مغلقة، قضبانها ممدودة الطول مرفوعة الجوانب.
وإكمالًا على ما سبق، يتناول الكاتب المرموق والمؤرخ صلاح عيسى إشكالية الثقافة في المملكة العسكرية باعتبارها “سمة محددة”، فيقسم المثقفين إلى مثقفين للسلطة ومثقفين للمجتمع، وعلى الأغلب مصير مثقفي المجتمع إما التضييق أو الفصل أو السجن والإعدام، مثل حالتي سيد قطب وشهدي عطية اليساري. أي بعبارة أخرى، تحولت مصر ما قبل النكبة المدمرة لملامح الدولة والمجتمع، إلى ما يشبه الجثة المخطوفة عنوة من أهاليها، بآثار مستمرة انتهت بالتخلي عن القضية الفلسطينية تمامًا بكامب ديفيد، اتفاقية العار والخزي، وأخيرًا إجهاض ثورة يناير ٢٠١١، والسيرك السياسي المنصوب يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣م.
مصر من حاضنة إلى مقبرة دائمة لأولادها… النكبة الثانية على مدار ١٢ عامًا.
كشأن المنظر المأساوي عقب القصف الإسرائيلي للطيران عام ١٩٦٧، نزلت صور المركبتين المصدمتين الخاصة بحادث الطريق الدائري الإقليمي باعتبارها حادثًا دالًا على استمرار النكبة البادئة من ١٢ عامًا على وجه التحديد. فالحادثة مركبة ومعقدة لأبعد الحدود لتداخل عدة كوارث من السلطة الغاشمة والباطشة، واعتبار القانون الوحيد قانون الغابة، الذي سمح بالحكم بالإعدام على الرئيس السابق الشهيد محمد مرسي، الذي قال ذات مرة إنه يريد الحفاظ على الفتيات؛ فترك مرميًا ومحبوسًا حتى أتته المنية عام ٢٠١٩، وهرولوا بشكل سريع إلى جلاد جديد عام ٢٠١٣م.
في هذا الصدد، أكَّد بروفيسور العلوم السياسية والعلاقات المدنية العسكرية يزيد صايغ، في أكثر من دراسة موسعة منها المنشور في ١٢ مايو ٢٠٢٥ تحت اسم إعادة تشكيل الدولة المصرية عبر عمليات متعددة، أن هذه العمليات استنزفت المواطنين، فأضحت الجمهورية الجديدة مملكة عسكرية مطعّمة بنزعة نيوليبرالية متوحشة، غرضها الأساسي حصرًا زيادة ثروات الأغنياء عن طريق صياغة منظومة نهب وفساد فادح، ممزوج بغباء خالص وجهل مدقع عالِ الوتيرة، ينم بحق عن الروح الكاملة والمتجسدة لنكبة ٣٠ يونيو ٢٠١٣؛ من دون حتى الالتزام بإرث الأنظمة السابقة لها، سواء مبارك أو حتى السادات.
وبحق، لقد قزَّمت الجمهورية الجديدة كل شيء، بدءًا من روح القوانين والأخلاق، حتى المكانة الخارجية لمصر الشقيقة الكبرى، فلا سبيل إلا للسبوبة السريعة والثراء الفاحش، بعزل الفقراء الذين ينتجون ويحرقون حرقًا، ولا سعر كبير أو اهتمام بهم إلا عند التجارة الرخيصة بهم ونيل اللقطة السينمائية. من دون حتى أي رد فعل يُذكَر، لأن مصير أي شخص معلوم بالضرورة في الجمهورية الجديدة: فهو محجوز مستعبد إما طبقيًا أو تعسفيًا أو في المنافي. لتتبلور بذلك الشريعة الأهم والأحق في عهد السيسي: “أنت ميت حتى إثبات العكس”، لصالح النخب الفاسقة المجرمة التي تخدم بمنتهى الأريحية الواسعة والبذخ الفاحش.
فكما اختفى كل شيء في عهد مقدمات نكبة يونيو ١٩٦٧، تبخرت حتى قيمة الإنسان، فأصبح رخيصًا، يموت في كل زمان ومكان: في الأبنية والطرقات وعلى قارعة الطريق وفي الصحراء، تحت مسميات واهية وحجج أكثر وهنًا، غير أنها مثبطة بشكل منهك ومهلك. فالسكوت والركود المقيت الذي حدث سابقًا في النكبة الأولى بات أمرًا اعتياديًا، لأن الألم المشاهد والدماء المُراقة والقهر المتراكم حوَّلت النفوس إلى مسوخ مشوّهة ومصمتة كالجبال، فالتسلط والاستبداد والإفقار والتجويع الممنهج سمات دولة إحلالية تهدم نفسها بنفسها.
والمضحك المبكي أن الفقراء رُعِيَ بهم في عهد عبد الناصر أكثر من السيسي، الذي يستحقر المعارضين السياسيين والخبراء، وحتى الطبقة الوسطى، لأنهم يرون أنفسهم أسياد الدولة والناس، فوق المحاسبة والقانون. فهي كما قالت الفيلسوفة حنة أرندت في كتاب الأصوليات: إن الديكتاتورية العسكرية “مميتة للفرد، مهشمة للمجتمع”. فيصبح الموت السمة الأساسية والمناخ السائد، لأن الأصنام العسكرية التي لا تفقه غير الضبط والربط والالتزام، تُحوّل الدولة كلها إلى مفهوم السجن المشدَّد، في جميع لحظات الحياة اليومية منذ الاستيقاظ وحتى النوم، غير تحولها إلى درع قديم ورديء.
فكما أكَّد الباحث ماجد مندور في كتابه مصر في عهد السيسي: أمة على حافة الهاوية، أن مصر انهارت على كافة الأصعدة والمستويات المتباينة، فأضحت البلد، كما في كتاب ميشيل فوكو العقاب والالتزام، دولة عشوائية، ما يجدر معه النظر إلى الحلول الواردة من غزة والجزائر في تلك التجربة الاحتلالية، أي ما تفرعت تصنيفها. الثورة تبدأ من العقل وإزالة الخوف المتشرّب في العظام… غزة والجزائر أنموذجان.
في كتابه معذبو الأرض يخبرنا المنظّر الأساسي للثورة الجزائرية فرانز فانون، أن أولى خطوات التحرر الفعلي من الاستعمار الخارجي أو المحلي تبدأ من الإدراك الفعلي والاحتكاك المتبادل والقريب مع السياسة الداخلية اليومية، ليس حبًا فيها، بل لأنها تأتيك إن لم ترغبها. وهذا ما حدث مرارًا وتكرارًا في مختلف الحوادث وتوفير العيش. حتى وإن انعزلت وتقوقعت حول ذاتك، فما مصيرك إلا أن تجد نفسك في الأخبار اليومية، إما سجينًا أو متوفيًا بأي حادثة طريق أو إهمال طبي.
بعد الإدراك العقلي، يجيء الدور على الخوف الأمني والشعوري، الحاكم للدول الديكتاتورية كافة بشتى أنواعها، باعتباره علاقة أصيلة بين الحاكم والمحكوم، لعلم الحاكم أنه في السلطة عنوة أو اغتصابًا بدرجة أولى، إما من أجندات خارجية، أو نتيجة تقاسم معين للسلطة، أو تحويلها إلى سلطوية تحكمها فئة معينة دون الأخرى، أو أقلّوية تحكم من أقلية عرقية أو دينية أو سياسية أو عسكرية. والخوف الشعبي، أو المُبسَّط بصورة مجملة، هو الخوف الأمني بطريقة أشبه بالالتصاق المحكم في الأرض، وهو ما أطلق عليه عالم الاجتماع الشهير بيير بورديو بـ”الخوف الرمزي”، أو “الخوف السائل” بتعبير زيجمونت باومان.
وهذا الخوف، التخلّص منه مرهق وصعب، لكنه يزيل الحدود الصلبة والاجتماعية والنفسية بين الحاكم والمحكوم، ليَعلم أن الحاكم ضئيل الحجم، صغير المقدار، مهتز العقل، مهزوز النفس. فضلًا عن بناء قاعدة واسعة وقوية لفكرة المقاومة، سواء سليمة أو غيرها. ولعل هذا ما نجحت فيه، بصورة مبهرة ومبهجة وخارقة، الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي، وغزة بمختلف الفصائل المقاومة في الاحتلال الإسرائيلي، مع الصبر الطويل والتفريح بالإيمان والمعاني الرفيعة التي حررتهم من أسر نفسية المحتل قبيل الاستمرار العملياتي ضدهم بقوة نادرة.
فالمشكلة المغلقة في مصر أن الجمهورية الجديدة متحللة وباطلة وشرنقة جوفاء فارغة. فبالتالي، يتعامل معها الناس باعتبارها نجاة فردية أو مؤقتة، أو فكرة الضعف أمام القوة الباطشة، بإغفال متعمد أو نتيجة الضغط. فإن لم نتعاون وننجُ جميعًا، ستغرق السفينة بأكملها. أو كما عبّر عنه عالم السياسة الهولندي دان إنييرغ في كتابه سقوط النظام الديكتاتوري: إن “الضغط السلطوي هادم بقوة لأسس الدولة من جذورها الماسكة والمحكمة”، دون حتى أن يجد الفروع الواصلة بالماضي أو بقاياه لمحاولة الإصلاح المُخفّف الطويل بعد زوال النظام نهائيًا أو تبخره، في حالة النظام السوري البائد، الذي أثبت فيه إخفاق الوسائل السلطوية.
فلا خير منتظر من وراء سلطويات عسكرية قمعية، طالما أن الرؤية الإجمالية والعامة لها جبانة، عاجزة، غير قادرة، لأنها تسير على طريق ذي اتجاه مميت، مع العلم الجازم بأن الخوف السلطوي نفسي، ينبع من الخوف من التغيير الأفضل للحرية. فالحرية في تلك الحالة القوية تهدد بتبدد الدولة كليًا بمنطق الحاكم وحاشيته. وهو ما حدث مع الأنظمة الفاشية والنازية، بالتدمير الممنهج والخراب الشامل الذي انطلق من السكوت وإغلاق المجال العام كليًا، لتتمكن النزعة التدميرية منها، بحد تعبير إريك فروم. ولا سبيل للفرار منها غير بالانطلاق المنظّم والمنهجي نحو التغيير الدراماتيكي لمستقبل مشرق.