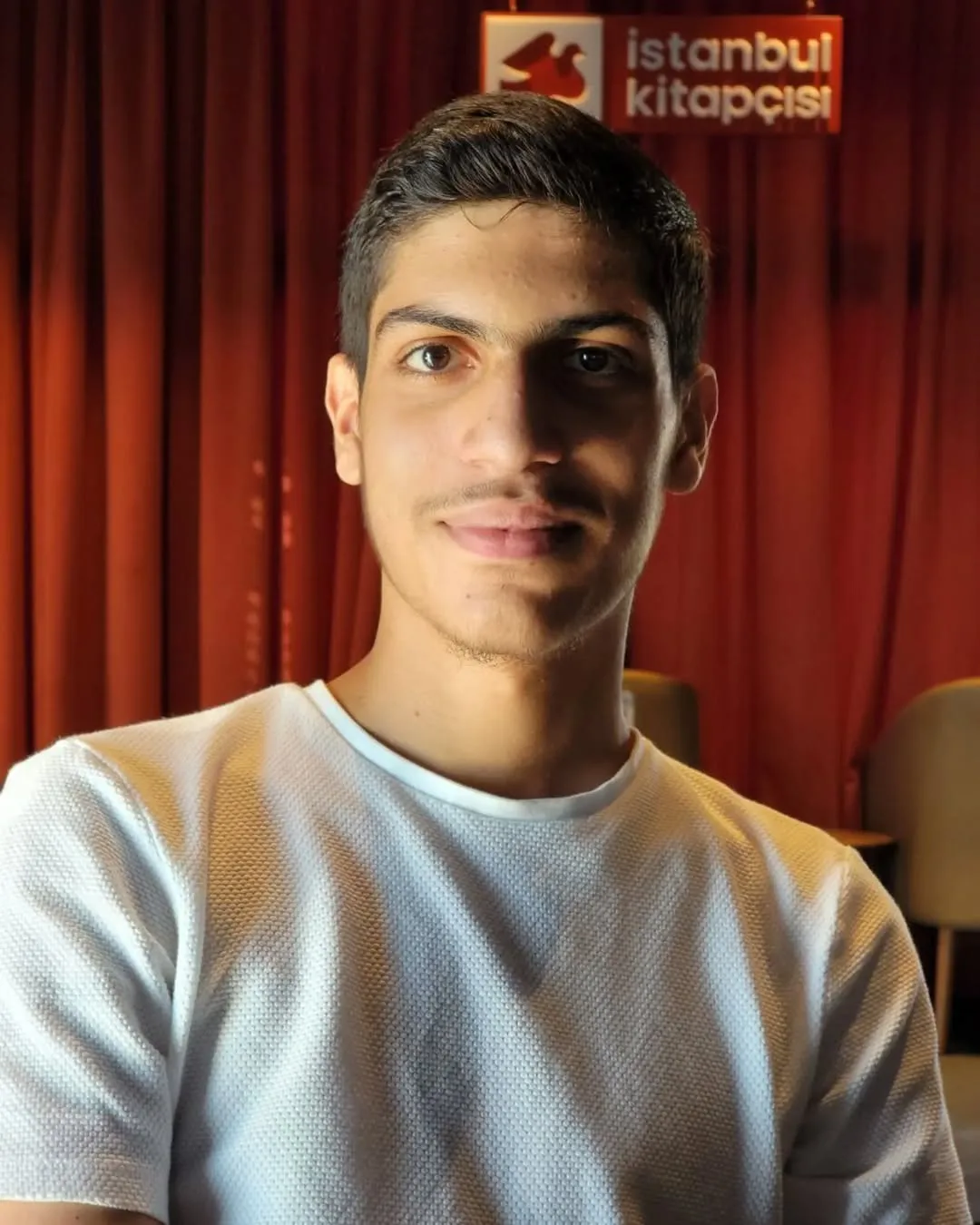سياسة
الموقف الشعبي السوري من إيران: بين مشروعية الألم واتهام التشفّي
الموقف الشعبي السوري من إيران: بين مشروعية الألم واتهام التشفّي
في كل مرةٍ تتعرض فيها إيران لهجومٍ أو خسارة، يتجدّد المشهد ذاته على المنصات: سوريون يعبّرون عن فرحهم، وعن شعورٍ بشيء من “شفاء الغليل”، وعربٌ كثر ينتقدونهم. بعضهم يتهمهم بانعدام الإنسانية، وبعضهم يعتبرهم أداة في حرب إعلامية ضد “محور المقاومة”. لكن قلّةً فقط تطرح السؤال الأخلاقي الأعمق: هل من حقّ السوري الذي قُتل أهله وهُدم بيته وعُذّب في السجون على يد حلفاء إيران أن يفرح بضعفها؟ هل يُلام الجريح إذا تمنى انكسار جلاده؟
العداء السوري الشعبي لإيران ليس موقفاً أيديولوجياً أو ناتجاً عن تحريض خارجي، بل هو نتاج مباشر لتجربة ملموسة ومروّعة، جُبلت بالدم والخذلان. ومع أن الموقف السوري خسر دوره في التأثير على صياغة السياسة الإقليمية، إلا أن صداه بات مسموعاً، وبات يشكّل إحراجاً لصورة إيران في الرأي العام العربي، بل يكشف هشاشة الخطابات التي كانت تحاول تلميعها باسم “المقاومة”.
في هذا المقال، نقترب من هذه الهوّة بين مشروعية الألم واتهام التشفّي، ونحاول فهم كيفية مساهمة الموقف الشعبي السوري من إيران في زعزعة مكانتها الأخلاقية على المستوى العربي، وما الذي يقوله هذا الموقف عن الذاكرة والعدالة والانتماء في زمنٍ مضطرب.
عمامة الجلاد:
الموقف الشعبي السوري من إيران لا يمكن فهمه ضمن ثنائية “مع محور المقاومة أو ضده”، ولا ضمن التصنيفات الطائفية التي تُفرغ كل غضب من محتواه السياسي والإنساني. بل هو موقف تشكّل عبر سنوات من الدم والحصار والتجريف، وعلى وقع التدخل الإيراني المباشر في إحدى أعقد المآسي الإنسانية في القرن الـ 21.
منذ بدايات الثورة السورية عام 2011، لم تكن طهران مجرد طرف متعاطف أو داعم سياسي للنظام، بل سرعان ما تحولت إلى ركيزة أساسية في بقائه. بحسب تقديرات معهد دراسات الحرب (Institute for the Study of War)، فإن إيران بدأت منذ 2012 بإرسال عناصر من الحرس الثوري إلى الداخل السوري، قبل أن تنشئ شبكة واسعة من المليشيات العابرة للحدود مثل “لواء فاطميون” (من أفغانستان) و”زينبيون” (من باكستان)، فضلاً عن مشاركة واسعة لحزب الله اللبناني في معارك مفصلية مثل القصير والقلمون.
وقد وثّقت عدة منظمات حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش والشبكة السورية لحقوق الإنسان، تورط هذه التشكيلات في عمليات تطهير طائفي، وتهجير قسري، ومجازر مروّعة، أبرزها ما جرى في ريف دمشق ودرعا وحلب، بما في ذلك عمليات إعدام ميداني، واحتجاز تعسفي، وتهجير كامل لمدن وبلدات تحت مسمى “المصالحات”.
ترافق ذلك مع مشروع أعمق وأخطر، هو إعادة تشكيل البيئة الديمغرافية والمذهبية في محيط دمشق وسهل الغاب وحمص. وقد أشار تقرير كارنيغي عام 2017 إلى أن النفوذ الإيراني في سوريا لم يكن عسكرياً فقط، بل أيضاً اجتماعياً وثقافياً، عبر نشر شبكات دينية وتعليمية تدعم التشييع الرمزي، وتقديم خدمات بديلة في مناطق النفوذ، مما زاد من شعور السوريين بأن هناك “احتلالاً ناعماً” يجري على أنقاض مدنهم المنكوبة.
أمام هذا الواقع، لم يعد السوريون يرون في إيران “حليفة للنظام”، بل شريكة في القتل والخذلان. المظلومية التي لطالما روّجت لها طهران في خطابها الرسمي، كمظلومية الشيعة بعد كربلاء، تحوّلت في الوعي السوري إلى أداة تم استخدامها لتبرير المجازر. فبدلاً من أن تكون إيران “ضحية تاريخية تقف مع ضحايا الحاضر”، باتت في نظر ملايين السوريين أحد الجلادين.
وما يزيد الأمر حدّة أن هذا العداء لم يتشكل في مناطق المعارضة وحدها، بل امتد حتى إلى داخل مناطق النظام، حيث بات يُنظر إلى إيران كقوة تفرض أجندتها على السيادة السورية، وتضع يدها على القرار الأمني والسياسي، مقابل حماية رأس النظام. هذا الشعور لا تعكسه المظاهرات فحسب، بل أيضاً المواقف المتكررة من شخصيات علوية ومسيحية ودرزية عبّرت عن امتعاضها من تحويل سوريا إلى ساحة صراع إقليمي تخدم فيه إيران أجندتها النووية والدولية على حساب مصالح الشعب.
إن هذا العداء الشعبي، المتجذّر في الذاكرة والواقع، لا يمكن محوه بسهولة من خلال قناة ناطقة بالعربية، أو دعم ظرفي لفصيل فلسطيني، أو خطاب رسمي يتحدث عن “وحدة الصف الإسلامي”، فالجراح لا يبرئها الكلام، والضحايا لا تنساهم الشعوب حين لا يأتيهم اعتذار ولا تعويض.
ذاكرة لا تُدفَن:
لم يبقَ الموقف الشعبي السوري من إيران حبيس القلوب أو الجدران الصامتة، بل خرج إلى العلن في كل مناسبة وساحة ومقام، متحوّلاً من شعور خاص إلى تعبير جماعي مفتوح عن الغضب والخذلان. وما بدأ كهتافات في الميادين، تحوّل مع الزمن إلى موقف سياسي وأخلاقي صريح، يتكرّر حضوره في الوعي والوجدان كلما طُرحت إيران كفاعل في أي قضية إقليمية.
منذ لحظات الثورة الأولى، لم يتردد السوريون في تسمية الأشياء بأسمائها. كانت الهتافات ضد إيران حاضرة إلى جانب الهتاف ضد النظام، رافضةً التواطؤ والمليشيات القادمة من خلف الحدود. شعارات مثل “إيران برا برا… سوريا حرة حرة” لم تكن مجرد كلمات، بل إعلاناً مبكراً عن إدراكهم لطبيعة التحالف الدموي الذي يتشكّل ضدهم.
وحين دخلت إيران بكل ثقلها إلى المعركة، عبر الحرس الثوري ومليشيات حزب الله وفاطميون وزينبيون، لم يعد الغضب السوري بحاجة إلى تفسير. أصبح وجود إيران العسكري والرمزي في سوريا قريناً للدمار، وارتبط اسمها في المخيال العام بمجازر وأحياء مدمّرة وخرائط سكانية تغيّرت بالقوة.
وحين سقط قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، لم يلتزم السوريون الصمت. في الوقت الذي كانت فيه شاشات عربية تبكيه كـ”شهيد المقاومة”، امتلأت منصات السوريين بعبارات الشماتة والغضب المكبوت. لم يكن الاحتفاء بموته فرحاً بالموت ذاته، بل بما يمثّله من انكسار رمزٍ ساهم في قتلهم وتشريدهم. كان التشفّي، بهذه الحالة، تعبيراً عاطفياً عن عدالة غائبة، وردّ فعل على سنوات من الانتهاك بلا حساب.
وفي كل مرة تتلقى فيها طهران ضربة أو تهتز صورتها، يعيد السوريون الكرّة: منشورات ساخرة، دعوات رمزية للفرح، ومشاركة كثيفة لأخبار تُظهر ضعف إيران أو انكشاف نفوذها.
قد يُقرأ هذا في الخارج على أنه قسوة، لكنه في الداخل السوري يُفهم كتنفّسٍ من تحت الركام. فحين تُسحق المدن وتُحرق البيوت وتُباد العائلات، لا يبقى للضحايا سوى اللغة، والذاكرة، وردود الفعل المؤجلة.
حتى على مستوى التمثيل الرمزي، أظهر السوريون رفضاً حاسماً لكل ما يرتبط بإيران: أعلامها، شعاراتها، قنواتها الإعلامية، وحتى أذرعها الثقافية في مناطق النفوذ. لا في الشمال السوري وحده، بل حتى في مناطق النظام ذاتها، بدأ هذا الرفض يتسرّب من الجدران إلى الكلمات، ومن الخوف إلى التعبير الخافت.
هذا العداء الشعبي إذن ليس خطاباً سياسياً لحظياً، بل سردية متماسكة بُنيت على التجربة والدم، وهو ما يجعل نبرته اليوم واضحة وحاسمة، ويجعل من محاولات تطبيعه أو احتوائه ضرباً من العبث السياسي. فالسوريون لا يرون في إيران طرفاً مجاوراً له مصالح، بل طرفاً شارك في الجريمة، وما تزال ذاكرته حيّة في وجوه الأطفال، وخرائط المقابر، وجدران البيوت المهدّمة.
صدام السرديات:
ليس الموقف السوري من إيران معزولاً عن محيطه العربي، بل يتقاطع معه ويحرجه أحياناً، ويكشف التباين الحاد بين سردية الضحية وسرديات المصالح والتحالفات والخطابات الكبرى. فمنذ أن بدأ السوريون يعبّرون عن عدائهم الصريح لإيران، واجهوا نوعين متضادين من الردود العربية: لومٌ أخلاقي من جهة، وتفهّمٌ عاطفي أو سياسي من جهة أخرى.
يظهر هذا التباين جلياً عند كل لحظة تتعرض فيها إيران لضربة أو أزمة: قصف منشأة، اغتيال قائد، احتجاج داخلي. حينها، تفيض المنصات بردود فعل سوريّة تعبّر عن الفرح أو الارتياح، فيقابلها قطاع من الجمهور العربي باتهامات تتراوح بين القسوة، وانعدام التعاطف، والانخراط في مشروع “معادٍ للمقاومة”.
في المقابل، يردّ البعض الآخر من العرب بالتفهم الكامل لموقف السوريين، معتبرين أن من عاش التجربة لا يُنتظر منه أن يكون متوازناً أو محايداً في وجه الجريمة.
الانقسام العربي حيال هذا الموقف يعكس صداماً أوسع بين الرؤية الأخلاقية للتاريخ والبراغماتية السياسية. فبينما ما تزال قوى سياسية وإعلامية عربية تتبنى خطاب “محور المقاومة”، يخرج الموقف السوري الشعبي ليقول إن المقاومة لا تُبنى على جثث المدنيين، ولا تُبرّر الاحتلالات المتعددة للبلاد باسم مشروع أكبر.
هذا التصادم في السرديات يُنتج في كثير من الأحيان ارتباكاً داخل المشهد العربي نفسه. إذ يصعب حتى على المراقبين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية مثلاً، أن يبرّروا دعمهم لإيران أمام من عاشوا تحت قصفها، أو رأوا مليشياتها تطوف في شوارعهم. وهو ما يخلق فجوة تتسع يوماً بعد يوم بين الخطابات السياسية المؤدلجة، وبين المواقف النابعة من معاناة حقيقية.
بعض المثقفين العرب كتبوا بوضوح في هذا السياق، مؤكدين أن من حق السوريين أن يغضبوا، وأن يُظهِروا فرحهم حتى إن بدا ذلك قاسياً. فالضحايا ليسوا ملائكة، ولا يُطلب منهم أن يكونوا أخلاقيين في وجه جلادٍ لم يُحاسَب بعد. هذا الاعتراف لا يُقلّل من قيمة القضايا الكبرى، بل يعيد ترتيب أولوياتها: فلا مقاومة حقيقية من دون احترام الإنسان أولاً.
إن الموقف السوري من إيران إذن لا يضعف موقعها في المنطقة بقدر ما يضعف صورتها الرمزية. فحين تتكاثر الأصوات التي ترفضها شعبياً، يصبح من الصعب الدفاع عنها أخلاقياً، حتى لمن يؤمنون بمشروعها السياسي أو يشاركونها أعداءها.
حلفاء بلا جماهير:
في العقود الماضية، حرصت إيران على أن تبني صورتها الإقليمية بوصفها “نصيرة للمستضعفين” و”حاملة لواء المقاومة”، مستخدمة خطاباً ممانعاً حاداً، وتحالفات عابرة للحدود، وأذرعاً إعلامية ناطقة بالعربية. لكنها لم تدرك أن صورتها الأخلاقية في الوجدان العربي لا يمكن فصلها عن سلوكها الميداني في سوريا.
لقد كان للحضور الإيراني في سوريا ثمنٌ معنوي، لم تدفعه طهران فقط على طاولة السياسة، بل في ساحات الرأي العام. فمنذ أن بدأ السوريون برواية تجربتهم، وتوثيق ما عانوه من جرائم ترتبط بإيران بشكل مباشر أو غير مباشر، بدأ هذا الثمن يظهر على شكل تآكل بطيء لصورة إيران في الخيال العربي الشعبي.
جيل عربي بأكمله، خاصة ممن وُلدوا أو تشكل وعيهم بعد 2011، لم يعرف إيران بوصفها الدولة التي دعمت حزب الله في حرب تموز، بل داعمة لنظام قصف شعبه بالبراميل، وشريكة في حصار المدن وتجويعها. وهذا التحوّل لم يكن ناتجاً عن دعاية مضادة، بل عن سيرة حقيقية مكتوبة بالدم والخذلان.
انعكس ذلك تدريجياً في خطاب الإعلام العربي، وخصوصاً في المنصات الجديدة التي يقودها شباب عرب متحررون من ثقل الأيديولوجيا. صار صوت الرفض أكبر، وبدأت تنتشر مواقف عربية تضع إيران في خانة واحدة مع قوى الاحتلال الأخرى.
حتى في القضايا التي كانت تمنح إيران شرعية عاطفية كفلسطين بدأ الصوت العربي يميّز بين الدعم السياسي والمصلحة الاستراتيجية. باتت إيران تُسأل عن نواياها، وعن انسجام خطابها المقاوم مع فعلها في سوريا والعراق واليمن.
ربما لم يؤثر الموقف الشعبي السوري في قرارات الدول، لكنه غيّر المعادلة الرمزية، فما عادت إيران تحتكر الحديث باسم العدالة أو الكرامة. لقد خسرت شيئاً أعظم من الحلفاء: شرعية القول الأخلاقي. وإن كان للضحايا من قوة، فهي قدرتهم على إرباك الصور، وتعطيل الروايات الكبرى، وتذكير العالم أن العدالة لا تُختصر بخريطة الصراع، بل تبدأ من الإنسان، ومن الدم الذي لا يُنسى.