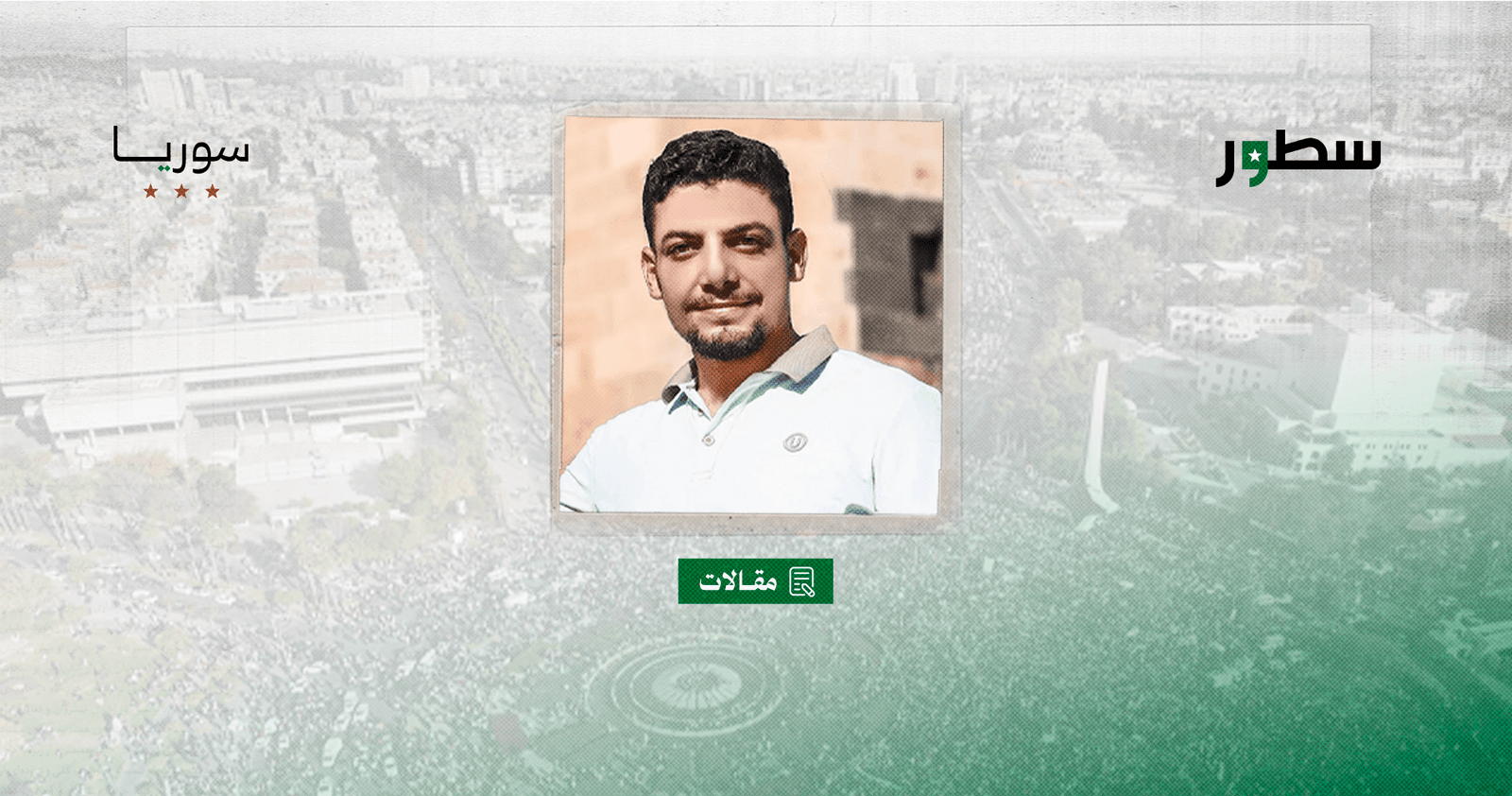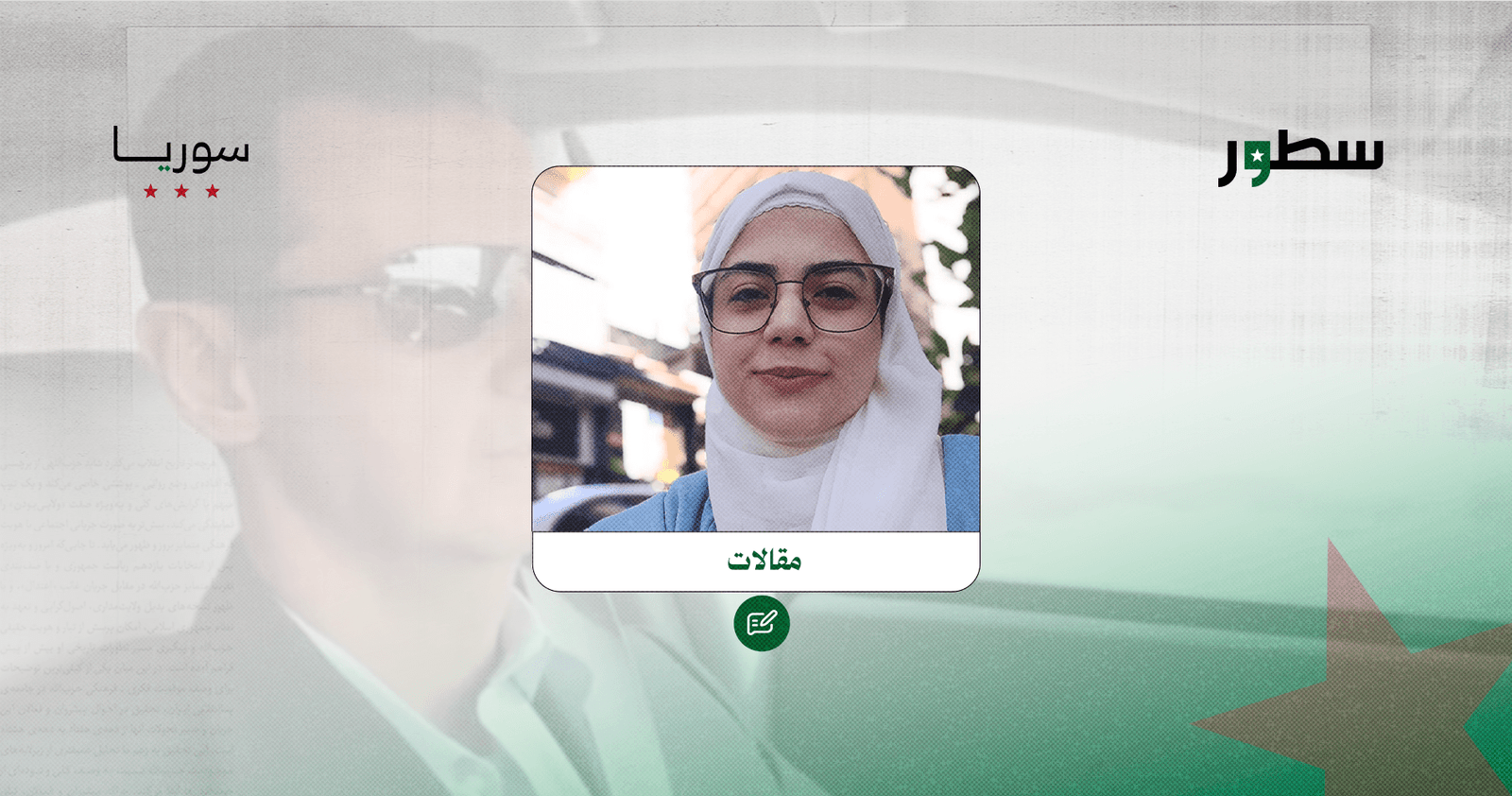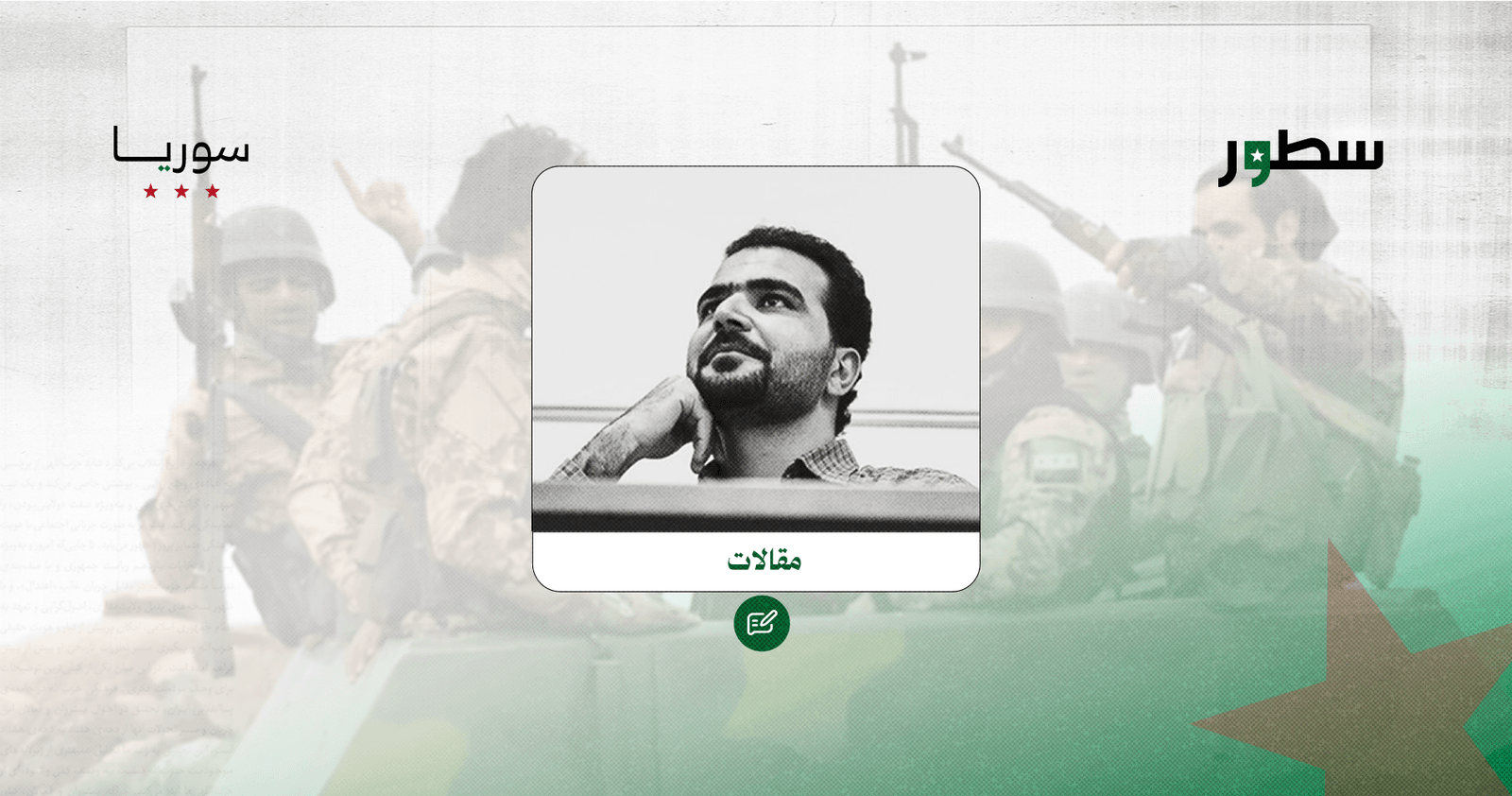مجتمع
بين العدالة الاجتماعية والمظلومية المجتمعية
بين العدالة الاجتماعية والمظلومية المجتمعية
لم يسلم أي مكون من مكونات المجتمع السوري من التهميش بطريقة ٍأو بأخرى في عهدي نظام الأسدَين ومن أساليبهما الانتقامية، إذ تحول الوطن إلى سجن كبير، تتفرع عنه سجون صغيرة جمعت مختلف فئات المجتمع، ما ولّد شعوراً جمعياً بالظلم أو المظلومية المجتمعية.
يسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على مظاهر المظلومية المجتمعية في سوريا، من خلال تتبّع أسبابها قبل الثورة وخلالها، وتحليل آثارها النفسية والاجتماعية والسياسي.
ما هي المظلومية المجتمعية؟
المظلومية المجتمعية حالة جماعية من الشعور العميق بالظلم المتراكم، تنشأ عنزمما تتعرض فئة أو أكثر من فئات المجتمع لظلم ممنهج، أو إقصاء، أو الانتهاكات، دون اعتراف كافٍ أو إنصاف عادل. تنشأ هذه المظلومية حين يُحرم أفراد هذه الفئة من حقوقهم الأساسية، أو يُعاملون كمواطنين من درجة أدنى، أو تُمارَس ضدهم سياسات عنف أو تمييز مباشر أو غير مباشر، ما يؤدي إلى تراكم شعور جماعي بالغضب، والانفصال عن الدولة أو المكونات الأخرى للمجتمع.
تُعدّ المظلومية المجتمعية أحد المفاهيم المفتاحية في فهم التحوّلات الاجتماعية والسياسية في السياقات التي تشهد قمعاً ممنهجاً وانتهاكات مزمنة لحقوق الأفراد والجماعات. وفي الحالة السورية، تبرز هذه المظلومية كعنصر بنيوي، تشكّل على امتداد عقود من التسلط الأمني، والتهميش المناطقي، والتمييز الاقتصادي، وغياب العدالة.
عُرفت سوريا، منذ سبعينيات القرن الماضي، بنظام حكم قائم على مركزية السلطة وتغوّل الأجهزة الأمنية كانتشار أفرع الأمن في الأحياء السكنية وانتشار رجال المخابرات في الأسواق والشوارع العامة، ما أدى إلى تشكل بيئة سياسية واجتماعية تتّسم بالقمع وغياب المساءلة القانونية أو توظيف القانون بما يلائم سياسات نظام الأسدَين، ولم يقتصر على المعارضين السياسيين فحسب، بل شمل المجتمع بمجمله، من خلال آليات رقابة صارمة على التعبير، وتقييد العمل المدني، وتفريغ الحياة العامة من الفاعلية السياسية، ولم يكن الاعتقال إجراءً أمنيًا فقط، بل ممارسة ممنهجة لتغييب المعارضين، وإرهاب أسرهم ومجتمعاتهم، ما جعل التجربة الأمنية تجربة جماعية لها آثارها المستدامة نفسياً واجتماعياً.
تهميش الأعراق المختلفة ثقافياً واجتماعياً:
لم يقتصر القمع على تقييد الحرية السياسية فقط، بل طال الحرية الثقافية لبعض المكونات السورية كالأكراد والشركس والتركمان وكان له أثر كبير عليهم وعلى المجتمع.
وعلى المستوى الثقافي والاجتماعي، أدت سياسات التوحيد الإجباري للهوية دوراً في إقصاء المكونات غير العربية، من الحقوق الثقافية واللغوية، وفرضت سردية وطنية أحادية لا تعترف بتعددية المجتمع السوري.
تعيش مكونات المجتمع السوري في مجتمعات منغلقة على نفسها نوعاً ما، إذ تسكن كل جماعة أو مكون بقرب بعضها البعض، فنسبة كبيرة من الكُرد والتركمان يسكنون في ريف حلب الشمالي والغربي وتستقر نسبة كبيرة من الكرد في الجزيرة السورية (الرقة، الحسكة، القامشلي) وأحياء محددة في حلب المدينة ودمشق، ويسكن التركمان أيضاً في جبال اللاذقية الحدودية مع تركيا، ما يعني توزعهم جغرافياً بأماكن متفرقة لكنهم اجتماعياً يعيشون في دوائر ضيقة ومحددة، ويصنف الكُرد ثاني أكبر مكون عرقي في سوريا ويليهم التركمان. وعن توزع الطوائف الدينية يسكن الدروز في الجنوب السوري في السويداء وأحياء من دمشق، والطائفة العلوية في الساحل السوري ومناطق محددة من مدينة حمص، وطوائف وأعراق أخرى يسكنون أماكن مختلفة في قلب المدن لكن بنسبة أقل كالشركس والأرمن والسريان والمسيح، قد يبدو الأمر غريباً لشخصٍ غير سوري يقرأ هذا الكلام، لكنه يصبح مفهوماً عندما نفكك الأسباب ونحاول فهمها.
عانى الكُرد والتركمان والشركس في سوريا من تهميشٍ متعمد خلال فترة حكم الأسدَين إذ أجبروا على طمس هويتهم ولغتهم ومنعوا من ممارسة تقاليدهم وثقافتهم حتى، فلا احتفالاتٍ قومية ولا إحياء لذكرى أحزانهم أو تهجيرهم، ولا أي مساحة للتعبير عن الهوية والثقافة واللغة.
يذكر الصحفي والناشط الحقوقي الكردي كمال شيخو عن حالات منع منح الهوية السورية للمواطنين الأكراد كيف أصبح أفراد من العائلة ذاتها بعضهم سوري الجنسية وبعضهم أجنبي، وبالتالي سلبت حقوقهم في المواطنة ولم يحصلوا على حقوقهم كالهوية والتعليم والسفر، ما يعني إقصاءهم عن المجتمع قبل السياسة. ويذكر كيف وصل التضييق إلى اختيارهم أسماءهم، فيقول إن لدى معظم الأكراد اسمان؛ في الهوية اسم عربي، وفي العائلة الاسم الكردي.
ولم يكن الريف السوري بمنأى عن هذا التهميش، إذ عانت مناطق دير الزور والرقة والحسكة ودرعا وإدلب من غياب مشاريع التنمية، وضعف في البنية التحتية، وندرة في الخدمات الأساسية، مما أدى إلى انتشار الفقر والبطالة والتهميش وانعدام العدالة التوزيعية للموارد والخدمات، بهذا أُجبر الكثير من أهالي هذه المناطق للسفر إلى مدن أخرى بحثاً عن فرص وظروف حياة أفضل، ولم يقتصر الأمر على العمل فحسب بل توسع ليشمل البنية التحتية لهذه المناطق.
بهذا المعنى، لم تكن المظلومية المجتمعية في سوريا ناتجة عن أحداث طارئة، بل كانت نتيجة بنية سياسية واقتصادية وثقافية متكاملة، تعتمد على إشغال المجتمع بأولوياته فقط وتقييده في صعوبات يفترض أنها بديهية ومن حق كل مواطن.
لم يمنح نظام الأسد امتيازات مطلقة لطائفة أو مكوّن بعينه، بل عمل على صناعة “طائفة أسدية” تقوم على الولاء الشخصي والمصلحة المادية والسياسية، بغض النظر عن الخلفية العرقية أو الطائفية. فكل من عارض هذا الولاء، كان عُرضة للتهميش أو القمع، بصرف النظر عن هويته.
وهكذا، تحوّلت العلاقة بين المواطن والدولة إلى علاقة قائمة على الخوف، والصمت، والإذعان، ما راكم شعوراً جماعياً بالعجز واللاعدالة، مهّد لانفجار اجتماعي في لحظة الثورة عام 2011.
الثورة السورية وأثار المظلومية المجتمعية:
شكّلت الثورة السورية عام 2011 لحظة مفصلية في تاريخ البلاد، إذ لم تكن مجرّد حراك عابر أو استجابة طارئة لموجة “الربيع العربي”، بقدر ما كانت تعبيراً عن تراكم عميق لمظلومية مجتمعية ممتدة، وصلت إلى حدود لم يعد من الممكن احتواؤها ضمن آليات القبضة الأمنية على المجتمع، فلم يكن خروج السوريين إلى الشارع بدافع سياسي فقط، بل تحت تأثير شعور جمعي متراكم بالانتهاك، والرغبة في استعادة الصوت الذي كتمه نظام الأسد لعقود.
قادت الثورة السورية جميع مكونات المجتمع من الأحرار وفئات كانت سابقاً على هامش الحقل السياسي كالشباب، النساء، سكان الأرياف، المهمّشين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً والذين وجدوا في الثورة فرصة لكسر بنية الخوف والمطالبة بحقوق أساسية طال إنكارها. ومن اللافت أن الشعارات الأولى التي صدح بها المتظاهرون لم تكن انتقامية، بل ركّزت على قيم الحرية والكرامة والوحدة الوطنية، وأشهر هذه الهتافات “الموت ولا المذلة ” ” واحد واحد واحد الشعب السوري واحد ” في تعبير واضح عن رغبة في إعادة تعريف العلاقة بين أبناء المجتمع ورغبة في صنع هيكلة جديد بين الدولة والمجتمع.
لكن النظام واجه هذه المطالب المشروعة بالعنف والاعتقال والتعذيب الجماعي، حيث أعادت الدولة إنتاج أدوات القمع القديمة نفسها، التي مارستها على مر عقود، وعلى رأسها الاعتقال والتعذيب، ولكن هذه المرة على نطاق أوسع وبصورة علنية وغير مسبوقة. فمع دخول الآلاف من المتظاهرين، بمن فيهم القُصّر والنساء، إلى المعتقلات، تحوّل ملف الاعتقال من وسيلة لضبط نخبة محدودة، إلى أداة قمع جماعية موجهة ضد المجتمع بكامله.
بهذا الشكل، لم تفتح الثورة باب الأمل فقط، بل كشفت كذلك حجم المظلومية المتجذّرة في المجتمع السوري، ووسّعت نطاق المتأثرين بها، لتشمل فئات جديدة من الضحايا الذين لم تكن لهم سابقاً تجارب مباشرة مع القمع. ومع استمرار القمع وتصاعد العنف، بدأت ملامح مأساة وطنية تتبلور، تجاوزت البعد السياسي، لتلامس عمق البنية الاجتماعية والنفسية للشعب السوري.
وكان لمسار الثورة السورية العسكرية ولما فرضته التغييرات التي طرأت عليها دور كبير في تفاقم حالة المظلومية، فتشكلت مجتمعات أكثر تتعرض للظلم، كالمناطق التي بقيت محاصرة مع القوى العسكرية، مثل المناطق التي حكمتها قوات سوريا الديمقراطية وما مارسته من انتهاكات وتغيير ديمغرافي في مناطق سيطرتها، والمناطق الذي حكمها الثوار-الفصائل المسلحة سابقاً- وما مارسته أيضاً من انتهاكات وتغيير ديمغرافي في بلداتٍ كردية في ريف حلب خصوصاً، شكلت هذه الممارسات خوفاً كبيراً بين فئات المجتمع وعززت الشعور بالظلم إذا تعرضت جماعات مختلفة تتشارك الهوية أو الدين ذاته إلى انتهاكاتٍ بشكلٍ اعتباطي وبدون إدارك على يد جماعات يفترض أنها تحمل المطالب ذاتها من الثورة.
غياب العدالة الاجتماعية في علم نفس الاجتماع:
تُعرف العدالة الاجتماعية بأنها التوزيع العادل للثروات والفرص والحقوق بين المواطنين.، ويشير مفهوم العدالة الاجتماعية إلى عملية قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية وحصولهم على ما يستحقونه اجتماعياً واقتصادياً.
تقول المختصة النفسية مرح الحموري إننا لنتمكن من فهم المظلومية المجتمعية لا بد من فهم الروابط التي تؤدي إليها وهي غياب العدالة الاجتماعية وتعزيز الهوية الجمعية والانتماء إلى الجزء عوضاً عن الكل، وتضيف أن النظام رسخ مفهوم الواسطة لا بمفهومها المادي فقط، بل بأن قيمة المجتمعات مرتبطة بقدر تقربها من السلطة، وسعى إلى زرع فكرة بأن كل مجموعة من مكونات المجتمع السوري هي أقرب إلى السلطة بما فيهم العلوية والسنة، مما زعزع ثقة المجتمع بحفظ مكانته ثم حقوقه داخل الدولة، وهذا أبعد ما يكون عن تطبيق العدالة الاجتماعية وإنما الفهم الاجتماعي لمكانة الجماعة لدى الدولة.
وهذه الممارسات ينتج عنها هوية جمعية أقوى على مستوى إيجابي وسلبي أو طائفي في الوقت ذاته، فكل مجموعة عندما تشعر بأنها مُعرضة للاضطهاد خارجياً تزداد روابطها الداخلية، فيصبح وصفها لجماعاتها وصفاً طائفياً بعيداً عن الوصف الأصح بأنهم مواطنون أولاً وجماعاتٍ مختلفة ثانياً، وترى أنه كلما ازداد التهديد للعدالة الاجتماعية، يزداد تعزيز الهوية الجمعية داخل المجموعة الواحدة وهذا يعني بالضرورة تحويل مشاعر الغضب الناتجة عن عدم العدالة إلى تعزيز المظلومية التاريخية باستدعاء أحداثٍ أو مآسٍ سابقة، فتصبح انتماءات الجماعة لمجموعاتها الصغيرة وليس للوطن، والمؤلم هنا بأن هذه السياسات كانت تطبق على كل الجماعات في سوريا.
هنا ندرك حجم الخلل في النسيج الاجتماعي الذي ورثه وسببه نظام الأسد، فلم يقتصر على مكونات المجتمع المختلفة فقط، بل كثرت الجماعات المنفصلة عن بعضها البعض وازداد الشعور بالظلم وهو مشروع في الحالات جميعها.
لا يمكننا الكتابة عن المظالم بحق المجتمع السوري دون التطرق لما عاشه المهجرون في المخيمات من تهميش وإقصاء عن الفاعلية في المجتمع أو حتى تقرير المصير، وظروف الحياة القاسية. وما عاشه أهالي المعتقلين والمفقودين، تقول أيضاً المختصة مرح الحموري: يعيش أهالي المفقودين حالة الفقدان الغامض لذويهم وما ينتج عن هذا الفقدان من صدماتٍ نفسية وشعور بالظلم، وتضيف لا يمكن لهذه الجراح أن تُشفى إلا بمساعدتنا لهم للوصول للعدالة والقصاص من المجرمين. ولأن ملف المعتقلين يُمثّل رمزاً قوياً للظلم البنيوي، فقد راكمت العائلات والأُسر المتأثرة رواياتٍ عن الإخفاء والاعتداء والتعذيب، ما خلق ذاكرة جماعية مؤلمة لا يمكن تجاهلها في أي عملية مصالحة أو بناء دولة مستقبلية. وعليه، يبقى الاعتراف بمعاناة المعتقلين ومعالجة آثار اعتقالهم خطوة لا غنى عنها لأي مسعى لإصلاح النسيج الاجتماعي واستعادة الثقة بين مكونات المجتمع والدولة.
خاتمة وإضاءات:
تراكم هذه الروايات المتوازية للظلم من دون منصة اعتراف أو مساءلة أو عدالة شاملة، جعل من العدالة الاجتماعية مطلباً معقّداً، لا يمكن تحقيقه بمجرد تحسين الخدمات أو توزيع الثروات. بل يتطلب قبل كل شيء اعترافاً متبادلاً بالمعاناة المتعددة، وبناء سردية وطنية لا تنفي أحداً ولا تستثني ألماً.
هكذا ندرك بأن العدالة الاجتماعية في سوريا ليست فقط قضية فقر وتمييز طبقي أو مناطقي، بل مسألة إعادة تعريف العلاقة بين السوريين أنفسهم بينهم وبين الدولة، والاعتراف بالمظلومية من دون استثمارها أو تسليحها سياسياً. سواء قبل الثورة أو أثنائها، لم يقتصر الشعور الجمعي بالظلم على الأذى المباشر، بل انسحب على البنية المجتمعية ككل، محدثاً شرخاً في العلاقة بين الأفراد والدولة، وبين المكونات الاجتماعية فيما بينها. إذ لكلٍ منا ذاكرته وسرديتهُ لمعاناته التي سببها إجرام الأسدين وكل من ارتكب انتهاكات بحق الأبرياء، لكننا الآن علينا أن نتشارك هذه الذاكرة المؤلمة نتشارك المعاناة ونكتبها ونحكيها، نحاول جميعنا كأفراد المجتمع والدولة بناء نسيج مجتمعي حقيقي يجمعنا على ما نتشارك به من قيمٍ وثقافة وتراث وتاريخ نكتبه جميعاً.