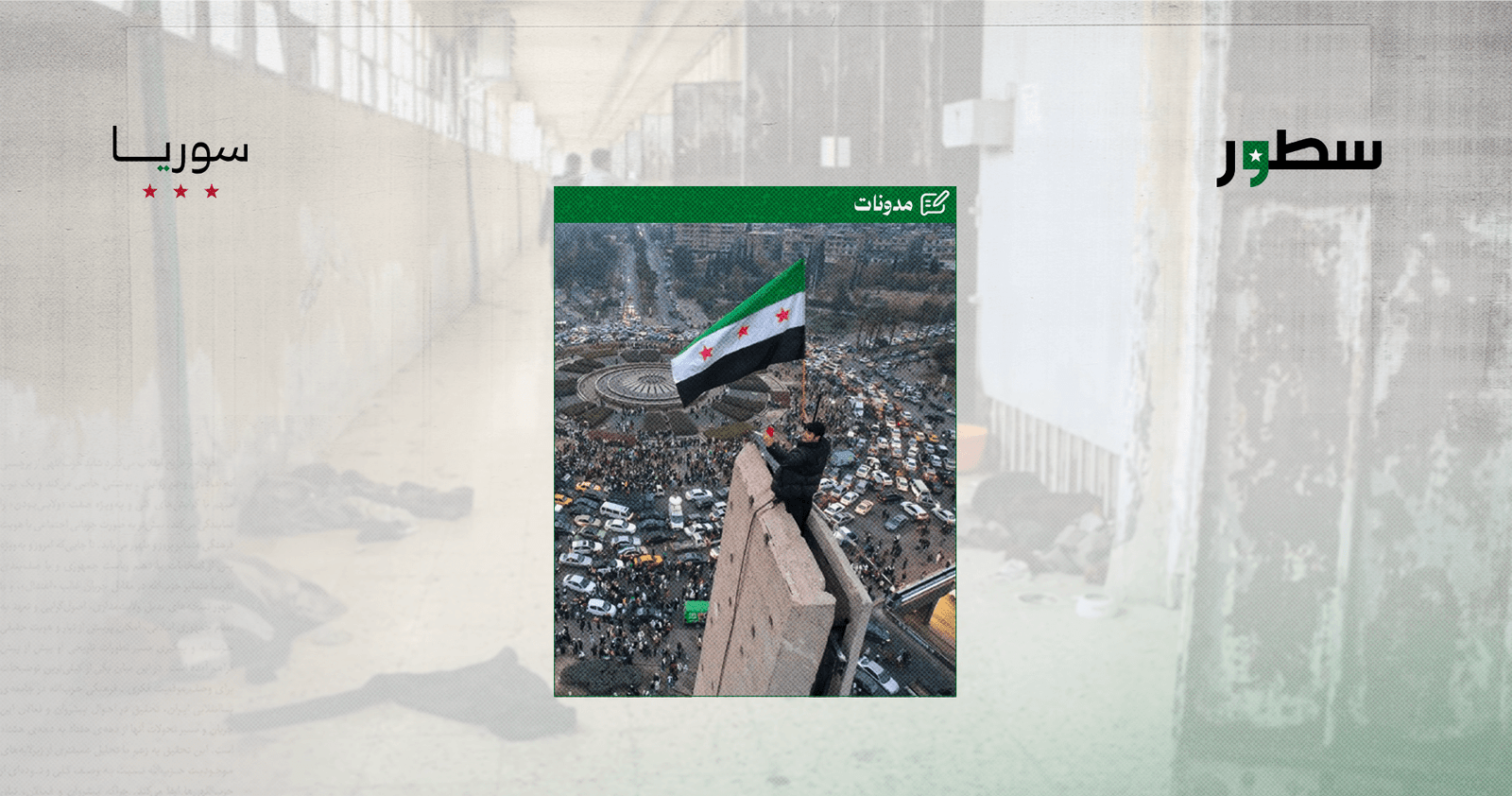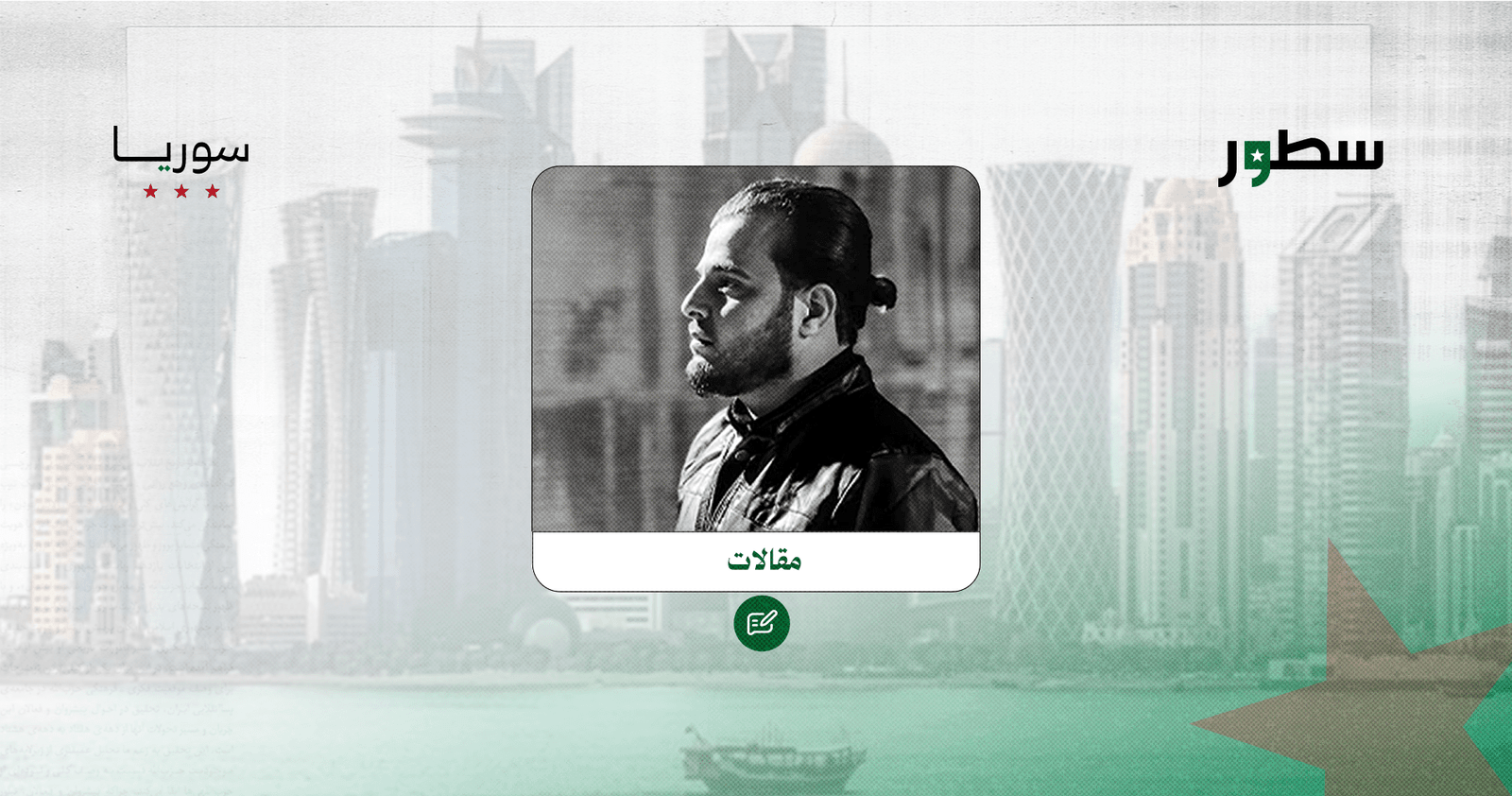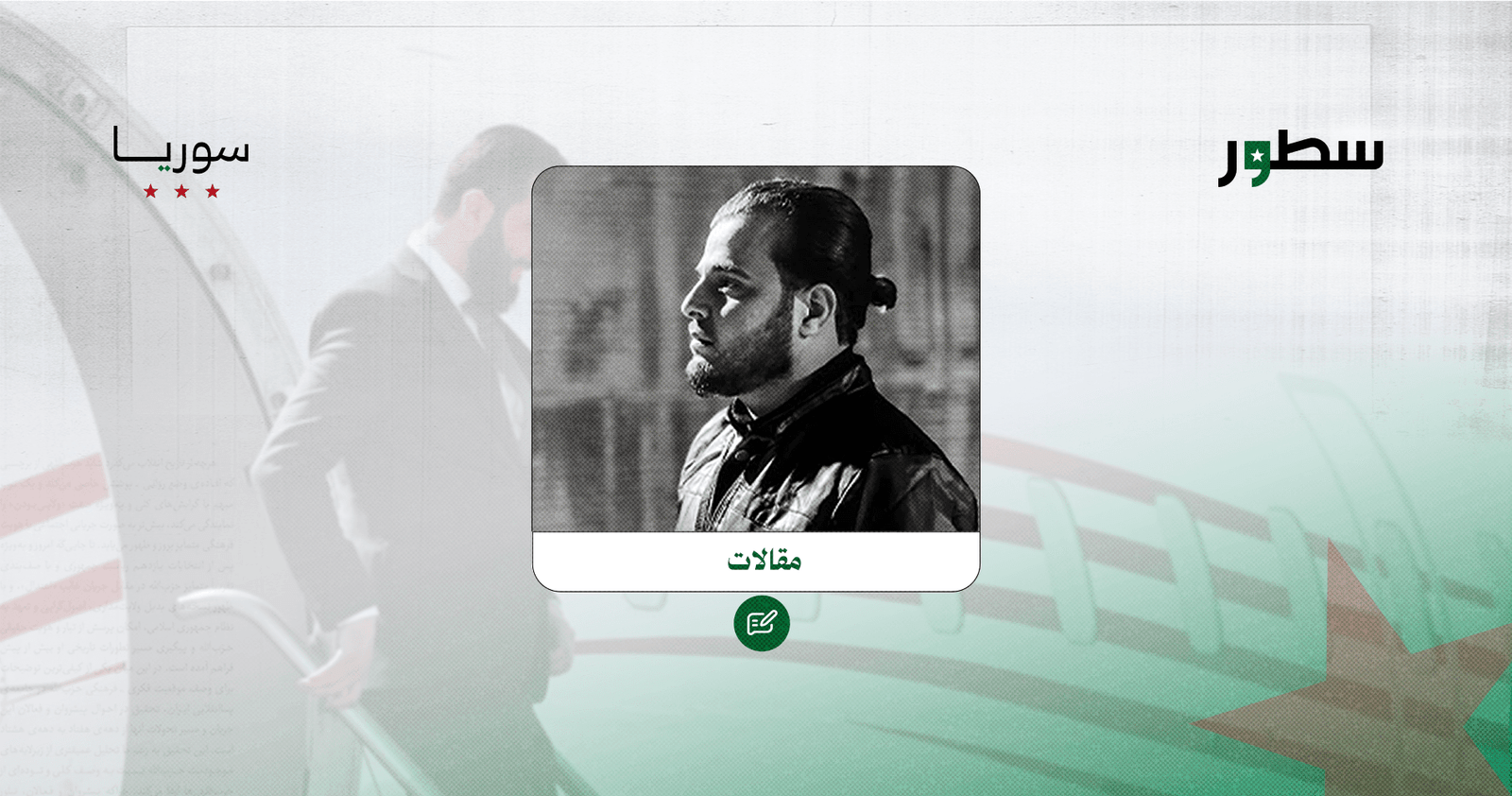مشاركات سوريا
حرب المياه في شمال سوريا: صراع البقاء في وجه العطش
حرب المياه في شمال سوريا: صراع البقاء في وجه العطش
تشهد مناطق شمال سوريا تحديات متفاقمة في مجال الأمن المائي، نتيجة تداخل العوامل البيئية مع تعقيدات النزاع والصراع على الموارد، لتتحول أزمة المياه خلال السنوات الأخيرة من قضية خدمية إلى ورقة ضغط جيوسياسية، فالبنية التحتية المتهالكة وسيطرة أطراف النزاع على منابع المياه ومحطاتها جعلت من العطش أحد وجوه المعاناة اليومية، كما وثّقت تقارير لمنظمات دولية ومحلية، منها تقرير صادر عن منظمة “هيفديستي” في أيلول/ سبتمبر 2023، وموقع “تلفزيون سوريا” الذي أشار إلى تفاقم أزمة المياه الجوفية في ريف حلب الشمالي بفعل الحفر العشوائي وتراجع معدلات الأمطار، أما صحيفة “العربي الجديد” فكشفت أن أكثر من 15 ألف شخص في جبل السماق بإدلب يعتمدون على صهاريج مياه مكلفة تُنقل من خارج المنطقة.
ووفقاً لتقرير لمنظمة اليونيسف (2023)، يعاني أكثر من 5 ملايين شخص في شمال سوريا صعوبة في الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة، ما ينذر بكارثة صحية في حال غياب الحلول المستدامة.
سنة جفاف: انهيار الموارد وتراجع الاستجابة
تظهر المؤشرات المناخية أن شمال سوريا يمر بسنة جفاف حقيقية، نتيجة انخفاض حاد في معدلات الأمطار وتراجع كبير في الموارد المائية، ووفقاً لما صرح به المهندس أنس الرحمون، المختص في أبحاث المناخ والبيئة والزراعة وعضو مركز الفلك الدولي، لموقع “سطور”، فإن كميات الهطول المطري خلال عام 2025 لم تتجاوز 60% من المعدل العام، ما انعكس على مستويات عدد من الموارد المائية الرئيسة مثل بحيرة ميدانكي في الشمال، وبحيرة الرستن في الوسط السوري، إلى جانب تدني تدفقات عين الزرقا وتوقف الضخ إلى سد البالعة، الذي يُعد مصدرًالري الأساسي لسهل الروج.
وأوضح الرحمون أن هذه الأزمة تتجاوز الطابع المناخي، إذ يفاقمها ضعف الاستجابة الطارئة من الجهات الرسمية والمنظمات المعنية، إلى جانب غياب الصيانة الفعالة للبنية التحتية، لا سيما فيما يخص السدود والمنشآت الحيوية، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تقتصر على عمليات ضخ محدودة من عين الزرقا نحو سد البالعة، وهي غير كافية لتلبية المتطلبات الزراعية القائمة.
وبشأن الحلول الممكنة، استبعد الرحمون إمكانية اللجوء إلى تحلية المياه في الظروف السورية الراهنة بسبب كلفتها العالية، وحاجتها إلى تقنيات واستثمارات كبيرة تصطدم بعقبات اقتصادية وقيود على استيراد المعدات، رغم التخفيف الجزئي للعقوبات، كما أشار إلى أن إعادة استخدام المياه الرمادية ما تزال غير مفعلة بشكل كافٍ، باستثناء مبادرات محدودة نفذتها بعض المنظمات، وسط غياب سياسة حكومية واضحة لتطوير هذا القطاع.
وأعرب الرحمون عن قلقه من الاستنزاف المتسارع للمياه الجوفية نتيجة الانتشار غير المنضبط لحفر الآبار، خاصة في المناطق الزراعية، حيث أشار إلى أن الآبار التي كانت توفر المياه على عمق 150 متراً باتت تتطلب الحفر حتى 200 متر للحصول على الكمية ذاتها ولفت إلى أن استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل المضخات ساهم في تسهيل الضخ، لكنه سرّع في الوقت ذاته من وتيرة الاستنزاف، في ظل غياب الرقابة القانونية والتنظيمية، محذراً من أن استمرار هذا النمط من شأنه أن يفضي إلى أزمة مائية أكثر تعقيدًا تهدد الزراعة والأمن الغذائي في شمال سوريا خلال السنوات القادمة.
نزوح مائي محتمل مرهون بتكرار سنوات الجفاف
رغم غياب مظاهر نزوح واضحة نتيجة أزمة المياه، يرى الباحث في الجغرافيا البشرية حمود ديب أن التحولات الديمغرافية المرتبطة بشح الموارد المائية ستتبلور تدريجياً في حال تكرار مواسم الجفاف، خاصة في المجتمعات الريفية المعتمدة على الزراعة البعلية.
وأوضح ديب لموقع “سطور” أن الريف السوري تاريخيًا كان الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية نظرًا لاعتماده على الأمطار، مضيفًا أن تراجع الهطول سيفضي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، ما قد يدفع السكان إلى الهجرة الداخلية نحو المدن في نمط يمكن وصفه بـ”النزوح المائي”، مشيراً إلى أن مناطق شمال سوريا كانت تسجّل أكثر من 600 ملم سنويًا، لكنها تشهد اليوم تراجعًا حادًا، وهو ما تظهر أولى علاماته في نضوب الآبار السطحية والاعتماد المتزايد على الآبار الجوفية، التي لا تتأثر بسنة جفاف واحدة بل بتراكم المواسم.
ومع انتشار الطاقة الشمسية بديل منخفض الكلفة لمضخات الديزل، ازداد الاعتماد على المياه الجوفية، ما يفاقم خطر الاستنزاف، خصوصًا في ظل استمرار التراجع المناخي، حيث سيضطر السكان إلى حفر آبار أعمق بتكاليف أعلى، مما يزيد الضغط الاقتصادي ويهدد الأمن المائي في المنطقة.
وعن التحولات الاجتماعية، يؤكد ديب أن تغيّر المناخ يعيد تشكيل الاستيطان البشري، إذ تميل المجتمعات إلى الاستقرار في البيئات الرطبة، بينما يُجبر الجفاف المتكرر السكان على الانتقال إلى مناطق أكثر ملاءمة، ما يخلق تحديات اقتصادية واجتماعية إضافية، ويشير إلى تعقيدات الجغرافيا السياسية بوصفها عاملاً مضاعفًا للأزمة، إذ تعتمد سوريا على أنهار عابرة للحدود تتحكم دول الجوار بمنابعها.
ويشدّد ديب على ضرورة ترسيخ ثقافة ترشيد المياه كخطوة أساسية لتحقيق الاستدامة، داعيًا إلى اعتماد سياسات دقيقة لتوزيع المياه وفرض عقوبات على الهدر، باعتبارها إجراءات ملحة لا ترفًا، على أن تواكبها جهود حكومية ومجتمعية شاملة.
إدلب تعتمد على المياه الجوفية وسط هشاشة متزايدة
في إدلب، يعتمد السكان بشكل شبه كامل على المياه الجوفية، بحسب رفيق حيدر، مدير مؤسسة مياه إدلب. وأوضح حيدر أن غياب المصادر السطحية الدائمة وتضرر البنية التحتية يفرضان تحديات كبيرة، تتطلب خططًا طويلة الأمد لمواكبة التوسع السكاني والعمراني.
المياه ورقة جيوسياسية
يرى الباحث السياسي جمعة لهيب أن أزمة المياه في شمال سوريا خرجت من إطارها الخدمي، لتصبح ورقة ضغط جيوسياسية بيد القوى المسيطرة على منابع الأنهار، ففي عام 2024، تراجع منسوب نهر الفرات إلى 244 م³/ث، وهو أقل من نصف الحصة المتفق عليها دوليًا، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء بنسبة 40% في الشمال الشرقي، ووفقاً للهيب، لم يكن هذا التراجع نتيجة طبيعية بل أداة ضغط تركية تجاه مناطق الإدارة الذاتية، ضمن صراع سياسي غير مباشر.
وأشار إلى أن سيطرة تركيا على منابع نهر عفرين منحها نفوذًا استراتيجيًا، خصوصًا في ظل هشاشة البنية المائية شمال سوريا، إلا أن الاتفاق الموقع في مارس/ آذار 2025 بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، فرصة لتفاوض متوازن حول تقاسم الموارد.
ورغم الآمال بتحييد المياه عن الصراع السياسي، يبقى التنفيذ الفعلي للاتفاقات مرهونًا بالإرادة السياسية، وسط الحاجة للانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة الموارد.
وفي المجمل، لم تعد المياه في شمال سوريا مجرد مورد طبيعي، بل تحوّلت إلى مرآة للصراع وتقاطع المصالح الإقليمية، ويبقى أمنها ركيزة لأي استقرار اقتصادي واجتماعي قادم.